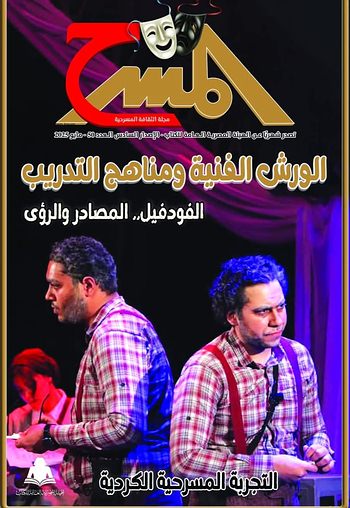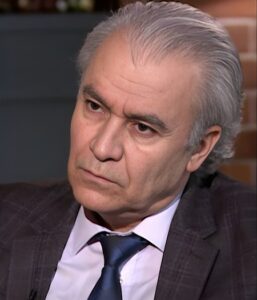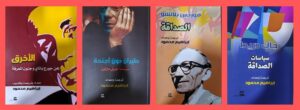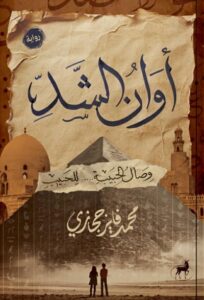أحمد اسماعيل إسماعيل
ثمة تأكيد عام على حضور السياسة في جميع مجالات حياتنا، خيراً كان هذا الحضور أم شراً، وإذا كان هذا صحيحاً، بهذا القدر أو ذاك، فإن حضور الفن في حياتنا أمر مؤكد، ومنذ بدء الخليقة، وقد تجلى ذلك، أول ما تجلى، في رسومات سكان الكهوف والرقص في المعابد، ولقد لجأ إليه الإنسان منذ ذلك الزمن لجعل حياته ممكنة العيش، وبشكل أجمل، ورغم اختلاف بنية المجالين وطبيعتهما؛ بل وتضادهما، إلا أن السياسة غالباً ما تتسلل إلى الفن وتمتزج فيه إلى حد يصعب الفصل بينهما، وخاصة في مجتمعات مقهورة مثل مجتمعاتنا، الامر الذي قد يحول المسرح، إن زادت جرعة السياسة فيه؛ إلى صخرة، والجمهور إلى جبل؛ والمسرحي إلى سيزيف.
قد يطول شرح موجبات هذا القول ودوافعه في حديث عن التجربة الكردية في المسرح، غير أن معرفة ذلك قد يساهم في تقريب معاناة التجربة الكردية في هذا المجال إلى ذهن المتابع العربي،
فرق وأحزاب:
ليس أدل من ارتهان التجربة الكردية في المسرح للسياسة؛ من ولادتها في سرير الأحزاب وأحضانها، فالجماعات المسرحية المنضوية ضمن الفرق الفولكلورية، والتي ظهرت دفعة واحدة بشكل فعلي تقريباً في نهايات السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الفائت، قد خرجت من معاطف الأحزاب، وتحت يافطة الرعاية لها، لتقلب بعدها، خلا استثناءات قليلة جداً، إلى وصاية.
قد تكون فرقة أزادي الفولكلورية هي السباقة في الظهور في الوسط الكردي، والتي تشكلت في مدينة دمشق من قبل بعض الشبان الكرد، وذلك سنة 1969، وكان للمسرح فيها قسمه الخاص به، الذي قدم فقرات ونمراً ومشاهد مسرحية قصيرة، وكما كان الحزب الديمقراطي الكردي، البارتي. راعي هذه الفرقة وحوذيها، فإن حزب الاتحاد الشعبي كان راعي فرقة كاوا التي ظهرت في تلك الأثناء، والحزب التقدمي الكردي راعي مواهب وعروض مسرحية قدم بعضها سنة 1973 .
ولم تستو هذه العروض فنياً، وتستوفي شروط العرض المسرحي إلا في بداية ثمانينيات القرن الفائت، ولقد تزامن في سنة 1981 تقديم عرضين مسرحيين، حمل الأول عنوان كاوا الحداد، تأليف وإخراج نذير شيخموس، أما العرض الثاني فقد كان بعنوان موت بطل الجبل من تأليف وإخراج الشاعر مروان عثمان، ليقدم الفنان محمد خليل بعد سنة في فرقة خلات، والتي أسست سنة 1978، مسرحية شعبية من تأليفه واخراجه حملت عنوان جتو، رفقة مجموعة من الفنانين أمثال الكاتب والفنان فواز عبدي والفنان إبراهيم احمد والفنان عبد المولى حسين. ليتزامن هذا العرض أيضاً مع عرض مسرحي آخر قدمته فرقة خاني الفولكلورية في السنة نفسها حمل عنوان خاني وخوديدا من تأليف وإخراج أحمد ناصر.
ومن اللافت للنظر أن عقد الثمانينات من القرن الفائت، شهد نهضة مسرحية كبيرة انتشرت فيها الفرق المسرحية في عموم المدن الكردية مثل: فرق خلات وخاني وبوتان ونارين وميديا في قامشلي، وحلبجه والحمامة المستقلة في مدينة الحسكة، وفرقة آشتي وجين وانكيزك وزوزان في مدينة عفرين…إلخ.
فعل السلطة ورد فعل الفرق المسرحية:
لم تتوان السلطات الشوفينية المتعاقبة في سوريا يوماً عن محاربة كل ما يمت للكرد أرضاً وشعباً، وكل ما يدعم ذلك فنياً وسياسياً، لقد حاربت اللغة الكردية شفاهة وكتابة، والتاريخ الكردي حاضراً وماضياً، والثقافة والفن الكرديين حتى في حفلات الزواج، وكل ما يمت للهوية الكردية وحاملها.
وكان من الطبيعي أن تجد هذه السلطة في ظهور الفرق الكردية تحدياً خطيراً لسياساتها الشوفينية، رغم تواضع المستوى الفني للفرق وتبعيتها للأحزاب الكردية.
وكالعادة، كان عنصر المخابرات دائم الحضور في أغلب العروض المسرحية، تماماً مثل العروض العربية، ليتم التحديق فيها بعين ميدوزا، بقصد تدوين أسماء من على الخشبة من ممثلين، وأسماء الوجوه البارزة من الجمهور، لتبدأ بعدها سلسلة من الملاحقات في الشارع وأماكن العمل، وحتى في البيوت، الأمر الذي راح ينعكس على ردود أفعال الفرق الذي اتخذت طابعاً انفعالياً في كثير من الأحيان، فتحول المسرح من فن تنويري وجمالي، إلى مجال ثوري، لتحدي سياسات السلطة وطرح مواضيع كردية غلب عليها نغمة المظلومية حتى أمد جد قريب، دون أن يوازي ذلك، ويتزامن، مع الثورة على المنهج الأرسطي التقليدي أيضاً، وتحطيم العلبة الإيطالية كصيغة فنية، رغم توافر كل أسباب هذا التمرد والتجاوز، ولعل أماكن العرض في البراري والأحواش واحدة من أهم هذه المسوغات.
عربة المسرح وأحصنة السياسة والتحزب:
على الرغم من ولادة التجربة المسرحية السورية، العربية والكردية، في بلد واحد، وتحت حكم السلطات المتعاقبة نفسها؛ إلا أن ثمة تباينات كبيرة بينهما، في البنية والشكل والتاريخ، غير أن عدم التماثل بين التجربتين، وغياب تقاطعات رئيسة كثيرة بينهما، لا تعود أسبابه إلى العوامل الحضارية، المتقدمة عربياً، رغم أهميتها الكبيرة، بل ترجع إلى سبب آخر مختلف تماماً: سياسي: القوي والفاعل.
ويعد تاريخ انطلاق التجربتين، أولى هذه التباينات، إذ أن قرناً كاملاً يفصل بين العرض المسرحي الذي قدمه الرائد أبي خليل القباني سنة1871 ، والذي حمل عنوان “الشيخ وضاح ومصباح وقوت الأرواح“، وعرض مسرحية كاوا الحداد وعروض أخرى لفرقة آزادي في نهاية سبعينيات القرن الفائت.
ولو قيض للرجعية العربية، الشامية، التي احرقت مسرح القباني، أن تنتصر، واستمرأت احراق المسارح ومنع العروض المرة تلو المرة، لما قامت للمسرح في البلاد الشامية قائمة، ولو لم تساهم مصر التي فر إليها القباني؛ في احتضان تجربته، لما راكم المسرح السوري التجارب التي كان لها الفضل في تقدمه وتألقه، ولكان حال هذا المسرح لا يختلف في كثير أو قليل عن حال المسرح الكردي في سوريا بسبب سياسة المنع والملاحقة من بل قبل السلطة البائدة.
ولقد انعكست سياسة المنع والملاحقات الأمنية للمسرحيين الكرد، وكذلك الوصاية الحزبية من قبل الأحزاب الكردية، بالسلب على هذه التجربة، والذي تجسد في انغلاق المسرحيين فنياً، وإيلاء حماية العرض وأنفسهم من المداهمات الأمنية، المرتبة الأولى، كما فعلت هذه السياسة فعلها في دفع الكتاب الكرد والدماء الجديدة بعيداً عن هذا الحقل.
مما دفع بعض الفرق المسرحية إلى التعويض عن ذلك بكتابة نصوصها بنفسها وإن بصيغ فنية وأشكال غير حداثية، ومعالجات غير عميقة لمواضيع حيوية، كما لجأت بعضها الآخر إلى الأدب المسرحي العربي، كخيار أفضل إبداعيا، وذلك بعد تكريد النص، بدءاً بالترجمة، ومن ثم إعداد النصوص لتناسب ذوق وقضية المتلقي الكردي، ولقد عثر المسرحي الكردي بغيته في نصوص سعد الله ونوس وممدوح عدوان ويوسف العاني ووليد اخلاصي وتوفيق الحكيم، والتي تتناول غالباً مواضيع مثل: العدالة والظلم والثورة والحريات، إضافة لنصوص كتاب أجانب مثل: عزيز نسين ويوربيدس وتسوكماير وبرتولد بريخت ومؤخراً نصوص كتاب كرد أمثال: موسى عنتر وأحمد اسماعيل إسماعيل.
ولقد كان لغياب المعاهد والدورات المسرحية المختصة أثرها السلبي في عمل الفنان الكردي، مما أصاب عدته الفنية بالفقر، والتي كانت مقتصرة على الموهبة والرغبة، وعلى العلبة الإيطالية: خياراً فنياً.
المهرجانات المسرحية
لا شك في أهمية المهرجانات لكل من طرفي العلاقة المسرحية: المسرحيون والجمهور، غير أن لإحياء هذه المناسبة مستلزمات عديدة، ويعد تأمين المكان أبسط هذه المستلزمات، حتى وإن كان غير صالح للعرض المسرحي في الحالة الكردية، ورغم ذلك، استطاعت الفرق الكردية إقامة مهرجانين في ليل سوريا أيام الأسد الأب، إذ أقيم المهرجان الأول في منطقة النبي هوري بمدينة عفرين سنة 1994، وقد بلغ عدد الفرق المشاركة فيه 15فرقة، تمكنت بعضها من المشاركة، وتخلفت بعضها الآخر عن الحضور والمشاركة بسبب سياسة المنع والمساءلة الأمنية، لتقتصر المشاركة على بعض الفرق مثل فرقة أهريمان وفرقة حلبجة وفرقة ميديا من الجزيرة السورية، وفرقتا نشتمان وزوزان من عفرين.. وحصدت فرقة أهريمن التي قدمت عرض هيكابي ليوربيدس من إخراج الفنان عادل إسماعيل؛ أغلب جوائز المهرجان: العرض واختيار النص والتمثيل. أقيم بعدها حفل اختتام المهرجان في صيف العام نفسه في قرية خالد كلو بالجزيرة.
لا شك في أن انجازاً كهذا في بلد بوليسي يمارس سياسة المنع والقهر ضد شعبه عامة؛ والكرد خاصة، يستحق أن يسمى انتصاراً للمسرح والمسرحيين، أضف إلى ذلك تجاوز الفرق المسرحية قيدها الحزبي الكردي الذي أعاق أي تواصل فعلي كردي- كردي، لجملة من الخلافات من الخصوم السياسيين، لينال هذا الفن شرف تحقيق حلم توحيد الفرقاء الكرد المختلفين، في صيغة وحدت العيون والقلوب كلّها من خلال النظر إلى المشهد ذاته.
الأمر الذي أغرى تلك الفرق بتكرار التجربة في السنة التالية، وكان لها ما أرادت سنة 1995، وبدأت الفرق المسرحية في الجزيرة تقدم عروضها أمام الجمهور ولجنة تحكيم ضمت كل من الكاتب المسرحي أحمد اسماعيل إسماعيل والمخرجين المسرحيين :أنور محمد وعدنان عبد الجليل. فقدمت كل من فرقة خلات “مسرحية موت الحجل” لأحمد إسماعيل إسماعيل وإخراج عدنان عبد الجليل وفرقة “ميديا” مسرحية من هناك لويليم سارويان وإخراج أنور محمد. و”الحمامة المستقلة “مسرحية المسابقة عن نص لعزيز نيسين إخراج كاوا شيخي وفرقة “نارين” مسرحية ليالي السكارى تأليف وإخراج رفعت حاجي”.. غير أن منغصات كثيرة حالت دون تحقيق المهرجان هدفه، ليس العامل الأمني هو السبب الوحيد، فتوقف بعد تقديم بعض العروض في منطقة الجزيرة السورية فقط.
ولم تتكرر محاولة إقامة مهرجان آخر، حتى بعد قيام الثورة السورية، وكان قبل ذلك نشاطها يقتصر على تقديم العروض بشكل منفرد: قريباً من الجمهور، وبعيداً عن السلطات: في الأحواش وأطراف المدن والبراري، وفي مناسبات كردية مختلفة مثل: يوم الصحافة الكردية، ويوم نوروز وكذلك في يوم المرأة العالمي.. إلى أن قامت الثورة السورية سنة2011 ، فقلبت المشهد الساكن إلى مشاهد حية، وحولت الأرض السورية إلى مسرح، والذي انشطر بعدها إلى مسارح تعرض الجمال، ومذابح تستعرض القبح والشر.
وقد يكون من الانصاف أن نشير إلى أن المسرح في ظل الإدارة الذاتية لمنطقة شمال شرق سوريا التي تأسست سنة 2013 قد تنفس بعض الهواء الصحي، الذي أنعش المهرجانات، فكانت الدورة الأولى لمهرجان يكتا في سنة 2015، حيث قدمت فيه عروض كثيرة، ومن مختلف المناطق، ومن هذه العروض نذكر:
– فرقة عامودا عرض “Îdî bese – كفى” تأليف: نواف بشير- إخراج حسن رمو.
– فرقة الشهيد داغستان عرض “Nasname – الهوية” معدة عن نص النقيب كوبينك للكاتب كارل تسوكماير وإخراج فواز محمود
– فرقة شانو أوبريت “Keleha kobanê rgu – قلعة كوباني” تأليف وإخراج عبدالرحمن ابراهيم
– فرقة (آفا مزن) ديريك عرض: “شورش أو سرخوش،الثورة” الكاتب ابراهيم فقة ومن إخراج حسين صبري
– فرقة تولهلدان عرض “الخبز المسموم” تأليف: فاسلين خانتشوف إخراج محمد رسول
– فرقة روسلين عرض “ثورة الموتى” تأليف أروين شو إخراج محمد رسول
– فرقة Jiyana Şano عرض ( خون- Xewin، الدم) توليف واخراج عبدالجابر حبيب
– مسرحية “أوكسجين” توليفة: محمد أشرف وأنور محمد – إخراج أنورمحمد
– عرض “Çirîsk – الضوء” عن نص النافذة للكاتب إيرينيوش إيريدينسكي- اعداد وإخراج عمران يوسف
ولا يمكن أن نغفل مهرجان آخر كان قد سبق يكتا وأقيم في مدينة عفرين وباسم مهرجان ميتان، تيمنا بمملكة ميتاني التي نشأت في القرن الخامس عشر وبداية القرن الرابع عشر قبل الميلاد والتي تعد حلقة ومحطة مضيئة في تاريخ الكرد، بدأ هذا المهرجان في سنة2014 ، وذلك من قبل مجموعة من الشباب العامل في المسرح، واللافت للانتباه أن الدورة الأولى، ومن ثم الدورات اللاحقة، كانت تبدأ انطلاقتها بكرنفال يجوب شوارع المدينة، يتقدمه المشاركون في العروض بأزيائهم المسرحية، يلي ذلك في اليوم الثاني افتتاح المهرجان بأغنية ميتان المغناة بثلاث لغات: الكردية والعربية والإنكليزية.
ولقد شاهد الجمهور في عفرين مسرحيات كثيرة تم عرضها في الدورة الأولى من هذا المهرجان، ومنها مسرحية للأطفال الحقل المنيع لأحمد اسماعيل إسماعيل وإخراج هيفان بوزو ومسرحية البرميل تأليف وإخراج رابرين كلكاوي وعدنان مصطفى. ومسرحية عفوا مموزين لأحمد اسماعيل إسماعيل وإخراج محي الدين أرسلان. قلعة المقاومة نص عدنان مسلم وإخراج أيبش أسو. مسرحية الدب لأنطون تشيخوف وإخراج محي الدين أرسلان. مسرحية لكنه شرعي نص محمود جقماقي إخراج جوان قاقو. مسرحية زفاف نص محي الدين أرسلان وإخراج أفستا علي. ونص عيون الزيتون نص وإخراج أسامة محمد.
وكان يمكن لهذا المهرجان أن يشكل حالة مسرحية كردية مميزة بدءاً من: حسن تنظيمه واخراجه والتزامه بموعد انطلاقته، ومروراً محاولاته في البحث عن صيغة مسرحية كردية من خلال توظيف بعض مظاهر التراث وطريقة معالجة المواضيع وطرح هموم المتلقي الكردي، لولا احتلال عفرين من قبل تركيا ومرتزقتها سنة 2018..
لم يستسلم مسرحيو عفرين لظروف التهجير القاسية، إذ سرعان ما أعادوا احياء مهرجانهم في منطقة التهجير، لينطلق من جديد سنة 2020، وكان استثمار خيمة اللجوء كمكان جديد، بمثابة تجربة كردية سورية مميزة، اختلط فيها الألم والغضب بالإبداع والتصميم. والفضاء الواطئ والجدران الهشة بفضاءات واسعة من نسج الحلم والخيال والإضاءات الموظفة، وفي هذا المهرجان تم تقديم مسرحيات كثيرة؛ لمخرجين شباب منهم: محي الدين أرسلان مؤسس هذا المهرجان ومحوره الفاعل. وسلام إيبو وميرزان بكر وهيوا بطال ولوران حسن وزينب حسن، وكانت غالبية النصوص المسرحية لكتاب كرد وعرب سوريين نذكر منهم: ممدوح عدوان الذي قدمت له مسرحية طريف الحادي. ومسرحية الطائر يسجن الغرفة لفرحان بلبل ومسرحية درويشه عفدي عن ملحمة كردية قديمة لريزان بكر. وسبع خيم غنائية لجوان حسن وثلاثة نصوص مسرحية لأحمد اسماعيل إسماعيل هي أهلا جحا، مجرد مزاح، ومونودراما نسرين.
ولقد تم تخصيص مهرجان للمونودراما للمرة الأولى ، والذي أقيم في الخامس شهر نيسان الجاري سنة 2025 ويتضمن تقديم عدة عروض:
– كوميديا الأيام السبعة نص: علي الزيدي. إخراج: عبد القادر عبود.
– الصورة نص :سما زيلان، إخراج: سمكو جودي.
– بارانويا: نص: عباس الحايك. إخراج محمد عمر.
– إيجار، نص :علي الزيدي، إخراج، معن دويعر.
-الموسيقا الحمراء: نص واخراج كزيزا عمر (كردستان العراق)
– حنين، نص: عباس الحايك، إخراج، عبد الرحمن إبراهيم.
– شهناز، نص وإخراج: وليد عمر.
– رصاصة واحدة، نص: صباح الانباري. إخراج شيفزان فواز محمود
– سبيرو، نص: آرشاك رؤوف كنبدي، إخراج :مائيدة دارلكي (كردستان إيران)
إضافة إلى محاضرات وندوات لبعض المختصين في مجال المسرح.
الوحش ذو الرؤوس الألف:
يؤكد غير مسرحي على دور الجمهور المركزي في العملية المسرحية، ويكاد جميع من تناول موضوع الجمهور المسرحي أن يتفق؛ من يصفه بالوحش، ومن يطلق عليه صفة السيد المحترم، على أن الجمهور هو الذي يكمل دائرة العرض، فهو شريك الفنان في الظاهرة المسرحية، بل سيده، وبحضوره يبدأ العرض، إذ لا عرض بلا جمهور، كما هو متفق عليه، مما استوجب احترام المسرحي لجمهوره، بل ومحبته، وهذا شرط فوق دستور أي عملية تنظم علاقة المسرح بالجمهور، حتى وإن كان هذا الجمهور فقيراً مادياً، وبسيطاً معرفياً.
وفي سعيها لتطبيق هذا الشرط، ابدعت تجارب مسرحية كثيرة طرائق ووسائل فنية وتقنية، وذلك على المستويات كافة: العرض أولاً والنص وحتى مكان العرض. وما ظهور البيانات المسرحية العربية والتجارب والنداءات والتقنيات الفنية سوى محاولة للوصول إلى قلب الجمهور وعقله. وفي الغرب ثمة تجارب سابقة كثيرة منها: تجربة ميرخولد وبريخت ومسرح المقهورين وغيرهم كثير. ورغم ذلك نجد أن الجمهور المسرحي في غير مكان وزمان، عربياً وغربياً، لا يُقبل على ما يقدم له من عروض، ومن أولى الأسباب في الساحة المسرحية العربية، تأتي حداثة هذا الفن في حياة المجتمعات في المقدمة، وعدم تمكنه من التحول إلى ثقافة وعادة اجتماعية، ومناخ القهر السياسي السائد في غالبية المجتمعات، الأمر الذي لا يقلل من شأن تقدم مستوى العروض المسرحية وتألقها في اكثر من بلد عربي، وظهور تجارب هامة في الساحة العربية استطاعت الارتقاء إلى مصاف العروض المسرحية في الساحة الغربية، في مجالات النص والعرض والسينوغراف والتمثيل.
الطريف في أمر الجمهور المسرحي الكردي، “إن صحت هذه التسمية” إنه، ورغم معاناة المسرح من كل أنواع الضعف والفقر، الفني وغير الفني، إنه يقبل على العروض بحماس كبير، وزخم قل نظيره، يصل أحياناً إلى عدة آلاف، متحدياً كل الحواجز التي وضعتها أجهزة الأمن في البلد.
ولذلك يعد مشهد متابعة الجمهور للعروض المسرحية جزءاً لا ينفصل عن العرض، بل مسرحية بحد ذاتها، في البرية وقوفاً، أو في القرى البعيدة وهو يَقّتعدُ الأرض، وبحرض شديد على عدم الانفعال وإطلاق العنان لأصوات التشجيع، خشية اقتحام الأجهزة الأمنية مكان العرض، وتخريب الدورة الروحية بين الشريكين، وذلك وسط حشد جماهيري منقطع النظير، ومن مختلف الأعمار والأجناس، ليتحول الجميع فيه إلى كتلة واحدة لها رؤوس عديدة، تتابع العرض بشغف ولهفة، وتصفق لصناعه بحماس. غير أن هذا الفعل الفريد من قبل شريك صانع المسرح، قد أضر بالمسرح وصناعه، فهذا الرضا التام منح الفنان الثقة الكاملة بأدواته وامكانياته، مما انعكس سلباً على نتاجه المسرحي، مما يفسر تكرره، ولزمن غير قصير، التيمة ذاتها فكرياً والصيغة نفسها جمالياً، علماً أن المسرح فن متمرد وجار كالنهر، إذا سكن؛ بل وأسن.. وهو ما حدث لهذا الفن في التجربة الكردية في كثير من المنعطفات.
لا شك في أن التجربة تحتاج إلى وقفة منهجية تؤرخ لها بشكل أحكم وأكثر دقة، ولعل هذه الاضاءة، ومقالة سابقة لي تناولت فيها مسرح قامشلي ونشرت في مجلة الحياة المسرحية السورية سنة 1999، بعنوان مسرح مدينة قامشلي والتي ذكرت فيها، وبشكل أشبه إلى الإشارات، أسماء بعض الفرق الكردية وغير الكردية: الأشورية والأرمنية والسريانية، طبعاً والعربية الرسمية التي كانت تقدم في مدينة قامشلي ذات التنوع الديني والاثني الغني، لعل هاتين المادتين، هما الوحيدتان اللتان فصلتا في شأن هذه التجربة، وإن بهذا الشكل والأسلوب الذي يحتاج إلى تفاصيل أخرى كثيرة، فالجهود التي عملت في المسرح الكردي قبل انتفاضة الشعب السوري كبيرة بتحديها وعنفوانها، وقد لا أبالغ لو وصفتها بالملحمة، فكل تجربة كردية في المسرح؛ والفن عموماً، تستحق وقفة طويلة. وثناء.
مساهمة نون النسوة في صناعة المسرح:
للمرأة حضورها في المجتمع الكردي رغم غلبة الطابع القروي عليه، وإذ كان العالم قد شاهد نضال المرأة الكردية في ساحات الحروب، مقاتلة في الجبهات الامامية، وخاصة في الآونة الأخيرة ضد تنظيم داعش الإرهابي، فإن مساهمتها في حقول أخرى مثل السياسة والفن لا تقل أهمية وفاعلية عن حضورها في تلك الساحات، ولقد تبلور هذا الامر بشكل أكثر قوة منذ سنة 2013 ، السنة التي قررت المنطقة الكردية والمسماة بإقليم شمال شرق سوريا، إدارة نفسها ذاتياً، مما منح المرأة العاملة في مجال المسرح مساحات أوسع وأكثر أمانا للإبداع، وتم الإقرار بإقامة مهرجان سنوي خاص بأدب وفنون المرأة، يُقام في مدن مثل قامشلي والرقة منذ عام 2020. ويهدف إلى تسليط الضوء على قضايا المرأة من خلال عروض مسرحية وغنائية تُعالج موضوعات حقوقها والعدالة الاجتماعية، حتى بات المهرجان أشبه بمنصة لإبراز الإبداعات النسائية في المسرح.
ومن أبرز ما تم قدمته المرأة الفنانة كان مسرحية “السلام في أجنحة العصافير” إخراج ساريا كولان، وأداء زلال موسى، شفين خليل، رهف زلفو وأخريات، وكذلك قدمت الكاتبة والمخرجة فاطمة أحمد عرضاً مسرحيا بعنوان “الصرخة” الذي اقتصر على النساء: شخصيات وممثلات وممن شاركن في العمل: جاندا كاوا، جمانة بشير، دارين أحمد وأخريات.
ولقد سبق أن قدمت فنانات كثيرات مسرحيات في مقاطعة عفرين قبل عملية النزوح منها: مسرحية الحجر لا يؤكل تأليف فيصل خليل وإخراج رومات بكو سنة 2017 وكذلك مسرحية المتراس، تأليف أولكير كوكسال. وكذلك قامت هيوا بطال وزينب حسن هيفان بوزو بإخراج بعض النصوص المسرحية لكتاب سوريين: عرب وكرد.
ولقد تم تنظيم ورش عمل متخصصة في المسرح النسائي في مدن قامشلي والحسكة وديريك بهدف صقل قدرات الممثلات والمخرجات وتطوير محتوى يُعبر عن تجارب المرأة في الحياة.
مصابيح على طريق وعر:
ثمة محاولات جادة من قبل الإدارة الذاتية في “روج آفا ” لتعبيد طريق المسرح الوعر، والذي لم تستطع التجارب المسرحية الكردية خلال أكثر من ثلاثة عقود من تاريخ انطلاقتها من السير فيه دون عثرات وحوادث كانت من صنع النظام البائد، وتعد إقامة مسابقات في الكتابة المسرحية واحدة من هذه المحاولات، وكذلك إطلاق الجوائز المحلية التي تُكرم الإبداعات المسرحية، مثل جائزة الإبداع المسرحي وجائزة الاخراج وجائزة أفضل ممثل وممثلة.
إضافة إلى تأسيس معاهد فنية وأكاديميات تدريبية متخصصة في المسرح والسينما والموسيقى، موزعة على كل من الحسكة وقامشلي وديريك، بهدف تأهيل الكوادر المختصة، في مجالات التمثيل والإخراج والكتابة المسرحية، وفيها يتم تقديم خدمات جد مريحة للطلاب من سكن وطعام ودراسة مجانية.
لعل الحديث عن المسرح وجمهوره لدى هذا الشعب ذي شجون، إذ لا يمكن فصله عما يجري في مسرح الحياة وعن خشبته الكبيرة، الأرض.
============
مجلة المسرح، القاهرة، مصر، عدد مايو، 2025