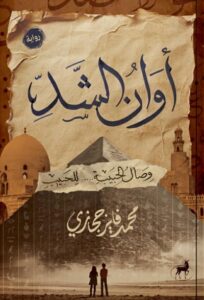ماهين شيخاني
وقف دارا أمام باب القاعة الكبرى.
كانت ترفرف فوقها راية كردية أنيقة، مربوطة بعمود طويل، كما لو أنها تحرس حلماً قديماً.
شد ياقة قميصه الأبيض، مسح غبار الطريق عن بنطاله، ودخل.
في الداخل، كان الهواء خانقًا، ممزوجًا برائحة عرق متعب ودخان سجائر رخيصة.
اصطف الجالسون في مجموعات صغيرة، كل مجموعة تهمس على حدة، وكأن المؤتمر ساحة قمار لا قضية شعب.
تقدم دارا وجلس أحد الكراسي البلاستيكية المتهالكة.
على المنصة، رجل بدين يصرخ في مكبر الصوت:
“الوحدة! المصير! الاستقلال الكامل!”
هتف الحاضرون بفتور كأنهم يؤدون واجبًا مدرسياً.
دارا صفق بحرارة، بقلب لا يزال يؤمن.
انتهت الكلمة الأولى، فصعد آخر، أصغر سنًا، بربطة عنق عريضة تكاد تخنقه، صرخ بلهجة حادة:
“سننتصر لأننا الأكثر وعياً!”
نظر دارا حوله.
الوجوه جامدة. بعضهم يتثاءب، وبعضهم يرسل رسائل خفية بهواتفهم.
خلال الاستراحة، اقترب منه رجل نحيل يحمل ملفًا منتفخًا. همس له:
“هل أنت جديد هنا؟”
أومأ دارا برأسه.
“احذر… هنا لا مكان للأفكار. هنا… تجارة شعارات.”
ابتسم دارا ظانًا أنها مزحة ثقيلة، لكنه سرعان ما رأى الحقيقة.
في الزوايا، كان بعض القادة يتبادلون أوراقاً موقعة. في الزاوية الأخرى، وفد يناقش “حصته” من لجان الحزب المستقبلية.
دارا جلس مذهولاً.
أي مؤتمر هذا؟ أين الحلم؟ أين البلاد؟
صعد أحدهم ، شيخ سبعيني، ناصب نفسه “ضمير الشعب”، وصرخ فيهم:
“نحن باقون فوق هذه الأرض ولن نفرط بحبة تراب!”
فيما مساعده، بهدوء، يمرر حقيبة جلدية لرجل ببدلة أجنبية عند الباب الخلفي.
رفع دارا يده يريد أن يسأل، أن يعترض.
اقترب منه أحد المنظمين كي يخفضها.
“ليس الآن”، همس في أذنه.
انتهى المؤتمر بتصفيق بارد وخطابات مدفوعة الثمن.
خرج دارا مع آخرين.
كانت الشمس تميل نحو المغيب.
رفع رأسه نحو الراية الكردية التي كانت لا تزال ترفرف.
اقترب أكثر، مشى حتى وصل إلى قاعدة العمود.
هناك، أسفل الراية، كان بئر قديم، محاط بجدار حجري متهالك، فارغ تمامًا.
رمى دارا بحجر صغير داخله.
لم يسمع أي صدى.
جف حلقه.
تمتم:
“راية جميلة… فوق فراغ هائل.”
سار عائدًا إلى قريته، مثقلاً بخيبة أمل.
لم يسقط الراية من قلبه، لكنه أدرك أن الذين يرفعونها لا يعرفون حتى عمق البئر الذي يقفون فوقه.
في المساء، كان دارا، المثقف العائد لتوه من مؤتمر الحزب، يسير على الطريق الوعرة عائدًا إلى قريته.
كان يحمل حقيبته الصغيرة، محشوة بأوهام طازجة وكلمات فضفاضة لا تصلح إلا للاستهلاك أمام عدسات الكاميرا.
حين وصل إلى مشارف القرية، استقبلته مجموعة من الأطفال الصغار، يركضون نحوه:
“عمو دارا! عمو دارا! متى سنحصل على وطن؟ متى نرفع رايتنا فوق الجبال؟”
ابتسم دارا ابتسامة شاحبة، شعر بثقل غريب يطبق على صدره.
مضى إلى الساحة الصغيرة، حيث كان أهل القرية قد اجتمعوا.
رجال شابت لحاهم من طول الانتظار، نساء عجائز ينسجن الأحلام البالية بخيوط الهواء، وأطفال بعينين واسعتين، تختزن كل جوع الأرض للحلم.
وقف المختار أمامه، بعمامته البيضاء الثقيلة وقال:
“بشرنا يا بني… بأي سماء سنغني غداً؟”
صمت دارا.
نظر حوله.
ثم وقعت عيناه على جدار المدرسة الحجري القديم، حيث علّقوا قبل سنوات راية كردية صغيرة خاطتها جدته الراحلة، وظلت هناك، باهتة مهترئة، تتحدى الزمن.
تنهد طويلاً، وقال بصوت بالكاد يسمع:
“غنوا… لكن لا ترفعوا أصواتكم كثيراً. الرايات هذه الأيام ترتجف من فرط الريح.”
**
تفرق الناس بهدوء، حائرين، خائفين من أن يفهموا الحقيقة.
أما دارا، فقد سار إلى بيته الصغير، واستلقى تلك الليلة وهو يحدق في السقف المتشقق.
في الحلم، رأى راية كردية عظيمة ترتفع فوق جبل شاهق.
راية مصنوعة من نور خالص.
لكن لم يكن أحد يحملها.
كانت ترفرف وحدها… حرة، كما يجب أن تكون.
- انتهت –