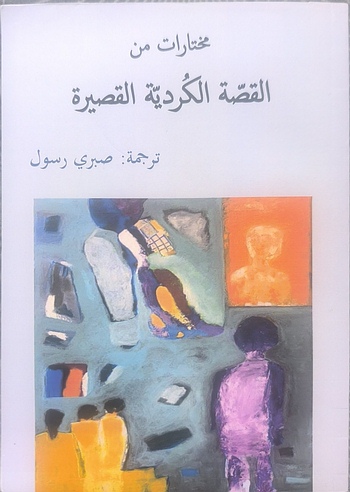فواز عبدي
لطالما كان الأدب الكردي انعكاساً حياً لمعاناة شعب يواجه محناً سياسية وثقافية ممتدة عبر قرون من التهميش. ففي ظل تقطيع أوصال الجغرافيا الكردية بين أربع دول، وحرمان اللغة الكردية من الاعتراف الرسمي والتعليم والمؤسسات الثقافية في تلك الدول، بقي الأدب الكردي محاصراً داخل قوقعة محلية، لا يتجاوز نطاقه الجغرافي أو اللغوي إلا في حالات نادرة. ويبدو التأثير السياسي واضحاً في كل زاوية من زوايا الإبداع الكردي: من الرقابة والمنع، إلى قلة دور النشر، إلى غياب الدعم المؤسسي، إلى الإهمال المتعمد من أولياء الأمر الكردي….
أما في روجافاي كردستان، فإن الكُتاب الكرد يواجهون تحديات مركبة: من جهة، قلة البنية التحتية الثقافية والتعليمية، ومن جهة أخرى، محاولة تأسيس هوية ثقافية مستقلة في خضم صراعات عسكرية وسياسية معقدة. ومع ذلك، تنبعث من هذه البيئة المتأزمة أصوات أدبية قوية، تنسج واقعها ومخيلتها من الرماد، وتقاوم الإلغاء بالحرف.
إن خروج الأدب الكردي من هذه العزلة الثقافية بات ضرورة ملحة، ولا سبيل لذلك إلا بالترجمة، التي تفتح نوافذ جديدة للتلقي، وتمنح هذه النصوص فرصة للحياة في فضاءات لغوية وثقافية أخرى. تُعدّ الترجمة جسراً حيوياً يربط بين الثقافات، ويمنح الشعوب فرصةً لفهم بعضها البعض، وتبادل المعارف، والانفتاح على تجارب إنسانية متنوعة. ولطالما لعبت الترجمة دوراً محورياً في نهضة الأمم، ليس فقط من خلال نقل العلوم والمعارف، بل أيضاً عبر الترجمة الأدبية التي تُعَرِّف العالم بالأحاسيس والتجارب والرؤى الخاصة بكل شعب.
في هذا السياق، تكتسب الترجمة من وإلى اللغة الكردية أهمية استثنائية، خصوصاً في ظل ما يمرّ به الشعب الكردي من تحديات سياسية واجتماعية وثقافية، وعلى مدى عقود وعقود من الزمن. فالكرد، الذين يعانون من تشتت جغرافي وتضييق على هويتهم الثقافية في بعض المناطق، يحتاجون إلى أن يُسْمَع صوتهم ويُقرأ أدبهم بلغات العالم. كما أن الحاجة ماسة أيضاً لنقل الأعمال الأدبية والفكرية من لغات أخرى إلى الكردية، بما يُسهم في إثراء الثقافة الكردية بشكل عام، واللغة بشكل خاص، وتعزيز الوعي والتواصل الحضاري.
وتأتي هذه المختارات من القصص الكردية القصيرة التي ترجمها مشكوراً صبري رسول كخطوة بالغة الأهمية ضمن هذا المسعى، إذ تتيح للقارئ غير الكردي نافذةً نادرة على عالم أدبي غني بالتجربة، مثقل بالمعاناة، ومشحون بالأمل، في آنٍ معاً. كما تُظهر هذه القصص التنوع في الرؤية والأسلوب والموضوع داخل الأدب الكردي، وتؤكد أن هذا الأدب، رغم ظروف العزلة والتهميش، يمتلك ما يستحق أن يُقرأ ويُحتفى به على نطاق واسع.
اعتمد المترجم في إعداد هذه المختارات على اختيار نصوص لكتّاب كرد من روجافاي كردستان فقط، متجاوزاً بذلك الكتّاب الكرد في باقي أجزاء كردستان… هذا الاختيار يعكس توجهاً منهجياً واضحاً لتسليط الضوء على نتاج أدبي محلي يرتبط بسياق ثقافي وسياسي خاص. كما أنه لم يخصص الكتاب لكاتب واحد بعينه، بل اعتمد على منهج “الأنطولوجيا”، لقد انتقى قصة أو اثنتين لكل كاتب، حيث ضم الكتاب ستاً وعشرين قصة لأربعة وعشرين كاتباً وكاتبة، ومن أجيال مختلفة، وهذا ما يمنح القارئ تنوعاً في الأصوات والأساليب والتجارب.
وقبل أن ندخل في تفاصيل الترجمة لابد من إيراد بعض شروط الترجمة بشكل عام ومميزات الترجمة الأدبية بشكل خاص.. فكلنا نعلم أن الترجمة أصبح علماً يدرس بذاته رغم أنها تحمل جانباً فنياً وإبداعياً..
فهو علم من خلال الفهم العميق لقواعد اللغتين وتراكيبهما الدلالية والنحوية، وفن من خلال القدرة على إعادة صياغة النص بأسلوب جذاب ومعبر في اللغة الهدف..
والترجمة الناجحة لا تتوقف فقط على معرفة اللغتين، بل تتطلب مجموعة من الشروط والمقومات الإضافية، سنوردها باختصار؛ الفهم العميق للسياق:
- المعنى لا يُؤخذ دائماً حرفياً، بل من السياق العام للنص (ثقافي، اجتماعي، مهني، إلخ).
- فهم خلفية النص يساعد على نقل الرسالة والمعنى المقصود بدقة.
الأمانة في النقل:
- يجب أن يحافظ المترجم على المعنى، لا أن يضيف أو يحذف أو يحرّف.
- لا يُشترط الترجمة الحرفية، بل الترجمة الأمينة التي توصل المعنى بوضوح.
الأسلوب والبلاغة:
- لا يكفي نقل الكلمات، بل يجب نقل الإحساس والأسلوب أيضاً، خاصة في النصوص الأدبية.
- الترجمة الجيدة تبدو وكأنها كُتبت أصلاً بلغة الهدف.
الحياد والاحترافية:
- لا يجب أن يُدخل المترجم رأيه الشخصي أو يحاول “تجميل” أو “تحريف” ما لا يعجبه في النص.
الاطلاع الثقافي والحضاري:
- معرفة الفروق بين الثقافات تساعد على تفادي سوء الفهم أو الترجمة المضلِّلة.
ولخصوصية الترجمة الأدبية لا بد من مراعاة شروط أخرى إضافية كالاهتمام بالأسلوب والجماليات، الصور البلاغية والتشبيهات، اللعب بالكلمات وخاصة في الألغاز والتوريات والقوافي والتي تعتبر من أصعب التحديات بحيث يتطلب من المترجم أن يكون مؤلفاً ثانياً، وأخيراً الحفاظ على صوت الكاتب، دون أن يذوب المترجم فيه أو يطغى عليه بأسلوبه هو.
ولا ننسى أن المترجم ناقل من جهة ومؤلف ثان من جهة أخرى، يسمح له أن يعيد تشكيل النص شرط ألا يخون الأصل.. ولكن لايسمح له تغيير الهيكل أو الشكل إذا أفسد التوتر الدرامي أو أفسد شخصية المتحدث/الشخصية أو إذا عكس ذوق المترجم الشخصي وليس حاجة اللغة..
يضم الكتاب قصصاً منوعة من حيث الموضوعات، تشمل الحرب، اللجوء، الحياة اليومية، المقاومة، الذاكرة، والهوية. وهذا يعكس اتساع التجربة الكردية وثراءها.
جاءت ترجمة القصص من الكردية إلى العربية بلغة تتسم بالبساطة والتدفق، مع محاولات واضحة للاحتفاظ بجوهر النص الأصلي. يصرح المترجم في مقدمته بأنه لم يعتمد الترجمة الحرفية بل السعي إلى نقل الإحساس والمعنى. وهذا يتضح في الترجمات التي تميل إلى الأدبية.
المترجم قدّم تمهيداً ناضجاً وممتلئاً بالوعي الثقافي حول الترجمة، وناقش فكرتي “الترجمة خيانة” و”الترجمة جسر”، موضحاً أن ترجمته تسعى لنقل الأحاسيس وليس فقط المعاني.
أبرز وعياً نقدياً حين وصف الصعوبات مثل “التعقيدات اللغوية”، “اللهجات المحلية”، و”تركيب الجملة الكردية”، مما يدل على أنه مارس الترجمة كفعل إبداعي لا مجرد نقل ميكانيكي.
الترجمة تمت بلغة عربية أدبية سليمة، وأحياناً شاعرية جداً، كما في قصة “جمهورية القرنفل” لمروى بريم.
التراكيب العربية تحافظ عموماً على روح الأصل، لكن في بعض المواضع قد تشعر بأنها أكثر “تزويقاً” من اللازم، وهو أمر قد يُفقد النص شيئاً من تلقائيته أو واقعيته.
المترجم كان مخلص للمحتوى الكردي فقد حاول جاهداً الحفاظ على خصوصية السياق الثقافي الكردي من خلال الإبقاء على أسماء الأماكن، اللهجات، وحتى المفردات الزراعية أو الشعبية.
لم يحاول “تعريب” النصوص بالمعنى السلبي، بل حافظ على أصالتها رغم صعوبة الترجمة.
كيف عالج النصوص الصعبة أدبياً؟
أشار المترجم إلى تحديات خاصة في نصوص بعض الكتاب مثل “مروى بريم”، حيث واجه نصوصاً “وعرة” لغوياً وثقافياً، لكنه تغلّب عليها بصبر وجهد واضح.
ترجمته أحياناً تبدو وكأنها إعادة كتابة، وهذا مقبول جداً في الترجمة الأدبية طالما لا يُفرط المترجم في التحرير.
ظلّت الهوية الثقافية الكردية بارزة جداً، وهو نجاح مهم للترجمة، فالنصوص رغم أنها مترجمة تبدو منتمية للبيئة الأصلية صوتاً وإحساساً.
القصص تنقل واقع الكرد السوريين بطريقة تمنح القارئ العربي نافذة صادقة ومؤثرة على معاناة ومخيلة وأحلام تلك البيئة.
وكتطبيق عملي تتناول هذه القراءة قصتين من الكتاب ولم يكن الاختيار إلا لأنني لم أتمكن من الحصول على النسخة الكردية إلا لهما فقط.. فقد طلبت من المترجم إرسال النسخة الكردية لكل قصة وقد أرسل لي هاتين القصتين فقط لأن عطلاً أصاب جهاز الكومبييوتر لديه..
والقصتان هما: جمهورية القرنفل، والحياة.
جمهورية القرنفل للكاتبة مروى بريم:
من خلال متابعتي أرى الكاتبة مروى من أبرز الأسماء الأدبية النسائية في روجافا كردستان، وهي تملك مخزوناً لغوياً ثريّاً في كل من الكردية والعربية. تمتاز كتابتها بأسلوب فريد قلّ نظيره بين الكتّاب الكرد، حيث تمتزج السردية بالشعرية، وتُولّد صوراً لغوية مذهلة حتى في أكثر مشاهدها الواقعية. إن محاولة ترجمتها إلى العربية تُشبه من بعض الوجوه محاولة ترجمة سليم بركات إلى الكردية؛ فخيالها الخصب النادر في توليد المجاز والصورة يتطلب مترجماً حساساً للشعر، متمكناً من أدوات السرد.
وقصتها “جمهورية القرنفل” واحدة من النصوص البارزة في هذه المختارات، لما تحمله من رمزية كثيفة وأسلوب سردي متداخل بين الواقعي والخيالي. وهي قصة تستحق الوقوف عندها مطولاً، خاصة مع توفر نسختها الأصلية بالكردية، مما أتاح للقراءة مقارنة دقيقة بين الأصل والترجمة، واختبار مدى احتفاظ النص المترجم بروحه ومقاصده الفنية.
فالعنوان “جمهورية القرنفل” يحمل طابعاً رمزياً قوياً، والمعروف أن القرنفل زهرة ترتبط غالباً بالفرح والاحتفال، لكنها هنا تُستخدم لتشكيل “جمهورية” خيالية أو حلمية، ما يوحي بعالم بديل أو ملاذ خاص بالشخصية الرئيسية بعيداً عن الواقع القاسي.
تتسم القصة بلغة شعرية كثيفة وبرمزية عوالمها على إيقاع هادئ وتأملي، وكأنها دعوة للتأمل في تفاصيل الحياة الصغيرة –كما في نتاجاتها الأخرى التي تمكنت من الاطلاع عليها- والهروب منها إلى عوالم داخلية.. بحيث تتجسد في هذه القصة رغبة البطلة في الهروب من واقعها الحزين إلى عالم متخيل (جمهورية القرنفل)، حيث يمكنها أن تجد السكينة والأمان..
وقد تعاملت الترجمة مع القصة بروح عالية من المسؤولية واستطاعت أن تخلق معادلاً ترجمياً لها على العموم، ولكن تميز القصة بأسلوبها الشاعري الرمزي خلقت بعض الصعوبات –وهو أمر يحدث في الترجمة- ستحاول هذه القراءة المرور سريعا على تلك الصعوبات.. وهنا جدول يحوي الجملة في الأصل والترجمة الواردة في الكتاب مع ترجمة مقترحة:
| الكردية/الأصل | الترجمة المقترحة | الترجمة |
| Rîsê xemgînyê teşiya bayê BAKUR ta qirikě standibû, bi dizîka zêvirî pînika sibehê vepincirand, mija ku ji êvar de tê de kurk bûye tev çêlikan , ajot mêrg û zozanan, | كانت خيوط صوف الحزن تلتف حول مغزل الريح الشمالية حتى الرقبة، الريح التي تسللت نابشة قن الصباح واقتادت الضباب الذي كان جاثماً منذ المساء كدجاجة تحضن صغارها إلى المروج والمصائف. | دوائر الحزن سيطرت على مغازل الريح الشمالي حتى الرقبة، رجع خلسة لكشف القنّ الصباحي، سيق الضباب، الذي كان جاثماً منذ المساء كدجاجة تحضن الصيصان إلى المروج والروابي العالية، |
|
_ Wey looo…looo!! Çiyayo..!!! ji sawên şev re peyayo…!!!!.. Were te hildim pişta xwe.. Ne tenê barê mêrayo.. Wey looo…. Looo.. Çiyayo..!!! |
ترتيبها كما جاء في الأصل: وي لووو لووو أيها الجبل
يا أيها التابع لأشباح الليل تعال أحملك على ظهري إنك لست َ عبئاً على الرجال فقط وي لولو …وي لووو أيها الجبل
|
أيها الجبل، إنك مريد تابع لأشباح الليل، تعال أحملك على ظهري لست فقط حملاً للرجال وي لولو وي لولو» أيها الجبل.
|
| Hîngê Êmê jî girtiyěn pînika xwe bi du sê mist şoqil qarmîş kirin, qiqida wan bi şemaqan bi riwê bermayên xewê ketin, apê Os hevjînê meta Êm di îşika xênî de mîna teyîka gundirê gilok hîn ji gufbûnê hayî nebibû, guhdariya her livekê dikir.
|
حينها أغوت إيمي معتقلي خمها ببضع حفنات من العلف، وبدأت تصفع بقايا النوم بقأقأتها، كان العم أوس، زوج العمة إيمي،خاملاً في عتبة الدار كشجيرة يقطين يصيخ السمع لكل حركة. | قرقرات ونقنقات الدجاجات صفعت وجه بقايا النوم.
العم أوس، زوج عمة إيمي كان في زاوية المنزل ملفوفاً كالبستان الدائري، مازال لم يصح من صرير الريح، كان يراقب كل حركة. |
| Li ser sewkiyê kabikên xwe misdan | جلست على المصطبة/الدكة تمسد ركبتيها | جلست القرفصاء على ركبتيها، |
| li sala tê Ferhadê min dê pileya bijîşkiyê bistîne, bûka min dê dîsa bi bêhna kesk avis bibe | في العام القادم سينال ابني شهادة الطب، وستحبل كنتي من الرائحة الخضراء.. | لكن ابني فرهاد سينال الشهادة الطبية في العام القادم، ستحبل كنتي مرة أخرى من رائحة الخضرة. |
| ji navika dîrokê me keskahî mêtiye, lewma jiyan mîna sîsalkan li vir dilûse, û bi me de vedide, belê em boheya jiyanê ne.
|
لقد رضعنا الخضرة من سرَّة التاريخ، لذلك تستقر الحياة هنا كطائر السيلكان وتصبغنا بصبغتها. أجل نحن قيمة الحياة. | لقد رضعنا من الخضرة في قلب التاريخ، لذلك تزدهر الحياة هنا، فنحن نبنيها كطائر سيسالكان (3)، أضفنا على الحياة صبغتنا الخاصة، فهي تتوسع فينا. نعم، نحن نمنح الحياة قيمتها |
| _ Ev e Efrîn, tevî ku tekeran civiland, dest ji keskahiyê berneda, bedewbûn şervan e | هذه هي عفرين، رغم أن العجلات دعستها/دعكتها إلا أنها لم تتخلَ عن خضرتها. الجمال مقاتل. | هذه هي عفرين، رغم أن الاحتلال مرعب، لم يغادرها جمال الخضرة، فالجمال مقاتل عنيد وشرس |
قصة الحياة للكاتب سلام حسين
قصة الحياة أو خمس حيوات في الأصل، قصة قصيرة رمزية/فلسفية تلامس الفنتازيا الوجودية والسيرة الذاتية المتخيلة.
- البنية السردية:
تنقسم القصة إلى:
مقدمة فنتازية: عالم الأرواح والملائكة بعد الموت، حيث تُمنح الأرواح فرصة العودة إلى الحياة.
ثلاثة محاور زمنية: كل محور يصف حياة مختلفة عاشها “أوميد”، بشخصيات مختلفة (هندي أحمر، امرأة أرمنية، طفل كردي من حلبجه).
ذروة درامية: اعتراض أوميد ورفضه العودة للحياة البشرية.
خاتمة مفتوحة: تُترك روحه في جسد طائر ثم شجرة، في استراحة رمزية من قسوة الإنسانية.
- الشخصيات:
أوميد: اسم يعني “الأمل” لكنه هنا يعاني من فقدان الأمل. روحه شاهدة على التاريخ والظلم. شخصيته تمثل الإنسان المتألم المتنور الذي لم تعد تهمه الحياة بل الحقيقة والعدالة.
الملائكة: كيانات تنفيذية، يظهرون في البداية غير متعاطفين لكنهم يتغيرون تدريجياً أمام سرد أوميد، مما يرمز إلى قابلية النقاء نفسه للتعلم من الألم.
- الثيمات الرئيسية:
رفض التناسخ كوسيلة للتكفير أو التجربة: أوميد لا يريد العودة، لأنه يرى أن الحياة لا تقدم سوى تكرار الظلم.
العذاب الإنساني مقابل العدالة الإلهية: هل تكفي “حياة خامسة” لتعويض ثلاث حيوات مليئة بالجحيم الأرضي؟
معنى الإنسانية: كونك إنساناً لا يمنحك الأفضلية، بل ربما يجعلك أكثر عرضة للظلم أو حتى مشاركاً فيه.
المقاومة والذاكرة: أوميد لا ينسى، وهذا ما يُميّزه عن الأرواح الأخرى. ذاكرته هي مقاومته.
الأسلوب الأدبي:
لغة شعرية، تصويرية، مأساوية. يمزج بين الواقعية التاريخية (الإبادة الأرمنية، حلبجة…) وبين رمزية الخيال (الملائكة، الأرواح).
استخدام ضمائر “أنا” و”هم” يُقرب القارئ من الشخصيات ويعزز التعاطف.
استطاعت الترجمة التعامل مع النص بمسؤولية كبيرة وإبراز الخطوط العامة والأفكار الرئيسة للقارئ العربي، ولكن عدم وجود لغة رسمية كردية وانعكاس اللهجات المحلية تقف أحياناً عائقاً أمام المترجم. وهنا أيضاً جدول مماثل:
| الكردية/الأصل | الترجمة المقترحة | الترجمة |
| Firîşteyan li hev temaşe kirin û bi sosretî gotin: “ma tu li hember fermana xweda radiwestî?” | تبادلت الملائكة النظر فيما بينهم وقالوا: أترفض أمر الله؟ | قالوا: وهل تقف ضد إرادة ومشيئة الله؟ |
| Ez weke çermesor hatibûm dunyayê, me xaka çermesoran diparast, xwezaya me pîroz bû, | جئت إلى هذه الحياة ببشرة حمراء وكنا نحمي أرض الهنود الحمر.. الطبيعة عندنا كانت مقدسة.. | جئت إلى هذه الحياة كائناً منتوفاً، منسلخاً، أحمر، كنا نحمي… ترابهم. كانت ولادتنا مباركة. |
| Xewna me bi cî hat û peravên rojhilat gemiyên ku me digot pêxemberan radike, hatin | تحقق حلمنا، فقد أقبلت إلينا من الشواطئ الشرقية سفن تحمل من كنا نعتقد أنهم أنبياء | تحقق حلمنا،… أجنحة الماء… في الشرق الأوسط التي قلنا أنها تحمل الأنبياء جاؤوا، |
| Lê firîşteyên delal, ew ne weke me xeyal kiribû | … لم يكونوا كما تخيلناهم.. | أيها الملائكة الأعزاء: هم لم يكونوا مثلنا يملكون الفكر |
| “Bila ûcaqa gawiran li ser rûyê cîhanê nemîne”. | سنقطع نسْلَ الكفر من هذه الدنيا..
أو سنقطع دابر الكفر في هذه الدنيا |
لن نترك “قداسة الكفر” على وجه الحياة |
| pêşmerge | بيشمركه | مقاتل |
| û ya pêncemîn jî di bedena dareke merxê de cih girtiye û ew dar hîn jî li ser rûyê jiyanê dijî û kes nizane ka kîjan merxa Omîd e.
|
والخامسة استقرت في شجرة صنوبر مازالت على قيد الحياة، لكن… | وفي الحياة السادسة كانت في جسد شجرة صنوبر، مازلت أشجار الصنوبر تعيش على وجه غايا(؟) لكن لا أحد يعرف أي شجرة هي أوميد |
كما يجب التنويه إلى أن الترجمة أغفلت في مواضع كثيرة بعض علامات الترقيم، وعلى وجه الخصوص العلامات التي تدل على القول وفي معظم الحوارات. وهذا يؤدي على الأغلب ضياع المتحدث أو المتكلم في المشاهد التي يتناوب فيها السرد مع الحوار، كما يحدث ارتباكاً في الإيقاع السردي؛ فعلامات الاقتباس ليست زخرفة أو مجرد تفاصيل شكلية، بل تنظم إيقاع القراءة وتمنح القارئ لحظات توقف وفهم. وكذلك يحدث خلطاً بين السرد والمناجاة مما يفقد النص عفويته وصوته الخاص.
وختاماً فإن ماذكر لا يقلل من أهمية الترجمة ولا ينتقص من جهود المترجم الذي يتمتع بوعي ثقافي ونقدي واضح هنا، وترجم المجموعة بلغة عربية سليمة وأنيقة (رغم أن الزخرفة اللغوية طغت على البساطة في بعض الأماكن)، إضافة إلى أنه كان وفياً للهوية الكردية وعدم طمسها في النصوص.
يُعد هذا العمل جهداً أدبياً وثقافياً ممتازاً، يجمع بين الإبداع والالتزام، والمترجم قدّم تجربة ترجمة أدبية ناضجة تعبر عن احترام للنص الأصل وللقارئ العربي على السواء. هي ترجمة تمنحنا مدخلاً مهماً لفهم “الآخر” داخل الوطن، وتمثل إضافة نوعية للمشهد الأدبي العربي المعاصر.