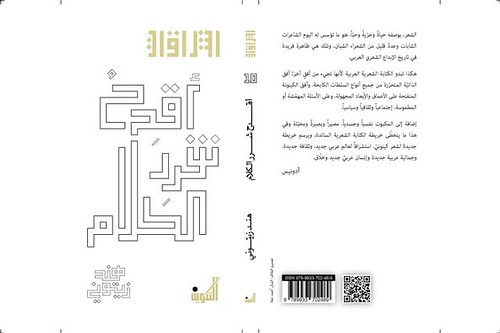رياض عبد الواحد| العراق
يمكن أن نلج إلى هذه المجموعة من منافذ عديدة، أولها ثريا المجموعة/ أقدحُ شررَ الكلام، تحليل الجملة “أقدح شرر الكلام” يمكن تقسيمه إلى ثلاثة مستويات: فونيمي (صوتي)، ودلالي (معنوي)، ونحوي (تركيبي).
التحليل الفونيمي (الصوتي):
الكلمة: “أقدح”
الأصوات الصامتة: (همزة)، (قاف)، (دال)، (حاء).
الأصوات الصائتة: (فتحة قصيرة).
البنية الصوتية: همزة قطع في البداية، يتبعها صوت قاف انفجاري شديد، ثم دال مجهور، وأخيرًا حاء مهموس حلقي.
التأثير الصوتي: الكلمة تبدأ بهمزة قوية، تليها القاف التي تحمل قوة وحزمًا، لتنعكس القوة بالانتهاء بحاء خفيف.
الكلمة: “شرر”
الأصوات الصامتة: (شين)، (راء مكررة مرتين).
الأصوات الصائتة: (فتحة قصيرة).
البنية الصوتية: الشين صوت احتكاكي مجهور يعطي إحساسًا بالبريق أو الحركة السريعة، والراءان المتتاليان يعكسان التكرار والارتداد، مما يشير إلى التوهج المتواصل.
الكلمة: “الكلام”
الأصوات الصامتة: (همزة)، (كاف)، (لام مكررة مرتين)، (ميم).
الأصوات الصائتة: (فتحتان قصيرتان)، (فتحة طويلة).
البنية الصوتية: تتكرر اللام مما يمنح إحساسًا بالإيقاع، والامتداد الصوتي في الألف الطويلة يعطي إحساسًا بالاسترسال والتوسع.
التحليل الدلالي (المعنوي):
أقدح:
المعنى المعجمي: الفعل /أقدح/ مشتق من القدح، ويعني إشعال الشرر، وهو فعل يتطلب احتكاكًا أو صدامًا بين مادتين.
الدلالة الرمزية: يشير إلى إثارة الأفكار، استثارة الحوارات، أو إطلاق الطاقات الإبداعية.
شرر:
المعنى المعجمي: الشرر هو الجسيمات الصغيرة المشتعلة المتطايرة من النار.
الدلالة الرمزية: يرمز إلى البدايات المتوهجة، أو الأفكار السريعة واللامعة، لكنه قد يحمل دلالة على الخطر أو التوتر
الكلام:
المعنى المعجمي: الكلام يعني الحديث أو التعبير اللغوي.
الدلالة الرمزية: يمثل الفعل الإنساني الأكثر تعبيرًا عن الفكر، ويشير إلى الإبداع، الصراع، أو التأثير.
الدلالة العامة للجملة:
الجملة تصور مشهدًا رمزيًا لإطلاق طاقة فكرية أو لغوية (شرر) بواسطة عملية ديناميكية وصراعية (القدح)، مما يوحي بتوهج الأفكار وخطورتها، وأثرها على المحيط.
التحليل النحوي (التركيبي):
أقدح: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الفاعل ضمير مستتر تقديره “أنا”.
شرر: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهو اسم نكرة يوحي بالتعدد والكثرة.
الكلام: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. يحدد نوع الشرر بأنه شرر لغوي أو فكري.
الدلالة التركيبية:
الجملة مبنية على فعلية قصيرة ومباشرة. الترتيب (فعل – مفعول – مضاف إليه) يبرز “الكلام” كمصدر الشرر، مما يعزز الانطباع بأن الأفكار والكلمات تشكل طاقة إبداعية متقدة.
الرؤية الجمالية:
تعتمد الجملة على التوتر الإبداعي بين القدح (الإشعال) والشرر (التأثير السريع المتطاير) والكلام (الوسيلة). التراكيب الصوتية والدلالية تعكس شحنة عالية من الحماس والطاقة، مما يجعلها عنوانًا قويًا لمجموعة شعرية.
أولاً: الرؤية الفنية للمجموعة الشعرية
1- الغربة والاغتراب في الشعر: بين المادي والوجودي
لطالما شكّلت الغربة والاغتراب محورًا مهمًا في التجربة الشعرية الإنسانية، إذ ينبثق من هذين المفهومين شعور مزدوج بالفقد والانفصال، يجسد المسافة بين الذات والعالم. وإذا كانت الغربة تشير إلى الابتعاد المادي عن المكان، فإن الاغتراب يرتبط بعمق بالانفصال الداخلي الذي يشعر به الإنسان تجاه ذاته، أو تجاه محيطه الثقافي والاجتماعي.
الغربة: تجربة الفقد المكاني
الغربة، بوصفها انفصالًا جغرافيًا أو فيزيائيًا، تتردد في الشعر كصوت حزين يشكو الفقد. وقد جسدها الشعراء بوصفها هجرًا للمألوف ومواجهة للغريب.
في الغربة يتحول المكان البعيد إلى عبء ثقيل على الذات، إذ تفقد العوالم البسيطة المألوفة ألوانها، لتحل محلها غربات جديدة، حتى وإن كان الإنسان محاطًا بالآخرين.
الاغتراب: وجع الوجود
أما الاغتراب، فهو تجربة أعمق من الغربة، حيث يتمحور حول شعور الإنسان بالانفصال عن ذاته أو عن العالم من حوله، حتى وهو في قلب مجتمعه. لقد أبدع الشعراء في تصوير هذا الإحساس، إذ يتقاطع مع قلق الإنسان وأسئلته الوجودية.
هكذا يصبح الاغتراب تضادًا داخليًا، حيث يشعر الشاعر أنه منفصل عن كل ما يشكل هويته، بما في ذلك اللغة التي يتحدث بها، وهي أداة التعبير الأهم
الغربة والاغتراب بين الرفض والبحث
إن الشعر الذي يعالج موضوع الغربة والاغتراب لا يكتفي بتسجيل الشكوى أو الحزن، بل يسعى في أحيان كثيرة إلى البحث عن معنى جديد لهذه التجارب. فالغربة والاغتراب يصبحان حافزًا للتأمل والبحث عن “وطن” جديد، سواء أكان هذا الوطن مكانًا فعليًا أم حالة من التصالح مع الذات.
الغربة والاغتراب في السياق المعاصر
في الشعر الحديث، تبدو الغربة والاغتراب أكثر حضورًا، متأثرة بعالم يزداد تعقيدًا، إذ العولمة والهجرة والنزاعات تشكّل أرضية واسعة للكتابة. أصبح الإنسان غريبًا حتى في مكانه، مغتربًا عن ذاته بسبب صراعات الهوية، والانفصال عن القيم والروحانية.
إن الغربة ليست مجرد ثيمة عابرة في ديوان “أقداح شرر الكلام”، بل هي المحور الأبرز الذي يربط النصوص ويمنحها وحدة شعورية وفكرية. الغربة هنا تأخذ أشكالًا متعددة، بدءًا من الاغتراب النفسي والوجداني، مرورًا بالغربة المكانيّة، وصولًا إلى شعور الاغتراب الوجودي الذي يسيطر على النصوص.
أ. الغربة النفسية والوجدانية
تظهر الغربة النفسية بوضوح في النصوص التي تتناول شعور الذات بالعزلة والبعد عن الآخرين، حتى وهي في وسطهم. على سبيل المثال، في قصيدة “المنفى آلام”:
المنفى وطنٌ منفى آخر،
نغرس فيه أسماءنا لنحصد النسيان.
هنا تعكس الشاعرة تناقضًا عميقًا: المنفى كحالة يعيشها الإنسان في داخله، بغض النظر عن مكان وجوده. الغربة ليست حالة مكانية بقدر ما هي شعور نفسي دائم. استعارة “نغرس فيه أسماءنا” تشير إلى محاولات الذات لإثبات وجودها، لكن النهاية تأتي بحصاد النسيان، مما يعمق الإحساس بالعبثية.
ب. الغربة المكانية
في بعض النصوص، تبدو الغربة مكانية، لكنها تتجاوز بعدها المادي لتصبح إسقاطًا على تجربة أعمق. يظهر ذلك في قصيدة “الغربية جارتي”، إذ يتم تصوير الغربة كجيرة غريبة عن الذات. الجيرة هنا ليست فقط مكانية، بل دلالة على شعور دائم بالتنافر مع المحيط.
ج. الغربة الوجودية
تتخذ الغربة في هذه المجموعة أحيانًا بعدًا فلسفيًا وجوديًا، فتعبر النصوص عن تساؤلات الذات عن مكانها في هذا العالم. في قصيدة “الحياة جرح”:
الحياة جرح لا يندمل،
نخيطه بالخيوط ذاتها التي تمزقه.
هذه الصورة تعكس شعورًا بالغربة تجاه الوجود ذاته، إذ تصبح الحياة تجربة مؤلمة وغير مكتملة، تحمل في طياتها تناقضات لا يمكن تجاوزها.
- ثنائية الحياة والموت
هذه الثنائية تشغل حيزًا كبيرًا في المجموعة، حيث تتكرر الصور التي تمزج بين الحياة كمصدر للألم والموت كحقيقة دائمة. على سبيل المثال، في قصيدة “الحياة تفاحة”:
نعضها كل يوم،
لكننا لا نأكلها كاملة.
هنا تتحول الحياة إلى استعارة عن تجربة ناقصة وغير مكتملة، إذ يظل الإنسان ساعيا لتحقيق الإشباع دون الوصول إليه. التفاحة تذكّرنا برمزيتها في أسطورة آدم وحواء، لكنها تحمل هنا بعدًا وجوديًا أعمق.
- الحب كتجربة معقدة
إن الحب في هذه المجموعة ليس شعورًا بسيطًا أو مصدرًا للسعادة، بل هو تجربة مليئة بالتناقضات والصراعات الداخلية. في قصيدة “وقحة جمرة الحب”:
الحب…
جمرة وقحة
تسكن بين الضلوع،
لا تحترق ولا تضيء.
تُقدَّم صورة الحب هنا بوصفه شعورًا يثير التوتر أكثر مما يحقق الطمأنينة. الجمرة كاستعارة تشير إلى شدة الشعور، بيد أنها في الوقت نفسه “لا تحترق ولا تضيء”، مما يعبر عن حالة من الركود والتناقض.
- رمزية الطبيعة
الطبيعة هنا ليست عنصرًا خارجيًا، بل هي جزء أساس من البنية الرمزية للنصوص.
الأشجار كرمز للأحلام:
في قصيدة “إشراقات”:
علقوا قلوبهم
على أغصان الحلم
قبل أن يغادروا.
هنا، تتحول الأشجار إلى رمز للأحلام الهشة، التي يمكن أن تنكسر أو تُقطع بسهولة، مما يعكس هشاشة الطموحات الإنسانية.
الياسمين كرمز للخلود:
في قصيدة “الياسمين حديث:
الياسمين لا يموت،
إنه حديث السماء.
يمثل الياسمين هنا الجمال المستمر والخلود الروحي، مما يضفي طابعًا تفاؤليًا على النصوص.
تركز نظرية التلقي على دور القارئ في إنتاج المعنى، حيث لا يُنظر إلى النص بوصفه كيانًا مغلقًا، بل يتم تفعيله من خلال تجربة المتلقي. في هذه المجموعة الشعرية، نجد أن الشاعرة تترك مساحات واسعة للقارئ لملء الفجوات الدلالية، عبر صور حسية ورمزية متجددة، وتوظيف المفارقة والتناقض. لذا، سنقوم بدراسة هذه العناصر مع الاستشهاد من القصائد لدعم التحليل.
أولًا: الصور الحسية والتجسيد – الجسد والطبيعة كلغة تعبيرية
تعتمد الشاعرة على الصور الحسية لتجسيد العاطفة والتجربة الإنسانية، حيث يتم تصوير الجسد والطبيعة بوصفهما عنصرين متداخلين، ما يمنح النصوص أبعادًا حسية وتأويلية غنية. على سبيل المثال، في قصيدة عزف، يتحول الجسد إلى نهر يتدفق بين يدي الحبيب، مما يعكس حالة من الاستسلام والسكينة:
معك يتخلى جسدي عن أسلحته
يستسلم من الحصار الأول
أتدفّق كنهرٍ مسالم بين يديك
هنا، يُستخدم التشبيه (أتدفق كنهرٍ مسالم) لإيصال شعور الانقياد المطلق للحب، حيث يصبح الجسد أشبه بعنصر طبيعي ينساب بلا مقاومة. كما أن العلاقة بين الحبيب والعاشقة تُرسم بلغة حسية مفعمة بالحركة، مما يسمح للقارئ بتخيل المشهد والشعور به وكأنه يعيشه.
كذلك، نجد صورة حسية موازية في قصيدة يشتعل النبيذ، حيث يتم ربط الرغبة بالضوء والعطر والقمر، مما يخلق تجربة حسية متكاملة:
تتسلل جدائل الضوء عبر نافذتي
تنادمُ ذكرى حبيبٍ قديم
فيفوح العطر في الأرجاء
هذه الصورة تعتمد على التجسيد، حيث تُمنح جدائل الضوء صفة إنسانية تجعلها تتحرك وتتفاعل مع المكان. القارئ هنا يصبح شريكًا في بناء المشهد، إذ يُترك له المجال ليكمل تفاصيل الذكرى الحسية المتداخلة بين الضوء والرائحة والحنين.
ثانيًا: التناقض والمفارقة– الشعر بين الخلاص والخديعة
تلعب الشاعرة على ثنائية الجدوى والعبث، حيث تقدم الشعر بوصفه قوة ساحرة، لكنها في الوقت ذاته عاجزة عن إنقاذ مبدعيه. يظهر ذلك في قصيدة أنا والشعر، التي تستعرض خيبة الأمل في قدرة الشعر على تغيير الواقع:
هذا الذي يسمونّه شعر
لمِ يحمِ رامبو من الموت
ولم يرمّم رئات جون كيتس من التهتك
لم يعِد لفان كوخ أذنهُ المقطوعة
لم ينحنِ خجلاً لبوشكين
يستخدم النص هنا التكرار (لم… لم… لم…) لإبراز المفارقة بين الأمل المعلق على الشعر وبين فشله في تقديم خلاص حقيقي. هذه الاستراتيجية تدفع القارئ إلى إعادة التفكير في الصورة الرومانسية التقليدية عن الشعر، ما يجعل النص مفتوحًا لتأويلات متعددة تتراوح بين الإيمان بقوة الإبداع وبين التشكيك في جدواه.
المفارقة تتجلى أيضًا في النهاية الساخرة للقصيدة:
كتبتُ الشعر
ولم يطعمني رغيفاً واحداً
كان يسرق مني دقيقَ الوقت ويضحك
هنا، يتحول الشعر إلى كائن حي مخادع يسرق الزمن بدلًا من أن يمنحه. هذا التجسيد يثير تساؤلات لدى القارئ حول العلاقة بين الشاعر والإبداع، ويخلق إحساسًا بازدواجية العطاء والأخذ بينهما.
ثالثًا: الرمز والانفتاح التأويلي– الوصية والشعر كامتداد للحياة
في قصيدة وصية، يتم تقديم الموت بوصفه امتدادًا للشعر، حيث لا تتحدث الشاعرة عن فنائها الشخصي بقدر ما تكرس صورة استمرارية القصيدة بعد رحيلها:
أوصيتُ بأن أُدفن بثوب شعري المنقّط
كما أوصت مارلين مونرو أن تُدفن بثوبها الأخضر
هنا، يتحول الشعر إلى كفن رمزي، مما يمنح القارئ مساحة لتأويل العلاقة بين الجسد والنص. هل الموت هو النهاية أم أن القصيدة ستبقى شاهدًا أبديًا على وجود الشاعرة؟ هذا التساؤل يبقى معلقًا، ما يعكس استراتيجية التلقي المفتوح التي تعتمد على تفاعل القارئ مع الرمز.
كما تتكرر الرمزية في المشهد التالي:
كلما تساقطت دموعي تنبت قصيدة على وجنتي وعنقي
الصورة هنا تقوم على استعارة عضوية، حيث يتحول الحزن إلى بذرة تنمو لتصبح قصيدة. هذا التداخل بين العاطفة والإبداع يفتح النص على قراءات متعددة، حيث يمكن للقارئ أن يرى الشعر كوسيلة لتخليد المشاعر، أو كاستجابة لوجع ذاتي يتجسد في اللغة.
رابعًا: العالم المثقوب– محاولات الترميم المستحيلة
في قصيدة ثقوب، تتخذ الشاعرة موقفًا تأمليًا تجاه تشوهات العالم، حيث تستعرض قائمة من الثقوب التي تحتاج إلى ترميم، لكنها تبدو غير قابلة للإصلاح:
أنا امرأةٌ تحاول أن تُرتّقَ
ثقوباً كثيرةً في الكون
ثقباً في قلبِ رجل مجروحٍ خانته الحبيبة
ثقب الحرب
الغائر في قلب مدينتي
هنا، تتحول محاولة الإصلاح إلى فعل عبثي، حيث لا يمكن ترقيع الخيانة أو الحروب أو الفقر. النص يوحي بفكرة العجز أمام قسوة العالم، لكنه في الوقت ذاته يدفع القارئ إلى التفكير في دوره الخاص: هل يمكنه أن يشارك في الترميم، أم أن المصير المحتوم هو الاستسلام لهذه الثقوب؟
هذه الاستراتيجية تلعب على البعد النفسي للتلقي، حيث يجد القارئ نفسه مشاركًا في التساؤل حول معنى التغيير وإمكانية الإصلاح.
خامسًا: الشعر كمرآة للمجتمع– الغيرة والهويات المستعارة
في قصيدة أشواك النساء، تتناول الشاعرة قضية التنافس النسوي في الكتابة، حيث تصور الشعر كغرفة للإيجار تبحث عن قارئ يسكنها:
القصيدةُ تبحثُ عن قلبِ قارِئٍ جيّدٍ لتسكنَ فيهِ
عن بحرٍ لا يأكُلُ أعشابَه اللطيفةَ
هذه الصورة التجسيدية تمنح القصيدة بُعدًا كيانياً، حيث تصبح ذاتًا مستقلة تسعى لإيجاد مأوى. لكن المفارقة تظهر في حديثها عن الكاتبات اللواتي يكتبن بأسماء مستعارة ويشتكين من قلة القراء:
معَ النساءِ الغيوراتِ
مع اللواتي يكتُبنَ بأسماءَ مستعارَةٍ ويشتكِينَ منْ قِلَّةِ القُراءِ
هذه الإشارة إلى الهويات المستعارة تفتح النقاش حول قضايا الاعتراف الأدبي، حيث يجد القارئ نفسه متورطًا في التفكير حول آليات التلقي في المجتمع الأدبي.
الخاتمة: تجربة القراءة كتفاعل ديناميكي
تقدم هذه القصائد تجربة تفاعلية مفتوحة، حيث تعتمد على الصور الحسية والرمزية، المفارقات، والتناقضات لخلق فضاء تأويلي غني. وفقًا لنظرية التلقي، لا يكتمل النص إلا من خلال القارئ، وهو ما يتحقق هنا بوضوح عبر الغموض المتعمد وفتح الدلالات. هذه النصوص لا تقدم إجابات بقدر ما تثير أسئلة، مما يجعل القارئ شريكًا أساسيًا في إنتاج المعنى، وهو جوهر التلقي الحديث في الشعر.