إلى أنيس حنا مديواية، ذي المئة سنة، صاحب أقدم مكتبة في الجزيرة
إبراهيم اليوسف
ننتمي إلى ذلك الجيل الذي كانت فيه الكتابة أمضى من السيف، لا، بل كانت السيف ذاته. لم تكن ترفًا، ولا وسيلة للتسلية، بل كانت فعلًا وجوديًا، حاسمًا، مزلزلًا. فما إن يُنشر كتاب، أو بحث، أو مقال مهم لأحد الأسماء، حتى نبادر إلى قراءته، ونتناقش فيه أنّى التقينا، في الطريق، في المقهى، في الزوايا المتاحة لنا في هوامش الحياة الضيقة.
أتذكّر جيدًا، كنت أحرص على المضيّ، يوميًا، إلى مركز مدينة قامشلي على امتداد أيام الأسبوع، في توقيت محدد يتزامن مع وصول شاحنة الصحافة القادمة من دمشق، قاصدًا مكتبة اللواء، المتعاقدة مع المؤسسة العامة للمطبوعات بموجب وكالةٍ حصرية لتوزيع الصحف في المدينة وما حولها من مدن، بالإضافة إلى مروري غير المنتظم إلى مكتبة الحرية، المجاورة، أو مكتبة جوان أو الرازي أو سومر، بحثًا عن صحافة اليوم وبعض المجلات والكتب. وفي الأحياء، كانت مكتبة الأنوار، ونوشين، وآواز، ودار الثقافة، وتشرين، ودار العلم، ودار القلم، ملاذًا آخر لعطشنا للمعرفة، إذا كانت النسخ قد نفدت قبل أن أتعاقد مع مكتبة: الأنوار، نوشين…
كما كنا ننتظر صحافة الحزب الشيوعي السوري، التي تصلني كملتزم بها منذ أول الثمانينيات، وكنت مراسل جريدته، على نحو نصف شهري أو أسبوعي، بالإضافة إلى بعض ما يصدر من الصحافة الكردية الممنوعة، غير المنتظمة، في أكثرها، والمتداولة سرًا، وكان بعض قياديي كلٍّ منها يوصلها إلي. كنا نقرأ تلك السطور بشغف الجائع، بشغف من يرى الكلمات نوافذ إلى العالم، وأسلحة من نور.
كنت أنشر في عدد من تلك الصحف السورية، والكردية، والعربية، قبل أن تصلنا صحف ومجلات كردستان العراق، وكنت مراسلًا لجريدة خبات، وكاتبًا معتمدًا في “كولان العربي”، إلى جانب مجلة “متين”، ولي صفحتي الخاصة في كل عدد، إضافة إلى صحف عربية اعتمدتني، من دون أن أنشر في الصحافة الخليجية، لموقف معروف، حتى العام 1993، عندما نشرت لأول مرة في مجلة العربي الكويتية.
كما عملت في هيئات تحرير أكثر من مجلة، كهيئة تحرير أو مستشار: مواسم التي أسستها، كراس، إلخ…
الكتابات التي كنت أنشرها – محليًا – في نقد مؤسسات الدولة، كانت تفعل فعلها. إلى جانب هاجسي الأدبي والإبداعي، كانت من عداد الكتابة عن:
متنفذ سلطوي كبير، أو دائرة مرتشٍ هنا، يهدد هذا الصحفي أو ذاك، مظلوم يلجأ إلينا فنكتب عنه، كلمة تضيء ظلمة، ومقالة تزلزل جدرانًا سميكة من الفساد. وكنت أشعر بمتعة كبرى عندما أقف إلى جانب أي مظلوم في وجه أي ظالم، وإن كانت ضريبة ذلك: التهديد، التضييق على اللقمة، إعلان الحرب من قبل صبيان أجهزة النظام المجرم. كانت تلك الكتابات مغامرة مني ومن أمثالي، كمن يصعد أعلى شجرة ويقصّ ما يقف عليه من غصن بالمنشار!
كنا نقرأ ما يُنشر في الصحافة خارج البلاد، نتابع الرؤى والقضايا، نحمل المقالات الجريئة إلى المجالس، نتناقشها، نختلف، نؤيد، نغضب، نصرخ، نحلم. كانت للكتابة هيبتها.
ثم جاء الإنترنت.
هذا الساحر الكوني بفوانيسه!
جاءت المواقع الإلكترونية، وكانت معدودة نوعًا ما، فقد كسرت شوكة الرقابة على الصحف والمجلات، تجاوزت الحدود، وأرعبت الطغاة.
فقد أصبح الآن لكل فرد إمكان أن يكون له منبره، ولم نعد نحتاج إلى استهلاك الوقت في الكتابة على الورق، أو إرسال المقالات بريدياً، التي كثيرًا ما كانت تتعرض للحجز، وكان – كشهادةٍ – موظف البريد الكردي، الصديق آنذاك، يمرّر – أحيانًا – رسالةً ما من يد الرقيب، أو يدسها في كيس الرسائل التي تعرضت للتفتيش.
كم من رسالة حُجزت من قبل الرقابة، واردة كانت أم صادرة، كم من جملة فُتّش فيها، كم من كلمة صودرت، وكأنها قنبلة…!
أما اليوم، فوسائل القراءة متوافرة.
بإمكان المرء أن يقرأ عبر جهاز هاتف بحجم الكف، أو آيباد، أو لابتوب، أو ديسكتوب. مكتبة عالمية تتقافز بين الأصابع، كي يتوافر له من خلال هذه الوسيلة أو تلك الوصول إلى ما يشاء من مقالات لملايين الكتّاب، مؤلفات بالملايين، شبكات تواصل للمليارات، كلٌّ يكتب، ينشر، أو حتى يصوّر، يبث، يصرخ، يضحك، يرقص.
صار لكل شخص أن يكون كاتبًا، وينشر ما يريد خلال ثوانٍ، دون أن ينتظر رسالته حتى تصل إلى المنبر أو الوعاء المطبوع، أيامًا أو أسابيع، أو حتى شهورًا.
يمكن لأي مبحر في الفضاء الأزرق أن يكون كاتبًا، محررًا، مدير تحرير، صاحب موقع، جريدة، أو حتى كتاب، أو مئات وألوف الكتب. ولكن، أية مقالات؟ أية صحف؟ أية كتب؟ بعد أن جاء جيل جديد من المستعينين بالذكاء الاصطناعي، يدبّجون مقالات في ثوانٍ، ولربما كتبًا في دقائق أو ساعة. وهناك لكل منهم مدققه، وناشره، ومديره العام، في تطبيق واحد.
لكن،
لا أحد يقرأ أحدًا،
ما عدا قلة، كما يشير عدّاد القراءة في كل موقع إلكتروني!
كتّاب كبار، لا يقرأ منشوراتهم إلا بضعة أشخاص. بينما تجد مهرّجًا، أو مدّعي ثقافة وسياسة وموقف… أو بهلوانًا… يقرؤهم الآلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف، بل ثمة من يتحدث عن ملايين المتابعين لبثّ ديجيتالي يقدمه وهو أمي، أو نصف أمي، جاهل، لا شيء يمكنه ما عدا انضوائه ضمن الظاهرة الصوتية التي أشار إليها د. عبد الله القصيمي، رحمه الله!
ثمة يأس مطبق،
يدفع الكاتب الحريص على رسالته إلى أن يسأل، بكل وجع:
لماذا أكتب؟
طالما لا أحد يقرأ،
طالما ثمة من يكتب نصًّا مشابهًا لما أكتبه، بعد جهد طويل، خلال ثوانٍ،
طالما لا تأثير لما أكتب، في زمن الصورة الإلكترونية، والمشهدية السطحية، والمحتوى السريع، والردود الآنية.
لماذا أكتب؟
وهل ما أكتبه، حقًا، يعني شيئًا في هذا الضجيج؟
لكنني، رغم كل هذا، أكتب.
أكتب، لأنني لا أستطيع ألا أكتب.
لأن في داخلي نارًا، لا تخمد إلا إذا تحوّلت إلى كلمات.
لأن الكتابة ليست وسيلتي للوجود فحسب، بل هي صمتي الأعلى، وصراخي الأعمق.
أكتب، ولو لم يقرأ أحد.
أكتب، لأنني كنت من الجيل الذي لم يكن فيه القلم وسيلة، بل كان موقفًا.
ولن أتخلى عنه الآن، ولو كنت آخر من يحمل قلمًا في زمن الشاشات.
*
كانت في مدينة قامشلي الصغيرة حوالي ثلاثين مكتبة، معذرة عن عدم تذكّر أسماء جميعها!




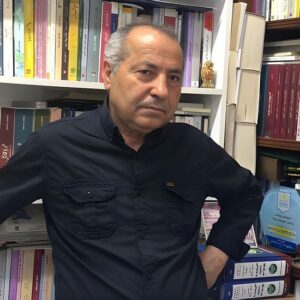

2 Responses
أخي العزيز الأستاذ إبراهيم اليوسف،
قرأت مقالتك بكل امتنان وشجن. لقد أعدتني بكلماتك إلى زمنٍ كانت فيه الكلمة نافذتنا إلى العالم، والمكتبة مأوى الروح.
في زمني، لم تكن في قامشلو سوى مكتبة أنيس مديواي — أطال الله بعمره وأسعده — كانت ملاذًا وحيدًا لكل من آمن بأن المعرفة مقاومة، وبأن الكتاب رفيق لا يُخيّب.
شكراً لك على هذا النص الذي لم يدوّن الذكريات فحسب، بل منحها حياة جديدة.
دمتَ وفيًّا للحبر، ولزمنٍ ما زلنا نؤمن بأنه الأصدق.
بوركتم