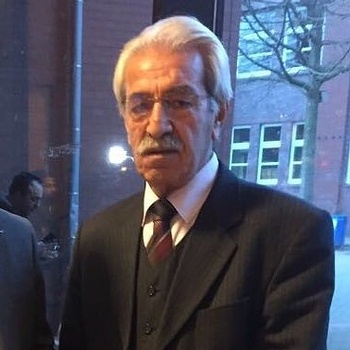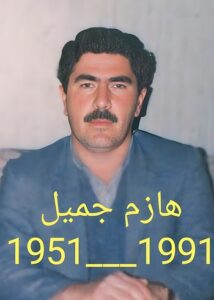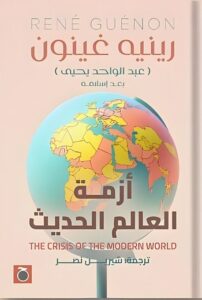حيدر عمر
أغلب الحكايات الشعبية، في الآداب الشعبية للأمم والشعوب نجدها مصاغة على ألسنة الحيوان، ولها غايات تربوية توجيهية، ولعل حكايات “كليلة ودمنة” تشكِّل مثالاً بارزاَ لها، فنحن نجد فيها أسداً هو رمز أو صورة للسلطان الجائر، وثعلباً هو رمز للبطانة الفاسدة المحيطة بالسلطان الجائر، يدله على طريق السوء. ثم نجد أن كل حكاية في هذا الأثر الرفيع تنتهي بما يمكن أن يكون حِكمة، تحثُّ على العمل النبيل، أو تُظهر نتائج الظلم والأعمال الجائرة. ومع أن الترجمة لا تدخل في باب الأدب المقارن، إلا أنها إحدى أدواته، فهي تفيد الباحث الذي لا يعرف اللغات الأصلية للحكايات التي سيدرسها ويعقد المقارنة بينها, من هنا نرى أنه لا بأس أن نمرَّ على إحدى حكايات “كليلة ودمنة”، وهي حكاية “السلحفاة والبطتان“. لأن هذا الأثر الرفيع في أصله الهندي يندرج ضمن الحكايات المروية، وهو من هنا يدخل في باب الحكاية الشعبية، ويلتقي معها من حيث الغاية التربوية والتوجيهية.
تقول الحكاية: “وُلد البوذا الموعود وكبُر، فصار مستشاراً للملك في الأمور الدنيوية والروحية. كان هذا الملك ثرثاراً جداً، حين يتحدث لا يترك فرصة الكلام لأحد، وكان البوذا يسعى للوصول إلى وسيلة لمعالجة هذه الثرثرة.
بينما كانت سلحفاة تعيش في بحيرة في جبال الهيملايا، وارتبطت بعلاقة صداقة مع بطتين كانتا تأتيان إلى البحيرة للحصول على الطعام. أرادت السلحفاة أن تأخذاها معهما إلى حيث تعيشان، وهو كهف ذهبي في تلك الجبال، ولكنها تساءلت كيف السبيل إلى ذلك وهي لا تستطيع الطيران؟، فاقترحت البطتان أن تأخذا بطرفَيْ عصا والسلحفاة تعضها من وسطها، ثم تطيران بها، وحذرتاها من أن تفتح فمها. ولما كانت البطتان تطيران فوق قصر الملك، ورآهما الناس، راحوا يصرخون “بطتان بريتان تحملان سلحفاة على عصا.” أرادات السلحفاة ان تردّ عليهم، وما أن فتحت فمها، حتى سقطت في باحة القصر وانشطرت إلى نصفين.
كان الملك وحاشيته والبوذا في الباحة حينذاك، فراح ينظر إلى السلحفاة، ثم سأل البوذا: “يا معلم، كيف حدث وأن سقطت السلحفاة هنا”. فكَّر البوذا، فرأى الحدث مناسباً لأن يعالج به ثرثرة الملك. فقال: لا بد أن كانت للسلحفاة صداقة مع البط البري، ولا بد أن البط طلبا منها أن تعض على العصا، وتطيرا بها عاليا في الهواء، ليأخذاها إلى الجبال، ولأن السلحفاة لا تستطيع التحكُّم بلسانها، وحين سمعت أحدهم يتكلم، لا بد أنها أرادت أن تقول شيئاً، ففتحت فمها، فوقعت وماتت. وقال للملك: “أولئك الذين لا نهاية لكلامهم، تنتهي بهم الأمور إلى هكذا حال مؤسفة. ثم أنشد ما يعني أن كثرة الكلام لا بد أن تؤدي إلى حال كحال السلحفاة”.
فهم الملك أن المعلم يقصده بكلامه، فقال له: أيها المعلم هل تقصدنا بكلامك؟ قال المعلم: سواء كنت أنت المقصود أم غيرك، فإن كل من يتجاوز الحدود في كلامه، يلقى مثل هذا المصير المحزن. فما كان من الملك إلا أن ضبط نفسه، وأصبح مقلَّاً في كلامه.
هذه الحكاية تهدف إلى توجيه الإنسان نحو اجتناب الثرثرة، وإلى أن يعطي المرءُ غيرَه فرصة الكلام، ويأخذ دور السامع الجيد. وهي من هنا تصلح أن تُروى لجميع الفئات العمرية، وفي كل زمان ومكان.
دخلت هذه الحكاية ضمن مجموعة حكايات “كليلة ودمنة” إلى اللغة البهلوية بترجمة الطبيب برزَوَيْهْ، ثم ترجمها ابن المقفَّع إلى اللغة العربية تحت عنوان “السلحفاة والبطتان،” بعد أن أحدث فيها تغييراً، فحذف شخصية البوذا لتتلائم مع البيئة الإسلامية، عندئذ لم يعد ثمة حاجة إلى ذكر شخصية الملك والبوذا وسقوط السلحفاة في باحة قصره، فحذف كل ذلك. ونقلها م. خالد ساديني من اللغة الفارسية إلى اللغة الكردية بعنوان “البطة والسلحفاة”.([1]) وفق صنيعابن المقفع.
ثمة حكاية ” الذئب و الثيران الثلاثة“([2])، في الموروث الكوردي، وهي معروفة في الموروث العربي أيضاً، باسم حكاية “الأسد والثيران الثلاثة”، كما ترد تحت عنوان “الاتحاد قوة” في مجموعة من القصص و الحكايات الشعبية، جمعها خليفة السيد.([3]) وقد أُثِر عنها، في الثقافتين الكوردية و العربية، المثل القائل “أُكلتَ يوم أُكِلَ الثورُ الأبيض”.
تدور أحداث هذه الحكاية حول ثلاثة ثيران، أبيض وأحمر وأسود اللون، ترافقت في إحدى المراعي الخصبة، وذات يومِ رآها ذئب (في الرواية الكوردية، وأسد في الرواية العربية)، فسال لعابه، إلا أنه لم يتجرَّأ أن يهجم عليها وهي مجتمعة معاً، فلجأ إلى الحيلة، وأقنعها ببقائه معها كأصدقاء أربعة. وإذ رأى الذئب الثورَ الأبيض ذات يوم وقد ابتعد عن الثورين الأحمر والأسود، مضى إليهما وأقنعهما بالخلاص منه، لأن لونه الأبيض يثير انتباه الأعداء من بعيد، فيكون سبباً في هلاكهم، ومن جهة أخرى فإن الخريف الذي بدا قدومه قريباً سيقضى على قسم كبير من المرعى، وقد لا يكفيهم ما يبقى منه حتى قدوم الربيع. وإذ ضمن موافقة الثورين الأحمر والأسود، مضى إلى الأبيض وأجهز عليه.
بعد مضيِّ بضعة أيام استغل الذئب أو الأسد ابتعاد الثور الأحمر عن الثور الأسود، فمضى إلى الأسود، وأقنعه أيضاً بالخلاص من الثور الأحمر، لأن لونه ملفت للنظر، وأن الشتاء على الأبواب، سيقضي بصقيعه على قسم كبير من المرعى، فلا يكاد يكفيهما ما يبقى منه حتى قدوم الربيع. وبهذه الحيلة استمال الثور الأسود إلى جانبه، وتأكد من أنه لن يقف إلى جانب الثور الأحمر، فأجهز عليه وقتله، واتخذه طعاماً له لبعضة أيام أخرى.
وإذ بقي الثور الأسود وحيداّ، لا صديق ولا معين له، تقدم منه الذئب أو الأسد وصرّح له علناً، أنه يريد قتله وأكله، فراح يتوسل إليه، ويذكِّره بالصداقة التي تعاهدا عليها، إلا أن كل ذلك لم يفده، ولم يثن الذئب أو الأسد عما عزم عليه، بل وضعه أمام الحقيقة التي ساهم فيها بنفسه، وقال له ” أُكِلْتَ يوم أُكِلَ الثور الأبيض “، وأجهز عليه، وراحت هذه الخاتمة مثلاً سائراً.
لهذه الحكاية مغزى فكري، هو أن الوحدة أو الاتحاد يُرعب الأعداء، وأن التنازل عن الموقف الصحيح مرةً، يعقبه التنازل مرات أخرى، وأن على المرء ألا ينسى طبيعة العدو، فـ ” الطبع يغلب التطبُّع” كما يقال في العربية، و ” تبلغ اللحية شبراً، ولا يصبح العدو صديقاً ” كما يُقال في الكردية. ” Rih dibe bost, dijmin nabe dost”، أي مهما كان العدو متعبِّداً يخاف الله، فإنه لن يصبح صديقاً.
مثل هذه الحكايات قد لا تُحكى للأطفال فقط، بل يتداولها الكبار أيضاً فيما بينهم، وذلك في ظروف صعبة يمر بها الشعب، كأن يُبتلى بحاكم مستبد ظالم، يحسب على الناس أنفاسهم، أو عندما يُبتلى بقوى خارجية تغزو بلده وتحتل أرضه، ويصيبه منها ظلم شديد. عندئذ تلجأ الشعوب إلى مثل هذه الحكايات رمزاً للدعوة إلى الاتحاد والعمل في مواجهة الحاكم المستبد والقوى الغازية والمحتلة بروح الفريق، وعدم التنازل عن الموقف الواحد، لأن التنازل مرة قد يعقبه مرات عديدة.
ثمة حكاية كوردية أخرى تدور حول هذه الغاية وهي بعنوان “كيف أُرعِبَ الذئب؟”([4]). تدور أحداث هذه الحكاية حول حصان خرج قاصداً مرعى ما، فالتقى في طريقه ديكاً رافقه، ثم التقى كبشاً ثم أرنباَ، فترافق الأربعة، وإذ كانوا في المرعى، لمحو عن بُعدٍ قطيعاً من الذئاب قادماً نحوهم، تقدم أحدها، فسأله الحصان: ماذا تريد؟ قال: أريد أن تعطيني الكبش لآكله. فقال الحصان: تعال كُلْني أولاً. فلما تقدم نحوه، أطبق الحصان قائمتيه على رأسه، وضغط عليه بكل قوته، وراح الكبش يضربه، والديك ينقر الأرض بحثاً عما يأكله، وأما الأرنب، فقد لاذ بالفرار. وإذ تمكن الذئب من الإفلات، فرَّ هارباً نحو قطيعه، فسأله أصحابه عما حدث، ولكنه لم يُجِب، بل قال: اتبعوني، ففي الأمر هلاكنا. ولما ابتعدوا عن المكان، وقف وقال لاهثاً: عندما وصلت إليهم، وضع أحدهم رأسي بين قطعتَيْ خشب، وضغط ضغطاً شديداً، وراح آخر يضربني ضرباً مبرحاً، والثالث أخذ يحفر لي قبراً، بينما الرابع مضى مسرعاً إلى طلب مزيد من القوات.
يتردد صدى هذه الحكاية في حكاية شعبية روسية هي”بيت الحيوانات الشتوي“([5])، التي تُروى حول زوجين عجوزين كانا يملكان ثورأ وخروفاً وبطة وديكاً وخننزيراً. أردا أن يذبحا الديك ذات يوم، فلما سمع الديك حديثهما، تحيَّن فرصة وهرب، وهكذا كلما أرادا أن يذبحا أحد الحيوانات، سمع الحيوان حديثهما، و هرب هو الآخر، فالتقى الحيوانات الخمسة في مكان ما. ولما حلَّ الشتاء ومعه البرد، اقترح الثور على كل واحد منها أن يبنوا مأوى لهم، إلا أنها جميعاً رفضت مشاركته، وقال إنه يستطيع أن يتدبَّر أمره بنفسه. فاضطر الثور أن يبنى المأوى وحده، ولما شعرت الحيوانات الأخرى ببرد الشتاء، ذهبت إلى الثورة واحداً تلو آخر، يرجوه قبول دخوله في المأوى. وهكذا أصبحت الحيوانات الخمسة مرة أخرى معاً داخل المأوى.
كان في الجوار ذئب ودبٌّ، عرفا أمر الحيوانات الخمسة، فتقدما يريدان افتراسها، والسكن في مأواها. واتفقا على أن يبدأ الذئب أولاً، وما أن دخل الذئب حتى نطحه الثور بقرنيه، وهاجمه الكبش فنطحه في جبينه، وراح الخنزير يصرخ عالياً: إنني أشحذ السكين والبلطة الكبيرة لأني أريد التهام الذئب، وأخذت البطة تقرصه في بطنه، والديك يقول لقد شُحذ السكين والقدر جاهزة لسلق لحمه. سمع الدب أصوات الحيوانات الخمسة، ففر هارباً مذعوراً، أما الذئب، فاستطاع أن يتخلَّص بصعوبة، وفرَّ هارباً حتى أدرك الدب، وحكى له كيف أنه أوشك على الموت…. وكيف هاجموه هجمة شرسة، وأوشكوا أن يقضوا عليه، وبالكاد استطاع أن ينجو من الموت. ومنذ ذلك الحين لم يتجرَّأ الذئب والدب أن يقتربا من الحيوانات الخمسة، التي عاشت في أمن وسلام.
إن هذا الصدى المتبادل بين الحكايتين الكوردية والروسية نسمعه في حكاية أوزبكية أيضاً، هي حكاية “العنزة الفطِنة“.([6])
كانت امرأة بخيلة تملك عنزة، لاتدعها ترعى، بل تحبسها في الحظيرة ستة أيام، وكانت تطلقها يوماً واحداً في الأسبوع إلى المراعي، فيصبح هذا اليوم يوم فرح وسعادة لها، تسرح في المرعى كما تشاء، وترعى الأعشاب الطرية بحرِّية. وكان أثر تلك المعاملة السيئة ظاهراً عليها، إذ بدت ضعيفة هزيلة، ولهذا كانت تتحيَّن فرصة للهرب، وذات يوم بينما كانت في المرعى، رأت نعجة صغيرة نحيفة مثلها، بل وأكثر. ولهذا راحت تسخر منها، ولكن النعجة ردت عليها بالسخرية نفسها، ما جعلها تشعر بالخجل. ثم تصالحتا، وراحت كل منهما تحكي للأخرى حكايتها وسبب نحافتها، فإذا النعجة أيضاً مبتلية بصاحبة لا تقلًّ عن صاحبة العنزة بخلاً وظلماً، فاتفقتا على الهرب بعيداً، واتجهتا نحو جبل كثير المرعى والمياه الصافية والهواء الطلق والنقي. فالتقتا في طريقهما ثوراً ضخم الجسم، ولكنه نحيف هزيل، فسلمتا عليه وسألتاه عن سبب ضعفه، فإذا هو أيضاً يعاني من صاحبه ما تعانيان. وأراد أن يرافقهما في الهرب، لعله يتخلَّص من ظلم صاحبه.
ترافقت الحيوانات الثلاثة ومضت إلى الجبل، حيث العشب النضير والماء العذب والهواء الطلق، ولم يمض وقت طويل حتى استعادت صحتها وامتلأت أجسادها، وبدا الثور ضخماً تخافه الحيوانات الأخرى في الجبل، حتى ظنت أن هذا الساكن الجديد ليس إلا ملك الوحوش المفترسة. وبنت لنفسها حظيرة تقيم فيها. وذات ليلة شعر الثور بالاختناق من هواء الحظيرة، فأراد أن يبيت خارجها.
في صباح اليوم التالي، رأت العنزة والنعجة العجب، فإذا بالثورة قد تجمَّد في مكانه من البرد، لايستطيع الحراك إلا بصعوبة، ولا بد من تدفئته، وإلا فلن يعيش. تسلَّقت العنزة إحدى الأشجار، تستكشف المكان، علَّها تجد ما يمكن أن يساعدهما في تدفئة الثور، فلمحت دخاناً يتصاعد من كهف غير بعيد، ما يعني أن أحداً قد أوقد ناراً هناك، فلا دخان بلا نار. راحت العنزة والنعجة تساعدان الثور وتدفعانه حتى وصلوا إلى مدخل الكهف، فرأت العنزة جلوداً من فراء نَمِر ودُبٍّ وثعلب وذئب معلقة بغصن شجرة، فالتقطتها وألقت بها كلها فوق الثور.
كان الكهف مكتظاً بالحيوانات من النمور والدببة والذئاب والثعالب، وأحد النمور كان متربّعاً على ما يشبه مصطبة، كأنه قائدها. اجتمعت كلها كعادتها مرة واحدة في الأسبوع، ليقيم أحدها وليمة للجميع، وهذه المرة كان الدور على الثعلب ليقيم الوليمة، ولكنه عجز عن أن يقدِّم شيئاً لأصحابه الذين راحوا يسخرون منه، ويتوعَّدونه بأن يمزِّقوه ويأكلوه، وهو يتوسل إليهم متمسكناً ذليلاً ويرجوهم العفو عنه. وإذا ذاك دخل الأصدقاء الثلاثة، العنزة والنعجة والثور، إلى الكهف، ولما رآهم الثعلب، ضحك وقال لأصحابه “إنما كنت أمزح معكم، انظروا ماذا أحضرت لكم؟”
زمجرت الوحوش، حين رأت الحيوانات الثلاثة، فتملَّك الخوف النعجة والثور، ولكن العنزة سيطرت على نفسها ولم تستسلم للخوف، وقالت في رباطة جأش: “أنا أعمل جزَّارة في مدينة “همنجان”، وقد تعاقد سكانها معي على جلود ستين نمراَ وستين دُبَاً وستين ثعلباً وستين ذئباً، والحمد لله الذي قادني إلى هذا الكهف، لأجد فيه بُغيتي، وإن لم تصدقوا كلامي، فانظروا”. ثم راحت تلقي الفراء من على الثور على الأرض أمامهم.
حين رأت الوحوش ذلك، تملَّكها الخوف ولاذت بالفرار. أما النمر المتربع على المصطبة، فقد بقي مكانه، والخوف بادٍ عليه، ولما تقدم نحو باب الكهف يريد الخروج والخلاص، اعترضه الثور ونطحه فأوقعه أرضاً، فراح يتذلّل ويطلب العفو، ويتعهَّد، إن بقي حياً، ألّا يعود إلى هذا الجبل، وسوف يمنع عنه الوحوش الأخرى. فتركه الأصدقاء الثلاثة، فمضى إلى أصحابه، وعاد الأصدقاء الثلاثة إلى حظيرتهم.
راحت الوحوش تفكّر في أمر نفسها وأمر أولئك الحيوانات، فاستغربت هروبها من عنزة ضعيفة، مع أن واحداً فقط يستطيع أن يقضي عليها. هنا دبّت الحمية في قائدهم النمر، فنسي عهده مع الأصدقاء الثلاثة، وقاد جموع الوحوش إلى حظيرتها وحين لمحت العنزة قدومها، طلبت من الثور والنعجة أن يتسلّقا شجرة، ويختبئا بين أغصانها، وصعدت هي إلى سطح الحظيرة.
ولما اقتربت الوحوش من الحظيرة، ووجدوها خالية، طلب النمر القائد من الثعلب الماهر في قراءة الطالع أن يستكشف المكان. وبينما كان منشغلاً في قراءة الطالع والتنجيم، دوّى صوت قويّ من السماء، وأثار الغبار، فسقط شيء ضخم على الوحوش. لم يكن ذلك الشيء سوى الثور، انكسر تحته غصن الشجرة، فهوى وأصدر ذلك الصوت من الهلع، وسقطت النعجة من خلفه.
تمالكت العنزة نفسها مرة أخرى، وهتفت من مخبئها فوق الحظيرة: “خذ فوق رأسك يا قارئ الطالع، خذ فوق رأسك أيها المنجّم”.
ارتعشت الوحوش من المفاجأة، وأسرعت هاربة. ثم لم تعد إلى ذلك المكان ثانية، وعاش الثور والعنزة والنعجة حياة سعيدة هانئة في الجبل.
لا يحتاج السامع أو القارئ إلى كبير عناء، ليستنتج أن للحكايات الثلاث غاية تربوية تعليمية وتوجيهية، فهي موَّجهة للأطفال قبل غيرهم، وتستطيع بحبكاتها أن تجذبهم نحو متابعة الاستماع أو القراءة وتنمِّي فيهم البداهة، وعدم الارتباك في مواجهة خطر ما، فالحصان رغم معرفته أنه وأصحابه ليسوا قادرين على مواجهة قطيع من الذئاب، فإنه ابتكر في الحال طريقة أو أسلوباً للدفاع عن نفسه وعن أصحابه الضعفاء. وفي الحكاية الروسية لم يرتبك الثور في مواجهة الذئب الشرس، بل باشر بضربه، وتبعته الحيوانات الأخرى. وكذلك في الحكاية الأوزبكية ابتكرت العنزة طريقة وأسلوباً للدفاع عن نفسها وعن صديقيها. وانتصر الجميع على أعدائهم، بفضل تعاونهم وتآزرهم.
ولا غرو في ذلك، فمرحلة الطفولة هي مرحلة حساسة، ولها تأثيراتها في المراحل العمرية اللاحقة، و تعتبر الثقافة الشعبية عامة، والحكاية المروية خاصة، “أحد أهم الروافد التي تعنى بالطفل، وتحتفي به، و تنمّي قدراته الجسمانية والعقلية، و تبثُّ فيه مفاهيم تربوية، وتعمل على تقويمه سلوكياً وأخلاقياً”.([7]) ولعل مثل هذه الحكايات تحثُّ الناس في كل زمان ومكان على التضامن والعمل بروح الفريق في مواجهة الأخطار.
ثمة حكاية في الموروث العربي مفادها أن حكيماً أراد أن يعلِّم أبناءه درساً من دروس الحياة، ويحثهم على التعاون فيما بينهم. فجمعهم وأعطاهم أعواداً، وطلب منهم أن يكسر كل واحد عوده، فكسروها بيسر. ثم جمع العيدان معاً، وطلب من كل واحد أن يكسرها مجتمعة، فعجزوا عن ذلك. عندئذ قال لأبنائه ما معناه: إن في التفرقة ضعفاً، وفي الاتحاد قوة. سمعتُ الحكاية نفسها في فيلم هندي، يقصها أحد الشخصيات لمجموعة من الأطفال. ولعل كل هذاما يدل على أن تجارب الشعوب متشابهة.
([1]) M. Xalid Sadînî: Çîrokên gelêrî, weşanên Nûbihar, çapa duyem, Istanbul 2013, rû 79.
([2]) Elî Cefer: Gotina mêrê Kurd gotin e, rû 8-11. M. X. Sadînî: Ҫîrokên gelêrî, rû 90, 91. Fettah Tîmar: Heman jêder, rû 41
([3]) خليفة السيد: قصص و حكايات شعبية، الطبعة الأولى، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و التراث، قطر 2002، ص 139. في هذه المجموعة يحل الثور البني محل الثور الأحمر.
([4]) Haciyê Cindî: Hikayetên cimaeta Kurda, çapa yekem bi elfabeya latînî, weşanên Ronahî, Amed 2011.
([5]) عبد الرحمن عبد الرحمن الخميسي: الحكايات الشعبية لشعوب آسيا، مصدر سابق، ص 39.
([6]) عبد الرحمن عبد الرحمن الخميسي: أساطير شعبية من أوزبكستان، ترجمة ج 2، الطبعة الثانية، المركز القومي للترجمة، القاهرة 2009، ص 173.
([7]) الدكتورة نيڤين محمد خليل و زميلاها: بحوث و دراسات في الثقافة الشعبية، 2016، ص 111.