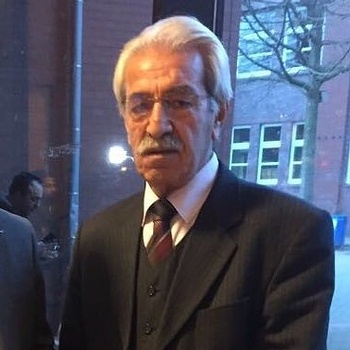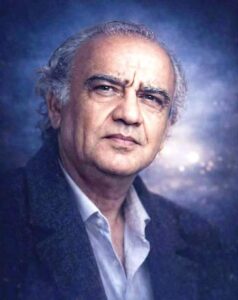حيدر عمر
هناك حكايات تتنازعها عدة ثقافات، مثل حكاية “شَنْگلو مَنْگلو / şekgelo menglo“التي تتنازعها الثقافتان الكوردية والفارسية، وهي مروية على لسان معزاة توصى صغارها الثلاث بألَّا يفتحوا باب الحظيرة في غيابها إلَّا بعد أن يسمعوا منها أغنية معينة تغنيها لهم. سمعها ذئب في أحد الأيام، كان يمر في الجوار. بعد ابتعادها عن صغارها، جاء الذئب، يغني الأغنية نفسها، ويقلِّد صوت المعزاة الأم، ليفتح الصغار له الباب، وبعد أخْذ وردٍّ بينه وبين الصغار، تمكن من خداع إحدى السخلات، ولما فتحت الصغار له الباب، فتك بها جميعاً، وبعد أن عادت المعزاة، ولم تجد صغارها، راحت تبحث عنها، فسألت عنها بعض الحيوانات التي التقت بها مثل الثعلب والدب وطائر اللقلق واحداً تلو آخر، ولما أجابتها هذه الحيوانات بالنفي، تابعت بحثها في الغابة، فوجدت ذئباً توقعت أنه افترس صغارها، فاتهمته بذلك، واستعدت لقتاله، فشحذت قَرنيها وقاتلت الذئب، فشقت بطنه بضربة من قَرنيها وقتلته، ثم أخرجت صغارها من جوفه، وكانت مازالت أحياء، لأن الذئب كان ابتلعها حية([1]).
تروي الثقافة الفارسية هذه الحكاية تحت اسم “شَنْگول و مَنْگول” ، وهي لا تختلف عن الرواية الكوردية. وترد في الثقافة الشامية بعنوان آخر هو “تيتيلا وبيبيلا”، على حدِّ قول الكاتب السوري عادل أبو شنب، وترد في الثقافة الألمانية بعنوان آخر هو “الذئب والسخلات السبع”. وإذا كان ثمة خلاف بين نماذج هذه الحكايات، فيكون بفعل الزمن وتبدُّل البيئة واللغة والرواة.”([2])
بالإضافة إلى تنازع الثقافات الكوردية والفارسية والشامية هذه الحكاية، ثمة حكايات أخرى ترد لدى الكورد والفرس، هي “الراعي الكذاب”، وهي عند الفرس بالعنوان نفسه “چوپان دروغگو”، و “الثعلب والغراب“، التي ترد لدى الفرس بالعنوان نفسه “روباه وزاغ”، و”الأسد والثعلب“، التي ترد لدى الفرس تحت العنوان نفسه “شير و روباه” (بإمالة الشين)، وغيرها من الحكايات.([3])
يتردَّد صدى حكاية “شَنْگلو مَنْگلو / şekgelo menglo ” في الثقافة الألمانية، في حكاية تحت عنوان “الذئب والسخلات السبع” مما جمعة الأخوان جريم، ياكوب و فيلهلم، وطبعاه في برلين سنة (1825)([4]).
تذهب الحكاية الألمانية إلى أنه كانت هناك في زمان ما عنزة لها سبع سخلات، اعتادت العنزة أن تذهب إلى الغابة للبحث عما تطعم به سخلاتها. ذات يوم حذرت سخلاتها من الذئب، وقالت سأذهب إلى الغابة، ربما يمر من هنا ذئب ما، فينقض عليكنَّ، ويأكلكنَّ، لذلك لا تفتحْنَ له باب الحظيرة. طمأنت السخلات أمهن، بألَّا يفتحن الباب لأيٍّ كان.
لم يمض وقت طويل، وإذ السخلات تسمع صوتاً “افتحْنَ الباب أيتها العزيزات، أنا أمُّكنَّ، قد أحضرت لكُنَّ طعاماً”. لكن السخلات ميِّزن بين هذا الصوت وصوت أمُّهنَّ، وأدركن أنه ذئب، فقلن له “لا نفتح لك الباب، أنت لست أمنا، صوت أمنا جميل، بينما صوتك خشن، أنت ذئب”. احتال الذئب، وجعل صوته ناعماً، ثم عاد إلى الحظيرة، ووضع مخلبه الأسود في النافذة، ونادى “هيا افتحنَ الباب، أنا أمُّكنَّ قد أحضرت لكُنَّ طعاماً”، ولكن السخلات اكتشفن حيلته، إذ رأين مخلبه الأسود، فقلن له “لن نفتح الباب، أمنا ليست لها أقدام سوداء، أنت ذئب”.
ذهب الذئب إلى الخبَّاز، وطلب منه أن يضع بعض العجين على قدمه، لأنه تعثَّر، فأصيبت قدمه، ثم ذهب إلى الطاحون، وطلب من الطحَّان أن يرش على قدمه بعض الطحين. أدرك الطحان أن الذئب يريد خداعه، فرفض طلبه، لكن الذئب هدَّده، بأنه سيأكله، إن لم يلبِّ طلبه، فخاف الطحان، ورشَّ بعض الطحين على قدمه، فصار لونها أبيض.
مضى الذئب إلى السخلات للمرة الثالثة، وقال لهن “افتحْنَ الباب، فأنا أمُّكنَّ، وقد احضرت لكُنَّ الطعام”. بكت السخلات، وقلن له “أرنا رجلك، لنعرف أنك أمنا أم لا”. وضع الذئب رجله في النافذة، وعندما شاهدت السخلات أنها بيضاء اللون، اعتقدن أنها رجل أمِّهنَّ، ففتحْنَ له الباب، فدخل الذئب، وأصيبت السخلات بالذعر، فاختبأت كل واحدة منها في مكان داخل الكوخ / الحظيرة، واختبأت السخلة الصغيرة في علبة الساعة المعلقة بالجدار، فلم يجدها الذئب. انقض الذئب على ست سخلات، فابتلعهنَّ، ثم خرج إلى مرج قريب، واستلقى في ظل شجرة، ونام.
عادت العنزة الأم، فوجدت باب الحظيرة مفتوحاً، وكل ما في داخلها من أثاث مبعثر، فبكت. نادتها السخلة الصغيرة من مخبئها “أمي العزيزة، أنا هنا في علبة الساعة”، أخرجتها الأم، فأخبرتها بما كان من الذئب. فحزنت حزناً شديداً.
خرجت العنزة ومعها سخلتها الصغيرة، وعندما وصلت إلى المرج، رأت الذئب نائماً في ظل شجرة يشخر، فقالت تحدِّث نفسها “تُرى هل سخلاتي ما زِلْنَ أحياء في بطن هذا الوحش؟”. أسرعت السخلة الصغيرة عائدة إلى الحظيرة، وأحضرت مقصَّاً وإبرة وخيطاً، ثم شقت العنزة بطن الذئب، فصارت السخلات الست يقفزن خارجات من بطنه، لأن الذئب كان قد ابتلعهنَّ أحياء على عجل. ثم ملأت بطنه بحجارة، وخيَّطته، ومضت مع سخلاتها إلى حظيرتهن.
ثمة حكاية شعبية تحت عنوان “شيخ صنعان“([5]). تدور أحداثها حول حب شيخٍ فتاةً قروية أرمنية في بعض الروايات، وجورجية في بعضها الآخر، و رومية في “منطق الطير” لفريد الدين العطار، يراها في بلدها، فيهيم بها لجمالها، ولا تقبله الفتاة إلا بعد أن يرتدَّ عن دينه (الإسلام) ويعتنق المسيحية، ويشرب الخمر، ويرعى خنازيرها عاماً كاملاً، فيمتثل الشيخ لطلبها. يعزُّ ما آل إليه الشيخ على مريديه، فيذهبون إليه، ويحاورونه فيدعونه إلى العودة إلى دينه، لكنه يأبى. وبعد عام أو أكثر بقليل، يعود الشيخ إلى رشده، فيترك الفتاه حيث هي، ويعود إلى بلده، فتتبعه الفتاة وتلتقيه، فتطلب منه أن يعلمها كيف تسلم، فتعتنق الإسلام، ولم تطل بها الحياة بعد إسلامها، إذ تموت.
هذه الحكاية مشهورة في الشرق، وفيما وراء القوقاز، ومن الصعب تحديد مكان نشوئها وزمانه، وكذلك يصعب تتبُّع تطورها، وليس بوسع المرء سوى أن يفترض أنها نشأت في الفترة التي ظهرت فيها الصوفية، كما يقول الدكتور عزالدين مصطفى رسول، وذلك في نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني. وقد انتقلت إلى الأدب المدوَّن لأول مرة على يد الشاعر والمتصوف الفارسي فريد الدين العطار الذي صاغها في شكل شعري قوامه أربعمائة وستة أسطر، وصاغها الشاعر الآذربيجاني حسين دزافيد (1882– 1941) شعراً، ولكنه يختلف عن غيره بأن أظهر الشيخ ليس كعجوز، بل كشاب قوي العزم، واختفى في صياغته الحب الصوفي الروحاني الذي تطفح به صياغتا فريد الدين العطار و فقي تيران، ليحل محله الحب الإنساني على الأرض.
أشار الأبشيهي في كتابه “المستطرَف” إلى حكاية شبيهة بها، وجعل بطلها شيخاً، كان يقيم في بغداد، ويُعرف بأبي عبد الله الأندلس البغدادي، وكان له مريدون وأتباع، وقع الشيخ في حب فتاة نصرانية، وارتدَّ عن دينه، ورعى خنازير أبيها، ثم آبَ إلى رشده ودينه، وعاد إلى بغداد، تبعته الفتاة معتنقة الإسلام.
أما في الموروث الشعبي الكوردي، فثمة أشكال متعددة لهذه الحكاية، تحت اسم “دوتا گُرجا” أي الفتاة الجورجية. من المحتمل أن الشاعر فقي تيران اتخذ أحد تلك الأشكال أساساً لقصته تحت عنوان ” شيخ صنعان” التي صاغها شعراً في ثلاثمائة وثلاثة عشر مقطعاً شعرياً رباعي الأسطر، يتكوَّن كل سطر من سبعة أو ثمانية مقاطع صوتية. واستوحى منها الشاعر الكوردي ملاي جزري المعاصر لفقي تيران قصيدة طائية بلغ عدد أبياتها خمسة وعشرين بيتاً. كما يوجد في الموروث الكوردي نص آخر لهذه الحكاية تحت اسم “شيخ سَدَنْيا”، وهو منظوم في شكل شعري.([6])
هناك بعض الاختلافات في الشكل وعدد أتباع شيخ صنعان بين هذه النصوص، جميعها، باستثناء نص الأبشيهي، منظوم شعرياً، بينما نص الأبشيهي نثر، و مرّ سابقاً أن نص العطار منظوم في أربعمائة وستة أسطر شعري، بينما نص فقي تيران ثلاثمائة وثلاثة عشر مقطعاً شعرياً رباعي الأسطر. وعدد أتباعه لدى العطار أربعمائة، وعند فقي تيران وشيخ سدنيا خمسمائة، بينما عند الأبشيهي ألف و مائتان.
موطن الشيخ عند العطار مكة، بينما بغداد موطنه عند الأبشيهي، وموطن الفتاة عندهما بلاد الروم. أما عند فقي تيران فموطنها هو أرمينيا، بينما موطنها في النص الكوردي الآخر “شيخ “سدنيا” هو جورجيا. بمعنى آخر، الفتاة في هذه النصوص رومية وأرمنية وجورجية
و عند العطار و الأبشيهي تسلم الفتاة في مكة ثم تموت، بينما عند فقي تيران تتبع الفتاة الشيخ وتسلم في “جبل الله أكبر” الذي أعتقد أنه يقصد مكة أيضاً، ثم يموت الشيخ ة والفتاة معاً، بينما في نص “شيخ سدنيا” تتبع الفتاةُ الشيخَ أيضاً، وحين يلتقيان، يحتضنان بعضهما، ويموتان معاً، فيصبحان عروسين في الجنة.(([7]
ما يهم البحث من أمر هذه الحكاية، ليس أساليب صياغتها، بقدر ما يهتم بإشاعتها بين ثقافات مختلفة من عربية وكوردية وفارسية وآذربيجانية، وجميع هذه الثقافات لم تحتفظ بنصها الشعبي، بل كل واحدة منها صاغتها بلغتها وأساليبها، ولكنها اتفقت، باستثاء الأبشيهي، في شكل صياغتها شعراً. أما المضمون فقد بقي متشابهاً، سوى أن الرواية ألآذربيجانية جعلت بطلها شاباً قوياً، وحلَّ فيها الحب الإنساني محل الحب الصوفي الروحاني.
([1]) Haciyê Cindî: Heman jêder, rû 8- 11. Fettah Tìmar: Çìrokèn Lawiran. Çapa yekem Weşanên Ar, Akara 2017, rû 21.
([2]). مجلة المعرفة السورية، السنة التاسعة عشرة، العدد 219، أيار/مايو 1980، ص 84 – 91.
(1). رسالة الكاتبة والمترجمة صائمة خاكپور، مصدر سابق.
([4]). https://www.deutschland-lese.de/streifzuege/maerchen/der-wolf-und-die-sieben-jungen-geisslein/
([5]) فريد الدين العطار: منطق الطير. ترجمة الدكتور بديع محمد جمعة، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 2002، ص 218- 240. شهاب الدين بن محمد الأبشيهيي: المستطرف من كل فن مستظرف، تحقيق الدكتور عبد الله أنيس الطباع، ص 169، 170. Feqî Teyran: Şêx Senan. Weşanên Roja Nû, Stockholm 1986.