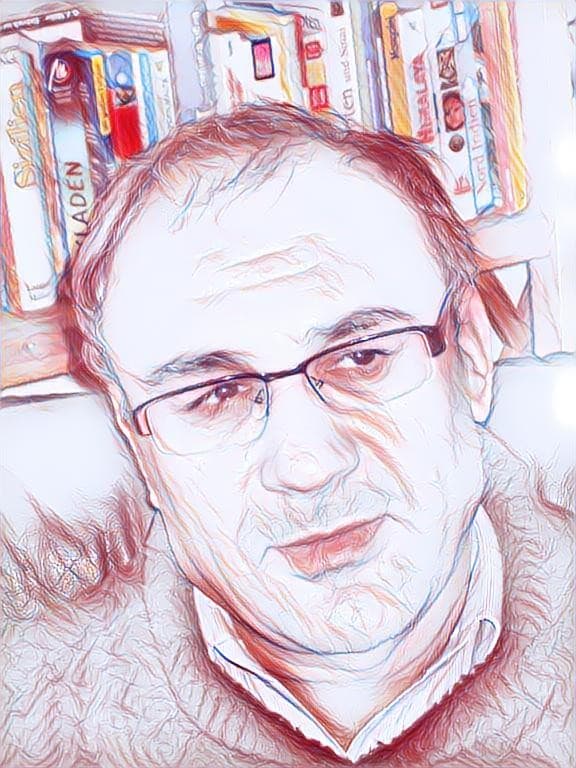تنكزار ماريني
الهرمنيوطيقا وما بعد الهرمنيوطيقا هما مفهومان مركزيان في الفلسفة والعلوم الإنسانية يتناولان فهم وتفسير النصوص والمعاني والظواهر الثقافية. وفيما يلي السمات والخصائص والاختلافات بين هذين المنهجين:
الهرمنيوطيقا. الخصائص والمميزات:
التعريف:
الهرمنيوطيقا هي فن وعلم التفسير، لا سيما للنصوص واللغة والمصنوعات الثقافية. تعود جذوره إلى الفلسفة القديمة وتم تطويره في القرنين التاسع عشر والعشرين.
الجذور التاريخية: للهرمينوطيقا جذور تاريخية في الدراسات الكتابية وتفسير القانون. ومن أهم ممثليها فريدريك شلايرماخر وفيلهلم ديلتي وهانس جورج غادامير.
الهدف: الهدف من التأويل هو فتح معنى ودلالة النصوص والظواهر الثقافية. ويتحقق ذلك من خلال عملية حوار بين القارئ والنص.
الأساليب التأويلية
السياق التاريخي:
التعريف: يشير السياق التاريخي إلى الظروف الزمنية والاجتماعية التي كُتب فيها النص. ويشمل ذلك العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
التطبيق: من أجل تفسير نص ما بشكل مناسب، من المهم فهم الظروف التي أثرت على تأليفه. على سبيل المثال، يمكن أن يكون فهم الوضع السياسي في الوقت الذي كُتب فيه العمل الأدبي أمرًا حاسمًا لفهم نية المؤلف ورسالة النص.
السياق الثقافي:
التعريف: يشمل السياق الثقافي القيم والمعايير والتقاليد والمعتقدات الخاصة بمجتمع أو مجموعة معينة التي شكلت النص.
التطبيق: قد ينطوي النص على معانٍ أعمق لا يمكن فهمها إلا في سياق الممارسات والمعتقدات الثقافية المحددة التي أُنتج فيها. ومن الأمثلة على ذلك تحليل عمل أدبي عالمي يستخدم رموزاً أو أساطير ثقافية محددة كانت مهمة للمجتمع في ذلك الوقت.
السياق الاجتماعي:
التعريف: يشير السياق الاجتماعي إلى البنى والطبقات والعلاقات الاجتماعية التي تؤثر على الديناميكيات بين المؤلف والنص والجمهور.
التطبيق: يمكن للظروف الاجتماعية التي يعيش فيها المؤلف أن تؤثر بقوة على منظوره والقضايا التي يتناولها. إن فهم التسلسلات الهرمية الاجتماعية والحراك الاجتماعي في وقت تأليف النص يمكن أن يقدم رؤى جديدة حول الشخصيات وصراعاتها.
نية المؤلف:
التعريف: تشير نية المؤلف إلى الأهداف التي يسعى المؤلف إلى تحقيقها من خلال عمله والرسائل التي يرغب في إيصالها.
التطبيق: يتيح النظر في نية المؤلف للقارئ أن يفهم بشكل أفضل النوايا الكامنة وراء خيارات معينة في سرد القصص وتطوير الشخصيات والمواضيع. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن نية المؤلف ليست واضحة دائمًا وتسمح بتفسيرات مختلفة
منظور القارئ:
التعريف: يشير منظور القارئ إلى الخبرات الفردية والمعرفة والخلفية الثقافية التي يجلبها كل قارئ إلى تفسير النص.
التطبيق: يجلب كل قارئ تحيزاته وعواطفه وتجاربه الخاصة إلى عملية التفسير. ويمكن أن تؤدي هذه الذاتية إلى مجموعة متنوعة من التفسيرات للنص الواحد. وتشجع المناهج التأويلية على التفكير في وجهات النظر هذه وكيفية تأثيرها على التفسير.
تأثير التأويل
ذاتية الفهم:
تأثير الذاتية: تدرك التأويلية أن فهم النص ليس مجرد تحليل موضوعي فحسب، بل يتأثر بشدة بذاتية المفسر. فكل قارئ لديه تجارب فريدة وخلفيات ثقافية تؤثر على قراءته.
الانعكاس: تتطلب هذه الذاتية موقفًا تأمليًا من جانب القارئ، الذي ينبغي أن يكون مدركًا لتحيزاته ووجهات نظره الخاصة من أجل تحقيق تفسير أعمق وأدق.
دور القارئ في عملية التفسير:
المفسر النشط: لا يُنظر إلى القارئ كمتلقٍ سلبي للمعنى، بل كمشارك نشط في عملية التفسير. فالقارئ ”يتفاوض“ مع النص ويجلب منظوره الخاص إلى الحوار.
العملية الحوارية: ترى الهرمنيوطيقا العلاقة بين القارئ والنص على أنها حوار، حيث يطرح النص أسئلة على القارئ، ويجيب القارئ على هذه الأسئلة بإجاباته الخاصة. تؤدي هذه العملية إلى تبادل ديناميكي يمكن أن يؤدي إلى رؤى جديدة.
مقدمة عن الفهم المسبق:
الفهم المسبق: كل قارئ لديه فهم مسبق يؤثر على تفسيره للنص. ويمكن أن ينتج هذا الفهم المسبق عن تجارب القراءة السابقة أو المعرفة الثقافية أو التجارب الشخصية.
توسيع الأفق: يشجع المنهج التأويلي القراء على التشكيك في تصوراتهم المسبقة وتوسيعها من أجل رؤية النص في ضوء جديد. وهذا يمكن أن يؤدي إلى فهم أعمق وإثراء منظور الشخص نفسه.
ما بعد التأويل. الميزات والخصائص:
التعريف: ما بعد التأويل هو تطوير إضافي للتأويل الكلاسيكي الذي يلقي نظرة نقدية على افتراضاته وأساليبه. وغالبًا ما يرتبط بمناهج ما بعد الحداثة.
نقد التأويلية:
افتراض وجود معنى مستقر وموضوعي:
الخلفية: يفترض التأويل الكلاسيكي، كما صاغه مفكرون مثل هانس جورج غادامر، أنه من الممكن اكتشاف ”المعنى الحقيقي“ للنص. ويعتبر هذا المعنى مستقرًا ومستقلًا عن القارئ.
ما بعد الهرمنيوطيقا. الميزات والخصائص:
التعريف: ما بعد التأويل هو تطوير إضافي للتأويل الكلاسيكي الذي يلقي نظرة نقدية على افتراضاته وأساليبه. وغالبًا ما يرتبط بمناهج ما بعد الحداثة.
نقد التأويلية:
افتراض وجود معنى مستقر وموضوعي:
الخلفية: يفترض التأويل الكلاسيكي، كما صاغه مفكرون مثل هانس جورج غادامر، أنه من الممكن اكتشاف ”المعنى الحقيقي“ للنص. ويعتبر هذا المعنى مستقرًا ومستقلًا عن القارئ.
النقد ما بعد الهيرمينوطيقي: يجادل النقد ما بعد الهيرمينوطيقي بأن المعنى ليس ثابتًا. بل هو ديناميكي ويتغير وفقًا للسياق والوقت والقارئ. ومن الأمثلة على ذلك نص أدبي مثل رواية ”1984“ لجورج أورويل، التي يمكن تفسيرها بشكل مختلف في سياقات سياسية واجتماعية مختلفة. فبينما يُنظر إليه في سياق شمولي على أنه تحذير، يمكن قراءته في سياق ليبرالي على أنه نقد للمراقبة وفقدان الخصوصية.
نسبية المعاني:
الشرح: يؤكد علم ما بعد التأويل على أن معنى النص يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك السياق الثقافي والتاريخي والاجتماعي. وهذا يعني أن النص ليس له معنى عالمي، بل يمكن أن يختلف تفسيره.
على سبيل المثال، يمكن تفسير عمل مثل ”المحاكمة“ لفرانز كافكا بشكل مختلف من قبل قراء مختلفين اعتمادًا على ما إذا كانوا يقرؤونه في سياق البيروقراطية أو الفلسفة الوجودية أو الهوية اليهودية. ينتج عن كل من هذه المنظورات معنى وقراءة مختلفة.
التناص
العلاقة بين النصوص:
التعريف: يشير التناص إلى فكرة أن النصوص ليست معزولة، بل هي في شبكة من العلاقات مع نصوص أخرى. ويتم خلق المعاني من خلال هذه العلاقات.
المعنى: تدرس المقاربات ما بعد التناص كيف يتأثر معنى النص بالإشارات والاقتباسات والتلميحات إلى نصوص أخرى. وهذا يوضح أنه لا يوجد نص مستقل، بل هو جزء من خطاب أكبر.
مثال: ترتبط رواية جيمس جويس ”يوليسيس“ ارتباطًا وثيقًا من الناحية النصية بـ”الأوديسة“ لهوميروس. فالطريقة التي يعيد بها جويس تفسير الشخصيات والموضوعات تخلق معنى متعدد الطبقات لا يمكن فهمه بالكامل إلا في سياق كلا العملين.
السياقات الثقافية والتاريخية:
الشرح: يعترف علم ما بعد التأويل بأن النصوص يتم إنتاجها وتلقيها في سياقات ثقافية وتاريخية محددة. تؤثر هذه السياقات على كيفية فهم النصوص.
مثال: يمكن النظر إلى فيلم مثل ”قائمة شندلر“ من خلال عدسة الهولوكوست، ولكن أيضًا من خلال عدسة المناقشات الحديثة حول العنصرية والإنسانية. تؤثر النقاشات المعاصرة حول الأخلاق والأخلاق على كيفية تفسير المشاهدين للفيلم.
الذاتية والتعددية.
تعددية وجهات النظر:
الشرح: يعترف علم ما بعد التأويل بأن القراء لديهم وجهات نظر وتجارب مختلفة تشكل تفسيرهم للنص. ويؤدي هذا التنوع إلى تعدد القراءات الممكنة.
مثال على ذلك: في النقد الأدبي النسوي، يُفسر عمل مثل ”كبرياء وتحامل“ لجين أوستن بشكل مختلف. فبينما يرى بعض القراء النص على أنه نص كوميدي رومانسي، يراه آخرون على أنه فحص نقدي لأدوار الجنسين والتوقعات الاجتماعية في القرن التاسع عشر.
استحالة التفسير النهائي:
التفسير: يرى علماء ما بعد التأويل أنه من غير الممكن إيجاد تفسير نهائي أو نهائي للنص. فالمعاني مائعة ويمكن أن تتغير حسب السياق والقارئ.
على سبيل المثال، قد يفسر أحد القراء قصيدة لإيميلي ديكنسون على أنها تعبير عن الوحدة والفقدان، بينما قد يراها قارئ آخر على أنها احتفال بالحرية الداخلية والفردية. هذه القراءات المختلفة صحيحة وتظهر مدى تعقيد النص.
تأثير النظرية
التفكيكية
التأثير: يشكك التفكيك، لا سيما التفكيكية التي طورها جاك دريدا، في استقرار العلامات والمعاني. ويبين أن النصوص غالبًا ما تحتوي على تناقضات وغموض يجعل من المستحيل تفسيرها بشكل واضح.
مثال: في التفكيك، لا يتم تحليل النص من خلال مقولاته الرئيسية فحسب، بل أيضًا من خلال ما يستبعده ضمنيًا أو يدفعه إلى الخلفية. ويمكن أن يتم ذلك عند تحليل نص سياسي من خلال فحص الأصوات ووجهات النظر التي لا تُسمع.
النظريات النقدية:
التأثر: يتأثر التأويل ما بعد التأويل أيضًا بالنظريات النسوية وما بعد الاستعمارية وغيرها من النظريات النقدية التي تحلل علاقات القوة والبنى الاجتماعية الكامنة وراء النصوص. تتحدى هذه النظريات افتراضات التأويل التقليدي وتجلب وجهات نظر جديدة للتحليل.
على سبيل المثال، قد تقوم نظرية ما بعد الاستعمار بتحليل نص مثل ”قلب الظلام“ لجوزيف كونراد من خلال دراسة البنى الاستعمارية والاختلافات بين التأويل وما بعد التأويل.
مقاربة المعنى: بينما يبحث التأويل عن معنى مستقر في النص ويؤكد على عملية حوارية بين القارئ والنص، فإن ما بعد التأويل يرى المعنى غير مستقر وتعددي.
دور المفسر: في علم التأويل، يُنظر إلى المفسر على أنه الشخص الذي يكتشف معنى النص. أما في ما بعد الهرمنيوطيقا، فيُنظر إلى المفسر على أنه مشارك نشط في خلق المعنى، حيث تكون وجهات نظره وسياقاته الخاصة حاسمة.
نقد الموضوعية: غالبًا ما تتبنى الهرمنيوطيقا نظرة متفائلة للفهم وإمكانية إدراك معنى النص. من ناحية أخرى، فإن ما بعد التأويلية أكثر تشككًا في إمكانية إيجاد معنى موضوعي.
تأثير السياق: في حين أن التأويلية تعتبر السياق مهمًا، إلا أن ما بعد التأويلية تؤكد على الطبيعة المعقدة والمتعددة الطبقات للسياقات وتأثيرها على المعنى بشكل أقوى.
باختصار:
يقدم التأويل وما بعد التأويل منظورين مختلفين لتفسير النص ومعانيه. ففي حين يهدف علم التأويل إلى اكتساب رؤى أعمق في معنى النص ومقاصده، فإن علم ما بعد التأويل يشكك في الافتراضات المتعلقة باستقرار المعاني وموضوعيتها. وهي تؤكد على دور المفسر وتعدد وجهات النظر الممكنة. وكلا المنهجين ضروريان لفهم الديناميات المعقدة للتواصل والتفسير في العلوم الإنسانية.
تؤكد المناهج التأويلية وآثارها على تعقيد الفهم والدور الفاعل للقارئ في العملية التفسيرية. ومن خلال أخذ السياق التاريخي والثقافي والاجتماعي بعين الاعتبار، بالإضافة إلى نية المؤلف ووجهة نظر القارئ، فإنها تتيح فهمًا متمايزًا للنصوص. لذلك، يشجع التأويل على اتباع نهج تأملي وحواري يعترف بذاتية القارئ وغموض المعاني
أخيرًا، تعريف التأويل وفقًا لهانز جورج غادامير هو
- فن الإصغاء (فن التلقي)
- فن الفهم
- فن التفسير
تعريفي للتأويل اللاحق أو ما بعد التأويل:
1- فن التلقي
- فن الفهم
- فن التأمل
- فن التفسير والتأويلات الغامضة 4. فن التفسير والتأويلات الغامضة
- فن التعامل
يوفر هذا الهيكل عرضًا واضحًا وموجزًا للمفاهيم..