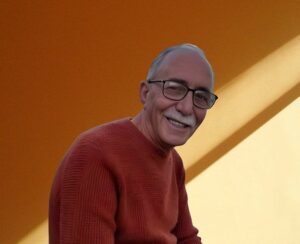نارين عمر
نارين عمرnarinomer76@gmail.com
قبلَ أشهرٍ نشرَ الأخ الكاتب محمد قاسم (ابن الجزيرة) وضمن سلسلة (ديرك في منقارِ البطّة) دراسة أدبية متسلسلة في أربعِ حلقاتٍ عن مجموعتي الشّعريّة (حيثُ الصّمْتُ يحتضر) الصّادرة عن دار الزّمان للنّشر والتّوزيعِ بدمشقَ في عام (2008), بعنوان (تداعيات أسماء في ديوان حيثُ الصّمْتُ يحتضر) وحال عودتي إلى الكتابةِ الألكترونيّة سارعَ العديد من الأخواتِ والأخوة القّرّاءِ والمهتمين بالشّأنِ الثقافيّ والأدبيّ إلى تجديدِ طلبهم إليّ بوجوبِ التّعريفِ ببعض الأسماء والأماكن التي لم يتعرّفوا إليها, والتي استفسرَ عنها الأخ الكاتب أيضاً, وتحديداً ما وردَ بشأن قصيدة (في سكرةِ نبضِ ديرك), لأنّ فقراتٍ منها ظلّتْ بحاجةٍ إلى إجابةٍ وتفسير, والبعضُ أكّدَ على أنّه ما يزالُ محتفظاً بنسخٍ منها حتّى يحصلَ على الإجاباتِ الوافية عنها.
بداية أقدّمُ باقاتِ شكرٍ وتقديرٍ إلى الأخ الكاتب على ما قدّمه حول المجموعة من دراسةٍ أراها قيّمة ومفيدة, حيثُ جاءت كشرحٍ وتفسيرٍ للعديد من قصائدِ المجموعة وإثْراء لها, ووسيلة للتعرّفِ إلى ديركا حمكو وبعض معالمها وأماكنها.
قصيدة (في سكرةِ نبضِ ديرك)1* أودّ أن أشكرَ كلّ مَنْ راسلني أو هاتفني أو التقى بي وأبدى إعجابه بمضمونها, وأعبّرُ لهم عن سعادتي بآرائهم لأنّها تدلّ على ملامستها لمشاعرهم الصّادقة. وتفاعلهم النّبيل معها على مختلف أعمارهم المتواجدون منهم في الوطن أو خارج الوطن وخاصة الدّيركيّون منهم, دليلٌ على محبّةِ الشّخص لمسقطِ رأسه أو المكان الذي نشأ فيه, حتّى أنّ البعضَ منهم ما ينفكّ يطالبُني بجزءٍ ثانٍ وثالثٍ منها. كما لابدّ من الإشارة إلى أنّني حين كتبتُ القصيدة لم أتعمّد ذكر أسماء محدّدة لأشخاص أو معالم وأماكن أو إغفال أخرى, إنّما دوّنتُ ما التقطته ذاكرتي في تلك السّاعاتِ من المسير والتّجوال, وهناك عائلات ديركيّة عريقة أكنّ لها كلّ الودّ. كنّا مثل عائلةٍ واحدة نتشارك في الأفراح والأتراح, نتقاسمُ الطّعام والشّراب وحتّى العمل المنزليّ كانت النّسوة والفتيات يقتسمنه فيما بينهنّ, والأهمّ بالنّسبة إليّ هو علاقات الرّفقة والزّمالة التي كنتُ أعقدها مع صغارهم, فننعمُ بطيب الأيّام وسهر ليالي الصّيف. كما أنّني لم أتقصّد تأريخ المدينة بقدر ما أحببتُ الحديثَ عن هيكليتها وشكلها ومعالمها الأساسيّة قبل أن تطالها يد الهدم والتّغيير أو الإهمال.
طاحونة ديرشوي أقصدُ بها تلك الطّاحونة اليّدويّة الصّغيرة التي كان يمتلكها المرحوم (محمد ديرشوي أبو نوري) وكان يسكن في الشّارع الذي كنّا نسكنه في شارع عين العسكريّة, يصنعُ عليها الشّعيريّة أو (شَعيرة), فكانت النّساء يجتمعن في مكانٍ معيّن, يحضرن العجين, وينتظرن دورهنّ أمامَ طاحونة ديرشوي الذي كان يضعُ الطّحين في أعلى الطّاحونة وكانت عبارة عن علبةٍ دائريّة الشّكل, فتحتها من الأعلى مربّعة الشّكل, فيخرجُ الطّحينُ من الأسفلِ مثل خيوطٍ رفيعة كنّ يسمّينها (شَعيرة), تكونُ صاحبة الشّعيرة قد بسطت الحُصُر أو قطع قماشٍ عريضة على الأرض أو فوق الرّصيف, فيمسكُ الرّجلُ الشّعيريّة التي تخرج من الأسفلِ بيديه ثمّ يرميها على البُسُط والحصر, والمرأة تتكفّلُ بمدّها على الطّول والعرض, تعرّضها لأشعةِ الشّمسِ, عندما تجفّ وتنشفُ تضعها في أكياسٍ قماشٍ صُنِعَتْ خصّيصاً لها, وفيما بعد تحمّصها على النّار, لتخلطها بالبرغل أو الأرزِ وغيرها من الحبوبِ وحسب الطّلبِ. كالعادة كنّا- نحن الصّغار- نجتمعُ حوله وحولهنّ دون أن ننسى القيامَ بحركاتٍ تنمّ عن الطّيشِ والشّغبِ. (كڤري حارو) كان عبارة عن حجرٍ كبير في شمال ديرك على طريق عين ديور كنّا نقصده في نزهاتنا ورحلاتنا. (حجي محمد) هو (حجي محمد إيسو أبو هادي) صاحب مراجيح العيد الشّهيرة, والذي كان ينشدُ لنا ((يا حجي محمد, فنردّد وراءه: يو..يو… ثمّ يقول: اعطني حصانك, أشدّ وأركب…إلخ. وكان يساعده في ذلك ابنه هادي أو أديب أو زوجته. (حمو ليلو), هو جارنا الملاصق بيته لبيتنا وكانت المرحومة أمّي تعْلِمُنا عن سبب تسميته بهذا الاسم كلّما سألناها عن ذلك بالقول: جارنا حمو ليلو اسمه الحقيقيّ هو محمد علي ولكنّ والدته ومن باب الدّلال والمحبّة له كانت حين تهدهده في سريره أو حين تراقصه تنشد:
(((Hemo lîlo lÎl kirÎ kerkê xwe kurtan kirî qesta warê xwe kirî ولإعجابِ النّسوةِ الأخرياتِ بهذه النّغمة صرن يردّدنها, وبذلك طغى الاسم عليه طيلة حياته وحتى يومنا هذا, وكان العمّ صاحبَ صوتٍ كرديّ أصيل يصدحُ بأروع الأغاني الفولكلوريّة الكرديّة ومن أبرزها أغنية (عيشانا علي). ابراهيم أبو أحمد الذي كنّا نناديه (علوكه :Elûkê ) نسبة إلى الحلويات الشّهيرة التي كان يصنعها في سبعينيّات وثمانينيّاتِ القرن العشرين, كنّا نظنّه حمويّاً ولكن تبيّن لنا فيما بعد أنّه حمصيّ, وفي الفترة الأخيرة سكنّا بجوار ابنه (أحمد) الذي أصيب بسرطان الرّئة توفي على إثرها منذ أشهرٍ, وقد ظلّ حتّى آخر يومٍ من عمره عاشقاً لديرك, محبّاً لأهلها وطبيعتها وهوائها, فعلى الرّغم من مغادرةِ إخوته المدينة وسكنهم في حمص إلا أنّه رفض الرّحيلَ معهم مؤكّداً على تعلّقه بديرك ووفائه لها, وظلّ مخلصاً للّغةِ الكرديّة التي كان يتقنها بطلاقةٍ, ونقلت عنه زوجته وأولاده أنّه وبعد شعوره بدنوّ أجله كان قد أوصى الأهل بوجوبِ دفنه في ديرك وإقامة مراسم العزاء له فيها. بحكمِ الجيرة الجديدة وتواصلاً مع الجيرة القديمة كنّا نتبادلُ معهم الزّيارات, في أكثر من مرّة التقيتُ أخته سناء, وحين أعلمتهم بما كتبته عن والدهم سرّوا كثيراً, وبدأنا نسترجعُ معظم ذكرياتنا عن والدهم وعن ديرك وأهلها وساكنيها بشكل عام, وحين ذكّرتُ سناء بشخصيّة والدها الصّارمة وهيبته وخشيتنا نحن الصّغار منه أطلقت ضحكة عريضة, وأكّدت على أنّها وأخوتها أيضاً كانوا يخشونه, لأنّه كان صارماً معهم أيضاً, وذكّرتني ببيتهم الذي كان يغمر بمياه الأمطار حينما كانت تفيضُ السّاقيّة التي كانت مقابل دارنا في فصل الشّتاء, فكان أهل ديرك يسارعون إلى إنقاذهم ومساعدتهم. كانت ديرك في سبعينيّات وثمانينيّات القرن العشرين وقبلهما غنيّة بعيون الماء والينابيع والآبار العاديّة, ومن أبرزها عين العسكريّة التي كانت تمتّع سكّان ديرك بمائها النّقيّ والعذب, وكانت ملتقى لفتياتِ المدينة, يتبادلون فيها أمتع الأوقات, ويظهرون الغنجَ والدّلال وهنّ يتلقين أحياناً عباراتِ الإعجابِ والرّقة من بعض الشّبابِ الذين كان الشّارع الطّويل والعريض يستهويهم. العين الأخرى كانت تسمّى (عين النّسوان), محصّنة بجدران من الحجر الأسودِ من الجهاتِ الأربع, تؤمّها النّساءُ والفتياتُ فقط, حيثُ كانت ملتقى لهنّ, يمضين فترات راحةٍ واستجمام, فيتوضأن بمائها, ويصلّين فوق صخرةٍ عريضةٍ تقع على الجانبِ الأيمن منها, ويسبحن فيها, ويتبادلن مختلفَ الأحاديثِ والحكايات, وقد ظلّت نظيفة ونقيّة بفضل بعض النّسوة الّلواتي تبرّعن بحمايتها والاعتناء بها ومن أبرزهم المرحومة (حسينة) زوجة المرحوم (حسين غازي), أمّا العين الثّالثة فكانت على شكل بركة ماء يسبحُ فيها الرّجال والشّبابُ هرباً من حرّ الصّيفِ الحارق. هذه العيون كلّها كانت تقعُ على خطّ سيرٍ واحدٍ تقريباً, على الطّريق الواقعة بين الشاّرع العامّ والسّاقيّة التي تفصلها عن بُخْچي نادرة. وكان عبارة عن بستان نُسِبَ إلى السّيّدة (نادرة) وكانت امرأة قويّة وصاحبة إرادة وإدارة, مات زوجها في سنّ مبكرة, فتكفّلت بتربية أولادها وتنشتهم, ولها ابن يسمّى (أحمد), ما يزالُ يعيشُ مع أولاده في ديرك, وكان عددٌ كبير من أهالي المدينة يزورون البستان وخاصة في الرّبيع, والصّغار أكثرهم زيارة وسعادة. بالإضافة إلى هذا البستان كانت ديرك تتباهى ببساتين أخرى كبستان العمّ (يوسف خرسي) والعمّ (نجم) أمّا (العمّ ملا محمد أبو يوسف) والذي كان يُعرف بـ (ملاى حمدية), مؤذّن المدينة, فقد كان يملكُ بستاناً جميلاً وأكثر ما أتذكّره فيه هي أشجار التّوتِ البهيّة التي كانت تثمر توتاً أبيض لذيذ الطّعم والّلون, وتوتاً أحمرَ أشدّ لذة ورونقاً, وما أزال أتذكّر المرحوم (صوفي عزير) الذي كان يؤذن بصوته فقط من دون الّلجوء إلى مكبّراتِ الصّوت, بالإضافة إلى بستان شخصٍ كان يُدعى (جرمودي أبو طلال) وعلى ما أعتقد كان عربيّ الأصل ولم يكن من سكّان ديرك الأصليين. (الجامع الكبير), نعم أقصدُ الجامع المجاور لمبنى البريد. ذكرتُ اسم (حنّا ديسچي) ولم أذكر اسم أخيه (عيسى ديسچي) ربّما لأنّه كان والد إحدى زميلاتي في المدرسة, فرسّخ الاسم في ذهني أكثر. أمّا بالنّسبة إلى (الحجة ديوانة) فقد ردّ الأخ (حسن اسماعيل), بأنّها جدّة رضوان رمّو (باڤي داستان), ولكنّني لم أذكرها لهذا السّبب فقط بل لأنّها كانت من أقاربِ أبي, وكانت تزورنا كلّ يومٍ, وتشعرنا بالمودّة والحنان, تؤكّدُ على الدّوام أنّها كانت (أختاً في عهدِ الله للوالد عمر سيڤدين). ومن أجمل ما تحمله الذّاكرة عن هذه العمّة العزيزة أنّها كانت تردّدُ باستمرار: ((كان أخي عمر قد حلّفني أن أبشّره بنجاح ثورةِ القائد البارزاني حتى بعد مماته, وفي بداية السّبعينيّات من القرن الماضي سمعنا نبأ مفرحاً عن نجاح الثّورة, فأسرعتُ إلى المقبرة المجاورة لبيتنا, وقلتُ ثلاث مرّاتٍ: أخي عمر! أبشّرك, لقد نجحت ثورة البارزانيّ, وفيما بعد تأكّدنا من عدم صحّةِ الخبر, وبقيتُ حزينة على الخبر الكاذب الذي نقلته إليه, ومحتارة في أن أخبره بذلك أم لا, ثمّ قرّرتُ أخيراً ألا أعلمه بالخبر ليظلّ سعيداً به وهو في قرارةِ القبر)). (عادل عمر سيڤدين) هو شقيقي الأكبر, وتربطه بالأخ الكاتب صداقة رائعة ونبيلة, وكما أوضح الأخ (حسن اسماعيل) مشكوراً هو صاحب أغنية الفنّان الخالد محمد شيخو (Azada şêrîn) وليس أغنية ((Ay lê gulê فهي من كلمات الشّاعر الكرديّ (عمر لعله). عادل هو من الشّعراءِ الكرد المجيدين والمتميّزين, لأنّه يكتبُ على أوزان وعروض شعريّة قويّة وبقواعد سليمة, وله مخطوطات شعريّة لأكثر من مجموعتين, ولكنّه لم ينشرها لظروفٍ ما, وهو الآن يحاولُ نشر إحداها, أتمنّى أن تُنْشَر في القريبِ العاجل ليستمتعَ قارئ الشّعرِ الكرديّ بها. كان يمتلك في البيتِ مكتبة ضخمة عامرة بمختلف أنواع الكتب الأدبيّة والثّقافيّة والدّينيّة والاقتصاديةِ والعلميّة, وبحرصُ على اقتناء الصّحف والجرائد اليوميّة والمجلات الاسبوعيّة والشّهريّة, وقد استفدتُ منها كثيراً, وكنتُ أواظبُ على قراءتها ومطالعتها مذ تمكّنتُ من القراءة والكتابة. (ﭘريخان), هي أختي الكبرى, والأخ الكاتب يعرفها جيّداً بحكم صداقته لأخي عادل ولكنّ الأمرَ اختلطَ عليه كوننا كنّا نناديها (ﭘَري), كانت بمثابة الأمّ الرّوحيّة لنا لأنّها تكفّلت بتربيتنا ورعايتنا بعد وفاةِ الوالدة المبكر, وهي التي شجّعتنا على سلوكِ كلّ ما هو خيّر وسليم وقيّم في الحياة, وعاهدت نفسها على أن تعيشَ لتحمينا وتسعدنا وتعلّمنا, وقد أسميتُ مجموعتي الشّعريّة المنشورة بالّلغةِ الكرديّة باسمها (Perîxana min). (موساكي عطار) كما كان يُسمّى وهو جارنا العمّ موسى الذي كان يمتلكُ حانوتاً صغيراً يضمّ مختلف السّكاكر والأطعمة التي يشتهيها الصّغار, ولكن من أبرزها وأكثرها لذة السّكاكر التي تأتي ضمن سلسلةٍ مربوطةٍ بخيطٍ رفيعٍ كنّا نسمّيها (حامض حلو). كذلك العمّ (ملا حاجي) كان بيته مقابل عين العسكريّة تماماً, ويمتلكُ دكّاناً كبيراً يبيعُ فيها كلّ مستلزمات العائلة من الأطعمة والأشربة والألعاب, وأكثر ما كان يشّدنا إلى دكّانه تلك الدّمى الجميلة التي كنّا نلهو بها ونسرّ . مدرسة (خولة بنت الأزور) وتسمّى اليوم (ناظم طبقجلي), أمّا في زماننا فكانت بدوامين, كلّ دوامٍ يحملُ اسماً, في دوامنا كانت تسمّى خولة, وأنهيتُ فيها المرحلة الابتدائيةّ مع أختي (دلبر: Dilber) وفي الدّوام الآخر كانت تسمّى مدرسة ناظم. وثانوية الطّليعة للبنات ما تزالُ قائمة وفيها أنهيتُ دراستي الإعداديّة والثّانويّة. ذكري للمدارس ولأماكنَ أخرى كان من باب التّذكّر والوفاءِ لها .
(ﭘرا بافد: Pira bafid: أو جسر الرّومان كما يُسمّى بالعربيّة, هو معلمٌ آخر من معالم ديرك, وقد استفاض الأخ الكاتب في وصفها وأسبابِ بنائها, ولكنّني سأجيبُ على بعض الأخوة الذين تساءلوا: وهل للجسر أبراج؟ نعم, لها أبراج, وكلّ مَنْ يزورها سيراها, وسوف يرى بقايا منحوتاتٍ لرموزها كالشّمس والأسد والعذراء والسّرطان والميزان والثّور وغيرها, وبحسب ما نسمعُ كان الأمير وحاشيته يتعرّفون من خلالها إلى وقتِ ظهور شمس الصّباح أو تأهّب شمس الأصيل للرّحيل. بالنّسبة إلى مشاعل عيد الأضحى فقد خصّصَ لها أخي ابن الجزيرة مساحة جيّدة وقيّمة, ما أحبّ أن أشيرَ إليه هو تعلّقنا بهذا العيد وانتظارنا له, لأنّنا كنّا نشعل في الّليلة التي تسبقه مشاعل, نجوبُ بها معظمَ حارات وشوارع ديرك ونحن نردّدُ بصوتٍ واحدٍ, قويّ وجهوريّ: (Meşel meşel dêre eyda haciya bi xêre ava zimzim têde dibezim her peşkekî bi hecekî)), وهذه المشاعل كانت عبارة عن بواري كرتونيّة نحصل عليها من أصحاب محلاّت الأقمشة حيث تُلفّ بها الأقمشة, وحين ينتهي البائع من بيع القماش الملفوفِ بها يرميها, لذلك كنّا نوصيهم أن يمنحوها لنا فنظلّ نجمعها قبل العيد بأياّم وربّما بشهرٍ. قبل العيد بيوم, نجتمع في مكان معيّن, وكان اجتماعنا على الأغلب في الجهةِ التي تفصل بين بيتنا وبيت العمّ صبري فندو, فنأتي بالمشاعل, نكبّ عليها من الجهة العليا بعض المازوتِ أو الكاز ونشعلها, أمّا الشّبّان والصّبايا فكانوا يأتون بعلبِ الحلاوة الفارغة المصنوعة من التّنك, وكانت مربّعة الشّكل, يثقبون وسطها ثمّ يعلّقون بها عوداً طويلة ومتينة أو قضيباً من الحديد, يربطونها جيّداً ويضعون فيها قطعاً من الخشب ثمّ يشعلونها فتضيء النّيران المشتعلة المدينة بأكملها في جوّ احتفاليّ مشوّق.
ملاحظات لا بدّ منها:
*- قصيدة (في سكرةِ نبض ديرك) كتبتها في ربيع عام ألفٍ وتسعمائة وخمسة وتسعين (1995)م أثناء تجوالي في أماكنَ عدّة من مدينتنا الرّائعة ديريك, أسعدُ النّظرَ بمباهجها ومعالمها, أسترجع الأيّام والّليالي التي أمضيتها مع رفاق ورفيقات الطّفولة, وحين مروري ببيتنا الأوّل الذي ولدتُ فيه, وعانقتُ الشّارعين الّلذين كان يطلّ عليهما وجدتني ألهو معهم من جديدٍ, وألعبُ لعبة (الغميضة: Pîpîkê, والمارشو والمستريح وصندوق زيرى زامَيْزو: Sindoq zêrê za meyzo)2*. أضمّ كفّي إلى كفهم وأردّدُ معهم قبل البدءِ بأيّة لعبةٍ:
((كروم ﭘان يِسْ. يِسْ يِسْ يِسِرْ: ((3*((Kirom pan yês. yês, yês yêsir وأبني معهم (خانيچوك) , والكلمة تصغير لمفردة (خاني: Xanî) التي تعني بالكرديّة البيت, وبيتان شعريّان للشاعرٍ العربيّ (أبو تمّام) يستحضراني في تلك الّلحظات, وفي كلّ لحظةٍ ألمحُ فيها الدّار وأتبادلُ العناقَ مع ترابِ الحارة وبيوتها وجدرانها وهمساتِ ناسها التي تدغدغُ سمعي من الأفقِ البعيد:
-نقّلْ فؤادك حيثُ شئت من الهــــوى ما الحبّ إلا للحبيبِ الأوّلِ
-كم من منزلٍ في الأرضِ يألفه الفتى وحنينُه أبــداً لأوّلِ منـــزلِ
كلّما أمرّ بمكان أو شارع يدفعني الشّوق والحنين إلى أخرى, خطرت في بالي فكرة الكتابة حول كلّ ما رأيتُ وشاهدتُ, وما استرجعتُ من طيبِ الأيّام, فكتبتُ الأفكار الرّئيسة منها في أثناء المسير, وعندما عدتُ إلى البيتِ كانت الفكرة قد اكتملت, ولكنّني ونتيجة تنقّلنا المستمرّ من دارٍ إلى أخرى فقدتها مع دفتري المحتوي على أوراقٍ أخرى, وفي عام (2004) وجدتها, فصرتُ أنتشي طرباً ومسرّةً لأنّها تتعلّقُ بذكرياتي مع ديركا حمكو التي أرى فيها الحياة بكلّ مباهجها ومفاتنها حتّى في الّلحظاتِ التي تغدر فيها بي, وبتّ أنشدُ على أوتار عشقي لديرك وأهل ديرك مع (ملاى جزيري: (Melayê Cizîrî) :
-نَوايَا مُطْرِبُ وچنگى فَِغانْ آڤِيتَهْ خَرْچنْكى
وَرَهْ سَاقى حَتَا كنْگى نَشُويينْ دِلْ ژِڤى ژَنْكى
حَيَاتا دِلْ مَيَا باقي بِنُوشِينْ دَا بِمُشْتَاقى
ألا يا أيُّها السّاقي أدِرْ كأساً وناوِلْها
عندما نشرتها أرّختها بعام (2004), تيمّناً ببركةِ هذا العام, بمعنى أنّ القصيدة لم تُكتَب في عام (2008) تاريخ نشر المجموعة كما اعتقدَ البعضُ, ولا في عام (2006) أو ما بعده كما ظنّ البعضُ الآخر.
2- (Pîpîkê, المارشو, المستريح ,صندوق زيرى زامَيْزو: Sindoq zêrê za meyzo). أسماء ألعابٍ كان الصّغار يمارسونها في فترتي الطّفولةِ والصّبا.
3-((كروم ﭘان يِسْ. يِسْ يِسْ يِسِرْ: (( .((Kirom pan yês. yês, yês yêsir
عبارةٌ كان يردّدها الصّغار قبل البدءِ بأيّة لعبةٍ تطلّبُ فريقين أو أكثر.
قصيدة (في سكرةِ نبضِ ديرك)1* أودّ أن أشكرَ كلّ مَنْ راسلني أو هاتفني أو التقى بي وأبدى إعجابه بمضمونها, وأعبّرُ لهم عن سعادتي بآرائهم لأنّها تدلّ على ملامستها لمشاعرهم الصّادقة. وتفاعلهم النّبيل معها على مختلف أعمارهم المتواجدون منهم في الوطن أو خارج الوطن وخاصة الدّيركيّون منهم, دليلٌ على محبّةِ الشّخص لمسقطِ رأسه أو المكان الذي نشأ فيه, حتّى أنّ البعضَ منهم ما ينفكّ يطالبُني بجزءٍ ثانٍ وثالثٍ منها. كما لابدّ من الإشارة إلى أنّني حين كتبتُ القصيدة لم أتعمّد ذكر أسماء محدّدة لأشخاص أو معالم وأماكن أو إغفال أخرى, إنّما دوّنتُ ما التقطته ذاكرتي في تلك السّاعاتِ من المسير والتّجوال, وهناك عائلات ديركيّة عريقة أكنّ لها كلّ الودّ. كنّا مثل عائلةٍ واحدة نتشارك في الأفراح والأتراح, نتقاسمُ الطّعام والشّراب وحتّى العمل المنزليّ كانت النّسوة والفتيات يقتسمنه فيما بينهنّ, والأهمّ بالنّسبة إليّ هو علاقات الرّفقة والزّمالة التي كنتُ أعقدها مع صغارهم, فننعمُ بطيب الأيّام وسهر ليالي الصّيف. كما أنّني لم أتقصّد تأريخ المدينة بقدر ما أحببتُ الحديثَ عن هيكليتها وشكلها ومعالمها الأساسيّة قبل أن تطالها يد الهدم والتّغيير أو الإهمال.
طاحونة ديرشوي أقصدُ بها تلك الطّاحونة اليّدويّة الصّغيرة التي كان يمتلكها المرحوم (محمد ديرشوي أبو نوري) وكان يسكن في الشّارع الذي كنّا نسكنه في شارع عين العسكريّة, يصنعُ عليها الشّعيريّة أو (شَعيرة), فكانت النّساء يجتمعن في مكانٍ معيّن, يحضرن العجين, وينتظرن دورهنّ أمامَ طاحونة ديرشوي الذي كان يضعُ الطّحين في أعلى الطّاحونة وكانت عبارة عن علبةٍ دائريّة الشّكل, فتحتها من الأعلى مربّعة الشّكل, فيخرجُ الطّحينُ من الأسفلِ مثل خيوطٍ رفيعة كنّ يسمّينها (شَعيرة), تكونُ صاحبة الشّعيرة قد بسطت الحُصُر أو قطع قماشٍ عريضة على الأرض أو فوق الرّصيف, فيمسكُ الرّجلُ الشّعيريّة التي تخرج من الأسفلِ بيديه ثمّ يرميها على البُسُط والحصر, والمرأة تتكفّلُ بمدّها على الطّول والعرض, تعرّضها لأشعةِ الشّمسِ, عندما تجفّ وتنشفُ تضعها في أكياسٍ قماشٍ صُنِعَتْ خصّيصاً لها, وفيما بعد تحمّصها على النّار, لتخلطها بالبرغل أو الأرزِ وغيرها من الحبوبِ وحسب الطّلبِ. كالعادة كنّا- نحن الصّغار- نجتمعُ حوله وحولهنّ دون أن ننسى القيامَ بحركاتٍ تنمّ عن الطّيشِ والشّغبِ. (كڤري حارو) كان عبارة عن حجرٍ كبير في شمال ديرك على طريق عين ديور كنّا نقصده في نزهاتنا ورحلاتنا. (حجي محمد) هو (حجي محمد إيسو أبو هادي) صاحب مراجيح العيد الشّهيرة, والذي كان ينشدُ لنا ((يا حجي محمد, فنردّد وراءه: يو..يو… ثمّ يقول: اعطني حصانك, أشدّ وأركب…إلخ. وكان يساعده في ذلك ابنه هادي أو أديب أو زوجته. (حمو ليلو), هو جارنا الملاصق بيته لبيتنا وكانت المرحومة أمّي تعْلِمُنا عن سبب تسميته بهذا الاسم كلّما سألناها عن ذلك بالقول: جارنا حمو ليلو اسمه الحقيقيّ هو محمد علي ولكنّ والدته ومن باب الدّلال والمحبّة له كانت حين تهدهده في سريره أو حين تراقصه تنشد:
(((Hemo lîlo lÎl kirÎ kerkê xwe kurtan kirî qesta warê xwe kirî ولإعجابِ النّسوةِ الأخرياتِ بهذه النّغمة صرن يردّدنها, وبذلك طغى الاسم عليه طيلة حياته وحتى يومنا هذا, وكان العمّ صاحبَ صوتٍ كرديّ أصيل يصدحُ بأروع الأغاني الفولكلوريّة الكرديّة ومن أبرزها أغنية (عيشانا علي). ابراهيم أبو أحمد الذي كنّا نناديه (علوكه :Elûkê ) نسبة إلى الحلويات الشّهيرة التي كان يصنعها في سبعينيّات وثمانينيّاتِ القرن العشرين, كنّا نظنّه حمويّاً ولكن تبيّن لنا فيما بعد أنّه حمصيّ, وفي الفترة الأخيرة سكنّا بجوار ابنه (أحمد) الذي أصيب بسرطان الرّئة توفي على إثرها منذ أشهرٍ, وقد ظلّ حتّى آخر يومٍ من عمره عاشقاً لديرك, محبّاً لأهلها وطبيعتها وهوائها, فعلى الرّغم من مغادرةِ إخوته المدينة وسكنهم في حمص إلا أنّه رفض الرّحيلَ معهم مؤكّداً على تعلّقه بديرك ووفائه لها, وظلّ مخلصاً للّغةِ الكرديّة التي كان يتقنها بطلاقةٍ, ونقلت عنه زوجته وأولاده أنّه وبعد شعوره بدنوّ أجله كان قد أوصى الأهل بوجوبِ دفنه في ديرك وإقامة مراسم العزاء له فيها. بحكمِ الجيرة الجديدة وتواصلاً مع الجيرة القديمة كنّا نتبادلُ معهم الزّيارات, في أكثر من مرّة التقيتُ أخته سناء, وحين أعلمتهم بما كتبته عن والدهم سرّوا كثيراً, وبدأنا نسترجعُ معظم ذكرياتنا عن والدهم وعن ديرك وأهلها وساكنيها بشكل عام, وحين ذكّرتُ سناء بشخصيّة والدها الصّارمة وهيبته وخشيتنا نحن الصّغار منه أطلقت ضحكة عريضة, وأكّدت على أنّها وأخوتها أيضاً كانوا يخشونه, لأنّه كان صارماً معهم أيضاً, وذكّرتني ببيتهم الذي كان يغمر بمياه الأمطار حينما كانت تفيضُ السّاقيّة التي كانت مقابل دارنا في فصل الشّتاء, فكان أهل ديرك يسارعون إلى إنقاذهم ومساعدتهم. كانت ديرك في سبعينيّات وثمانينيّات القرن العشرين وقبلهما غنيّة بعيون الماء والينابيع والآبار العاديّة, ومن أبرزها عين العسكريّة التي كانت تمتّع سكّان ديرك بمائها النّقيّ والعذب, وكانت ملتقى لفتياتِ المدينة, يتبادلون فيها أمتع الأوقات, ويظهرون الغنجَ والدّلال وهنّ يتلقين أحياناً عباراتِ الإعجابِ والرّقة من بعض الشّبابِ الذين كان الشّارع الطّويل والعريض يستهويهم. العين الأخرى كانت تسمّى (عين النّسوان), محصّنة بجدران من الحجر الأسودِ من الجهاتِ الأربع, تؤمّها النّساءُ والفتياتُ فقط, حيثُ كانت ملتقى لهنّ, يمضين فترات راحةٍ واستجمام, فيتوضأن بمائها, ويصلّين فوق صخرةٍ عريضةٍ تقع على الجانبِ الأيمن منها, ويسبحن فيها, ويتبادلن مختلفَ الأحاديثِ والحكايات, وقد ظلّت نظيفة ونقيّة بفضل بعض النّسوة الّلواتي تبرّعن بحمايتها والاعتناء بها ومن أبرزهم المرحومة (حسينة) زوجة المرحوم (حسين غازي), أمّا العين الثّالثة فكانت على شكل بركة ماء يسبحُ فيها الرّجال والشّبابُ هرباً من حرّ الصّيفِ الحارق. هذه العيون كلّها كانت تقعُ على خطّ سيرٍ واحدٍ تقريباً, على الطّريق الواقعة بين الشاّرع العامّ والسّاقيّة التي تفصلها عن بُخْچي نادرة. وكان عبارة عن بستان نُسِبَ إلى السّيّدة (نادرة) وكانت امرأة قويّة وصاحبة إرادة وإدارة, مات زوجها في سنّ مبكرة, فتكفّلت بتربية أولادها وتنشتهم, ولها ابن يسمّى (أحمد), ما يزالُ يعيشُ مع أولاده في ديرك, وكان عددٌ كبير من أهالي المدينة يزورون البستان وخاصة في الرّبيع, والصّغار أكثرهم زيارة وسعادة. بالإضافة إلى هذا البستان كانت ديرك تتباهى ببساتين أخرى كبستان العمّ (يوسف خرسي) والعمّ (نجم) أمّا (العمّ ملا محمد أبو يوسف) والذي كان يُعرف بـ (ملاى حمدية), مؤذّن المدينة, فقد كان يملكُ بستاناً جميلاً وأكثر ما أتذكّره فيه هي أشجار التّوتِ البهيّة التي كانت تثمر توتاً أبيض لذيذ الطّعم والّلون, وتوتاً أحمرَ أشدّ لذة ورونقاً, وما أزال أتذكّر المرحوم (صوفي عزير) الذي كان يؤذن بصوته فقط من دون الّلجوء إلى مكبّراتِ الصّوت, بالإضافة إلى بستان شخصٍ كان يُدعى (جرمودي أبو طلال) وعلى ما أعتقد كان عربيّ الأصل ولم يكن من سكّان ديرك الأصليين. (الجامع الكبير), نعم أقصدُ الجامع المجاور لمبنى البريد. ذكرتُ اسم (حنّا ديسچي) ولم أذكر اسم أخيه (عيسى ديسچي) ربّما لأنّه كان والد إحدى زميلاتي في المدرسة, فرسّخ الاسم في ذهني أكثر. أمّا بالنّسبة إلى (الحجة ديوانة) فقد ردّ الأخ (حسن اسماعيل), بأنّها جدّة رضوان رمّو (باڤي داستان), ولكنّني لم أذكرها لهذا السّبب فقط بل لأنّها كانت من أقاربِ أبي, وكانت تزورنا كلّ يومٍ, وتشعرنا بالمودّة والحنان, تؤكّدُ على الدّوام أنّها كانت (أختاً في عهدِ الله للوالد عمر سيڤدين). ومن أجمل ما تحمله الذّاكرة عن هذه العمّة العزيزة أنّها كانت تردّدُ باستمرار: ((كان أخي عمر قد حلّفني أن أبشّره بنجاح ثورةِ القائد البارزاني حتى بعد مماته, وفي بداية السّبعينيّات من القرن الماضي سمعنا نبأ مفرحاً عن نجاح الثّورة, فأسرعتُ إلى المقبرة المجاورة لبيتنا, وقلتُ ثلاث مرّاتٍ: أخي عمر! أبشّرك, لقد نجحت ثورة البارزانيّ, وفيما بعد تأكّدنا من عدم صحّةِ الخبر, وبقيتُ حزينة على الخبر الكاذب الذي نقلته إليه, ومحتارة في أن أخبره بذلك أم لا, ثمّ قرّرتُ أخيراً ألا أعلمه بالخبر ليظلّ سعيداً به وهو في قرارةِ القبر)). (عادل عمر سيڤدين) هو شقيقي الأكبر, وتربطه بالأخ الكاتب صداقة رائعة ونبيلة, وكما أوضح الأخ (حسن اسماعيل) مشكوراً هو صاحب أغنية الفنّان الخالد محمد شيخو (Azada şêrîn) وليس أغنية ((Ay lê gulê فهي من كلمات الشّاعر الكرديّ (عمر لعله). عادل هو من الشّعراءِ الكرد المجيدين والمتميّزين, لأنّه يكتبُ على أوزان وعروض شعريّة قويّة وبقواعد سليمة, وله مخطوطات شعريّة لأكثر من مجموعتين, ولكنّه لم ينشرها لظروفٍ ما, وهو الآن يحاولُ نشر إحداها, أتمنّى أن تُنْشَر في القريبِ العاجل ليستمتعَ قارئ الشّعرِ الكرديّ بها. كان يمتلك في البيتِ مكتبة ضخمة عامرة بمختلف أنواع الكتب الأدبيّة والثّقافيّة والدّينيّة والاقتصاديةِ والعلميّة, وبحرصُ على اقتناء الصّحف والجرائد اليوميّة والمجلات الاسبوعيّة والشّهريّة, وقد استفدتُ منها كثيراً, وكنتُ أواظبُ على قراءتها ومطالعتها مذ تمكّنتُ من القراءة والكتابة. (ﭘريخان), هي أختي الكبرى, والأخ الكاتب يعرفها جيّداً بحكم صداقته لأخي عادل ولكنّ الأمرَ اختلطَ عليه كوننا كنّا نناديها (ﭘَري), كانت بمثابة الأمّ الرّوحيّة لنا لأنّها تكفّلت بتربيتنا ورعايتنا بعد وفاةِ الوالدة المبكر, وهي التي شجّعتنا على سلوكِ كلّ ما هو خيّر وسليم وقيّم في الحياة, وعاهدت نفسها على أن تعيشَ لتحمينا وتسعدنا وتعلّمنا, وقد أسميتُ مجموعتي الشّعريّة المنشورة بالّلغةِ الكرديّة باسمها (Perîxana min). (موساكي عطار) كما كان يُسمّى وهو جارنا العمّ موسى الذي كان يمتلكُ حانوتاً صغيراً يضمّ مختلف السّكاكر والأطعمة التي يشتهيها الصّغار, ولكن من أبرزها وأكثرها لذة السّكاكر التي تأتي ضمن سلسلةٍ مربوطةٍ بخيطٍ رفيعٍ كنّا نسمّيها (حامض حلو). كذلك العمّ (ملا حاجي) كان بيته مقابل عين العسكريّة تماماً, ويمتلكُ دكّاناً كبيراً يبيعُ فيها كلّ مستلزمات العائلة من الأطعمة والأشربة والألعاب, وأكثر ما كان يشّدنا إلى دكّانه تلك الدّمى الجميلة التي كنّا نلهو بها ونسرّ . مدرسة (خولة بنت الأزور) وتسمّى اليوم (ناظم طبقجلي), أمّا في زماننا فكانت بدوامين, كلّ دوامٍ يحملُ اسماً, في دوامنا كانت تسمّى خولة, وأنهيتُ فيها المرحلة الابتدائيةّ مع أختي (دلبر: Dilber) وفي الدّوام الآخر كانت تسمّى مدرسة ناظم. وثانوية الطّليعة للبنات ما تزالُ قائمة وفيها أنهيتُ دراستي الإعداديّة والثّانويّة. ذكري للمدارس ولأماكنَ أخرى كان من باب التّذكّر والوفاءِ لها .
(ﭘرا بافد: Pira bafid: أو جسر الرّومان كما يُسمّى بالعربيّة, هو معلمٌ آخر من معالم ديرك, وقد استفاض الأخ الكاتب في وصفها وأسبابِ بنائها, ولكنّني سأجيبُ على بعض الأخوة الذين تساءلوا: وهل للجسر أبراج؟ نعم, لها أبراج, وكلّ مَنْ يزورها سيراها, وسوف يرى بقايا منحوتاتٍ لرموزها كالشّمس والأسد والعذراء والسّرطان والميزان والثّور وغيرها, وبحسب ما نسمعُ كان الأمير وحاشيته يتعرّفون من خلالها إلى وقتِ ظهور شمس الصّباح أو تأهّب شمس الأصيل للرّحيل. بالنّسبة إلى مشاعل عيد الأضحى فقد خصّصَ لها أخي ابن الجزيرة مساحة جيّدة وقيّمة, ما أحبّ أن أشيرَ إليه هو تعلّقنا بهذا العيد وانتظارنا له, لأنّنا كنّا نشعل في الّليلة التي تسبقه مشاعل, نجوبُ بها معظمَ حارات وشوارع ديرك ونحن نردّدُ بصوتٍ واحدٍ, قويّ وجهوريّ: (Meşel meşel dêre eyda haciya bi xêre ava zimzim têde dibezim her peşkekî bi hecekî)), وهذه المشاعل كانت عبارة عن بواري كرتونيّة نحصل عليها من أصحاب محلاّت الأقمشة حيث تُلفّ بها الأقمشة, وحين ينتهي البائع من بيع القماش الملفوفِ بها يرميها, لذلك كنّا نوصيهم أن يمنحوها لنا فنظلّ نجمعها قبل العيد بأياّم وربّما بشهرٍ. قبل العيد بيوم, نجتمع في مكان معيّن, وكان اجتماعنا على الأغلب في الجهةِ التي تفصل بين بيتنا وبيت العمّ صبري فندو, فنأتي بالمشاعل, نكبّ عليها من الجهة العليا بعض المازوتِ أو الكاز ونشعلها, أمّا الشّبّان والصّبايا فكانوا يأتون بعلبِ الحلاوة الفارغة المصنوعة من التّنك, وكانت مربّعة الشّكل, يثقبون وسطها ثمّ يعلّقون بها عوداً طويلة ومتينة أو قضيباً من الحديد, يربطونها جيّداً ويضعون فيها قطعاً من الخشب ثمّ يشعلونها فتضيء النّيران المشتعلة المدينة بأكملها في جوّ احتفاليّ مشوّق.
ملاحظات لا بدّ منها:
*- قصيدة (في سكرةِ نبض ديرك) كتبتها في ربيع عام ألفٍ وتسعمائة وخمسة وتسعين (1995)م أثناء تجوالي في أماكنَ عدّة من مدينتنا الرّائعة ديريك, أسعدُ النّظرَ بمباهجها ومعالمها, أسترجع الأيّام والّليالي التي أمضيتها مع رفاق ورفيقات الطّفولة, وحين مروري ببيتنا الأوّل الذي ولدتُ فيه, وعانقتُ الشّارعين الّلذين كان يطلّ عليهما وجدتني ألهو معهم من جديدٍ, وألعبُ لعبة (الغميضة: Pîpîkê, والمارشو والمستريح وصندوق زيرى زامَيْزو: Sindoq zêrê za meyzo)2*. أضمّ كفّي إلى كفهم وأردّدُ معهم قبل البدءِ بأيّة لعبةٍ:
((كروم ﭘان يِسْ. يِسْ يِسْ يِسِرْ: ((3*((Kirom pan yês. yês, yês yêsir وأبني معهم (خانيچوك) , والكلمة تصغير لمفردة (خاني: Xanî) التي تعني بالكرديّة البيت, وبيتان شعريّان للشاعرٍ العربيّ (أبو تمّام) يستحضراني في تلك الّلحظات, وفي كلّ لحظةٍ ألمحُ فيها الدّار وأتبادلُ العناقَ مع ترابِ الحارة وبيوتها وجدرانها وهمساتِ ناسها التي تدغدغُ سمعي من الأفقِ البعيد:
-نقّلْ فؤادك حيثُ شئت من الهــــوى ما الحبّ إلا للحبيبِ الأوّلِ
-كم من منزلٍ في الأرضِ يألفه الفتى وحنينُه أبــداً لأوّلِ منـــزلِ
كلّما أمرّ بمكان أو شارع يدفعني الشّوق والحنين إلى أخرى, خطرت في بالي فكرة الكتابة حول كلّ ما رأيتُ وشاهدتُ, وما استرجعتُ من طيبِ الأيّام, فكتبتُ الأفكار الرّئيسة منها في أثناء المسير, وعندما عدتُ إلى البيتِ كانت الفكرة قد اكتملت, ولكنّني ونتيجة تنقّلنا المستمرّ من دارٍ إلى أخرى فقدتها مع دفتري المحتوي على أوراقٍ أخرى, وفي عام (2004) وجدتها, فصرتُ أنتشي طرباً ومسرّةً لأنّها تتعلّقُ بذكرياتي مع ديركا حمكو التي أرى فيها الحياة بكلّ مباهجها ومفاتنها حتّى في الّلحظاتِ التي تغدر فيها بي, وبتّ أنشدُ على أوتار عشقي لديرك وأهل ديرك مع (ملاى جزيري: (Melayê Cizîrî) :
-نَوايَا مُطْرِبُ وچنگى فَِغانْ آڤِيتَهْ خَرْچنْكى
وَرَهْ سَاقى حَتَا كنْگى نَشُويينْ دِلْ ژِڤى ژَنْكى
حَيَاتا دِلْ مَيَا باقي بِنُوشِينْ دَا بِمُشْتَاقى
ألا يا أيُّها السّاقي أدِرْ كأساً وناوِلْها
عندما نشرتها أرّختها بعام (2004), تيمّناً ببركةِ هذا العام, بمعنى أنّ القصيدة لم تُكتَب في عام (2008) تاريخ نشر المجموعة كما اعتقدَ البعضُ, ولا في عام (2006) أو ما بعده كما ظنّ البعضُ الآخر.
2- (Pîpîkê, المارشو, المستريح ,صندوق زيرى زامَيْزو: Sindoq zêrê za meyzo). أسماء ألعابٍ كان الصّغار يمارسونها في فترتي الطّفولةِ والصّبا.
3-((كروم ﭘان يِسْ. يِسْ يِسْ يِسِرْ: (( .((Kirom pan yês. yês, yês yêsir
عبارةٌ كان يردّدها الصّغار قبل البدءِ بأيّة لعبةٍ تطلّبُ فريقين أو أكثر.