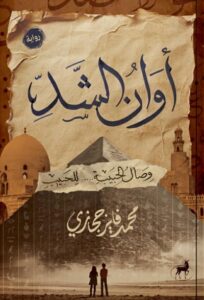د. محمد زكي عيادة
– أَسرِعْ بُنيّ، فقدْ أوصاني والداكَ بالحفاظِ عليك.
– حَسَنًا عمَّاه، أنا في إثْرِكَ.
نسيرُ بعجلٍ؛ فالطريقُ يبدو أطولَ وأخطرَ ممَّا وصفوه، أحملُ أمتعتي القليلةَ وآمالي الكثيرةَ، أتلمَّسُ باستمرارٍ نقودي المخَبَّأةَ بِحرصٍ، إنَّها عُصارةُ ما امتلكوه، باعوا كلَّ شيءٍ؛ ليشتروا ليَ هذا الطريق.
كمْ كنتُ أستعجلُ الأيامَ والسنينَ لأطويَ ملامحَ الطفولةِ، وأبدو يافعًا في أعينهم! بلْ أحيانًا كثيرةً كنتُ أسبقُ الزمنَ من لهفتي، فتارةً أرتدي مقاسًا أكبرَ من جسدي الصغير، وتارةً أخرى أُقلِّدُ هيئةَ الكبارِ ونبراتِهم، وبالرغم من ذلك حينما تلوحُ لي فرصةُ لعبٍ بَعيدةٌ عن الأنظارِ أخلعُ ذاك الشعورَ المتمرِّدَ؛ لأعودَ إلى حجمي الطبيعيِّ مُنسَلًّا مع صبيانِ الحَيِّ، فنجري بحريَّةٍ، ونلهوَ بأكوامِ الرُّكامِ مُبتكرينَ ألعابًا عجيبةً من بقايا الأشياءِ المدمَّرةِ!
وحتى في قلبِ ذلكَ الشَّغَبِ الطفوليِّ يجتاحني الشوقُ لأنْ أكبرَ وأكبرَ… والغريبُ أنَّ القَدرَ استجابَ؛ فوجدتُني كبيرًا حقًّا مِن دونِ أنْ أحتاجَ إلى المزيدِ مِن الطولِ في القامَةِ والعُمر! فقدْ صدرَ قرارُ الأسرةِ، ووقَعَ اختيارهُم عَليّ برغمِ تعلُّقهم بي وحُبِّهم اللامحدود …
لن أشكَّ يومًا في عطفهم وتفانيهم ولوعتهم، ولن أتَّهمهم بالتخلِّي أو القسوة؛ فأخاديدُ وجوههم الغائرةُ الحزينةُ تُسطِّرُ رحلةَ عطائهم وحنانهم الأبديّ، لن أنسى الغُصَّةَ الجافَّةَ التي ألجمَتْ أَبي حينَ الوداعِ، ولا دموعَ أُمِّي الحارَّةَ التي ستبقى تُجدِّدُ وحشتي، مضيتُ مودِّعًا مُتعثِّرَ الخُطَى، لم أقوَ على التلفُّتِ والنظرِ إليهم، ولأوَّلِ مرَّةٍ تملَّكتني رغبةٌ جامحةٌ في سماعِ مناداتهم لأعودَ إلى البيت!
مضتْ تلكَ اللحظاتُ الجنائزيةُ، وضمَّني الرَّكبُ في سوادهِ البائسِ، لأبدأ رحلتي حاملًا آلامَ الطفولةِ وآمالَ الأسرةِ؛ لعلِّي أُنقِذُ ما تبقَّى من أحلامهم!
“يا جماعة، ليلزمِ الجميعُ الصمتَ؛ فالهمسةُ الآنَ ستحرقُ الجميعَ، إنَّها الحدودُ الأولى”
حينما سمعتُ ذلكَ من (المهرِّبِ) وجدتُ غبارَ الأقدامِ يتلاشى مِن الخوفِ، وبانتْ لي أعدادُ الرَّكبِ وسَطَ العتَمةِ، قُرابَة العشرين، منهم الكبيرُ والصغيرُ والرضيعُ، ومنهم الصحيحُ والمريضُ والجريحُ… راودني شعورٌ بأنِّي أقواهم وأخفُّهم حِمْلًا؛ فبتُّ أبحثُ عمَّن أُعينهُ على نفسهِ، أدهشني صمتُ الرُّضَّعِ في حضنِ ذويهم إلى أنْ لمحتُ عُلبَ الدَّواءِ التي تكفَّلتْ بنومهم!
ها هي الأسلاكُ أمامنا تشقُّ السوادَ الحالكَ، ولا شيءَ سوى الخوفِ والتوتُّرِ، بدأَ الجميعُ يصارعُ الأشواكَ الحديديةَ الحادَّةَ بأناملهِ العاريةِ في مشهدٍ مهولٍ تسودهُ أنانيَّةُ الحَشْرِ، نَفْسِي… نَفْسِي…، حتى الرجلُ الموصَى بي همَسَ لي:
“انتبهْ بُنيّ، هُنا لا أحدَ لأحدٍ، ولا سيَّما حينَ يأتي العسكر”
صوتُ الأنينِ والندمِ والصراخِ المكتومِ كانَ طاغيًا على المشهَدِ، تتخلَّلهُ بشائرُ الخلاصِ التي بدأت تلوحُ لبعضنا، لم تمنعني الخدوشُ والجروحُ الصغيرةُ ولا لذَّةُ العبورِ من إنقاذِ شيخٍ عالقٍ بينَ الأسلاكِ، لا تزالُ ملامحُه الحائرةُ حاضرةً في ذاكرتي.
كادَ الجميعُ أنْ يعبُرَ لولا الدوريةُ التي داهمتِ المكانَ، أضواءٌ سُلِّطَتْ ورصاصٌ تطايرَ في كلِّ الجهاتِ وصُراخٌ أعجمِيٌّ ملأ المكانَ؛ فدبَّ الفزعُ، وانكبَّتِ الوجوهُ، ولاحَ المصيرُ المحتومُ للجميعِ، كانَ خَيارُ الهربِ هو الأفضلُ برغمِ خطورتهِ، فقدْ تخطيتُ الحدودَ والفوضى تُغطِّي المكانَ، جريتُ بكلِّ قوايَ مُتجاهلًا الأزيزَ والصياحَ والفزع، لم أُفكِّر بشيءٍ سوى بالابتعادِ أكثرَ فأكثرَ إلى أنْ بزغَ الفجرُ، وكم طالتْ بي الأيامُ بعدَ ذلكَ الفجرِ!
شهورٌ مِنَ التشرُّدِ والجوعِ والبردِ والتِّيهِ، أتنقَّلُ بينَ الخِيَمِ والكواليسِ والمقابرِ، أبحثُ عَمَّن يعبرُ بيَ الحدودَ الثانيةَ، إنَّهُ البحرُ هذهِ المرَّة، المعبرُ الوحيدُ، وما أكثرَ القصصَ الباكيةَ المولودةَ منه، تلكَ التي تحكي لوعةَ الفقْدِ كلَّ يومٍ!
دفعتُ كلَّ ما تبقَّى لديَّ لأعبُرَ مع الفوجِ القادمِ، آخرُ اتِّصالٍ معَ والِدَيَّ كانَ منذُ شهرين، اجتمعَتْ في صوتهما كلُّ أسبابِ الحياةِ، وأنفاسُهم المفجوعةُ تتمنَّى عودتي، ولكنَّهما لم يقويا على نطقها ونحيبُ الإخوةِ يملأُ المكان.
غدًا موعدنا مع قاربِ الموتِ… هكذا يسمّونه؛ لكثرةِ ما أغرَقَ مِن أمنيات! وبينما أستعدُّ لخوضِ ذلكَ المجهولِ قررتُ النظرَ في المرآةِ التي حُرِمتُها منذُ زمن، أهذا أنا!؟
كلُّ هذهِ المعالمِ حُفِرتْ في جسدي في السنةِ الأخيرةِ! وجهُ رجلٍ تتقاطعُ في ملامحهِ الشجاعةُ والخوفُ واللينُ والقسوةُ، ويتعانقُ اليأسُ والأملُ على جبينهِ الأسمرِ، شَعرٌ رماديٌّ طويلٌ مجعَّدٌ، وعيونٌ حائرةٌ، ولا يزالُ يسكنني ذاكَ الطفلُ الصغيرُ المتمرِّدُ على بطاقةِ الميلادِ! وضعتُ رأسي تحتَ صُنبورِ الماءِ؛ لأطردَ كُلَّ الهواجسِ والأحلامِ والذكريات، وأستعِدَّ للنِّزالِ … نزالِ الموتِ.
وما إنْ وطئتُ أرضَ القاربِ المتهالكِ المزدحمِ حتى ضجَّتِ الجوارحُ، وجمَدتِ الدماءُ، سلَّمتُ نفسي المنكسرةَ للأذكارِ والأدعيةِ، وفي عينيَّ تطفو كُلُّ الصورِ والذكرياتِ السعيدة، خاضوا بنا البحرَ برهبتهِ ومزاجهِ المتقلِّب، أمواجٌ تعلو، ورياحٌ تعوي، وصياحٌ ونواحٌ يتبدَّدُ في غياهِبِ البحرِ وأغوارِه السَّحيقةِ.
بقيتُ منكمشًا في زاويتي مُغمِضَ العينَين أتحاشى الحَراكَ، ولكنِّي لم أستطع أن أُغلِقَ أُذُنيَّ أمامَ هديرِ الأصواتِ الجامحة “ساعدوني ابني عم يموت”
“وينو أبي؟”
“أمسكوني عم أغرق”
“وينها زوجتي؟”
“يا الله راح الولد”…
لم تكُنْ تلكَ الأصواتُ حروفًا بل رصاصًا يخترقُ كياني المرتعشَ العاجزَ حتى عنِ النظر!
في ذلكَ القَبْرِ المتحرِّكِ غابتِ القِيَمُ، وتلاشَتِ الإنسانيةُ، وغدتِ النخوةُ والمروءةُ والشجاعةُ عبئًا يزيدُ المحتضَرينَ تمزيقًا وألمًا، كانَ هولُ المشهدِ أكبر من عُلبِ الدواءِ، ووعودِ النجاةِ. امتزجَ لُعَابُ الأمواجِ بدموعِ الرُّضَّعِ وابتهالاتِ الكِبارِ، حاولتُ أنْ أدفِنَ يقظتي، وأتجاهلَ كُلَّ شيءٍ لكنَّها صرخةٌ قويَّةٌ بجانبي منعتني “ساعدني مشان الله”
هممتُ أمدُّ يدَيَّ، ناولَتني الطفلَ واختفت! ظلَّتِ التوسُّلاتُ تهوي تباعًا مِن القاربِ المشلولِ حتى بزوغِ الفجرِ، كانتْ ليلةً تجلَّى فيها الجحيمُ…!
خَفَرُ السواحلِ يتلقَّفونَ بقايا القاربِ، نظرتُ فيمن معي… لا حياة، أصبحوا أحاديثَ، وبينَ ذراعيَّ ما يشبهُ الطفلَ! استغرقتُ ساعاتٍ طويلةً حتَّى استعدتُ ذاتي، وفي أوَّلِ فرصةٍ هاتفْتُ والِدَيَّ أُبَشِّرُهم بوصولي؛ فتعالتْ أصواتُهم بالزغاريدِ والحمدِ ووعودِ الوفاءِ بالنُّذورِ فرحًا بنجاتي مِن حُضنهم، وبُعْدِي عنهم إلى الأَبَد!!!