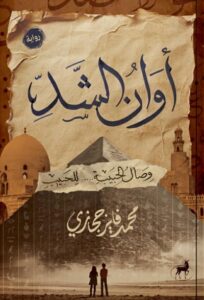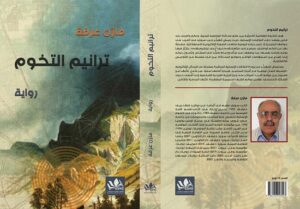محمد باقي محمد
محمد باقي محمد لا شكّ في أنّ هذه الأسئلة تشي بنجاح القاصة في اجتراح عتبة نصية ممهدة، من غير أن تكشف أسرار المتن دفعة واحدة، تاركة مسافة بينه وبين هذا المتن لمصلحة التشويق، أي لاستدراج القارىء نحو قراءة النص!
الأطروحي بسيط في ظاهره، لكنّه من خلف هذه البساطة يطرح علاقة بين انتماءين وثقافتين، فهو يبدأ بآلان الذي راح يعدّ الغداء، والرجل الشرقي لا يقبل على نفسه عملاً موكلاً للمرأة بحسبه، فيما كانت صوفي تشتري الخبز، وأثناء تناول الطعام الغريب بالنسبة لها، أخذت تمتدح الموسيقى التي وضعها، وذوقه في اختيار الزهور، لتقارن ثانية بين سلوكهما، فهي لا تلجأ إلى شراء لزهور إلاّ عندما تكون مضطرة لزيارة ما، بينما يشتري آلان الزهور للمنزل، أي للمتعة الخاصة! لقد سكنت في أكثر من مكان قبل أن تنتقل للسكن معه، بيد أنّها لم تقتني لوحة فنية، لا لغلاء ثمنها، بل لأنّها لا تأبه لمثل هذه الأمور، إنّها تترك له ترتيب المنزل، وتنظيفه، واقتناء التحف، حتى ترتيب خزانتها، ثمّ أنّها تعتقد بأنّها لا تجيد الاعتناء بمظهرها الخارجيّ، وهي ترى بأنّها تشكو ضعفاً في تحسس الجمالي، لكنه يعزو السبب إلى أنّها ترفض الإذعان لأحاسيسها، لأنّها تخاف من الاستقرار، ولما بينت له أنّ الأمر في رأيها يعود إلى افتقادها للأمان، فاجأها ثانية برأيه، فهو يرى بإصرار أنّها تخاف الاستقرار لأنّها لا تثق بالأشياء من حولها!
كانت ترى فيه المستعمر السابق، الذي لم يجرب شعور الكائن الخاضع للاستعمار، لقد توهّم بأنّها فرنسية، لكنّّها أفهمته بأنّها فرنسية على الورق، فتساءل عن انتمائها إذا كانت ترفض الانتماء إلى فرنسة، أعياها الجواب، الذي راحت تتفكّر فيه، وهي تقدم على سلوك آخر غير مفهوم له، إذْ راحت تشرب الشاي بالقرفة غبّ الطعام، وانشغل هو بالقراءة في رواية الكيميائي لباولو كويللو، ” كيف يشعر الإنسان بالانتماء!؟”، هذا ما كان يشغلها، وهي تستبدل شريط الموسيقى بآخر، ثمّ أخرجت دفتراً، وأخذت تسطر فيه أسئلتها عن الانتماء و السكن كاستقرار, ناهيك عن الارتحال!
أسئلة جارحة تطرح نفسها على المهاجرين نحو الغرب، فيما يرى الغربي نفسه إزاء أنماط تفكير مغايرة، قد يعييه التعامل معها، فكيف اشتغلت ” الحسن” على الفنيّ في متنها!؟
يبدو النصّ كقطعة مستقطعة من الحياة، نقلته القاصّة بوساطة الفعل الماضي، نحن إزاء سرد تقليديّ إذن، لقد تناوب على السرد كلّ من الرجل والمرأة، ولذلك احتل الحوار حيّزاً غير قليل في المتن، وإذا كان هذا الحوار قد أوضح آراء الشخوص، إلاّ أنّه لم يسهم كثيراً في حركة القصّ، إنّ السارد الحقيقي هو القاصة، التي توارت خلف الشخصيتين بحدود، ما يُحيلنا إلى السارد الكليّ لمعرفة!
أمّا الزمن فلقد جاء – انسجاماً مع البنية السردية – على الفيزيائيّ، الذي يسير من الماضي نحو الحاضر فالمستقبل، ذلك أنّ القاصّة لم تعفه من نسق التعاقب، مع أنّ النصّ كان يسمح بالاشتغال على المنكسر، وذلك باللجوء إلى ضمير المتكلم لإنجاز مونولوج، يتيح الغوص عميقاً في دواخل الشخوص، أو اللجوء إلى تعدد الضمائر، بحيث يعبّر كل عن نفسه من غير تدخل مباشر، بشكل يتيح الاشتغال على الذاكرة كحامل حرّ في ارتحاله نحو الماضي، خزان الذكريات، والمستقبل عبر التخيل أو الحلم!
ويعود السبب في وهمنا إلى هيمنة الموضوع على القاصة، بحيث شغلها عن الانشغال بالفنيّ، ذلك أنّ قدرتها على السرد، أو إدارة الحدث تبدو واضحة!
أمّا اللغة فهي تميل إلى التعبيريّ، ربّما للسبب ذاته، وبالتالي فإنّ النصّ لم ينشغل بالمجنح ذي الأفياء والظلال والتوريات، على الرغم من تراخي قانون الحذف والاصطفاء، فاللغة لم تنجز بدلالة الاقتصاد اللغويّ، وبالتالي فهي قد لا تشكو من الترهل، إلاّ أنّها لا تخضع إلى ذلك الضبط الصارم أيضاً، ثمّ أنّها تتوخى السلامة، بعد أن تخطت وظيفة التواصل نحو نسيج فني قصصيّ!
ولأنّ النصّ تعامل مع ردّ الفعل لا الفعل ذاته، وعكس صراع الأفكار، جاءت النهاية باهتة، فلم تنضوي على المدهش، أي على المفارق والصادم، لتشكل لحظة كشف وتنوير، ما اقتضى التنويه!