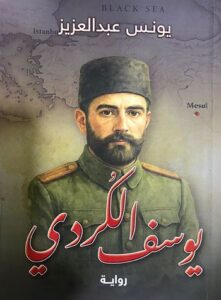إبراهيم اليوسف
إبراهيم اليوسفأي تضاد بين ما يجري من حولنا و الفكر؟، هل جفت ضروع غيمة الإبداع؟، وما الذي جعل تأثير الفعل الثقافي على الحياة العامة يتراجع حتى يصل الحضيض؟، هلا عثرنا على رؤى متميزة تشدنا إليها، في هذه المرحلة التي يتصاعد فيها دخان الحرب عالياً، و يكفهر فضاء المشهد إلى الدرجة التي نكاد لا نبصر الآفاق بالشكل المطلوب، أسبب ذلك أن حواس المرء باتت تصاب بالعطالة ، لاسيما أن أصداء دوي المدافع وهدير الطائرات باتا يصمان الآذان، بل أن الذائقة التي كانت شعيراتها في حالة استنفار عالية في حضرة أي ملمح جمالي، باتت تفتقد للدور الذي طالما كانت تؤديه، وصارت أسيرة العطب،
هذا غيض من فيض أسئلة كثيرة، صارخة، مدوية، قد تطرح على أي مشتغل في المجال الثقافي، من قبل عوام المعنيين بهذا المجال، وهي مشروعة في المقام الأول، مادمنا نجد بأمَّات أعيننا اكتساح القبح مواقع الجمال، وهزيمة هذا الأخير، إذ بتنا لا نجد له أي حضور، وجدوى، وتأثير على مجريات الأمور، فأين هم جمهور القصيدة العالية الذي طالما استظهرها قراؤها في الأحداث الكبرى التي مرت بها المنطقة، فكانت تحرك جماهيرها، حينما كان الإبداع يؤرخ اللحظة، جمالياً، لتغدو موازية للشريط الزمني، يحيل كل منهما إلى الآخر، وإن كانت اللحظة الجمالية دائمة الديمومة، سيان ذلك في لحظات الأفراح أو الأتراح . بل وأين هاتيك القصة القصيرة التي كانت تكتب إلى جانب القصيدة، كي تتفاعل مع الشريط الزمني -بدورها- وهو ما يطبق على الرواية -ذاتها- وإن كان بعضنا يحاول أن يتعامل معها، وكأنها حالة استثنائية، بيد أن لجوءنا إلى لغة الأرقام والإحصاءات والاستبيانات يؤكد أنها أسيرة عوالم النخبة، وهي لا تعدو أن تخرج عن تدوير ما تناوله جيل الرواد فيما يخص ثلاثية أبعاد التابوهات، من خلال الاصطدام بها، لتنحصر إضافة-الروائي الأكثر بروزاً- من خلال معجون لغته، وكيفية بثه الروح فيه.
ورغم أننا قلنا قبل اثني عشر عاماً أننا نعيش” زمن المقال” فإن المقال نفسه، ورغم انفتاح الآفاق، أمامه، إلا أنه لا يقرأ إلا ضمن شروط “القارىء العابر”وهو ما يؤدي للمغامرة بشرط هذا الفن، وكتابة نصوص مضغوطة، تكاد تتعالق مع فنون أخرى ك” نص الهايكو” أو ال” ق. ق. ج” وإذا علمنا أن النشر الإلكتروني يوفر لمليارات القراء متابعة ما يقدم عبره، إلا أننا نجد أن الكثير من الكتاب الكبار لا تحظى كتاباتهم-رغم أهميتها- إلا بعشرات أو مئات القراء، وقد يصل الرقم، في حالات استثنائية إلى الآلاف، وكلها أرقام قليلة تبين وجود تلك الهوة الشسيعة بين أهم شكل كتابي و جمهرات المتابعين المفتوحة في وجه الحدود والحواجز والرقباء، وهذا ما يدل على وجود فقر معرفي، بل قبل ذلك انعدام الثقة بين أهم طرفين في المعادلة المعرفية، وهما: النص والمتلقي…
وفيما لو ضيقنا الدائرة، وسألنا عن المثقف والرأي البارزين، لوجدنا أن هناك خلطاً فظيعاً بين الآراء، حيث أن ذلك الجو الملبد بدخان الحرب ورائحة القتل والدمار، لم يعطب الرؤية إلى درجة العماء، بل بات ينسف الرؤى، فأي كاتب في الرقعة الفلانية من المسارح الأكثر سخونة، وعنفاً، استطاع أن يحافظ على حضوره، ويقدم رؤية متكاملة، منذ ثلاث سنوات ونيف، من دون أن يتأثر بغبش الرؤيا، ومن دون أن نلاحظ أشكال التناقض في مسيرته المحددة، هذه، فلرب من وضع مقدمات ما صحيحة، بيد أنه راح يناقضها، بل ثمة من كانت افتراضاته الأولى مشوشة، إلى أن بات يكتشفها، على نحو تدريجي، كل ذلك إلى جانب من لما يزل يتخبط في مستنقع التضليل، أومن لم يقارب الحقائق، بل من بقي-لأسباب كثيرة معروفة-على الهامش، يهرب إلى الوراء، بعيداً عن الجاري من حوله، الأمر الذي يدعو للسؤال: مَن مِن كتاب ربيع المنطقة، استطاع أن يرتفع بمنجزه الكتابي عن ردود الفعل، ويكتب بشكل موضوعي؟، وبعيداً عن دقة الإجابة، عن السؤال، فإن كل ما يجري الآن من حولنا لم يساهم في صناعة مفكرو احد، في منطقتنا، الأكثر سخونة، يرتبط اسمه بهذه المرحلة-تحديداً- على غرار ما قدمته العقود الماضية من قامات فكرية بل وفلسفية عالية، انطلقت من واقعها، ونظرت له، خارج ما هو مرئي؟؟!…..
لعل الصورة الإلكترونية تمكنت خلال السنوات الأخيرة الماضية، من أن تتصدر الفضاء الكوني، وأن تكون الأكثر جاذبية، وتفاعلاً مع مليارات المتابعين، على امتداد الكرة الأرضية، ودون التأثر بحدود اللغة، أو القومية، أو غيرهما، بيد أنها-نفسها-ترزح تحت نير قيود أشدَّ ثقلاً، لاسيما فيما يخص توجيهها، بحسب ما ترتئيه وسائل الإعلام التي توظفها، وهنا، فنحن أمام شكل أكثر حساسية وخطورة من أدوات التزوير الإعلامي والثقافي، يتحمل وزر ما وصلت إليه أحوال أوساط واسعة، تم خداعها، أو تبليد أحاسيسها، وغير ذلك.
ولنعترف، بأننا لما نزل لم نستفد من تطور أدوات نشر الثقافة والإعلام، بل بتنا تحت سطوة غول شره يستنزف الطاقات، ويشغل المليارات من أبناء العمارة الكونية، ويقصيهم عن إمكان إحياء روح تذوق الجمال، والتخلص من شراك القبح الذي بات يتوغل في دواخل النفوس، يسرطنها، يمزقها إرباً إرباً، أو يهمشها. بل وما يزيد من مأساتنا التي لا ينجو منها أحد، موات روح التضامن، وهيمنة الأنانية، بل و وحشنة إنسانيتنا- في الوقت الذي نحن مطالبون فيه باستعادة، واستنفار أدوات الرؤى الصائبة، والاستعانة ب”بجكتوراتها” الكاشفة، لاختراق طبقات العتمة، المتراكمة، وملامسة الحقائق، واستبصارها، واستكناهها، وسماع الآخر، والتفاعل مع رأيه.
أجل، ثمة منزلق جد خطير انزلقنا إليه، وخطورته تتجاوز حدود دائرة مهاد خطابنا، حيث أن هناك بتراً لكل آصرة تربطنا بالآخرين، بل كل ما يوشجنا بهم، ما جعلنا نبدو كأفراد، وكمجتمعات، بمكونات خلاياها، أشبه بقارات معزولة عن بعضها، بل قارات متضادة، متطاحنة، ينشغل أصحابها بما هو خلافي، من دون أي إيلاء أية أهمية لما هو جامع، وهنا ذروة الخطورة. هذه الحالة سبب في هذا الجدب، والتصحر الروحيين اللذين ألنا إليهما، وطبيعي أن هذه الحالة لم تنشأ مصادفة، بل جاءت نتيجة عوامل عديدة، منها ما هو موغل في ذواتنا، ومنها ما هو مخطط له في مصانع القرار الدولي، حيث باتت الفوضى قانوناً، والقانون فوضى، في عالم دون قيادة، عالم تقوده الأشباح، عالم تتوزعه مافيات القوة.