 إبراهيم اليوسف الشاعر والإنسان هو نفسه إبراهيم يوسف الروائي والناقد والمسرحي .. تعدد السرود الأدبية التي أتقنها لم تكن عائقا أمام إبداعه، وحضوره المميز، حتى وإن كان يصر على أنه شاعر في كل حالاته، بما في ذلك حالته الروائية.. في هذا اللقاء، حاولنا الاقتراب منه، لفهم القصيدة التي تكتبه والقضية التي تشغله والتي يعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الحق الإنساني في الوجود.. فتح لنا قلبه وكان هذا الحوار.
إبراهيم اليوسف الشاعر والإنسان هو نفسه إبراهيم يوسف الروائي والناقد والمسرحي .. تعدد السرود الأدبية التي أتقنها لم تكن عائقا أمام إبداعه، وحضوره المميز، حتى وإن كان يصر على أنه شاعر في كل حالاته، بما في ذلك حالته الروائية.. في هذا اللقاء، حاولنا الاقتراب منه، لفهم القصيدة التي تكتبه والقضية التي تشغله والتي يعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الحق الإنساني في الوجود.. فتح لنا قلبه وكان هذا الحوار. لو طلبت من إبراهيم اليوسف أن يقدم نفسه للقارئ الجزائري ماذا يقول؟
قبل كل شيء، لابدَّ من أن أؤكد أنني أجدني-الآن- ولأول مرة، أمام امتحان كهذا: من أنا؟ من إبراهيم اليوسف؟. أو يعقل أنني لا أعرف ذاتي بذلك القدر الذي يسمح لي أن أتحدث فيه عن نفسي؟. مؤكد ثمة ما أعرفه عن ذاتي، ولكن: هل كل ما أعرفه جدير بأن أبوح به لقارىء له مكانة خاصة لدي؟ حسناً، سأعترف- هنا- ببعض ما يمكن قوله.
أنا امرؤ في العقد السادس. امرؤ كبر بسرعة في سجلات النفوس، في بلد كل شيء فيه مزوَّر. ها أكتب -الآن- عشية ليلة ولادتي في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر. لقد سجلتني أمي في سجلات النفوس في إحصاء العام 1962، نتيجة غياب أبي، عن طريق الجيران. كان عمري آنذاك حوالي السنة، بيد أنه تم وضع تاريخ افتراضي لولادتي هو1960. هذه الحقيقة لم أبح بها يوماً ما، لأسباب ما، وإن رحت أكرِّرها مع بعض أولادي ممن ولدوا مثلي عشية رأس السنة، أو بعدها بأسابيع- كل لسبب- محافظاً على تاريخ يوم الولادة.
جبلت على أمرين: الرقة والعنف. الرقة مع الناس والعنف في مواجهة الذات والآخر، في سبيل الموقف: لم أسكت أمام أية آلة رعب. كنت أقول كلمتي، على طريقتي الخاصة. من هنا فإنني وقعت في خسارات فادحة، واكتسبت- في المقابل- ثروة فادحة. ثمة أذى لحق بأسرتي، من جراء موقفي. من أبنائي من أبعد عن عمله، من أخوتي من أبعد عن عمله. نلت حقد حفنة المتكسبين، لكنني فزت بمحبة أوساط واسعة. هذا ما أملكه الآن، وإن أتت الثورة السورية، لتفتك ببعض هذا الرصيد، وذلك لأن شبح وحش الحرب عندما يخيم فهو يفتك بنفوس الكثيرين، ويعرِّي كل من هو في فضاء مشهد هذه اللعنة.
الحلم كان السمة الرئيسة في حياتي. كنت طفل أحلام. فتى أحلام. مراهق أحلام. شاب أحلام. كهل أحلام. كانت أحلامي كبيرة جداً. أرسم العالم كما أريد. أرسم من حولي كما أحلم. أرسم صورة عدوي في لحظة إنسانيته بعد أن يتحول إليها، ويستقر فيها. أرفع الأسوار بين الناس. أرفع الحدود. أرفع الظلم. أرفع الطغيان. ثمة ما تحقق على الصعيد الشخصي: حلمت أن أكون معلماً فعملت في حقل التعليم. حلمت أن أكون إعلامياً فحققت ذلك. حلمت أن أكون شاعراً. كاتباً، فحققت ذلك، قدر المستطاع. حلمت أن أكون لي أسرة ناجحة فحققت ذلك. ثمة أحلام أخرى ربما، أكثرهم يهرول صوبها، إذ لم يخطر في بالي أن أكون غنياً يوماً ما، ولا أن تكون لي سلطة إلا على عبارتي قبل أن أصوغها، لتكون في مستوى ذائقة المتلقي. في مستوى رؤاي.
جربت الفنون كثيراً: لجأت إلى عالم الخط، ثم نسيته، كما الرسم، كما المسرح، كما الخطابة إذ ألقيت ذات مرة كلمة في “مسجد” وأنا في الثانية عشر من عمري، كان في المسجد عدد كبير من الناس. منذ سن الخامسة عشرة، راسلت بعض المنابر، نشرت في بعضها. كانت كتاباتي الأولى عبارة عن نصوص شعرية، أو قصصاً، أو مقالات في قضايا شتى. قدمت الكثير من الأسماء. اهتممت بالمواهب الجديدة، أطلقت مجلة ثقافية بمعونة- حزبية- أشرفت على منتدى أدبي قدم الكثير من المواهب، وبالرغم من ذلك كنت أبتعد عن تقديم نتاجاتي على هذا المنبر. اشتغلت في الصحافة. كتبت في النقد. كتبت في الشعر. كتبت في السرد: قصة ورواية وسيرة، وها أنا ذا أراني، لا أحلم إلا أن أكون الشاعر الذي كتب قصيدة ما أعجبته، ولايزال يحث الخطى، كي يكتب أكثر.
نالت المرأة مساحة واسعة من حياتي، كما القراءة والكتابة، والعمل الحزبي. كنت أجد فيها خير مؤنس، إلى جانب حياتي التي كرستها لأصدقائي. هي كانت سرَّ الأعماق، حتى وإن كانت سراً معلناً، أحياناً. ثمة أنثى وقفت معي. ثمة أنثى منحتني الحب. ثمة أنثى كانت الملاذ لي، في هاتيك اللحظات التي تطبق على روحي الآفاق, ثمة أنثى كانت في قصيدتي. في كتابتي. في موق العين، أو النبض، أو الدم، أو الروح. لم أعش دونما امرأة: حلماً أو واقعاً، لحظة واحدة، هي الجزء الرئيس من معادلتي الروحية.
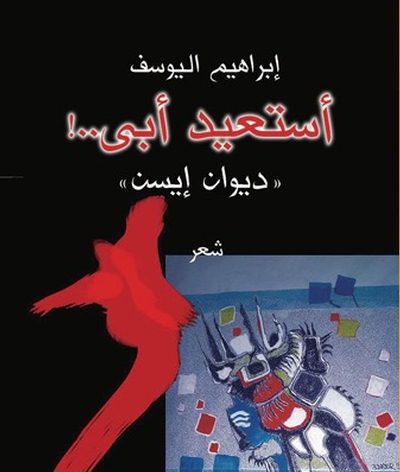
ثمة سمة شخصية ظللت أحافظ عليها. لم أقترب يوماً ما من طاغية، أو حاشيته. كنت أنفر منهم. ولد هذا الشعور على نحو عفوي لدي، وكلما ازددت وعياً- كما أزعم- ازددت إصراراً على البعد عن هذا العالم القميء. في كتاباتي الأولى مسست بالقضايا الممنوعة، ودفعت ضريبة ذلك. كنت أتلذذ عندما أجد رقيب الطاغية مستفزاً، حتى وإن كان ثمن ذلك باهظاً: التضييق على اللقمة. التهديد. الاستجوابات. محاولات إلحاق الأذى بي. المطاردة، التهجير
أنا امرؤ سريع الغضب. سريع الندم. أصرخ، وأضحك. إن أَستفِزَّ مستضعفاً مثلي، على نحو فعلي، أو انفعالي، سرعان ما أعتذر إليه. اضطررت لخوض حروب ثقافية- للأسف- مع أبعاضهم. لم أكن في أية مرة: البادئ، إذ لطالما حاولت استيعاب هذا الأنموذج، إلى أن ينفد صبري. ما أراجع نفسي، بصدده، دائماً، هوما يتعلق بالأسماء التي واجهتها، والتي كانت دوافع أصحابها في إيذائي، شخصية، بعكس مواجهاتي مع أزلام السلطة، إذ إنني أراني قد تصرفت بشكل صحيح. الآن أرى أن هذا الأنموذج هو أكثر من آذوا أنفسهم وأنني أرأف بهم. حيث أراني أتنعم في جحيمي وأنهم يتلظون في فردوسهم.
ثمة خطأ كبير وقعت فيه وهو أنني سوفت إنجاز ما هو إبداعي، منخرطاً فيما هو يومي. حتى أرشيفي الكتابي أهملته، وقد نالت منه نيران الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى نيران الحرب. نيران التنقل من عنوان إلى آخر. كان من الممكن أن تكون لي كتب كثيرة، لم تر الطباعة، منها ما كان مخطوطاً، ومنها ما كان متوزعاً بين أرشيفي من أقنية وسائل النشر. كلما تذكرت هذا الجانب أشعر بألم جد كبير.
أو ترينني استرسلت؟
ثمة ما أقوله- هنا- للمرة الأولى. أنت من استفززتني وعليك تحمل كل هذه البوح، أو إرساله إلى مقصلة الحذف الإلكتروني.

من الشعر إلى الرواية؟ كيف حدثت هذه النقلة؟
ما زلت لا أرى نفسي غير شاعر. كتبت في الصحافة، طويلاً، وعملت فيها، مراسلاً لبعضها، ومحرراً في إحداها، ومؤسساً لأخرى، إلا أنني لم أنظر إلي، ألا كشاعر. كتبت في السرد، إلى جانب الشعر. كتبت المسرح. كتبت القصة. عملت في التمثيل. عملت في الإخراج. عملت في السياسة. ما زلت أعمل في مجال “حقوق الإنسان” و” المجتمع المدني” عملت في تأسيس أكثر من مؤسسة نقابية، أو مدنية، لكنني لم أر نفسي خارج القصيدة. كانت القصيدة حاضرة، في كل مراحل حياتي، حتى في حواراتي. جلساتي. حبي. ردود فعلي. انفعالاتي. كثيراً ما كانت الشعرية تتسرب إلى مقالي الصحفي، أو إلى مسرحيتي، أو إلى نقدي الأدبي الذي كنت أكتبه. كتبت القصة، ونشرتها مع الشعر في بداياتي. كتبت مخطوطاً روائياً، تحت وطأة أمرين: الحب والأيديولوجيا، إلا أن ظروفي لم تسمح لي، بطباعته. ربما كان ذلك، من حسن حظي، أو لربما من الضروري أن أعود إلى ذلك المخطوط وأشعل فيه الحياة، من جديد، لأنه مرآة مرحلة مهمة من حياتي.
حدث أن ابتعدت عن الشعر. أعني عن النشر، لاعن كتابته، وكان ذلك في أحرج مرحلة من تاريخ بلدي، وشعبي، إذ وجدت الحاجة ماسة، إلى من يقول: لا. لقد قلتها، بأشكالها، وفق طبيعة كل مرحلة. وجدت أن مخاطبة ولي الأمر لا تكون عبر قصيدة، فهو لا يقرأ ولا يسمع. لذلك كتبت بالطريقة التي تستفزه. بالطريقة التي يلتقط فيها” عيونه” حبري الرافض له. كرست أهم مرحلة من حياتي، في سبيل أهلي. بلدي. وطني. مواطني. أتبعت العمل بكل السبل المتاحة: السياسة. الصحافة. الندوة الجماهيرية. الاعتصام، إلا أنني أحسست فيما بعد أني قصرت في مجال مشروعي الجمالي، ولا شيء يبقى لي من رصيد، سوى قصيدتي، لاسيما إنني امرؤ عاف كل ما يفكر به سواي مما هو عرضي. انشغلت بالانتفاضة. انشغلت بالثورة، ولكنني قلت فيما بعد. بعد انكسار مشروع بلدي. بعد عرقلته. بعد كبحه. بعد لجمه: لابد من استئناف مشروعي الشعري. عدت إلى قصيدتي، وكان من حقها أن تتمنع علي، لاسيما في بدايتها، قبل أن تكف عن “حردها” وتسلس بين يدي، كما حبيبة قديمة، مخلصة، أخطأت معها، ماجعلني أعود إلى بعض كراريسي. مسوداتي. مخطوطاتي. أضيف إليها مخطوطات أخرى، فأطبع ثلاث مجموعات شعرية، دفعة واحدة.
بعد طباعتي لمجموعاتي الشعرية، بعد صعود الإرهاب في بلدي، ووصوله إلى مدينتي. حيي. شارع بيتي. بل حتى مكتبتي التي تهاوت كتبها، إثر انفجار هائل، أودى بحياة جيراني. كتبت سلسلة مقالات عن الحدث، بعد مئات المقالات ومثلها من البيانات عن مجريات الثورة في بلدي. كتبت بورتريهات عن وجوه جيراني الضحايا، لكنني اكتشفت أن لا شيء يرتقي إلى مستوى هكذا حدث، إلا لغة السرد. إلا الرواية منها، تحديداً. كان كل شيء معداً. الأدوات جاهزة. العنوان. الشخوص والأشخاص. تفاصيل المكان. أجساد الضحايا التي تفحمت. أحلامهم. عويل أمهاتهم، وأخواتهم. الدموع المتحجِّرة في أعين أطفالهم. الغصات المتيبسة في حلوق ذويهم. أخطوطة الخلاص. وهكذا، كتبت الرواية نفسها. كتبتني.
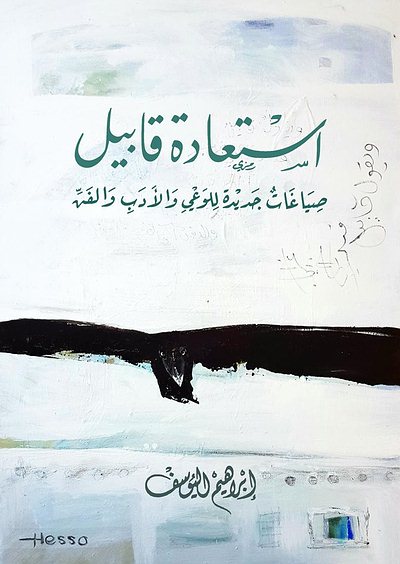
هل تعدُّ هذه الرواية منعطفاً في مسيرتك الإبداعية التي تنوعت بين الشعر والقصة والصحافة والنقد؟
لطالما وجدت، أن الإبداع لا يُجزَّأ، بل هو متكامل، وإن كنت أعرف أن في- التخصص- الكتابي ما قد يجنِّح الإبداع، كما أنه قد يكون قفصاً، يمنع الخروج عليه أو منه، وإغناء حالته الإبداعية. جاءت كتاباتي متكاملة. القص إلى جانب الشعر والمقال، بل وقبلهما المسرح إلى جانب الشعر، كما أن مغامرة الكتابة في مجال النقد الانطباعي، فالتكاملي، ضمن إطار الوعاء الصحفي، لازم عملي الصحفي، وقراءاتي الشعرية، وكان ذلك منذ أول الثمانينيات، إذ كتبت، ولأول مرة عن مجموعة شعرية للمفكر إبراهيم محمود. أما كتابتي للرواية، فلا أعرف” هي” كيف؟” وإلى أين؟. بدأت بعد انتهائي من- روايتي الأولى- بكتابة أخرى، بعنوان ” شنكالنامة”، عن الأسيرات الإيزيديات لدى تنظيم داعش الإرهابي، مع الجرائم التي ارتكبوها. مسرحها المكاني- ما سمي ب” دولة العراق والشام”. انتهيت من كتابتها في زمن قياسي. كما- شارع الحرية- ولربما إنها تختلف عن الأولى. هذه الأولى كانت- حالة- أما هذه فقد كان لها عالم آخر. أنجزت بعدها عملين آخرين، لا يزالان مخطوطين، ولم أفكر بطباعتهما، وذلك لأنني بصدد مراجعة الذات، في إطار كتابة مختلفة. منذ سنة توقفت عن الكتابة. الأحداث تؤثر في. ما جرى ويجري للكرد في إقليم كردستان. في عفرين. ما يجري في سوريا. تقهقر الثورة. تنفس النظام السوري الصعداء، بعد كل ما ارتكبته أياديه الأخطبوطية من جرائم، دعاني للتوقف عن الكتابة. هاجسي الأول والأخير، أن أواصل مشروعي الشعري. أن تعوض القصيدة عن عالم الرواية.

في (شارع الحرية) ثمة مزجٌ بين العام والخاص.. لكن لماذا اخترت أن تكون بطلها الرئيسي؟
أجل. أزعم أنني اشتغلت في عالم- الميتا سرد- إنه عالم المغامرة. ما زلت أسأل نفسي: أحقاً ما كتبته هو رواية؟. بعد إنجازي للرواية أرسلت مخطوطها لحوالي عشرين روائياً، وناقداً، وكاتباً، وإعلامياً، وشاعراً، وقارئاً متابعاً. الآراء التي وردتني كانت جد مشجعة. أكثرهم رأوا فيها رواية مميزة، مع بعض الملاحظات الطفيفة من لدن بعضهم. في هذا النص الروائي انطلقت من: المذكرة- السيرة- الواقع- الخيال..، واستعنت بالوثيقة، والتاريخ، والبيان، والشهادة. حاولت جاهداً أن أقصي الشعرية الفائضة، ما جعل لغته، متعددة. حيث شعريتها، إلى جانب الريبورتاج. إلى جانب” الكولاج” الذي انتبهت إليه إعلامية وقارئة، إذ استعنت بفصل من كتابي السيروي” ممحاة المسافة” في ما يتعلق ب” شارع الحرية” المتناول نفسه.
حاولت الكتابة بصيغة ضمير الغائب، لكنني عدلت عن الفكرة. من هنا حضرت الذات. حضر الروائي والراوي، إلا أنني عبر كل ذلك، كان لابد من الخيال، ربما كتكنيك، ولد عفوياً. بين روايتي الأولى وكتابي السيروي خيط مشيمي، أدركه، بيد أن عدم انتشار الكتاب الثاني، نتيجة-آليات دار النشر- التي اعتمدتها، جعل القراءات المتعمقة للرواية لا تدرك ذلك. لدي مشروع نقدي في- مقالات- سأنجزه، في وقت لاحق، أتناول فيه فضاء تجربة هذا النوع من الرواية التي تحاول تشكيل ملامحها، بعيداً عن الاستسهال الذي قد تقع في فخاخه على أيدي كثيرين، من أنصاف الموهوبين، الذين أساؤوا، ولايزالون يسيئون، إلى عالم قصيدة النثر، وكانوا إلى جانب صناع – التفعيلة- و ناظمي- العمود- أكثر من أحدثوا هذا البون ما بين جمهرات القراء والشعر، ومن هنا، فإن استسهال الرواية، لتكون ركاماً من الهذاءات سيسيء إلى عالم الرواية، عامة، وليس هذا النوع الروائي، وحده، فحسب..!.
ما الفكرة الأساسية التي أردت إيصالها للقارئ من خلال الرواية؟ وهل هي نداء استغاثة من الأكراد إلى العالم في ظل التحولات الجارية؟
تتناول الرواية حكاية صحفي كردي سوري له أرشيف كبير، اشتغل عليه سنوات طويلة، إلا أن أجهزة أمن النظام في بلده، حاربته، فاضطرَّ إثر ذلك للسفر إلى خارج بلده، وترك أرشيفه، وليستقرَّ أخيراً في بلد أوربي هو ألمانيا، كلاجىء حرب، و لاجىء موقف، لذلك فهو يغامر بالسفر إلى إقليم كردستان، لينطلق منه إلى مدينته- قامشلي- عبر مغامرة جد خطيرة، لأن رأسه مطلوبة-هناك- من قبل أكثر من جهة تحكم البلاد. تبين الرواية أن وجوه مدينته تغيرت، وأن صور الأمس استبدلت بصور جديدة، في الكثير من الأماكن. كما تبين أن ملامح مكانه قد تغيرت، وهذا ما يثير شجونه، إذ يصرُّ على المرور من شارع بيته، والذَّهاب إلى بيته الذي يسكنه آخرون، غيره، إلا أن هذا الشارع بات مقطَّع الأوصال. إذ فيه ثلاث وزارات، كما أن من معه يمنعونه من الدخول إلى بيته، حرصاً على حياته. وإذا كانت الرواية تركز على استبداد مرحلة ما قبل الثورة، فإن استبداداً آخر، بات المكان وأهلوه يعانون منه، كما يبين ذلك بعض الشخصيات التي يلتقيها.
ثمة رمزية- حقاً- في توظيف الأرشيف، كما أشارت إلى ذلك بعض قراءات الرواية، إذ إن الأرشيف هو- في حقيقته- مواجهة لحالة المحو التي تقلق ابن المكان، وهوما كان دافعاً إلى كتابة عملي السيروي” ممحاة المسافة: صور، ظلال وأغبرة”، لتناول المكان وكائنهما، من خارجه. مؤكد، أن الكردي هو الكائن الذي حمى خرائط مكانه. خرائط الشرق كلها، وهو ما فعله ويفعله إلى اليوم، في محاربة الإرهاب، من دون أن تكون له خريطته، بل إن كل تلك الخرائط تأسست على أنقاض خريطته، بالرغم من أنه لا يمكن أي تأريخ لجغرافيا المكان، أو أية جغرفة تاريخية، بمنأى عنه. ولعل مصادفة نشر الرواية عشية” استفتاء إقليم كردستان” وبدء المؤامرة والغدر الغربيين بالكرد، بعد أن كانوا نواة محاربة الإرهاب، ليس في المنطقة وحدها فقط، وإنما نيابة عن العالم كله، إلا أنهم كوفئوا بالطعن في الظهر، لقاء مصالح أمات الدول الكبرى: لاسيما أمريكا وروسيا، ناهيك عن إيران. من جهة أخرى لم تكن الرواية منغلقة على الكردي وحده، وإنما كانت رواية كل شركاء المكان، من عرب، وسريان، وأرمن، بل وكرد إيزيديين وغيرهم. إن- شارع الحرية- الذي سماه شيوعيو المكان بهذا الاسم، وكان فيه الكرد، وممثلو أحزابهم، وكان أحد عناوين- المظاهرات- فقد حتى حلم أهله، بعد أن ازدادت أحوالهم سوءاً، واضطروا للهجرة، وتفريغ المكان من أكثرهم.
كروائي.. كيف تعاملت مع الحقبة التاريخية الراهنة؟ وإلى أي حد كنت وفياً لها؟ وهل يمكن اعتبار هذا العمل وثيقة تاريخية أم إنسانية؟
أجدني أتعرض ل- قشعريرة- حينما تطلق عليَّ صفة “روائي” فأنا لست روائياً، إنما شاعر راح يواصل قصيدته بوساطة الرواية. إنها تفكيك للرؤى الشعرية، كما كنت أفعل أثناء كتابتي للقصة، أو المسرحية، أو المقال. إنها هوامش المتن الشعري. أما فيما يتعلق بوثائقية، أو تاريخية هذا النص الروائي، فإنهما حاضران. الوثيقة كجزئية من التاريخ، لكن التاريخ هو مجرد بعض الفضاء العام، لأن هذه الرواية لم تتخل عن فنيتها، وبعدها الجمالي الدلالي، من منظور إنساني، هو محور رؤيتي كناص، لا يتنكر لخصوصيته القومية ك: كردي، بل يحاول أن يكون وفياً لثنائية هذه المعادلة التي تكاد تحولات المرحلة أن تجهز على بعدها الإنساني، بل وسواه، من خلال التركيز على ما هو فردي، في مرحلة ما بعد ما بعد الحداثة.

دعني أسألك عن مدى اقترابك من الأدب الجزائري؟
قرأت في سوريا ما توافر بين يدي في مجال الأدب الجزائري- لاسيما في مجال السرد- سواء أكان ذلك ما ينتمي إلى مدونة كتاب فرنسيين، كألبير كامو، أو ما ترجم لكتاب عرب جزائريين كتبوا بالفرنسية كما مالك حداد ومحمد ديب وآسيا جبار، أو ما أنتجه وينتجه كتاب مهمون أو لافتون بدءاً من رشيد بوجدرة و واسيني الأعرج و أحلام مستغانمي و عبدالرزاق بو كبة وليس انتهاء ببعض الأسماء الجديدة. الأدب الجزائري، لطالما وجدنا فيه بوابة للقاء بين الأدبين العربي والغربي، وبخاصة: الفرنسي، منه.
في الإمارات التقيت عدداً من الكتاب الجزائريين الذين توطدت علاقتي بهم، بعد لقاءاتنا السابقة بعدد ممن تابعوا دراستهم في دمشق، أو لجؤوا إليها، أثناء- الأحداث العاصفة- التي مر بها هذا البلد العزيز. أحتاج إلى مسرد لأسماء هؤلاء الأصدقاء: مسرحيين، وشعراء، وروائيين، وبعض النقاد.
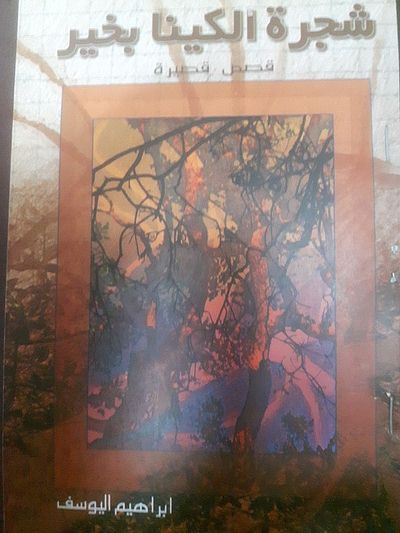
ماذا عن حدث حريق سينما عامودا الذي يتردد ذكره كثيراً من قبل بعض الكتاب الكرد؟
عامودا مدينة كردية صغيرة، تبرعت مدارسها بريع فيلم سينمائي حضره مئات التلاميذ الصغار، للثورة الجزائرية. اشتعلت النار في دار السينما غير المجهزة بالشكل اللازم، تحولت أجساد المئات من فلذات أكباد هذه المدينة إلى مجرَّد رماد، أو فحم. بعض من نجا منهم غدا كاتباً، أو شاعراً، أو طبيباً، أو مفكراً، أو فناناً، أو مخترعاً، أو مربياً. هذه المدينة قدمت جيلاً من أبنائها كأضحيات للجزائر، لذلك فإن الكرد آلمهم أن تبرم اتفاقية شاه إيران وصدام حسين برعاية شخصية سياسية جزائرية، في الوقت الذي كانوا ينتظرون أن يكون للأطفال الكرد تمثالهم، أو تماثيلهم في إحدى ساحات العاصمة الجزائرية، أو أن يتناول الكتاب الجزائريون هذه المأساة الكبرى التي تعرضت لها هذه المدينة المنكوبة.
ثمة كِتاب-وثائقي- عن هذه المأساة بعنوان” حريق سينما عامودا” دونه على شكل ريبورتاج الأديب الراحل ملا أحمد نامي، بلغته الكردية الأم، ولم يتمكن من طباعته، ونشره، بسبب منع أنظمة الحكم المتعاقبة في سوريا، طباعة، أو ترجمة، أو نشر، أي كتاب، أو أية قصيدة، أو أغنية كردية، حتى ولو كانت غزلية. هذا الكتاب ترجمه وطبعه سراً الكاتب صلاح محمد، وقمت شخصياً بالصياغة النهائية للترجمة.
وكأنك أدمنت منفاك الألماني؟
لقد غادرت مدينتي- قامشلي- منذ حوالي عشر سنوات، عدت خلالها مرة واحدة إلى الوطن، وخرجت من الوطن بأعجوبة، بجهود صديق كاتب هو الشاعر صقر عليشي، بعد أن غدت الأخطار محدقة بي. كان خياري وبعض أفراد أسرتي أن نعمل في بلد عربي، إذ كنا نرفض الهجرة. لجأنا إلى الإمارات على أمل العودة إلى الوطن، ما أن يتم رفع الظلم عن كواهل السوريين، إلا أن تحول الثورة إلى حرب على السوريين، عبر عسكرتها، وتمويلها، وخدمة توجهات الممولين، جعل أمل العودة إلى البلاد صعباً، لاسيما بعد انتهاء مدة صلاحية جواز سفري وبعض أفراد أسرتي. من هنا اضطررنا إلى الهجرة إلى ألمانيا. لا أنام ليلة، إلا وأقول: إنني أتمنى أن أنام ليلتي المقبلة في بلدي. في مدينتي. في بيتي هناك. أعيش أقصى درجات التوتر، لاسيما في ظل الجهل بلغة المكان. لقد أجلت مشاريعي الكتابية إلى مرحلة- التقاعد الوظيفي- ولكن ها أنا على أبواب الستين من عمري، ولم أتفرغ للكثير من المشاريع الكبيرة. ثمة عامل رئيس وراء تأجيلها، بالإضافة إلى انخراطي في الدفاع عن- لقمة الناس- وحرياتهم، وهو أنني كنت كائناً حلمياً. أؤجل كل شيء. أؤجل مشاريعي كمن يرفع كتاباً من فوق رف في مكتبته ليضعه فوق آخر، في متناول اليد. أحلامي انكسرت. إن أعد إلى الوطن.. إن نعد إلى الوطن-غداً- فإننا نحتاج إلى خمسين سنة لفرض الأمان، بعد نشر روح ثقافة الثأر والدم. لكم وددت-هنا- أن أثقفن، رؤاي، حول الغربة والاغتراب. حول المنفى، المتشظي، إلا أنني غرقت، تحت وطأة الألم، في تفاصيل ما هو يومي.
ماذا تقرأ الآن؟
ثمة معاناة كبيرة أتعرَّض لها، بسبب وجودي بعيداً عن مكتبات أسستها. فقد واظبت على قراءة كتب والدي رجل الدين. العالم، في القرية، ومن ثم أسست مكتبتي الشخصية التي لم يرتح أبي للكثير من كتبها، لاسيما مجلدات: ماركس- لينين- أنجلز، وأعمال الكتاب الروس إلخ. كبرت مكتبتي صارت أعدادها بالآلاف، أعددت أرشيفاً ضخماً على مدى أربعين سنة، لكنني افتقدت أكثره بسبب حالة الهجرة والحرب. مكتبتي ما قبل الأخيرة أسستها في دولة الإمارات. اقتنيت كتباً مختارة، وصلت الألفي كتاب، لكنني اضطررت لمغادرة المكان، وترك مكتبتي، هناك.
كتب مكتبتي الآن، وبعد ثلاث سنوات من إقامتي- الاضطرارية في ألمانيا- تقل عن المئتين. بينها كتب جديدة، إلى جانب كتب قديمة. أكثرها كتب الإهداءات. أو ما حمله معهم أفراد أسرتي المصابون بلوثة القراءة. نتبادلها نقرؤها. أقرأ بعض الروايات القديمة والحديثة. أقرأ حالياً بعض كتب التاريخ. منها كتب: شرف خان البدليسي، ومحمد أمين زكي. أقرأ بعض إصدارات المفكر إبراهيم محمود.
ماذا تكتب؟
عكفت في العام2016 على جمع بعض أرشيفي الشخصي، بعد أن تم ضياع وتضييع أكثره، نتيجة تنقلاتي من مدينتي: قامشلي التي تقع في أقصى الشمال الشرقي، من خريطة سوريا اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم إلى ألمانيا التي اضطررت للهجرة إليها، نتيجة انتهاء صلاحية” جواز سفري”، أضف إلى ذلك فإن ذاكرة حاسوبي الشخصي تعرضت مرات للقرصنة والمحو، وجاءت خيانة ذاكرة “غوغل” وأشباهه من محركات البحث لما نشرته ألكترونياً ليزيد الطين بلة، بعد أن تم توقف بعض المنابر الألكترونية التي استودعتها مقالاتي، وكتاباتي، على امتداد عقد ونصف من الزمن. الآن، ثمة جزء من هذا الأرشيف أشتغل على جمعه. بين يدي بعض مخطوطاتي التي تحتاج إلى التدقيق، بيد أن كسلي المزمن يحيل بيني ووضع اللَّمسات الأخيرة عليها، وأهمُّها ثلاثية ” المثقف والسلطة” بعد ضياع مخطوط كامل لي في هذا المجال.
لديَّ أكثر من مشروع عن الثورة السورية، بالإضافة إلى عمل روائي عن إحدى المحطات الكردية المهمة، وسأحاول أن أتفرغ لها، كما أن نوستالجيا عارمة تشدُّني إلى مواصلة مشروعي الشعري، في مجال قصيدتي التفعيلة والنثر.، وأن لدي مشروع عن- الشعر الكردي والثورة- والشعر السوري والثورة- من خلال اختيار تجارب لشعراء مميزين، بعد أن طفت على السطح أسماء بعضهم ممن بات يقدم نفسه أنه” بوعزيزي الثورة” أو” أبو قاسمها الشابي”، من خلال التمادح الذي بات يتعمق، كأحد مفرزات حالة الحرب.
لدي مشروعات كتابية كثيرة، بيد أن قلق زمن الحرب، يحيل دون اشتغالي عليها، بالشكل اللازم، وهوما يزيد من متاعبي. فخلال فترة شهرين من استقراري أنجزت مجموعتين شعريتين، بالإضافة إلى إنني خلال فترة أقل من ستة أشهر أنجزت أربعة أعمال سردية، من بينها مجموعة قصصية.
كلمة أولى (لا نقول أخيرة).
إنني هنا أمام السؤال الأكثر صعوبة. الأكثر إحراجاً. كل شيء يمكن قوله هنا. نوستالجاي نحو الوطن. سيرتي والأنثى. سيرتي والشعر. انهدامي اليومي وأنا أتابع ما يجري لوطني. لبلدي. لإنساني. لشعبي. لمواطني. مأساة الحرب. خيانة العالم لثورتنا السورية. تفاصيل فصول- دراما السوريين- إذ تضيع أشلاء أسرة كاملة، تحت سقف بيت، أو في بلم في أحد البحار. قساوة قلوب العالم الذي يتابع مسيل نهر الدم، وبات من مستكملات شاشة تلفازه، أو أخبار جريدته. خيبة السوريين فيمن ظنوا فيهم ملائكة سينهون حربهم اللعينة، بينما هم منكبون على إطالة أمدها. صناع الأسلحة الذين جعلوا خريطتنا مسرحاً لتجريبها، أو صرفها، في الوقت الذي يتشدقون فيه بأنهم آوونا. خيبتنا تجاه المسلمين. تجاه العرب. تجاه بعض الخليجيين. تجاه لصوص الثورة. تجاه القتلة الذين تحولوا إلى وحوش كاسرة، لا يمكن أن يعيشوا إلا على دماء الناس. كان عليك ألا تسألي. ربما إن هذا السؤال نفسه دعاني ألا أجرؤ خلال الأشهر الماضية إلا على مقاربة سؤاله الأول، لأستكمله في منتصف آذار، حوارك المهم هذا جعلني أحاول قراءتي- من جديد- قبل سواي.
حاورته المجلة الثقافية الجزائرية
*ياسمين بن مسعود
حوار النسخة الورقية الفرنسية من المجلة معد للطباعة والنشر





