
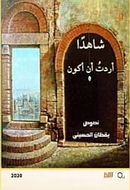 عبد الستار نورعلي
عبد الستار نورعليلعنوان المُؤلَّفِ ـ كتاباً كانَ أم نصّاً ابداعياً ـ أهمية خاصة، فهو مدخلُ العمل، والنافذةُ المشرعةُ على دواخلِه، والمصباحُ الأولُ في إضاءةِ طريق المتلقي، والبوابةُ لولوجهِ واستكشافِه، وما تختزنُ النصوصُ من مضمونٍ ومعنىً أو حسٍّ وخيالٍ. فهو العتبة التي تمهّد الطريقَ أمامه، واليدُ التي تُقدّمُ مفاتيحَ المنتج الإبداعي. لذا حظيَ باهتمام الدارسين والباحثين والنقاد، ليستقلّ بمنهجه الخاصّ (السيمياء)؛ لأنّه “النصّ مقابل النصّ”، كما يرى الباحثون والمتخصصون، إذ يشاركُ في إجلاء ظواهر وخبايا النصّ الأساس، فبينهما علاقاتٌ إنعكاسية مثل الصورةِ في المرآة.
النظرةُ الأولى الى عنوان المجموعة الشعرية للشاعر العراقي يقظان الحسيني “شاهداً أردْتُ أنْ أكون” تُظهرُ لنا بجلاء هذه العلاقة الجدلية الإنعكاسية بين العنوان ومضمون المجموعة بما تحتويه من قصائد (50 قصيدة).
يهدفُ الشاعرُ باختيارهِ هذا العنوانَ الى أنْ يكشفَ لنا مع عتبةِ المجموعةِ ومدخلها: (أنّه شاهدٌ)، وليسَ بمفسّرٍ ومحلّلٍ وحاكمٍ ـ في قصائده ـ على ما رأى وشاهدَ، وعايشَ فعانى في حياته من أحداثٍ وقصصٍ وأحاسيسَ ومشاعرَ. فما هو إلا كاميرا مُلتقِطة ناقلة، تقدّمُ لنا مشاهداتِ المُصوِّر (الشاعر)، ويتركُ النظرَ الدقيقَ والمعايشة والحكمَ لنا نحن القرّاء، حتى نخرجَ بحصيلة ما رأى. وهو أيضاً بذلك يروم أنْ نعيشَ ونتفاعلَ معها. إنّه بالعتبةِ هذه (شاهداً…) يذكّرنا بمدخل ملحمة (جلجامش):
“هو الذي رأى كلَّ شيءٍ
فغنّي بذكره، يابلادي”
فهل سنغني بذكر (يقظان الحسيني) حين يُرينا ما (رأى)؟
اختار الشاعر عنوان مجموعته من إحدى قصائدها “شاهداً..” (ص 62) :
لم أكنْ أريدُ
أنْ اكونَ شاعراً
شاهداً
أردْتُ أنْ أكون
هادئاً
أواكبُ النهرَ
أمشّطُ عشبَ الضفاف
لم يردْ الحسينيّ أنْ يكونَ شاعراً بل “شاهداَ”؛ فالشاعرُ هو الباحث عن الجمال فيما يرى، أو القبح النازف قيحاً، وينقلها بباذخات الألفاظ، وجزالة الأسلوب، وجمال التعبر والتصوير، والسباحة في موج الخيال، أو يكون ملتزماً فكرياً واجتماعياً ليعبّر عن الأحداث مُصوّراً وحاكماً ومُديناً وفق موقفه الأيديولوجي والاجتماعي المُسبَق. بينما الحسينيُّ يكتبُ ليكونَ الشاهدَ الناظرَ المُبصِرَ على ما رأى ويرى، وينقلها الينا على بساط الشعر السحريّ المؤثر، وبإحساسه المرهف، ومعايشته الشعورية للأحداث والوقائع التاريخية الوطنية، أو الذاتية، ليجد الطريق الى نفوس وعقول متلقيه من الجمهور. هو لا يريد أنْ يكونَ واعظاً ومرشداً وقاضياً، بل شاهداً بصيرا.
إنّ قصائدَ الشاعر تقول لنا بالفم الشعريّ المليان: هو شاعرٌ (شاهدٌ)، لم يخرجْ في شهادته عن أصول وقوانين وخصائص الشعر في أعلى مراتبها الفنية الجمالية والبلاغية، فقد زاوجَ بإتقان فنيّ وجماليّ بين المشاهدة والشعريةِ بعناصرها واشتراطاتها الفنيّة عاليةِ الأداء، مع اختياره قصيدةَ النثر شكلاً شعرياً في دربه الإبداعي بقدرةِ ومهارة وحذاقةِ الشاعر المقتدر.
خصيصة التقديم في جملة العنوان:
استخدم الشاعر في جملة العنوان خصيصةً من خصائص الجملة العربية، وهي “تقديم ما حقُّه التأخير”، عندما لجأ الى تقديم خبر الفعل الناقص (شاهداً) على فعله العامل فيه نصباً (أكونَ)، بينما حقُّه التأخير نحوياً بحسب ترتيب الجملة العربية، إذ يقع الخبرُ بعد اسم الفعل الناقص، الضمير المستتر (أنا) في الفعل (أكونَ)، لتكونَ الجملةُ لغوياً (أردْتُ أنْ أكونَ شاهداً.)، فتحوّلتْ عنده (شاهداً أردْتُ أنْ أكونَ.) وهو بتقديمه هذا جعل (شاهداً) في صدارة الجملة، حتى قبل الفعل التام الأساس في الجملة (أردْتُ)، ليبيّن للقارئ مَطلعاً، ومن خلال عتبة العنوان، أهميةَ ودافعَ إرادته في كتابة القصائد وهي (الشهادة)، دون التدخل مفسّراً ومديناً وحاكماً لما تتضمنه من مشاهد مرّت به في حياته بحوادثها العظيمة ومعاناتهِ القاسية، ومشاعره وأحاسيسه المُرهفة، تاركاً الحُكمَ للمتلقي. فالتقديمُ هذا إشارةٌ الى عنايته واهتمامه وتخصصيه لهدف ابداعه لنصوص المجموعة، وهي من أسباب التقديم بلاغياً: “العناية والاهتمام” ، إضافة الى “التخصيص والقصر”.
تتجلّى أبرزُ شهاداته على الأحداث والوقائع التي مرّت به في حياته الحافلة بالمشاهدات والمعايشات، تتجلّى في قصيدة “مدارات” (ص 41)، التي يسردُ فيها شعرياً قصةَ زميلين له (زاهر وسلام) وقصته معهما أيامَ الدراسة في متوسطة الحلة في سبعينات القرن العشرين وما جرت من حوادثَ إبانها، مُعتمِداً على السرد الحِكائيّ في القصيدة:
زاهر من يسار القلب
لا تسكتُ ضحكتُه أبداً
ربما أحببْتُ فنونَ الكهرباء
منْ رزانة أبيه رزوقي الكهربائي
……….
نجلس في زاوية الشُعبة
سلام فاضل بجانبي
وزاهر أمامنا لا أتذكرُ من كان بجانبه
آخر مرة رأيت سلام في طابور الباص حلة ـ بغداد
…….
تودعهُ أمُهُ العلوية خارجةً توّاً من نور
آخر ما قالت وهي تودعُهُ:
يستر عليك وعلى أمة محمد
يااااه…
الوجدانُ خلايا لا تنضب
ذهب مع الريح أخذه “الأمن” لا رجعة
……
وهكذا يستمر في الحكاية شعرياً ليمرّ على ما عاناه وهو التلميذ على مقاعد الدراسة المتوسطة من ضرب وكدمات بقبضات “عادل الأسود”؟ ثم يمرُّ بأسماء مدرسين وطنيين: مدرس العربية الشاعر “شريف الزميلي”، ومدرس الجغرافية “مجيد بيعي”. هو لم يصدر حكمه على تلك الحقبة وما حملت من تجاوزات وظلم، لكنه بسرده الشعريّ قدّم لنا شهادته، وترك الحكمَ والإدانة للقارئ، رغم أنّ الشهادة بحدّ ذاتها إدانة، لكنّها غير مباشرة، حتى لا تفقد عنصرَ مشاركة المتلقي في النظر والحكم.
لقد ضمّن قصيدته هذه عنوان رواية “ذهبَ مع الريح” للكاتبة الأمريكية مارغريت ميتشل (1900 – 1949). ربما في إشارة الى الأحداث الكبيرة في الرواية (الحرب الأهلية الأمريكية) والأحداث المثيرة التي مرّت بالشخصيات الواردة أسماؤها في القصيدة:
((ذهب مع الريح أخذه “الأمن” لا رجعة))
هذه الشهادات تردُ في عددٍ من قصائد الديوان: “شُرُفات”، “سيراميك”، “مدارات”، “نبض”، بالأحداث وشخصياتها.
كما نحسُّ بها أيضاً في القصائد الوجدانية الذاتية التي يصوّرُ فيها معبّراً عن تأثيرات التجارب النابعة أيضاً من معاناة الحياة في الوطن، وما مرّ به من ظروف قاهرة دامية مثل قصيدة “يأس” التي يقول فيها (ص 14):
القشةُ التي تقعُ هنا
تصوّتُ
أستميحكَ لوناً أريدهُ
فوسادةُ البوحِ تتلوّنُ
على قارعةٍ وانعطافات
المياهُ الآسنةُ تُبقي القواربَ
بلا رعشةٍ للبدءِ
بأسىً
تتلوّى عصفورةُ الروحِ
ذبيحةُ الوجوهِ العابرة
لا مجاذيفَ لها
………
التجربةُ الذاتيةُ والأسى والألم والحسّ الجريح واضحة في القصيدة، تقول: ها أنا (يقظان الحسيني) حاملُ تباريح جرحٍ غائرٍ في الروح، يُلقي مراسيهِ (الجرح) في مينائها المزدحم بالمشاهد الصاخبة العاصفة على سواحل بحر مائج لا قرارَ له؛ من عمق ما تحملُ النفسُ، مثلَ عصفورةٍ ذبيحةٍ تبحث عن زورق نجاة بلا مجاذيف، فاسم القصيدة “يأس” يختزل هذه الشواهد الحسّية لشاعرنا في مجموعته.
المنفى:
لتجربة (المنفى) عند الحسينيّ شواخصُها الحسّية، وشواهدُها على ما عاشه الشاعر خلال حياته من ضغوط نفسية عبر ما مرّ به شخصياً، وما عاناه غيرُهُ من الشباب، وما عاشه وطنُه خلال سبعينات وثمانينات القرن المنصرم ـ فترة عنفوان صباه وشبابه ـ نتيجة قناعاتهِ الفكرية ومواقفه، وعلى وقع ناقوس الخطر المُحدِق بهم حملوا أثقالهم على أكتافهم وطناً مثقلاً بالجراح والنزيف راحلين (اختياراً إجباريّاً) مُنهَكين بهمٍّ قاسٍ، وجرحٍ غائر، مشتتين في المنفى وفي (الوطن)، لنقرأُ ما يقولُ في قصيدة “شُرُفات” ص 38:
في المنافي البعيدةِ
والقريبةِ
المُختارَةِ بعناية
والمُجبَرون عليها عنوةً
وهل دون عينيكِ من منفىً قريبْ
المُترفّهون بها
والضائعون
والذين حملوا أوجاعهم
يظنون أنها ستهدأ
يجترّون عَدَّ أصابعهم
يستحضرون ما مضى
تماثيلَ مُنهَكةً
…….
وفي المنفى ظلّوا مع أوجاعهم بلا نهايةٍ، وهم الذين حملوها من بلادهم ليستقرّوا في المنافي البعيدة أملاً بأنْ تهدأ آلامُهم وهمومُهم، لكنَهم صُدموا بأنّها قدرٌ منحوتٌ بعمقٍ لا فكاكَ منها. هي إرثهم التاريخيُّ الوطنيّ غيرُ القابلِ للمسح والإندثار. فما هي إلا حسابُ أيامٍ تمضي بنصالها المنغرزة في القلب، وذكرىً مُجترَّةٌ وعضُّ أصابعَ، ليُمسوا كالتماثيل المُنهكة من الجمود في مكانها.
فهل من شهادةٍ واخزةٍ أكثرُ من تباريح شاعرٍ منفيٍّ رغمَ إرادته وحُلُمهِ أن يكونَ آمناً مطمئناً في بلادٍ تسيّدَها منْ هو غيرُ قادرٍ على أنْ يكونَ الحاديَ القائدَ العادلَ الحكيم!
هذه الشهاداتُ القاسيةُ قساوةَ المناظر التي شهدها الشاعرُ الشاهدُ بمِنظارهِ البَصَريّ الحادِّ والبَصيريّ النافذِ الدقيق، وعينهِ الشعرية، وأنامله الصائغة الماهرةِ، وصُوَرِه اللغويةِ البلاغيةِ الحاذقة، هذه الشهادات تنقل الينا ما رأى شاعرُنا لنغنيَ ألماً ذبيحاً على وقع موسيقاها الصادمةِ. هي إرادتهُ أن تكونَ شهادةَ مَنْ رأى وعايشَ، لنرى معه نحن أيضاً بأحاسيسنا ومعايشتنا، ثمّ أحكامنا.
هذه المشاهد بسنانِ رماح حوادثها ووقائعها الدراماتيكية الفاجعة أوقعت شاعرنا في مهاوي وجعٍ لا ينضب، وألمٍ لا يسكنُ، ويأسٍ يطردُ أحلامَ الأمل لشدّةِ ما رأى ونرى، وعظمةِ الصخرةِ على صدر الوطن، وكثرةِ السيوف الطاعنةِ. قصيدةُ “يأس” المذكورة شاهدة صريحة. وكذا قصيدة “جوّالون” ص 19 :
جوّالون من ألفِ عامٍ وعام
نزاولُ لعبةً خرسى
جوّالون فجّرنا الحياة
على وسائدِ الهمِّ والنطع
وأضغاثِ الكلام
سِيّانَ إنْ بدَتْ تجري
وتحملُنا الرياح
وإنْ قذفَتْ بنا على رملٍ
نسي أهلَهُ في لُجّةِ السأم
عامٌ يتبعُه عام
جوّالون لا نرقى إلى حُلمِنا
و لا يرنو إلينا
نِمنا ونام
في صحوةِ الألمِ النديم
……
الجوَالون في المهاجرِ والمنافي البعيدة نديمُهم الألم، وأعوامُهم تمضي وتمضي في هائجاتِ السأمِ، بلا حلمٍ رفيق. إنها شهادة وصرخة المنفى، ونازلةُ القهر والظلم، وشتاتُ وطنِ ضاعَ بين هذا وذاك.
أمّا قصيدة “سُبُل” (ص 15) فنجدُ فيها إشارة الى علّةٍ من عِلَلِ اليأس الماسك بخناقِ النفس، والزاحفِ في ثنايا شِعره شاهداً:
بالجنون
غمسْنا كلَّ شيءٍ
فآثرتْنا السُبُلُ باختياراتها
أفردتْنا في زنازينها
دون إيماءةٍ منّا
أو قرارٍ خجول
شرعَتْ تبتني صروحَ أوثانها
على سفوحِ أعمارٍ
أوثقَها العتاةُ بالرهن
تسيرُ القوافلُ
وترمي بفتاتِ أيامنا
خلف متاهةٍ ليسَ لها
رأسُ نملةٍ منْ نمالِ البلاد
وهو يأكلُ منْ أحيائنا
………
الألم الجوّال في قلب شاعرنا هو البوابة المشرَعةُ على اليأس الذي تسرّبَ في نفسهِ عميقاً منْ هولِ الوقائع. يقول في قصيدة “طَرْقٌ أول” ص 17:
أسمِعْنا، أيُّها القَدَرُ، حفيفَ خُطاك
كي نعودَ الى بدايةٍ أخيرةٍ
الى وجهةٍ أُولى
نلبسُ جلوداً خشِنةً
لنرتعَ في ذاتِ الصراخِ
وذات الطَرْقِ
يا لهونِ الكلام
بين منْ فَقدوا حاسّتَهم له
منذ الولادةِ المُبكرةِ للجري
تأرَّقَ صوتُهُ
على حافات الألمِ المُتماسكة
الأمل:
بقول الشاعر مؤيد الدين الطُغُرائيّ:
أعلـِّـلُ الـنـفسَ بالآمـالِ أرقـبُـها
ما أضيقَ العيشَ لولا فسحةُ الأملِ
صدقَ الطغُرائيُّ: الأملُ قاربُ النجاةِ للنفس البشريةِ في خضمِ الموجِ المتلاطمِ للصعابِ والمشاقِّ والمعاناةِ والآلامِ المُسببةِ للقنوط والاكتئاب واليأس. لولاه لبقيَت النفسُ تتلوّى في كهوفِ الألم، بلا أفقٍ مشرقٍ. إنّه إكسيرُ الحياة، ونافذةُ القلبِ المُطلةُ على فضاءاتٍ عامرةٍ بالتفاؤل، ومُلهِمُ الشعراءِ والفنانين والمفكّرين، وعليه بُنيَتْ أعمدةُ النجاح والجمالِ والبهجةِ والحبِّ، والتقدّمِ والارتقاءِ للأمم والجماعاتِ والأفرادِ. إنّه خلّاقُ النصوصِ الفنية الراقية، والأسماء الكبيرة، وقادةِ الثوراتِ العظيمةِ على مدى التاريخ الإنسانيّ.
فهل يمخرُ شاعرُنا (يقظان الحسيني) عُبابَ الصعابِ والعواصفِ بزورقِ الأملِ الشعريّ بعد تلك القواصفِ والنوازلِ منَ الحزنِ واليأسِ وغياب الحُلُمِ خلف ضبابِ المشاهداتِ والمعايشاتِ؟
سؤالٌ تُجيبُ عنه بعضٌ من قصائدِ المجموعةِ، مثل “أشرعة” ص 11:
هي اسلحتي الساكنةُ
ورثـتُها على مهلٍ
لا فوهات لها
وخضْتُ حروبي
……….
أيصدأُ الخوف؟
أم يتمكنُ من اللحاقِ
بطيّاتِ الأجل
أنا الأبيُّ
نسجَتْ دودةُ القزِّ
حريرَ أشرعتي
يقولُ في قصيدته الذاتيّة أعلاه شاهداً لمعاناته الخاصة: أنّه هو الأبيُّ العصيُّ على الخضوعِ لنازلاتِ الألمِ الناشباتِ سنانَ رماحها في وجدانِهِ المرهفِ (حرير أشرعتي). إنّها أشرعةُ أحاسيسِهِ ومكامن نفسهِ التي خاضتْ غمارَ الهائجاتِ منَ الوقائعِ والأيام المليئةِ بما يُثقلُ كاهلَ النفسِ الحسّاسةِ في هذا العالمِ المضطربِ بالفوضى غيرِ الخلّاقةِ. هو ينتظرُ الفجرَ الجديد الحاني بأملهِ وإشراقه، وهو الذي يلتقط أوراقَه المتساقطةَ واحدةً..واحدةً.. لتلتحمَ في نفسه صَلابةً تصدُّ الرياحَ الهائجةَ. إنّه (الأملُ) مُطلّاً برأسهِ وسط الضبابِ المخيِّمِ في عالمٍ مُضطربٍ بلا أفُقٍ مرئيٍّ مضيء:
عصافيرُ مُكتظّةٌ تبوح
تنتظرُ مطلعَ فجرٍ يحنو
وأحنو ويحنو
الياسمينُ
(قصيدة “الياسمين”) ص 37
ويقولُ أيضاً في قصيدة “أبنوس” ص 45 :
لا تنحني
تلتقطُ أوراقيَ المتساقطةَ
أنا أناولُكَ إيّاها
واحدةً واحدةً
لنصُدَّ رياحاً هائجةً
لقد عثرَ شاعرُنا على (الأمل) في ثوّار انتفاضة تشرين الأول 2019 في العراق، وثورتهم الكبرى في وجهِ الفسادِ، وضياع الوطن، ومعاناة شعبٍ عريقٍ، وحضارةٍ تمتدُّ في عمق التاريخ، فكانت أبرزُ قصائدهِ فيها وفي تخليدِ شهدائها: “هتاف”، “في عيد تشرينهم”، “نبض”. لقد فجّر المنتفضون في نفسِه جمراتِ الحلم ليُشرقَ الأملُ الغافي في أعماقِه، فيرى النورَ في آخر النفق.
الرمـزيّة:
يتجهُ الشاعر (يقظان الحسيني) في فنّه الشعريّ إلى عنصر الرمز في الأسلوب والتعبير والتصوير. فالرمز من عناصر الشعر المُحدَث المتأثر بالمدارس الشعرية الغربية، وهو يطغي على الكثير من النصوص الشعرية في هذه الأيام، وكأنّه مقياسُ الشاعرية عند البعض. بعضٌ من الشعراءِ يلجأ الى الرمزية حين يريدُ النأيَ عن التعبير بلغةٍ خطابية مباشرة أو سهلة في نصّه. و هذا اللونُ من الكتابة يستوجبُ قراءةً فاحصةً (مُماطِلة)، ونظراً دقيقاً، وحسّاً قادراً على التقاط المضمونِ الكامن خلفَ الشكل. فالشاعرُ الحاذقُ الماهرُ المتمكّنُ منْ أدواتهِ الشعرية يستخدمُ هذه التقنيةَ الفنيةَ بشكلٍ لا يُسقِطُ النصَّ في التعقيدِ والغموض المُستعصيّ، وكأنّ في هذا دليلاً على الشاعرية. كلُّ القصائد قديماً وحديثاً ـ التي تُصاغُ بشاعرية كبيرةٍ ـ فيها من الرمزِ الكثير. أليسَ المجازُ والكنايةُ والاستعارةُ والتوريةُ ـ مثلما تردُ في النقد العربي القديم (البلاغة) ـ طرُقاً في القول رمزاً؟
يقولُ القاضي الجرجاني:
“ليسَ في الأرض بيتٌ من أبياتِ المعاني لقديمٍ أو مُحْدَثٍ إلا ومعناه غامض”.
ويقولُ ابنُ الأثير:
“أفخرُ الشعر ما غمُضَ فلم يُعطِكَ غرضَه إلا بعدَ مماطلةٍ منه”.
الغموضُ (الرمزية) في قولِ القدماءِ لا يعني الانغلاقَ والاستعصاءَ على مداركِ القرّاءِ، وفهمِهم، بل الجهدَ (المُماطَلة) في فهم المعنى وإدراكِهِ من خلال معايشةِ النصّ، وحذاقةِ ودقّةِ النظر فيه، واستكشافِ ظواهرهِ ودواخلِه، وبلاغة أسلوبه وصورهِ المُتخيَّلة، بالاعتماد على الثقافة الأدبية والعامة العميقةِ، والعقلِ الواعي، والإحساسِ العالي، والإلمامِ باللغة نحوِها وصَرْفِها وبلاغتِها، والعلاقةِ بينَ اللفظِ والمعنى والصُوَر. بمعنى أنَّ على القارئ أنْ يُماطلَ (يتأنّى ويُطيلَ النظرَ) ويُصارعَ النصّ حتى يحوزَ على الغرض الكامن خلفَ إبداعهِ.
عبد الستار نورعلي
آذار/مارس 2021





