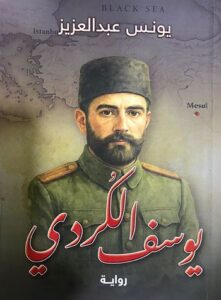ولهذا يُوصَمُ شعرُ بركات بأنه خاضعٌ لتعميةٍ (بل لتعميةٍ مطلقةٍ!) لا سبيل لتفكيكها واللعب معها، ليغدو شعرَ الشَّاعر محلَّ اتهام واستغلاق. في شذرات ثلاث من مَجْموعةِ بركات الشّهيرة: (بالشباكِ ذاتها بالثعالبِ التي تقود الريح)([ii]) ثمة محاولةٌ هنا لإبراز أنَّ التعميةَ أصلٌ في الشِّعر ولا شِعْرَ دون التباسٍ وتعميةٍ:
لنقرأ:
» هذا هو أنتَ،
أيُّها المنتفضُ تحت بروقِ الحبرِ. هذا هو أنتَ،
وقربكَ ظلٌّ سكرانُ،
ظلٌّ مما تلقيهِ الأرضُ، في غروبها، على رغيف الكائن.
(….)
هذا هو أنتَ
دأبُكَ دأبُ المؤرِّخ، لكن تؤرِّخُ المياه وحدَها.
بسيطاً تؤرِّخُ المياه. بسيطاً تغوي الحبر ليتهيّأَ الحبرُ لسباتِ الكلام،
لتبقى وحدَكَ يقظانَ في حلمِ الحروفِ، يقظان حتى آخرِ انتحارٍ للأرضِ
قربَ مرآتها.
(….)
هيا،
أحكِم الأرضَ عليكَ،
وافتح البابَ لتخطفَكَ الصّرخةْ«
تتضافرُ العلاماتُ النَّصية، لتقدِّمَ لنا كينونة الشَّاعر، وهي في مجملها علاماتٌ دالَّة على شؤون الكائن ـ الشَّاعر، ذاك الذي يفسِّرُ مكائد البياضِ بالكلمة السوداء، ويتقمَّص دورَ المؤرِّخ، ليقود الكلام إلى ضفة المحتمل، ليغدو عرّاب «الاختلاف» في تأريخه للوجود(= المياه)، حيثُ لا يمكنُ للمرء أنْ يمسكَ بالموجةِ ذاتها، وبذلك يتقمَّص الشَّاعرُ جَلَدَ هيرودوت، ويرى العالم بعيني هيرقليطيس: لا يمكنُ النزول في النهر مرتين، ذلك أنَّ الوجود لا يكفُّ عن الدّيمومةِ، ومن هنا ينهضُ التّباين بين الشَّاعر والمؤرِّخ، فالثاني مأخوذٌ بالحدث وقد اكتملَ، في حين أنَّ الأوّل يُسحَرُ بالمحتمل والممكن واللامرئي والظلال، ولهذا ينحازُ حكيمُ الإغريق أرسطو للشَّاعر ضدَّ المؤرِّخ: »أنَّ الفرقَ الحقيقي يكمن في أنَّ أحدهما يرى ما وقع، والآخر ما يمكن أن يقعَ. وعلى هذا، فإنَّ الشِّعر يكون أكثر فلسفةً من التّاريخ وأعلى قيمةً منه «، ولا غرْوَ أن ينحاز مارتن هايدغر لاحقاً، لسلفه أرسطو، إلى الشِّعر، القصيدة على نحوٍ تامٍّ:» غير أنَّ الشِّعر طريقةٌ من طرق تصميم الحقيقة المنير «، أي حقيقة الكائن والكينونة، ومن هنا تمتدُّ مسافةُ الاختلاف بين المؤرِّخ والشَّاعر الذي يوقظُ «الدَّالّ» من سلطة «المدلول»: دأبُكَ دأبُ المؤرِّخ، لكنْ تؤرِّخُ المياه وحدها. إنَّ ما يجمعُ المؤرِّخ والشَّاعر سمة (+ كتابة)، غير أنَّ الشَّاعر مؤرِّخ فيلسوف، يرى ما يراه المؤرِّخ بحدس الفيلسوف، فهو يؤرِّخُ « أثر» الحدث لا الحدث ذاته، وهكذا يقذفُ بـ «الدَّال» في هوّةٍ بلا قرار، دالّ لا يمكن لـه أن يتصالح مع ذاته أو هويته، فهويته من هوية « المياه » التي تنكرُ ذاتها في كُلِّ لحظة. وهكذا يتهيّأ الشَّاعر مسكوناً بالعالم «الأرض» لإطلاق الصّرخة ـ «القصيدة»؛ لتأتي، وتقول سرَّ الكينونةِ وحقيقتها.
هذا الاختلاف الذي يدشّنه الشَّاعرُ في علاقة اللغة بالعالم «تأريخ المياه» يمارسُهُ «سليم بركات» في هذه النَّصّيّة، لتقرنَ ثيمة الكائن المختلف بالأسلوب المغاير والمتباين، متمثِّلاً بهذه الدَّلائل (الكلمات) الشَّاردة عن مدلولاتها: بروق الحبر، إذ تتخذ «الكتابة» صورة العاصفة استعارياً فتعصفُ بالشَّاعر وهو يرصد اللامرئي، وهو إذ ينتفض تحت عواصف الكتابة يتحوَّلُ العالم بأشيائه وعناصره، وتستبدُّ به الصّيرورةُ، فيقتنصُ «الظلُّ» صورة الكائن الثملان، و «الأرض» صورتي الكائن والشّمس، ويمضي سليم بركات بمجرّة المجاز بعيداً عبر المشابهة بين «المياه» و «الحدث»: تؤرِّخ المياه وحدها، وبين «الحب » و«الأنثى»: بسيطاً تُغوي الحبر ليتهيأ الحبرُ لسبات الكلام. وفي انعطافةٍ متعمدة بإحداث الانزياح بين الدَّال والمدلول تتقمَّصُ كلماتُ: الكلام، الحروف، الأرض، سمة الكائنية لتغفو، وتحلم، وتنتحر، لينتهي النَّص بالصرخة، صرخة القصيدة، ولكن أليس العنوان: بالشِّباك ذاتها بالثَّعالب التي تقودُ الرِّيح، هو ما يتناهى إلينا من تلك الصرخة؟ كما تتجلَّى صورة أخرى «للشَّاعر» في مقطعٍ نصيٍّ موسوم بـ «العنكبوت»:
» بحلمٍ واحدٍ، وأذرع كثيرةٍ، تخيطُ الأعماق فضاءَها،
وبأذرعٍ كثيرةٍ يصلُ المساءُ قناديلَ أشباحهِ،
لكن،
هذه الشِّباكُ، التي تتخبّطُ فيها فراشاتُ الأبدِ الثقيلةُ، ليست نسجَ حكيمٍ،
بل نسجُ طاهٍ يتذوَّقُ الغيبَ كما يتذوَّقُ الحساء.
(الطهاةُ لا ينسجون الشِّباكَ
الطهاةُ ينثرون توابلهم على الذي في الشِّباكْ)
ما همَّ، كلٌّ ينسجُ خطابَهُ بالأذرع الكثيرة الهادئةِ،
والسّطورُ تتقاطعُ بالرغيف الهادئ لأجنحة الموت«..
كلٌّ ينسجُ العالم حسب مهارته، العنكبوتُ تفرزُ خيوطها، لتنسج شباكها، واللغةُ شباك الشَّاعر في اصطياد «العالم» وتصْييره قصيدة، والقصيدة نسيجٌ متكتِّمٌ، هكذا يعضدُ سياقُ النَّص هنا تأويل مفردة «الشِّباك» بمعنى «اللغة»، فيغدو «العنكبوت» من تلقاء ذاته المتكلم بأسلوب القَسَم: الشَّاعر و«الفراشات» فرائس العنكبوت، وقصائد الشَّاعر أو الشّعراء التي تتموقع في شبكة اللغة موروثاً، وما على العنكبوت (الشَّاعر) لحظتئذٍ، سوى إعادة كتابة هذه القصائد أو الموروث تطابقاً أو تماثلاً أو تضاداً، أو بلغة ابن الأثير الجزري نسخاً وسلخاً ومسخاً، فالقصائد تغفو بهناءةٍ في شبكة اللغة (الموروث)، يأتي الشّعراء (الطهاة)، ولكلٍّ توقيعه، إمضاؤه (ينثرون توابلهم)، لتكتسب القصيدة قوّةَ دفعٍ جديدةً في مسار الزّمن. إنَّهُ نسجُ الشَّاعر الذي يُحيلُ المجرد (الغيب) إلى محسوس (الحساء)، حتى يكونَ في متناول المتخيَّل، وهو نسج يتوسَّل بالصورة، بالتجسيد في صياغة اللامرئي في مواجهة نسج الحكيم الذي يتوسَّل بالمفهوم والمقولة في تسمية العالم وصياغته. يطرحُ «سليم بركات» مفهوم النص ـ النسيج، الذي تشارك أذرعٌ كثيرةٌ في نَسْجِهِ، أقلام الشّعراء السّابقين وأرواحهم، فالنَّصُّ يُطلُّ نحو الخلف والأمام في حركةٍ أبدية من النوسان هناك وهنا.
تستأثر موضوعة الكائن الشاعر (= الصّيّاد) أو المتلفِّظ بالقَسَم بمساحات نصّيّة كبيرة في الشريط اللغويّ للنّصّ، فالكائن الصياد يغدو الفاعل الريئسي للحدث الشعريّ في قصيدة «قلق في الذهب»، وسواء أكان الحدث الشعريُّ يومىء إلى لقاءٍ بالأنثى أم بالطريدة، فإنَّ المعجم الشعريّ يخدم الحدثَين، لكنْ ما شؤون الفاعل اليائس في هذين المسارين:
» ابتدعْ أيُّها اليأسُ في مهبِّكَ يأسي
وليكن قِرانٌ يُعَجِّلُ الخواتيمَ، والعرسُ نفسي«.
أو
» …فاصعدي من يقين الهباء، أو من كثيفهِ المهدومِ
اصعدي يا طرائدَ اليأسِ حتى جحيمي «.
هذا اليأسُ هو الذي يطبعُ مفردة «القنص» باستفهامٍ عنيفٍ في القصيدةِ
» أيُّ قَنْصٍ،؟ إذاً، في الشِّعاب أو في الثّواني؟
(….)
أيُّ قَنْصٍ؟ سيذرفُ الليلُ قلبي إلى الصّباح (…).
أيُّ قَنْصٍ؟ تفرُّ من سربها الأعيادُ«.
طرديةٌ تبدأ باليأسِ لتنتهي به، ويعودُ الصّياد من حيثُ أتى مخفوراً بالاستفهام خالي الوفاض:
» أيُّ قنصٍ إذاً؟ طَبْعُ هذا المكانِ رطبٌ، وطيرُهُ التّأويل
(…)
فأنا ذلكَ الشريكُ هَمَّ أنْ يُري الأرضَ مِلْكَها، وهَّمتْ
تلكُمُ الأرضُ ألاّ تريه. «.
إنَّ التّأمُّل في الشذرة الأخيرة يقودُ القراءةَ إلى التّوقف لدى مفردة «الأرض»، لكونها الموضوع المستأثر باهتمام الفاعل، فـ «الأرض» وفق خبرتنا بالعالم، دالٌّ ثري يُغَطّي مساحةً واسعةً من المعنى، لكنها ترمز هنا إلى «مملكة الأنثى» أو الطَّريدة المستهدفة بالقنص، غير أنَّ الفاعل(= الصياد + العاشق) يَفْشَلُ في الاتصال بالموضوع، وتنتهي المغامرة بالانفصال بين الفاعل والموضوع بين الذّكر والأنثى، ويتأجَّل الاكتشاف، بامتناع الموضوع عن عملية الاتصال بالفاعل. ويستثمر الشَّاعر المعجم القرآني في سورة يوسف: ] وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ[، مع استبدال المراكز، فيوسف في القصة القرآنية، يتخذُ موقع «الموضوع» وامرأة العزيز موقع «الفاعل»، في حين نجدُ في «قلق في الذّهب» تغييراً في تلك الأدوار، لكنَّ الانفصال هو سيدُ المشهد بامتياز، فهل يمكننا القول إنَّ الشَّاعر، الصياد حنث بقسمه الوثني: بالشِّباك ذاتها بالثَّعالب التي تقودُ الرِّيح، وخسر الرّهان في اقتناص الطَّريدة؟ ثمّة كينونةٌ أخرى للشّاعر نتلمَّسُها في القصيدة الأخيرة الموسومة بـ «انتقام»، لنقرأ:
» المعاطفُ كلُّها هناك.
الرِّياحُ كلُّها هناك.
الخطى الغائصةُ في الثلج، والثلجُ كلُّه هناك.
القناديلُ، والبيوتُ، والأشباحُ الأخيرةُ، كلُّها هناك.
فاجمع بيديكَ الأليفتين ما تتَّسعان من كمالٍ، واجتهدْ أنْ يكونَ المشهدُ صَداكَ الأليفَ«.
تبلورُ لنا العلامات اللغوية مشهداً مكانياً بامتياز، تشترك في تكوينه إشارات ثقافية دالَّة على الكينونة الإنسانية: المعاطف، الخطى الغائصة، القناديل، البيوت، بيديك الأليفتين، وعناصر طبيعية «الرِّياح، الثّلج» ويبئِّرُ الظرف «هناك» بتكراره الرّباعي المشهد المكاني، بمفصلته عن أمكنةٍ أخرى، بتعيين المكان وتوجيه الانتباه إليه، وبمعنى آخر، فالظرف هنا يؤدِّي وظيفةً استراتيجيةً في تنظيم الفضاء، واستقطاب انتباه المتلقيّ، إذ الإشارة إلى مكانٍ محدّدٍ تكون بغرض التّهيئةِ لحدثٍ مرتقب. إنَّ الحدث الشِّعري ـ سواءٌ أكان فاعلَ الحدث شاعراً أم صياداً، والنَّص يقبلُ التّأويلين ـ هذا الحدث يتحدّد بالحدين الآتيين: العَالم ـ الشَّاعر (تبعاً لتأويل الفاعل بالشّاعر)، وبناءً على ذلك، ينبغي على الشَّاعر أن يكون صدًى للعالم، يعكسه في كتابةٍ شفافةٍ، يتحرَّك فيه الدّال نحو مدلوله المتواضع عليه، أو أنْ يكونَ المشهدُ(العالم) صدًى للشَّاعر، أيْ أنَّ العالم يكتسب مشروعيتَهُ من الكتابة ذاتها: واجتهد أنْ يكونَ المشهدُ صَداك الأليف، ولا يتحقَّق هذا «الصدى = الكتابة» إلاّ بتفتيت العالم بعناصره وإعادة صياغته، ليرى هويته على نحو مختلفٍ ومغايرٍ. وربما تأتي نهاية القصيدةِ، لتعضد هذا التّأويل:
» كحذاءً يلتمعُ صِباغُهُ،
كمقبضِ بابٍ من نِيْكلِ:
هكذا صرختُكَ«.
لا يحفلُ «سليم بركات» بالمنطق الدّلالي السَّائد بين عناصر العالم، بقدر ما يسعى وفق رؤيته التّفكيكية إلى تقويض البنية المنطقية لعلاقة اللغة بالعالم من جهة والدَّال بالمدلول من جهةٍ أخرى، وبنينة منطقٍ دلاليٍّ مغايرٍ ومفارقٍ وغرائبيٍّ كالصورة الماثلة أمامنا، فما القاسم المشترك بين «حذاءٍ ملمّع» ومقبضٍ من نيكل» وبين الصرخة؟ فالصرخة ليست إلاَّ الصوت الخاص، أو القصيدة المختلفة، الكتابة المغايرة، التي تنزعُ إلى التّباين والاختلاف، صرخةٌ يُحْتَفى بها، كما يحتفي الكائن بأشيائِهِ الجديدة، صرخةٌ من الصلابة والمتانة بمكانٍ، لا تتأثر بحكم التّاريخ، وإنَّما مستمرة في دوِّيها الأقصى، صرخةٌ تسْتَحقُّ هذا القَسَم الوثنيَّ: بالشِّباك ذاتها بالثَّعالب التي تقودُ الرِّيح، أي باللغةِ ذاتها، بالإرادة التي تقودُ الخيال لأَصيدَنَّ العالمَ قصائد.