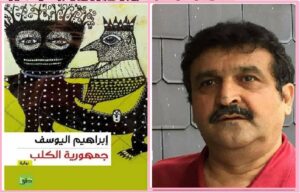محمد باقي محمد*
محمد باقي محمد* عمّا جاء في مقالة صديقنا ” عدنان كنفاني” عن قصيدة النثر، تحت بند إشكاليّة التوصيف، يقصد بذلك الردّ على ما ورد في مقالتي ” عن قصيدة النثر”، التي نشرتها الأسبوع الأدبي قبل بضعة أعداد، كدت أمتنع عن الردّ لما حملته المقالة من انفعال ينأى بنا عن الموضوعيّ، ربّما بسبب الاحتكام إلى الما قبليات، إذ ها هي النفس تُفصح عن هذا مع البدايات، التي ذهبت إلى يقيناتها غير القابلة للحوار من الأحكام القطعية، فوضعت موضوع النقاش بوثوقية الميثولوجيات في خانة” النثر العربيّ”، بشكل يسم أي حوار لاحق باللاجدوى، ليبدو كحوار طرشان بمعنى ما، ما وأد فرحاً ابتدائياً بنذير معركة ثقافية، تشبه تلك المعارك التي شهدناها زماناً، لا سيما أنّها خلت من صفة الافتعال، لكنّ الخوف من الاتهام بالعنجهية والتعالي دفعني إلى التفكّر بصوت عال، لا سيما حين تذكّرت جمهوراً عريضاً يسمع ويقرأ ويحكم!
وعليه سأتساءل باستغراب عن الدوافع اللاطية خلف انتصار كاتب قصة – أساساً – لقصيدة النثر، ووقوف قاص آخر في الطرف النقيض من ساحة القتال، ما يشي بخلل ما يحكم البدايات!
البدايات – إذن – ستستبطن الزمان، لتستنطق التاريخ في مكره، انطلاقاً من زعم مفاده أنّ الشعر العربيّ جزء عضوي من الشعر العالميّ، وأنّ علاقته بالأخير تندرج في إطار علاقة الجزء بالكلّ، بهذا المعنى فإنّني سأنظر إلى الشعر العربيّ باعتباره ابناً شرعياً – أو غير شرعيّ – للشعر الذي تواتر عن الحضارات القديمة في الشرقين الأدنى والأوسط، وذلك في تداخله – تناصاً أو مُثاقفة أو عبر حوار من نوع ما أو تأثراً وتأثيراً – بالآخر، وهذا ما ألمحت إليه في مقالي عن شعر السومريين، أو البابليين أو المصريين القدامى أو الإغريق، لأتساءل عن السبب في غياب اتهام الشعر الموزون المقفى – من قبل تلك الأقوام – بالخروج عن تقاليد الأجداد، هذا إذا وافقني الصديق عدنان كنفاني على أنّ ملحمة جلجامش – مثلاً – أو إلياذة هوميروس شعر غير مقفى أو غير موزون، وإذن فالقاعدة في الشعر لم تكن الوزن الظاهر على شكل نظم، فلماذا انقلبت الطاولة على الأسّ بهذا الشكل المذهل في تطرّفه في لاحق الوقت والأوان!؟
أمّا السؤال الثاني، فسيذهب جهات التساؤل عن سبب ظهور قصيدة التفعيلة – ثمّ ظهور قصيدة النثر- أساساً، إذا كانت قصيدة العمود تفي بالغرض! انطلاقاً مرة ثانية من أن لا شيء يأتي من فراغ، وأنّ تلك الأشكال اللاحقة إنّما كانت اعترافاً ضمنياً بعجز قصيدة العمود عن تلبية احتياجات الشعراء إلى التعبير عن هواجسهم، وإلاّ فإنّ تلك الأشكال ستتوضّع في خانة الحداثة لمُجرّد الحداثة، ممّا سيقودنا إلى تيه وضياع ما بعدهما تيه، ويوقعنا في شكلانية مُفرطة، على ألاّ يُفهم من كلامي بأنّ قصيدة العمود قد استنفذت مهامها تماماً!
ولكن أن يذهب أحدنا إلى أنّ محمود درويش إمام، فهذا قطعاً ليس وارداً، بيد أنّه – وعلى الطرف الآخر- أن ننال من مقام الكبار كدرويش أو غيره من الشعراء، وأن يفعلها أخ فلسطينيّ على وجه التحديد، فلابدّ أن يكون وراء الأكمة ما وراءها، ذلك أنّ درويش ليس أيّ شاعر، فهو شاعر، وهو ظاهرة, وهو مدرسة، حاله في ذلك حال أدونيس مثلاً!
ومع ذلك فالطامة الكبرى تكمن في أن يتطاول أحدنا على رموز تراثية، كانت قد شكّلت محطات مضيئة في مسيرة طويلة استنفذتنا، لتلقي بنا ككمّ بيولوجيّ رثّ ومُهمل- على حد تعبير الـ : د . برهان غليون – عند تخوم راهن مأزوم، وأن يطال هذا التجاوز قامة لا تدانى كالتوحيديّ، فلا أجدني قادراً على تفسير المسألة إلاّ في ضوء غياب التقاليد الثقافية، مضطراً إلى الهمس في إذن الصديق كنفاني- لا سيما عندما تُكتب ” يتحلى” بالألف الطويلة- أن ما هكذا تورد الإبل يا سيدي!
ثمّ أن نقول بأنّ قصيدة التفعيلة قد أثبتت وجودها، فهذا ثابت بالقرائن غير القابلة للدحض، على ألاّ ننسى بأن السياب توفي مريضاً وفقيراً ومنبوذاً، وأنّ الملائكة التي لم تكتف بـ ” اقتراف ” هذا الضرب من الشعر، بل حاولت أن تقعّد له أيضاً، انتهت معلمة منسية في الكويت، وأنّ الأشقاء العرب لم يغفروا لبلند الحيدري انتماءه العرقي لأكراد العراق، بعد أن طرده هؤلاء – أقصد الأكراد – من جنتهم عندما أجاب من باب الموضوعي لا المسيء عن سؤال الكردية الغائبة عن شعره، بأنّها – أي الكردية – لا تلبي حاجته إلى التعبير! هل أجرؤ- مثلاً- على القول بأنّ مجلة شعر لو قُيّض لها أصحاب يتفكرون بطريقة مُعينة، لما وجدت التفعيلة طريقها إلى الجمهور لحين، وأنّ مخاضها العسير – أساساً – كان سيطول، لا لشيء ولكن لنقرّ – من جهة أخرى – بفضل شاعر من وزن يوسف الخال شاءت الأقدار أن يكون على رأس ” شعر “!؟ وأن أذكّر بأنّ انتزاع المشروعية تأخر إلى أن جاء الرعيل الثاني من شعراء التفعيلة، ممثلاً بشعراء الأرض المحتلة، وكان محمود درويش على رأسهم، إلى جانب محمد الفيتوري من السودان الشقيق، وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي من مصر، وفايز خضور وعلي الجندي وممدوح عدوان من سورية ، والبياتي وآخرين من العراق، على سبيل التمثيل لا الحصر!
تأسيساً على ما تقدّمَ سأعفي نفسي من الإجابة على درس الكنفاني عن الشعر، ولكنّني لن أقع في النفاج، فأنكر التأثير والتأثر بين الثقافات، وسأستشهد ببوح السياب الصادق الذي يذهب جهات الإقرار بفضل ناقد ومترجم وروائي وقاص وشاعر وتشكيليّ من وزن الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا- الذي يدين له التشكيليون العراقيون بتسليط الضوء على تجربة جواد سليم وآخرين التشكيلية- في إدخاله إلى العوالم الرحيبة لـ : ت س أليوت، وسيصّح هذا لاحفاً عندما نأتي على ذكر قصيدة النثر- المنثورة.. الكريستالية – لنقرّ فقط من باب الموضوعية بتأثير شاعر كبير كوالت ويتمان، أو شاعر من وزن عزرا باوند في مجمل التجربة الشعرية العالمية، بعيداً عن تأويل رغبوي يذهب إلى أنّنا خير أمة أخرجت للناس، ذلك أنّ الامتلاء بالذات المتضخمة لن تنسيني بأنّ علاقتنا – اليوم – بالآخر هي علاقة أطراف بالمركز، إلاّ إذا كان كنفاني سينكر بأنّنا نشتغل على أدبنا اليوم بدلالة نظرية أدب غربية أنتجها رينيه ويليك، وأنّنا نقدياً نشتغل بدلالة رولان بارت مثلاً وليس بدلالة القاضي الجرجاني، ما يُعيدني إلى مقولة كان الجليل ابن خلدون يقول بها، أنّ تماهي الضعيف بالقوي هي من طبيعة الأشياء، ولا أظنّني بذلك مفارق زواريب التأصيل والبيان، حتى لو تعثرنا بنصوص كثيرة غثة في هذا المجال، فالاتهام هنا يطال النقد الذي قصّر عن مواكبة العمارة الإبداعية لغير سبب، فلم يبوّب ويرتّب ويصنّف، ولم يبعد المُتسللين وأنصاف المواهب عن الساحة الأدبية على وجه التخصيص، والفنية على وجه التعميم!
وفي الخواتيم، لم أكن أرغب في أن ألعب دور المعلم، لأبيّن للكنفاني معنى الموسيقى الداخلية لقصيدة النثر، ربّما لأنّ المسألة في مقام البساطة كالماء، ومقام الوضوح كطلقة مسدس – رياض الصالح الحسين، بسيط كالماء واضح كطلقة مسدس، الديوان الثالث – بيد أنّ الواجب يقضي بالاستجابة لرغبة صديقنا، وعليه سأنطلق من القول بأن الموسيقى أصوات أوكأها الموسيقيّ إلى مقام الهارموني، أي التناغم بالتدرج مثلاً، أو بالتضاد كما في القرار والجواب، وأنّ اللغة – أداة الشاعر الرئيسة – هي الأخرى أصوات، لكنّها – في العادي من الأحوال – لا تحتكم إلى التناغم، بيد أنّ الاشتغال عليها في هذا المستوى ممكن، كأن نشتغل على الهامس من الحروف أو الحلقي والمُفخّم ، في ائتلاف أو اختلاف قصديّ مُضمر يحدث جرساً موسيقياً، ليُحيل إلى علائق داخلية تشي بالعميق والحميم من الإحساس باللغة والالتصاق بها، لن أدعيّ بأنّها بديل عن الوزن، ولكنّها فعالة على حدّ تعبير درويش، ولا أجدني مضطراً إلى الخوض في الفيض الغنائي الدراميّ كخاصية في قصيدة النثر، أو في العتبة والتكثيف إلى حدّ التبئير كمُشترَكات بين التفعيلة وقصيدة النثر، بل والعموديّ أيضاً!
ثمّ أنّ الموضوع يتعلق بإنصاف قامات مديدة كأدونيس ومحمد الماغوط ونزيه أبو عفش وأنسي الحاج ، مع إقرارنا بأنّ الأخير ربّما أخذ حقّه من الاهتمام على حساب شاعر مهم كخليل حاوي، وهذه وجهة نظر غير قابلة للتعميم، ناهيك عن أنّها تحتمل الخطأ، تماماً كما تحتمل الصواب، ذلك أنّنا إذا بترنا المُنتج في هذا الجانب من بانوراما الشعر العربي المعاصر، لاختل المشهد الشعري، وأنكرنا على الآخرين عرقهم وجهدهم وسهرهم فيما نحن نائمون على فوات، ما اقتضى التنويه!
البدايات – إذن – ستستبطن الزمان، لتستنطق التاريخ في مكره، انطلاقاً من زعم مفاده أنّ الشعر العربيّ جزء عضوي من الشعر العالميّ، وأنّ علاقته بالأخير تندرج في إطار علاقة الجزء بالكلّ، بهذا المعنى فإنّني سأنظر إلى الشعر العربيّ باعتباره ابناً شرعياً – أو غير شرعيّ – للشعر الذي تواتر عن الحضارات القديمة في الشرقين الأدنى والأوسط، وذلك في تداخله – تناصاً أو مُثاقفة أو عبر حوار من نوع ما أو تأثراً وتأثيراً – بالآخر، وهذا ما ألمحت إليه في مقالي عن شعر السومريين، أو البابليين أو المصريين القدامى أو الإغريق، لأتساءل عن السبب في غياب اتهام الشعر الموزون المقفى – من قبل تلك الأقوام – بالخروج عن تقاليد الأجداد، هذا إذا وافقني الصديق عدنان كنفاني على أنّ ملحمة جلجامش – مثلاً – أو إلياذة هوميروس شعر غير مقفى أو غير موزون، وإذن فالقاعدة في الشعر لم تكن الوزن الظاهر على شكل نظم، فلماذا انقلبت الطاولة على الأسّ بهذا الشكل المذهل في تطرّفه في لاحق الوقت والأوان!؟
أمّا السؤال الثاني، فسيذهب جهات التساؤل عن سبب ظهور قصيدة التفعيلة – ثمّ ظهور قصيدة النثر- أساساً، إذا كانت قصيدة العمود تفي بالغرض! انطلاقاً مرة ثانية من أن لا شيء يأتي من فراغ، وأنّ تلك الأشكال اللاحقة إنّما كانت اعترافاً ضمنياً بعجز قصيدة العمود عن تلبية احتياجات الشعراء إلى التعبير عن هواجسهم، وإلاّ فإنّ تلك الأشكال ستتوضّع في خانة الحداثة لمُجرّد الحداثة، ممّا سيقودنا إلى تيه وضياع ما بعدهما تيه، ويوقعنا في شكلانية مُفرطة، على ألاّ يُفهم من كلامي بأنّ قصيدة العمود قد استنفذت مهامها تماماً!
ولكن أن يذهب أحدنا إلى أنّ محمود درويش إمام، فهذا قطعاً ليس وارداً، بيد أنّه – وعلى الطرف الآخر- أن ننال من مقام الكبار كدرويش أو غيره من الشعراء، وأن يفعلها أخ فلسطينيّ على وجه التحديد، فلابدّ أن يكون وراء الأكمة ما وراءها، ذلك أنّ درويش ليس أيّ شاعر، فهو شاعر، وهو ظاهرة, وهو مدرسة، حاله في ذلك حال أدونيس مثلاً!
ومع ذلك فالطامة الكبرى تكمن في أن يتطاول أحدنا على رموز تراثية، كانت قد شكّلت محطات مضيئة في مسيرة طويلة استنفذتنا، لتلقي بنا ككمّ بيولوجيّ رثّ ومُهمل- على حد تعبير الـ : د . برهان غليون – عند تخوم راهن مأزوم، وأن يطال هذا التجاوز قامة لا تدانى كالتوحيديّ، فلا أجدني قادراً على تفسير المسألة إلاّ في ضوء غياب التقاليد الثقافية، مضطراً إلى الهمس في إذن الصديق كنفاني- لا سيما عندما تُكتب ” يتحلى” بالألف الطويلة- أن ما هكذا تورد الإبل يا سيدي!
ثمّ أن نقول بأنّ قصيدة التفعيلة قد أثبتت وجودها، فهذا ثابت بالقرائن غير القابلة للدحض، على ألاّ ننسى بأن السياب توفي مريضاً وفقيراً ومنبوذاً، وأنّ الملائكة التي لم تكتف بـ ” اقتراف ” هذا الضرب من الشعر، بل حاولت أن تقعّد له أيضاً، انتهت معلمة منسية في الكويت، وأنّ الأشقاء العرب لم يغفروا لبلند الحيدري انتماءه العرقي لأكراد العراق، بعد أن طرده هؤلاء – أقصد الأكراد – من جنتهم عندما أجاب من باب الموضوعي لا المسيء عن سؤال الكردية الغائبة عن شعره، بأنّها – أي الكردية – لا تلبي حاجته إلى التعبير! هل أجرؤ- مثلاً- على القول بأنّ مجلة شعر لو قُيّض لها أصحاب يتفكرون بطريقة مُعينة، لما وجدت التفعيلة طريقها إلى الجمهور لحين، وأنّ مخاضها العسير – أساساً – كان سيطول، لا لشيء ولكن لنقرّ – من جهة أخرى – بفضل شاعر من وزن يوسف الخال شاءت الأقدار أن يكون على رأس ” شعر “!؟ وأن أذكّر بأنّ انتزاع المشروعية تأخر إلى أن جاء الرعيل الثاني من شعراء التفعيلة، ممثلاً بشعراء الأرض المحتلة، وكان محمود درويش على رأسهم، إلى جانب محمد الفيتوري من السودان الشقيق، وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي من مصر، وفايز خضور وعلي الجندي وممدوح عدوان من سورية ، والبياتي وآخرين من العراق، على سبيل التمثيل لا الحصر!
تأسيساً على ما تقدّمَ سأعفي نفسي من الإجابة على درس الكنفاني عن الشعر، ولكنّني لن أقع في النفاج، فأنكر التأثير والتأثر بين الثقافات، وسأستشهد ببوح السياب الصادق الذي يذهب جهات الإقرار بفضل ناقد ومترجم وروائي وقاص وشاعر وتشكيليّ من وزن الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا- الذي يدين له التشكيليون العراقيون بتسليط الضوء على تجربة جواد سليم وآخرين التشكيلية- في إدخاله إلى العوالم الرحيبة لـ : ت س أليوت، وسيصّح هذا لاحفاً عندما نأتي على ذكر قصيدة النثر- المنثورة.. الكريستالية – لنقرّ فقط من باب الموضوعية بتأثير شاعر كبير كوالت ويتمان، أو شاعر من وزن عزرا باوند في مجمل التجربة الشعرية العالمية، بعيداً عن تأويل رغبوي يذهب إلى أنّنا خير أمة أخرجت للناس، ذلك أنّ الامتلاء بالذات المتضخمة لن تنسيني بأنّ علاقتنا – اليوم – بالآخر هي علاقة أطراف بالمركز، إلاّ إذا كان كنفاني سينكر بأنّنا نشتغل على أدبنا اليوم بدلالة نظرية أدب غربية أنتجها رينيه ويليك، وأنّنا نقدياً نشتغل بدلالة رولان بارت مثلاً وليس بدلالة القاضي الجرجاني، ما يُعيدني إلى مقولة كان الجليل ابن خلدون يقول بها، أنّ تماهي الضعيف بالقوي هي من طبيعة الأشياء، ولا أظنّني بذلك مفارق زواريب التأصيل والبيان، حتى لو تعثرنا بنصوص كثيرة غثة في هذا المجال، فالاتهام هنا يطال النقد الذي قصّر عن مواكبة العمارة الإبداعية لغير سبب، فلم يبوّب ويرتّب ويصنّف، ولم يبعد المُتسللين وأنصاف المواهب عن الساحة الأدبية على وجه التخصيص، والفنية على وجه التعميم!
وفي الخواتيم، لم أكن أرغب في أن ألعب دور المعلم، لأبيّن للكنفاني معنى الموسيقى الداخلية لقصيدة النثر، ربّما لأنّ المسألة في مقام البساطة كالماء، ومقام الوضوح كطلقة مسدس – رياض الصالح الحسين، بسيط كالماء واضح كطلقة مسدس، الديوان الثالث – بيد أنّ الواجب يقضي بالاستجابة لرغبة صديقنا، وعليه سأنطلق من القول بأن الموسيقى أصوات أوكأها الموسيقيّ إلى مقام الهارموني، أي التناغم بالتدرج مثلاً، أو بالتضاد كما في القرار والجواب، وأنّ اللغة – أداة الشاعر الرئيسة – هي الأخرى أصوات، لكنّها – في العادي من الأحوال – لا تحتكم إلى التناغم، بيد أنّ الاشتغال عليها في هذا المستوى ممكن، كأن نشتغل على الهامس من الحروف أو الحلقي والمُفخّم ، في ائتلاف أو اختلاف قصديّ مُضمر يحدث جرساً موسيقياً، ليُحيل إلى علائق داخلية تشي بالعميق والحميم من الإحساس باللغة والالتصاق بها، لن أدعيّ بأنّها بديل عن الوزن، ولكنّها فعالة على حدّ تعبير درويش، ولا أجدني مضطراً إلى الخوض في الفيض الغنائي الدراميّ كخاصية في قصيدة النثر، أو في العتبة والتكثيف إلى حدّ التبئير كمُشترَكات بين التفعيلة وقصيدة النثر، بل والعموديّ أيضاً!
ثمّ أنّ الموضوع يتعلق بإنصاف قامات مديدة كأدونيس ومحمد الماغوط ونزيه أبو عفش وأنسي الحاج ، مع إقرارنا بأنّ الأخير ربّما أخذ حقّه من الاهتمام على حساب شاعر مهم كخليل حاوي، وهذه وجهة نظر غير قابلة للتعميم، ناهيك عن أنّها تحتمل الخطأ، تماماً كما تحتمل الصواب، ذلك أنّنا إذا بترنا المُنتج في هذا الجانب من بانوراما الشعر العربي المعاصر، لاختل المشهد الشعري، وأنكرنا على الآخرين عرقهم وجهدهم وسهرهم فيما نحن نائمون على فوات، ما اقتضى التنويه!