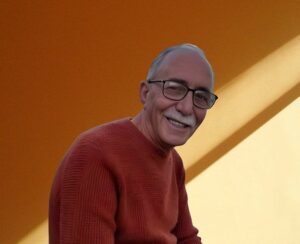كرم يوسف
كرم يوسف ورغم اختلاف الأذواق موسيقياً، إلا أنه ولابد أن يجد الإنسان ضالته في مقام موسيقي، يرتاح إليه،ويسند إليه جراحه، وهي ضرورة حيوية كالضرورة التي تحتم علي الذكر أو الأنثي أن يجد كل منهما، نصفه الآخر، الذكوري، أو الأنوثي، من العالم الذي يعيش بينه، ووسطه.
التوحد والنشوة غنائياً
في جانب الحديث عن حالات الانتشاء، و التوحد مع عوالم الأغنية، علينا أن نعود أدراجنا إلي الماضي، الحافل في كثير من جوانبه، سواء أكان شرقياً، أم غربياً، بتلك اللحظات المذهلة من العطاء، والتلقي، وأعني هنا: الجانب الطربي، علي وجه التحديد، ومن هنا، دعا الإسلام في أوائل عهده، إلي التحريم في الاستماع إلي الموسيقا، فقد قال الرسول صلي الله عليه وسلم :” من استمع إلي غانية يصبّ في أذنيه الآنك يوم القيامة ” ، حيث أنها تعد بمثابة مسكر، يقطع صلة العبد بربه، من خلال إدخاله عوالم الأغنية، وفصله عن التوحد بخالقه.
أما الموسيقا، اليوم، بغالبية أشكالها، وأطروحاتها، فماعادت تقدم في الغالب، لا لمقدمها، ولا لمتلقيها تلك اللحظات النشووية، ولعل هذا يعود إلي التأثيرات التكنولوجية التي لم تسلم الأغنية منها، حيث من الضروري مواكبتها، كما غيرها من الجوانب الإبداعية، لعصرنا ، عصر السرعة، بل للموسيقا المتعولمة.
ألا يمكن، اعتبار الرقص المرافق مع الموسيقي، و الانشداد إليه، و إطلاق كافة مشاعر الخجل أثناء الرقص، هو نوع من التوحد مع الموسيقا؟، مادمنا في مضمار الحديث عن التوحد مع الموسيقا، طبعاً، هذا من جانب المتلقي الذي يري في التفاعل الحي جسدياً، مع الموسيقا، طقساً لا شعورياً، أشبه بواجب مقدّس، يؤديه مع الموسيقا، وألا يمكن إعطاء دور للموسيقا في تلك الإيقاعات، التي يتوصل بها الصوفية، إلي مرحلة الجذب، وممارسة الضرب بالسيف، أو الرصاص، أو الخنجر، أو “السّيخ”، ويتعدي الأمر مع الهرمسيين، وتلميذهم فيثاغورث، إلي رؤية نوع من الموسيقا في حركة الأفلاك والكواكب..!.
الموسيقي دواء
أشارت دراسات كثيرة إلي أن المصريين القدماء كان يلجؤون إلي الموسيقا، كنوع من العلاج لكثير من الحالات المرضية النفسية، والتي كانوا يفسرونها ــ حين ذاك ــ بالأرواح الشريرة التي تسكن الإنسان داخلياً، فعمدوا إلي مداواة مرضاهم عبر تراتيل خاصة، لطرد تلك الأرواح ، وكانت نظرية المصريين ــ حينذاك ــ في أن الآلهة تحب الموسيقا، وحينما يعزفون لها، فإنها تساعد علي مداواة ذلك المريض، وتعدي الأمر بالفراعنة إلي إدخال الموسيقا لمستشفياتهم التي يعالج فيها المرضي، للعزف لهم، وكسب رضي الآلهة، ناهيك عن حالات مشابهة عند الكثير من الشعوب القديمة، كالصينيين واليونان، والآشوريين القدماء، والسومريين، وكذلك ابن سينا، الذي توصل إلي نتائج مماثلة، في مساعدة الموسيقا، علي شفاء المرضي.
طبعاً هذا لا يعني أن الموسيقا ــ اليوم ــ لا يمكنها تقديم أي دور علاجي، فهي تقدم دوراً علاجياً في غالبه، هو التنفيس عن المرضي، لئلا تؤدي بهم همومهم، وضغوطهم، إلي الإصابة بأمراض مثل: انخفاض ضغط الدم، والسكر، بل ولوأد أمراض أخري، أساسها الانفعال، والغضب ، وعلي الرغم من محاولة الكثير من العلماء إلي مداواة أمراض عضوية بالموسيقا، لقوة الرابطة بين النفس والجسد، إلا أن هذا الموضوع لا يزال طي المحاولات.
الموسيقي والهوّية
إذا كانت الموسيقا هي انعكاساً لكل تلك الهواجس والمشاعر التي تعتصر في قلب الإنسان، فلا شك في أن خصوصية طبيعة ــ كل مكان ــ علي وجه المعمورة، بقساوة بيئاتها، أورقتها، قد انعكست علي سايكولوجيا أبنائها، فجعلتهم يدندون بالألحان الأولي، التي تربطهم بالمكان الأنطولوجي، ومن ثم البحث عن الآلة التي تلبي حاجة تلك الدندنات، حتي أصبح اليوم معروفاً طابع موسيقا كل شعب، والأساس الذي تفرعت منه شجرة الموسيقا، هو دافع الوجود المكاني الذي أصبح ــ فيما بعد ــ حاجة، تفرض ذلك النوع من الغناء، أي أن الارتباط الطبيعي بين الموسيقا والإنسان، كان علاقة لابد لها أن تمر بالإطار المكاني، قبل أي اعتبار آخر، ومن هنا، فقد ارتبطت هوية ــ أي شعب علي وجه الأرض ــ بموسيقاه، وكأنها أصبحت معلماًُ من معالمه التي لا يمكن القفز عليها، حين تتم دراسة “نفسية” أي شعب من الشعوب، ودرجة رقته، أو عنفه، أو تسامحه، أو عدوانيته، فعبرت الموسيقا، التي هي الوجه الحقيقي للروح، عن الرّقة، أو العنف، أو التسامح، أو العدوانية، وهلمجرا…!
الجسد والأغنية
بالعودة إلي مفرزات التكنولوجيا التي حولت عصرنا هذا إلي عصر السرعة، فكان لا بد للموسيقا من أن تحث ّالخطا ــ هي أيضاً ــ لتتمكن من التماشي مع هذا العالم، الذي بدأ يسير بخطا مسرعة، نحو المجهول، المخيف ، فكان للموسيقا أن استسلمت ــ بغض النظر إن كان هذا الاستسلام طواعية أم جبرياً ــ وكان نصيبنا، نحن، أن نعيش واقع هذه الموسيقا، التي ارتبط بها الكثيرون، حتي تم إدمانها، مخرجة، أيضاً كراهية، أو طواعية، ما تبقي من نكهة طربية من قلوبنا، أو ذاكراتنا.
ولكن ، لأن هذه الموسيقا ــ وهي تعاني من صعوبة وصولها إلي قلوب مستمعها ــ كانت بحاجة إلي ما تستعين به، فاستعانت، ولكن بماذا؟ استعانت بالجسد، ولتتحول الوسيلة إلي غاية، بعدما كان الجسد وسيلة لغاية روحية ، وبدأ الجسد يقدم كمادة إغرائية، اوية، بغرض إيصال الأغنية إلي مستمعها، حيث أن التعري بات الملجأ الأوسع، والناجع، للفشل الفني، ويمكننا أن نقول: إنه يوجد ثمة تساوٍ دائم، بين درجة العري والفشل، حيث أن الفشل يستدعي حضور العري، ليحضر هو بوجه آخر، ويجبر المشاهد علي الاستماع إلي الأغنية التي يمكن الاستغناء عنها، بكتم الصوت، ومشاهدة “الفيديو كليب” وهو ما يحدث أحياناً.
في المقابل الا يعد هذا الهجوم علي التعري اجحافاً بواقع هذه الموسيقا التي باتت غير قادرة، كما ينبغي، علي جذب جمهور لها، دون الجسد، أولا يروج للكثير من المأكولات، حتي والأدوية بصورعارية؟ فلماذا لا تستعين الموسيقا ــ نفسها ــ بالجسد؟، ربما أمكنها ــ بذلك ــ إعادة الاعتبار إلي الجسد، ليس كمادة، فحسب، بل لإعطائه حقه، لا سيما وأنه كان دائماً، وبتأثير الأديان، والعادات، والتقاليد، بعامة، محظوراً ظهوره، وأيضاً: ألم يقدم الجسد ــ سابقاً ــ في الحانات، بالتوازي مع تقديم الأغنية، حيث أن الراقصات، كن إما ينشدن ويرقصن، أو يرقصن فقط، مع ألحان المغني، أي أن تقديم الجسد، مع الأغنية، ليس وليد هذه الأيام، أو ليس مفرزاً من مفرزات التكنولوجيا، فتقديم الجسد الأنثوي، لجذب الجمهور،كان له حضور منذ القدم.
إذاً، لا مناص من البحث عن الفرق بين عري اليوم، والبارحة، الذي يسوق عبر الأغنية، والضرورات التي حتمت علي كل عصر اللجوء إلي الجسد، لجذب الجمهور، وتوسيع دائرة الجذب، من جهة التوافق، نجد في كلا العصرين، ورغم كل الفروقات، نوعاً من التقديس للجسد، الأنثوي، لأنه إذا ما كان مقدساً، فما من شك في أنه لم يكن يحظي بهيبة حضوره، واللجوء إليه، كوسيلة لدرّ الأرباح من الناس، لحضور الحانات، ولجذب المشاهد إلي أغنية اليوم.
ولكن الفرق الواسع أن الجسد لم يبلغ حد الاستهلاك، وهو واقع حال التعري اليوم، الذي يقدم مع الأغنية، حيث أن تعري اليوم، يبلغ حدود الإثارة الجنسية، بأكثر من حيث التركيز، علي مواضع حساسة من جسد الأنثي، فهو ــ بهذا الشكل ــ يكون متعمداً، كما أن تعري اليوم، يفرق كثيراً عن التعري القديم، هذا إذا كان يجوز تسمية تقديم الجسد الأنثوي الراقص ــ وحده ــ مع المزيد من الحشمة ــ تعرياً، وذلك من باب التجاوز طبعاً.
ورغم كل هذا، فإن التعري، غنائياً، إن جاز التعبير، ليس ذا درجة و نمط واحد عند كل الشعوب، فكل شعب يقدم الجسد بدرجات، فالمجتمعات التي باتت توصف بالمتحضرة، تتميز بتقديمها مساحات أنثوية أكبر، من تلك المساحات التي تقدم في المجتمعات التي تحكمها العادات والتقاليد، والمدهش بحق، هو أغنية لفنانة يونانية ،حيث يتم تصوير خيانة الحبيب للفنانة، بممارسة الجنس مع فتاتين أخريين، قبل أن يندم الحبيب، ويعود للفنانة ويمارس الجنس معها كنوع من الاعتذار!
ولا مناص من القول: إنه ورغم كل المفرزات والتأثيرات التكنولوجية والحضارية، فإن الفنان الذي يقدم كغاية، بحد ذاته، فإنه لا يقدم الجسد، وهذا هو حال كافة الفنانين، سواء أكانوا يقطنون في بقاع متقدمة، أو متخلفة حضارياً، حيث أن الأغنية هي التي تقدم، وليس الجسد، وتقدم الأغنية ضمن أجواء تقديرية، لحشمة و هيبة الجسد، فتصور خيانة الحبيب، أو الحبيبة، بمشهد مقبول، بدل أن تحاول تصوير خياناتهم مع شركائهم علي الفراش ؟.
تري:.ألا يمكن ترك تصوير تلك المشاهد الخيانية على الفراش، لفيلم إباحي، والاكتفاء بتقديم إشارات خيانية، أو تصوير درجة الحب، بتقديم الجسد للحبيب، إلي فيلم إباحي، أيضاً.
والسؤال الذي يبقي مفتوحاً، ودون إجابة: كيف يمكن للموسيقا التي جعلت و تجعل الإنسان يبكي فرحاً، أو حزناً ، و التي استعملت كدواء، وارتبطت بها هويات الشعوب، أن تصل إلي هذا الحد من تقديم الإثارة، و هذا المكان، بحضور التعري فيها، بهذا الشكل الواسع…!؟