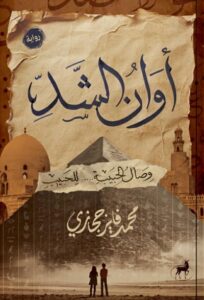فتح الله حسيني*
فتح الله حسيني*لم أكد أستيقظ من نومي المتقلب، قلقاً على الدوام، مما هو آت في غياهب زمن سخيف ممل، حتى افاقتني رنة المسج لصديق من منفانا الطوعي، السليمانية، على الموبايل، وردتني ثلاث كلمات “وفاة صلاح برواري” هو خبر مبدأه الموت وخبره الموت.
هكذا وافى الصديق العزيز صلاح برواري الأجل، الأجل المحتم، سواداً في دوائر سواد، تكلم معي صديق مشترك لكلينا من القاهرة، فقال “بكيت كثيراً على سماعي نبأ رحيل صديقنا صلاح برواري، تؤلمني غربتي كثيراً وأنا أسمع نبأً قاسياًً” فما كان مني إلا وانا أقول له، لماذا يرحل صلاح؟ وهو الذي كان وحيداً طوال عهده، لماذا أتى به خالقه وحيداً الى الوجود، ويأخذه وهو لا أحد له إلا حفنة جميلة من الأصدقاء المبعثرين في مذابح الله وأركانه، وحدائقه، وموانئه وشطئانه التي تأكل أجساد أبناءه الطيعين واللاطيعين.
عرفت الصديق الراحل، صلاح برواري أول مرة في مدينة القامشلي، في بداية تسعينيات القرن الماضي، أوان الصخب الأدبي، الطازخ، أبان صدور مجلة “زانين” للصحفي عبدالباقي حسيني وصديقنا الراحل أيضاً الصحفي والشاعر فرهاد جلبي، كان برواري منفذاً قويأ للدوريات الكردية في زحمة مطابع دمشق وهي تستقبل أرواحنا غير المرخصة وصفحاتنا المحظورة، كان برواري، الراحل الآن، مؤازر الكتاب الكورد في كل شئ طباعة وتسهيلاً وتوصيلاً، ثم انتبهنا أنه علينا أن نكون في العاصمة، بعد خفوت صوتنا في القامشلي، وإخفاقنا في تحقيق جزء من الحلم الأدبي، فما كان من بد إلا الاتصال ببرواري، الملبي دائماً، تاركاً مكتبه ومشاغله الكثيرة، للقائنا إما في مكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني أو في أي نادي أو مقهى دمشقي كمحطة للسفر الى صخب بيروت، أو المجئ من بيروت، الى حيث صلاح برواري ودمشق مستقرة.
لم أعِ قط، أني سأكتب عن الراحلين من الأصدقاء تباعاً، وهم ينطوون قسراً تحت رايات الموت والفناء، تلك الرايات المعذبة للنفس البشرية.
فأي موت هذا الذي يتربص بكل هذه الأرواح الجميلة؟
وأية مقابر ستحتضن أجساداً غير هادئة بعد كل هذا وذاك التعب؟.
قبل سفره الأخير الى دمشق، منطلقاً من مدينة السليمانية، كانت لنا آخر زيارة الى غاليري “سردم” الذي كان يحتضن، آنذاك، معرضاً للفنان الكوردي السوري المغترب بهرام حاجو، وهناك اجتمعنا ثلاثة، مغتربين في كل شئ، أنا وصلاح برواري وخالد سليمان، نوزع اللوحات على مشيئتنا، ننظر الى بعضها على عجل، ثم نبطئ في التأمل في لوحات أخرى، كانت تأخذنا أصوات النساء الكثيرة من حولنا، نستهدي بها، ثم نعقل قليلاً، لمحنا “كاوه” الذي كان يجول بكاميرا الغاليري ذهاباً وإياباً باحثاً عن لقطات جميلة ضمن حركة المعرض، فغمزناه لأخذ صورة للذكرى عسى أن تنفعنا الذكرى، يوماً، صورة فوتوغرافية واحدة، كانت جامعة لتأمل برواري وعيناي اللتان تنفران من الكاميرا وعينا خالد سليمان اللتان كانتا مسرروتان لفلاش الكاميرا، صورة سريعة أخذها كاوه، وذهب الى جولته في الصالة، سافر برواري، الى دمشق، لتأتنا أخباره منه بالذات دون غيره، وهو المتألم، يطمئننا عن صحته المتدهورة كحياة المناضلين القدامى، ننزعج لما ألمّ به، وهو يقول بسيطة، يا شباب أنه مرض وسيمضي، يتحدث عن مرضه كأنه يتحدث عن مشوار عابر في شارع كبير في السليمانية أو في دمشق.
آه من دمشق، ها هي تأخذ جنازته المضمخة بدموع الأصدقاء الى عفرين، وتظل روحه تتلألأ بين دمشق وعفرين كأنه آخر الوارثين لحزن الحياة.
روح أخرى، مضت هكذا الى فنائها.
تاريخ عابر سيدونه الأصدقاء برحيل أحد أهم المترجمين والمؤرخين لتاريخ القادة.
سنوات كثيرة تلزم الأصدقاء لتكون روح برواري في متن الماضي.
سلاماً أيها الصديق..
حزنتُ لوحدتك في الوجود، وحزنت أكثر لوداعك الأخير، وحيداً في عتبات الوجود الأخيرة.
لم أعِ قط، أني سأكتب عن الراحلين من الأصدقاء تباعاً، وهم ينطوون قسراً تحت رايات الموت والفناء، تلك الرايات المعذبة للنفس البشرية.
فأي موت هذا الذي يتربص بكل هذه الأرواح الجميلة؟
وأية مقابر ستحتضن أجساداً غير هادئة بعد كل هذا وذاك التعب؟.
قبل سفره الأخير الى دمشق، منطلقاً من مدينة السليمانية، كانت لنا آخر زيارة الى غاليري “سردم” الذي كان يحتضن، آنذاك، معرضاً للفنان الكوردي السوري المغترب بهرام حاجو، وهناك اجتمعنا ثلاثة، مغتربين في كل شئ، أنا وصلاح برواري وخالد سليمان، نوزع اللوحات على مشيئتنا، ننظر الى بعضها على عجل، ثم نبطئ في التأمل في لوحات أخرى، كانت تأخذنا أصوات النساء الكثيرة من حولنا، نستهدي بها، ثم نعقل قليلاً، لمحنا “كاوه” الذي كان يجول بكاميرا الغاليري ذهاباً وإياباً باحثاً عن لقطات جميلة ضمن حركة المعرض، فغمزناه لأخذ صورة للذكرى عسى أن تنفعنا الذكرى، يوماً، صورة فوتوغرافية واحدة، كانت جامعة لتأمل برواري وعيناي اللتان تنفران من الكاميرا وعينا خالد سليمان اللتان كانتا مسرروتان لفلاش الكاميرا، صورة سريعة أخذها كاوه، وذهب الى جولته في الصالة، سافر برواري، الى دمشق، لتأتنا أخباره منه بالذات دون غيره، وهو المتألم، يطمئننا عن صحته المتدهورة كحياة المناضلين القدامى، ننزعج لما ألمّ به، وهو يقول بسيطة، يا شباب أنه مرض وسيمضي، يتحدث عن مرضه كأنه يتحدث عن مشوار عابر في شارع كبير في السليمانية أو في دمشق.
آه من دمشق، ها هي تأخذ جنازته المضمخة بدموع الأصدقاء الى عفرين، وتظل روحه تتلألأ بين دمشق وعفرين كأنه آخر الوارثين لحزن الحياة.
روح أخرى، مضت هكذا الى فنائها.
تاريخ عابر سيدونه الأصدقاء برحيل أحد أهم المترجمين والمؤرخين لتاريخ القادة.
سنوات كثيرة تلزم الأصدقاء لتكون روح برواري في متن الماضي.
سلاماً أيها الصديق..
حزنتُ لوحدتك في الوجود، وحزنت أكثر لوداعك الأخير، وحيداً في عتبات الوجود الأخيرة.
*نائب رئيس تحرير أسبوعية “الأمل” السليمانية