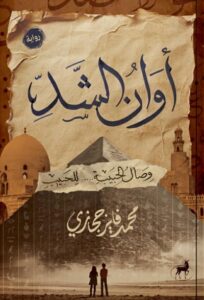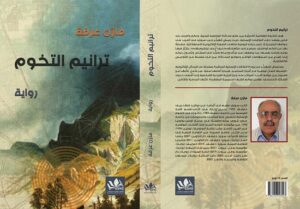إبراهيم محمود
إبراهيم محمودأي مدخل يمكن أن يعدنا بالأنسب في هذه المقاربة السريعة لـ”غبار البراري”..؟
صحبةَ المبنى والمعنى
إنها لإشكالية كبرى، تلك التي تسمّي حالة التجاذب بين المبنى والمعنى، بين ما يكونُه القول في السرد، وما يكوّنه السرد دلالياً في بنية القول، ربما هو تدافع التصورات وحدود رهانات متخيَّل الكاتب وما يثيره تموقعه زمكانياً!
لعلّي مؤثِر هذا التحليق بالصور المركَّبة لغوياً ومقامات الذائقة الأدبية، نظراً لوجود محفّز فني يهجس بها، وهو
يتكشَّف أمامي وأنا في الأثر المرئي في المجموعة، ما يضفي عليها طابعاً من الحداثة المغامرة في القص أساساً!
ثمة استمرارية في الكتابة المقطَّعة، من خلا ل المزج بين النثري والشعري، بين حضور الآخر بتشكيلاته القيمية أو حالات وروده كافة، وغياب مشهد الدال الفعلي على هذا الآخر نظراً لوجود معوقات تحول دون تجلّي موقعه كما هو مستحقه، استمرارية تصل هذه المجموعة بسابقتها، وقبل سنوات سبع (وغاب وجهها)، إذ إن لدينا تناصاً في العلاقات وتتبع الأثر لشخصيات آثرت أن تتقاسم بطولات المعنى وتقصّي الحقيقة الآلمة واقعياً، من خلال مفهوم (الغياب- الغربة، الاغتراب، الاحتفاء الضمني بالألم الوامض للمعنى..)، وأنا أشير هنا إلى (هدية إيفا- غاب وجهها- شهقة فجر…الخ)، وهي تتمازج، بقدر ما تتصادى مع( شعرت أن الثلج يسقط- الباز واختيار الباشا- غبار البراري…الخ)، كما لو أن ميثاقاً من ذات الأبدية جار ٍ العمل بموجبه في عقد هذه التحالفات في تحرّي مؤثرات الموت وفولكلوريات أحداثه وطرق أرشفته في الذاكرة، وتوضعات الطفولة، ومرايا الذات الواحدة وقد تفاوتت صور الهوية الشخصية ومرتجعاتها من المعيش اليومي، والملتقط من سقط متاعه…
يحدث هذا من خلال الاستئثار بعامل الإحالات الزمنية، والتنقلات على تخوم الومضات التي تفجرها أو تجلوها قائمة التباينات بين فعلية الجملة وتركيبتها وتلك التي تليها أو تكون السابقة عليها، ولعلها السمة الضالعة في تبين هذا النوع من السرد المتعلق بالقهر اللماح، واستشرافه ذاكرة ضاجة بخطوط التواصل بين الأزمنة، أو ترانزيت الإحالات ومرجعيتها، حيث تنتفي الهدأة، ويكون السارد الكلامي حامل مصائر تترى لمجمل شخوصه.
يتأكد ذلك، بمعنى ما، في الشعور بالانمساخ وهو شعور لم يستولده الفاعل الأدبي إلا جرَّاء انضغاط استلاب أو تُمرئي سطوة واقع لا يملك القاص إلى كيفية التعامل معها سبيلاً، كما في (أصبحت نملة)، وهو الشعور الذي يحيل كائناً حيوانياً متناهي الصغر نسبياً مقارنة بحيوانات أخرى، من حالة الدأب واستثمار الزمن في تأكيد بهائمية النملة، كما هو المتعارف عليه نملياً، تعبيراً عن مضاعف قهري وفي زمن لا يطول يأتينا النبأ( تحسست وجهي، بأناملي…هل أصبحت نملة…. يا إلهي! لقد أصبحت نملة..ص9)، إنها جمل اقتطعتُها من بداية القصة، إفصاحاً عن عري الكائن وتعرية المعيش اليومي، و(حشرات تشبه الملائكة)، عندما ينقلب العداء إلى ألفة، ومع عالم الصراصير، وميزة هذا الكائن في إتلاف الوسط المغاير (باتت هذه الحشرات أليفة أكثر من أي شيء آخر..ص102)، تكون (أكثر من أي شيء آخر) متعدية لمفهوم الود، إنها شارة فقدان المعنى في وسط مجتمعي موسوم بنظام قيمي، بسيطرة القيم الأحادية الجانب وإيغالها في العسف وتفتيت المجتمع وإقلاق راحته.
أو حين يكون الاسم ذاته جلاب لعنة مميتة ليس لشخص معين، إنما لكل من يحمل الاسم نفسه، في (لعنة الاسم)، ويكون القضاء على الاسم بمثابة انتصار للوطن الذي ينتسب إلى القائد (قهقه ذو الكتف المزخرف بالنجوم، ثم هتف: عاش الوطن للقائد..ص 16)، وحين يزداد ضغط الشعور النفسي بالانسحاق، كما في (ن يشنق ظلي؟)، وما يعنيه أن يفقد الإنسان ظله، وأي شعور باللاشيئية تعرّف به، وذلك التداخل بين فقد حبيب هو الأخ أو من في مرتبته، وما هو مفقود من محفّز اعتباري، كما في (شعرت أن الثلج يسقط)، وما هو أكثر كارثية في المنحى الذي يجرد المرء من صلاحيته ككائن إنسي، كما في (رقم في القطيع)، ووطأة الأهلية وشغف العائلة والأحبة في النطاق العائلي، حيث تكون قسوة الغربة دافعاً متنامياً في جعل الذاكرة ميمّمة وجهها شطر ما كان، أو ما من شأنه وضع حد لهذا الانشطار الذرّي، كما في (غبار البراري)، لحظة معايشة الوجه الحبيب والراحل وحضوره الآسر في حمَى الذات (ما زال قلبي على كف القلق، وما زال توقيعي البليد على وثيقة سفرها يتألم لغيابها عشر سنوات..ص96)، وحين يسهم القهر في التعبير عن روافده، كما في (أنفاس مخنوقة)، وتكون الذات في موقع البطل متعدد الجغرافيات والتواريخ والأصداء، إن استعنَّا بحقيقة الذاكرة المسكونة بمأسوية ماض لا تفارقه، حيث تكون الأم، كما تكون البنت في عمر الوردة، والأخ العصي على النسيان في موقع محفزات الألم (أحرقت ثلاثين زهرة من الزمن لاهثاً وراء الأمنيات، فارتبطت أمنياتي برصيف الغربة. وأمنياتك برصاصة الحيرة.ص106).
أحسب أن رسول يتقدم بتعريف قاص، بينما في قرارة نفسه يستهويه شاعر على ولاء تام لمتخيله الشعري، أو ما يندرج في خانة الصور الشعرية والتقليل من شأن الحدث، كما لو أن النثر كنف حاضر، والشعر متحلق خيال سابر في الأزمنة، ربما هي استراتيجيا التعبير عن واقع لا يطاق، واحتجاج على نثر اليومي، واحتفاء بشعرية المفقود وجمالية السرد غير المتاح لأي كان، وما هو ممكن تحقيقه في لا محدودية الشعري، عندما يتفجر السرد القصصي، إذا مضينا الظاهراتي متعدد المواهب بول ريكور، وما يقوله في كتابه( الزمان والسرد” التصوير في السرد القصصي”، ترجمة: فلاح رحيم، دار الكتاب الجديد،ط1/ 2006، ج2)، وجمالية الممكن (إذ في السرد القصصي فقط يضاعف صانع الحبكات الالتواءات التي تسمح بإقامة تقسيم إلى زمن يستغرقه السرد وزمن الأشياء التي تُسرد، وهو تقسيم يدشنه نفسه التفاعل بين التلفيظ والتقرير في سياق السرد. ص262).
ويمكن إيراد بعض من هذا المستهوى شعرياً عند رسول تأكيداً على فعل الهجنة في الكتابة القصصية (تقودني مساحات من الألم…ص11- فضجت بهم عتمة العفونة تحت الأرض.ص15- شعرها من حزن الليل.ص20- نسيج من الرغبة في غليانها الهائج…ص 22- تبسمت الطبيعة الحيرى..ص44- كف القلق.ص93- فروسية الفرح.ص96- فدمع قلبه..ص105…الخ)
ثمة سيولة كاملة من الأمثلة ذات الصلة بالموضوعة، تمثل رصيداً فاعلاً في خلق شقاق ما بين المرتكز النثري، إذ الحدث يتابع سرديته القصصية، وفي المتعالي الشعري، حيث نابض المتخيل النفاث يقود إلى اللاحدثي، وبين المتواليتين تمارس القصة حيوية حضورها على الورق، بما ينبئ عن تلذذ ذات كاتبة وقدرتها على تنويع المعنى.
العتبات: الحلبات
أثرت العنوان الفرعي، بنوع من التقابل الكيدي، انطلاقاً من رغبة حافة بمكونات عالم صبري رسول الفنية، إذ إن مفهوم (عتبات: بدءاً من العنوان، الغلاف، دار النشر، طريقة الكتابة، الإهداء.. وانتهاء بالبياض المسرَّح أو المتروك وفراغات تجلو الصفحات…الخ)، لا يبدو أن القاص في حل مما يمضي به ويمضي عليه، إنما يعيش كتابته، بقدر ما تمارس الكتابة نوعاً من لقيا الذات الخفية، ومعاينة الآخر المتنوع فيه، وأي” رسول” يتشكل في جماع قصصه، كونه المرجع في كل قصة، والمندمج فيها، ومحط كل سؤال عنها.ذلكُم وضع تنازعي إجمالاً!
الإهداء في المجموعتين يكون إلى أم القاص، مع فارق التعبير، إذ يكون البحر مدخلاً لتبين العلاقة بينهما، بينما تكون في الثانية (زهرات اللوتس). إنما أيضاً مع فارق يؤوَّل دلالياً أو في سياق اللاشعور، عندما يوضع في نهاية كلمة الإهداء في (غاب وجهها) اسم القاص” صبري”، بينما ينتفي ذلك في الثانية، إضافة إلى الترتيب، حيث يكون الإهداء في وسط الصفحة في الأولى،، بينما يضاف حرف الجر في الثانية، مع وضع نقطتين إشارة إلى المهدى، وما في ذلك من انزياح معان أو دلالات، لعله صراع المعنى الواحد مع نسخه أو أشباهه، ومدى التجاذب بين المعنى الذي يتحرك في ذات القاص، والتعبير الذي يطلب استقراراً جملياً يوقف سيلان فعل المعنى، بقدر ما يمارس تأطيراً له، وبالتالي يكون كل تنويه إلى المغيَّب الدلالي ضرباً من مغامرة تأويلية.
بالنسبة للقصص الواردة، وهي خمس عشرة قصة، ليس من ترتيب تبعاً للزمن، إنما هو اختلاف، أي تقديم وتأخير، ولا يمكن الجزم بحقيقة ثابتة أو مثبتة تكاشف مقصد القاص، سوى أن ذلك يدفع إلى المزيد من الظنون أو التأويل، ومن ثم مضاعفة الجهد في الربط، لأن القصة التالية هي التي تكون في محمية تأثرية ما للسابقة عليها. أي من جهة التناص وما يخص جانب التشابه، مثلاً بين الأولى وما قبل الأخيرة، كما ذكرنا ذلك سابقاً، إذ إن (حشرات تشبه الملائكة) والبعد الدلالي فيها بعمق، تتقدم زمنياً وولادة من خلال التأريخ (أصبحت نملة).
بقدر ما تتفجر أسئلة عن هذا التسلطن للاسم أو الجملة الاسمية في العنوان مقابل الفعلية، حيث نجد لدينا عنوانان فقط، في نطاق (الجملة الفعلية)، وهذه” الإسمنة: من الاسم” إن جاز التعبير، يستشرف عنف واقع والموقف من التغيير فيه، ويكون لكل عنوان مقامه في توليد المعنى المتناسب وصياغته (لعنة الاسم- لؤلؤة ضائعة- الجرح الغامض- غبار البراري- أنفاس مخنوقة…الخ)، كما لو أن ثمة شاهد عيان في الخلف يصرّح بجمود الاسم وطغيان أثره.
ثمة جانب آخر في بنية العنوان، وهو المتعلق بمفهوم التأريخ، كما نوهَّت سابقاً، إذ نجد قصصاً مؤرخة، ومؤرخة جزئياً، وغير المؤرخة إلا جزئياً هي (من يشنق ظلي؟- شعرت أن الثلج يسقط- الباز واختيار الباشا..) وكما جاءت في الترتيب داخل المجموعة، إذ انتفى اليوم، بينما (أنفاس مخنوقة) فمؤرخة بالسنة فقط”2000″.
يضاف إلى ذلك الاعتماد على حرف الجر في بعض الحالات وعدم وجودها في حالات أخرى، مثلاً، في (أصبحت نملة)، يأتي التأريخ هكذا” جدة في 20/9/2005″، بينما في قصص أخرى لا وجود لحرف الجر، مثلاً، في (صور في العتمة) يأتي التأريخ هكذا” قامشلي 28/11/2005″، وما لا تأريخ لها (الجرح الغامض- خلف شجرة التوت)، وما على القارئ أو الناقد إلا أن يمارس قراءة محيطية لمجتمع الكاتب، ويسعى جاهداً إلى القبض على معنى متوار خلف في قصته هذه أو تلك، والعامل الرمزي الذي أحال دون التأريخ فعلاً!.
في الظلال المتقطعة
أتوقف هنا عند جانب الاهتمام باللغة، وكيف أن القاص، وهو في غمرة انشغاله بجريان أحداث قصصه، وسريان فعلها الذاتي، أو ما ينتمي إلى الذائقة التصورية للمعنى، تكون اللغة ، وفي أكثر من مكان، غير مهتَمٍّ بها، ومن جهة التوصيف الذي يظهر أنه لم ينل حظه من العناية والرعاية كما ينبغي، ورغم أن العثرات أو الأخطاء الحاصلة لا تشير إلى ضعف لغوي لديه، كما تقول أبنية قصصه وكيفية صوغها نحوياً، إنما هي شغف الذهني والوجداني وليس اللغوي وسطوة القواعدي ونفاذ فعله الدامي أحياناً.
في (أصبحت نملة)، يتأمل الممسوخ، وهو السارد القصصي، حجمه وشكله في المرآة، ويقول( يا إلهي ما أقذر هذا الحجم! ص 11)، حيث أرى أن مفردة (أقذر) لا تتناسب والحكم القيمي، إنما (أحقر)، انطلاقاً من الموقع الدوني الذي وجد نفسه فيه، اللهم إذا أضفى على النملة بعداً أخلاقياً: رجسياً أو نجسياً، هي في الواقع ليست كذلك!
(والارتياد إلى الأسواق. ص11)، يكون الصحيح (فارتياد الأسواق)، و(حصلي لي.ص12)، هي( حصل لي)،
عندما قضي ساعات… أشعر..ص21)، والصحيح في السياق( شعرت)، وسنة (200، ص 23) هي (سنة 2000)، أو غيرها،و( بلاط الغرفة لامعة أنيقة.ص27)، تكون (لامعاً أنيقاً)، و(كنا نحن الثلاث.ص29)، تكون (كنا نحن الثلاثة.).
وفي قصة (الباز واختيار الباشا)، نقرأ (الطائر) تارة، و(الطير) تارة أخرى، ولا بد من وحدة الاسم في ذلك.
وبالنسبة للقدمين( ولم يعلم أأكلتها أم تضاءلتا بفعل كثافتها.ص58)، والصحيح (أأكلتهما)، و(أزيز الرصاص تخرق.ص66)، والصحيح (وأزيز الرصاص يخرق)، و(بعد إن سقطت.ص82)، تكون (بعد أن سقطت)، و(الأحمر الدكن.ص89)، هي( الأحمر الداكن).
في قصة (من يشنق ظلي؟)، ثمة اضطراب في المعنى بسبب التداخل بين توصيفين لمشهد تخيلي لدى القاص، عندما نقرأ( أنظر إلى قلبي المشنوق هناك والمتدلي من حبل غير مرئي وسط السقف…ص27)، ثم ينظر إليه هو، وقلبه ينزف، وقد مارس فيه طعناً بالسكين” ص28-29″.
إن وجه الخطأ هو أن القلب المشنوق يعني الموت، وتجمد الدم، بينما يظهر السارد القصصي ناظراً إليه، كما لو أنه حي يخفق وهو يطعنه بسكينه، لينزف دماً، وأعتقد أن ثمة عدم تركيز كان وراء هذا الخلط أو عدم التدقيق في حالتين، لكل حالة مسار تصوري ودلالي مختلف عن الأخرى.
هل نعود إلى البعد القهري الذي يتملك على القاص أحياناً وعيه المطلوب في التركيز والربط بين نقاط استناد للقصة هذه أو تلك؟ أنقول إن سردية القهر أوصلت إلينا داءها التاريخي، بقدر ما أعلمتنا بعنفها الوالغ في اللاشعور، كما هو الأثر الذي يُتحرَّى لحظة قراءة مجموعة (غبار البراري) لصبري رسول؟
أعتقد أن ثمة برار ٍ تشدنا إليها، أو تدعونا إليها، ونحن ننفض الغبار عنها، كما هي العثرات التي توقفنا عندها، باعتبارها غباراً من نوع آخر، تبقي براريه ماضية في بسط فضائها وباعتبارها لسان حال طبيعة تستحق المعايشة، وأن ظهور طبعة ثانية يقرّبنا أكثر من بهاء البراري هذه، وجلاء جماليات المعنى في جنباتها!
———-
ملاحظة: بعضٌ مما ورد في سياق المقال، ارتجلته في ندوة أدبية أقيمت حول المجموعة القصصية (غبار البراري)، في بيت الصديق القاص صبري رسول، في حي” البشيرية- قامشلي” بتاريخ17 آب2011، وبحضور لفيف من الأصدقاء وأهل الأدب في المنطقة.