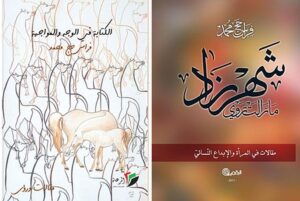محمد قاسم ” ابن الجزيرة “
محمد قاسم ” ابن الجزيرة “m.qibnjezire@hotmail.com
يبدو لي أن البحث يبدأ دائما من نقطة “معرفة الذات”. وكان سقراط، الفيلسوف اليوناني المعروف قد أعلنها حكمة تتردد في كل مناسبة تستوجبها ” اعرف نفسك بنفسك” ويقال انه استوحاها من شعار مكتوب على باب معبد دلف في أثينا… واتبع ديكارت الفرنسي ما سمي بـ”الكوجيتو” انطلاقا للمعرفة وإدراك الحياة وما فيها، كما انتهج أبو حامد الغزالي الشك الحقيقي عندما هرب من المدرسة النظامية بحثا عن الحقيقة لمدة زادت عن الشهرين قبل أن يعود الى بغداد ويعلن منهجه الصوفي الذي يعتمد الإيمان والإلهام في معرفة الحقيقة.
فإذا كنا قد حاولنا تصنيف الأولويات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما سبق في المقدمة والأجزاء السابقة، فبدا لنا أن الأولويات في الحراك الإنساني … يمكن تصنيفها كالتالي بشكل سريع :
– الأولوية الأولى هي: البحث عن الذات، ومعرفتها في كل مكوناتها الأساسية، العقل..النفس..الغرائز.. الميول..الرغبات..العواطف…الإرادة…المؤثرات الاجتماعية المختلفة ومنها التربوية، والضغط الاجتماعي….الخ.
لنقل، مجمل الثقافة المتكونة في لحظة تاريخية معينة.
– الأولوية الثانية هي: البحث عن الكيفية التي ينبغي أن نعيشها…
– الأولوية الثالثة هي: البحث في الغايات والأهداف التي نسعى لتحقيقها، ومشروعيتها وفقا لمعايير نتعرف عليها في سياق البحث عن الذات، خاصة في صلتها الاجتماعية-ومنها الخصلة – أو الخصال – الأخلاقية (بمعناها العام–الايجابي والسلبي معا، كما تعتمد الفلسفة نهج تعريفها ودراستها).
بخلاف الفهم الشائع اجتماعيا-أو شعبيا- وهو البعد الايجابي فحسب. وهذه قضية معرفية ذات طابع فلسفي كما هو واضح.
– وتأتي الأولوية الأخرى-الرابعة– وهي: السعي إلى تحسين كل ما يتعلق بحيوية ونشاط وأداء الإنسان …ربما هذا هو المنحى الجمالي في حياة الإنسان نظريا وميدانيا…
ويمكن تفكيك هذه الأولويات، فنستنبط أولويات أخرى متفرعة عنها، لكننا- كما قلنا –منذ البداية- نكتب مقالا في أجزاء صغيرة، لا تتيح لنا الاسترسال كثيرا، لذا سنبقى في حدود الأولويات الأربعة الرئيسة هذه، والتي حددناها، ونحاول –خلال البحث أن نذكّر –أو نشير الى أفكار قد تبدو لنا ذات علاقة -أو مكان- في السياق…ودون الإدعاء بأنها التصنيف النهائي لها…وإنما هي محاولة مني وفقا لمنهجي المتواضع – وربما القاصر – في الفهم والتفكير …!
في الجزء الثالث ذكرنا التشوه في التفكير والسلوك لدى بعض الأشخاص والجماعات –بغض النظر عن تسميتها وتصنيفها- أو في الممارسة عموما، لا سيما في قضايا ذات صلة بإدارة- وإرادة- الشعوب والمجتمعات، وتسمى -عادة -الحكم –أو الإدارة السياسية، أو القيادة، أو الزعامة ..الخ؛ في اللغة العربية.
كل هذه الكلمات تشير الى البعد السياسي – أي ما يمكن تسميته بالوظيفة العليا -أو الأعلى– في المجتمع.إنها وظيفة ضرورية اجتماعيا،وبحسب الدراسات الواقعية لأنماط الحياة الاجتماعية؛ منذ بدء وجودها، ابتكرها الإنسان، وهي-خلاصة هذه الدراسات- قابلة دائما لإعادة النظر فيها؛ كلما تم اكتشاف ما يؤثر على مصداقيتها في شكل ما.وهذا نهج علمي لا يجادل فيه إلا بعض الأيديولوجيين الذين يخلطون بين الفلسفة والعلم والسياسة- وعن عمد، وسبق إصرار، لغاية في نفس يعقوب- كوظيفة اجتماعية – السياسة- مؤثرة، وفاعلة، ومهيمنة على المجتمعات ومقدراتها –خيراتها- لمن امتلك قوة إدارتها.
للأسف بعض الأيديولوجيين يمارس هذا النهج باسم المحتاجين والفقراء والكادحين، وهذا نهج سياسي يهدف لمصلحتهم ، ويؤثر سلبا –من الناحية الأخلاقية-على طبيعة العلاقات الاجتماعية بمعناها العام.
في الواقع هؤلاء المحتاجون والفقراء والكادحون…هم الذين يدفعون ضريبتها السلبية؛ عبر مجموعة من الأمور منها، فقدان الحرية الشخصية، وحرية النمو طبيعيا، والقدرة على المشاركة الحية انطلاقا من واقع ما يفهمون ويرغبون به، ويحقق مصالحهم، وذلك لقاء فتات من الأموال أو الوظائف التي “لا تغني ولا تسمن من جوع” فيوقّعون –عن جهل –صك عبودية تلزمهم طوال الحياة بالتصفيق والهتاف بشعارات –أحيانا –لا يعرفون لماذا يرددونها سوى الخوف من المحاسبة، أو الحرمان من بعض هذا الفتات الذي هو أصلا حق لهم “لو يعقلون”.
ويلاحظ أن المنصب والحكم، -الكرسي بلغة أخرى- يفرز مع الزمن، نمطا خاصا من نهج التفكير، وتكوين السيكولوجية والذهنية-أو الثقافة بشكل عام- ومن ثم تكوين الشخصية ؛ خاصة -إذا طال الزمن بالحكم-.
أشار ابن خلدون الى طبيعة ذلك، ومراحله، بوضوح، في مقدمته المشهورة بـ ” مقدمة ابن خلدون”
والذي اعتبر –لذلك- منشئ علم الاجتماع قبل “اوغست كونت” ودوركهايم وغيرهما… بقرون.
هذا التكوين غير الطبيعي –والمفترض-في الشخصية، غالبا ما، يؤدي الى بروز نوع من الشخصية التي تميل الى الاستبداد، والتحكم في حياة الناس؛ إرضاء لنزوع متعال،وربما تعويضا عن شعور بالحرمان في مرحلة ما…-هتلر مثلا وغيره إذا تتبعنا قصة حياتهم.- وخوفا على فقدان الكرسي من أن يتحرك- بعد أن اعتاده طويلا،وتماهى مع مقتضياته ، كما نلاحظ في الثورات التي سميت الربيع العربي.
إن محاولة التماس أعذار لهذا النموذج من الشخصية الحاكمة والمتسلطة،هنا أو هناك– هي غير مقبولة على كل حال- لكنها قد تكون ذات معنى في صورة ما، لجهة أن المصلحة في هذا السلوك –المشوّه- ترتد عليها مباشرة، وهي تستمرئها، وما فيها من لذائذ تستهوي النفوس، وتأسر العقول… وتدفع نحو الفعالية المشوّهة للبقاء على هذه المصالح واللذائذ…والتي هي في مستوى ما –فلسفي-أخلاقي، تعتبر انحطاطا، وانحدارا في القيمة الحياتية- والمعنى المفترض لها- للإنسان، والمأمول منه…!
لكن السؤال الذي يبقى ملحا ودوما هو:
كيف نلتمس للصف الثاني والثالث والرابع… نزولا حتى المستويات الأخيرة في الدرجة من أبناء المجتمع، كيف نلتمس عذرا لها، في سلوك من موقع التبعية التي تتنازل الشخصية فيها- دون ممانعة حقيقية- عن الكثير من مقوماتها الإنسانية القيمية، والتي يتميز الكائن البشري بها؛ قياسا الى الكائنات الأخرى، والتي لا عقل لها، ويختص البشر بالعقل وحده من بينها…؟!
كيف نتقبل مثل هذا السلوك الذي ينحدر عن المفترض من المستوى العقلي المميز،وما يفرزه من تخلّ- أو تجرد-عن القيمة الأساسية في الإنسان (البشر).
الآيات التالية تخاطب البشرية في ما ورد في مضامينها- القيم والمعاني-:
” ولقد كرمنا بني آدم”.
“ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم”.
– الأولوية الأولى هي: البحث عن الذات، ومعرفتها في كل مكوناتها الأساسية، العقل..النفس..الغرائز.. الميول..الرغبات..العواطف…الإرادة…المؤثرات الاجتماعية المختلفة ومنها التربوية، والضغط الاجتماعي….الخ.
لنقل، مجمل الثقافة المتكونة في لحظة تاريخية معينة.
– الأولوية الثانية هي: البحث عن الكيفية التي ينبغي أن نعيشها…
– الأولوية الثالثة هي: البحث في الغايات والأهداف التي نسعى لتحقيقها، ومشروعيتها وفقا لمعايير نتعرف عليها في سياق البحث عن الذات، خاصة في صلتها الاجتماعية-ومنها الخصلة – أو الخصال – الأخلاقية (بمعناها العام–الايجابي والسلبي معا، كما تعتمد الفلسفة نهج تعريفها ودراستها).
بخلاف الفهم الشائع اجتماعيا-أو شعبيا- وهو البعد الايجابي فحسب. وهذه قضية معرفية ذات طابع فلسفي كما هو واضح.
– وتأتي الأولوية الأخرى-الرابعة– وهي: السعي إلى تحسين كل ما يتعلق بحيوية ونشاط وأداء الإنسان …ربما هذا هو المنحى الجمالي في حياة الإنسان نظريا وميدانيا…
ويمكن تفكيك هذه الأولويات، فنستنبط أولويات أخرى متفرعة عنها، لكننا- كما قلنا –منذ البداية- نكتب مقالا في أجزاء صغيرة، لا تتيح لنا الاسترسال كثيرا، لذا سنبقى في حدود الأولويات الأربعة الرئيسة هذه، والتي حددناها، ونحاول –خلال البحث أن نذكّر –أو نشير الى أفكار قد تبدو لنا ذات علاقة -أو مكان- في السياق…ودون الإدعاء بأنها التصنيف النهائي لها…وإنما هي محاولة مني وفقا لمنهجي المتواضع – وربما القاصر – في الفهم والتفكير …!
في الجزء الثالث ذكرنا التشوه في التفكير والسلوك لدى بعض الأشخاص والجماعات –بغض النظر عن تسميتها وتصنيفها- أو في الممارسة عموما، لا سيما في قضايا ذات صلة بإدارة- وإرادة- الشعوب والمجتمعات، وتسمى -عادة -الحكم –أو الإدارة السياسية، أو القيادة، أو الزعامة ..الخ؛ في اللغة العربية.
كل هذه الكلمات تشير الى البعد السياسي – أي ما يمكن تسميته بالوظيفة العليا -أو الأعلى– في المجتمع.إنها وظيفة ضرورية اجتماعيا،وبحسب الدراسات الواقعية لأنماط الحياة الاجتماعية؛ منذ بدء وجودها، ابتكرها الإنسان، وهي-خلاصة هذه الدراسات- قابلة دائما لإعادة النظر فيها؛ كلما تم اكتشاف ما يؤثر على مصداقيتها في شكل ما.وهذا نهج علمي لا يجادل فيه إلا بعض الأيديولوجيين الذين يخلطون بين الفلسفة والعلم والسياسة- وعن عمد، وسبق إصرار، لغاية في نفس يعقوب- كوظيفة اجتماعية – السياسة- مؤثرة، وفاعلة، ومهيمنة على المجتمعات ومقدراتها –خيراتها- لمن امتلك قوة إدارتها.
للأسف بعض الأيديولوجيين يمارس هذا النهج باسم المحتاجين والفقراء والكادحين، وهذا نهج سياسي يهدف لمصلحتهم ، ويؤثر سلبا –من الناحية الأخلاقية-على طبيعة العلاقات الاجتماعية بمعناها العام.
في الواقع هؤلاء المحتاجون والفقراء والكادحون…هم الذين يدفعون ضريبتها السلبية؛ عبر مجموعة من الأمور منها، فقدان الحرية الشخصية، وحرية النمو طبيعيا، والقدرة على المشاركة الحية انطلاقا من واقع ما يفهمون ويرغبون به، ويحقق مصالحهم، وذلك لقاء فتات من الأموال أو الوظائف التي “لا تغني ولا تسمن من جوع” فيوقّعون –عن جهل –صك عبودية تلزمهم طوال الحياة بالتصفيق والهتاف بشعارات –أحيانا –لا يعرفون لماذا يرددونها سوى الخوف من المحاسبة، أو الحرمان من بعض هذا الفتات الذي هو أصلا حق لهم “لو يعقلون”.
ويلاحظ أن المنصب والحكم، -الكرسي بلغة أخرى- يفرز مع الزمن، نمطا خاصا من نهج التفكير، وتكوين السيكولوجية والذهنية-أو الثقافة بشكل عام- ومن ثم تكوين الشخصية ؛ خاصة -إذا طال الزمن بالحكم-.
أشار ابن خلدون الى طبيعة ذلك، ومراحله، بوضوح، في مقدمته المشهورة بـ ” مقدمة ابن خلدون”
والذي اعتبر –لذلك- منشئ علم الاجتماع قبل “اوغست كونت” ودوركهايم وغيرهما… بقرون.
هذا التكوين غير الطبيعي –والمفترض-في الشخصية، غالبا ما، يؤدي الى بروز نوع من الشخصية التي تميل الى الاستبداد، والتحكم في حياة الناس؛ إرضاء لنزوع متعال،وربما تعويضا عن شعور بالحرمان في مرحلة ما…-هتلر مثلا وغيره إذا تتبعنا قصة حياتهم.- وخوفا على فقدان الكرسي من أن يتحرك- بعد أن اعتاده طويلا،وتماهى مع مقتضياته ، كما نلاحظ في الثورات التي سميت الربيع العربي.
إن محاولة التماس أعذار لهذا النموذج من الشخصية الحاكمة والمتسلطة،هنا أو هناك– هي غير مقبولة على كل حال- لكنها قد تكون ذات معنى في صورة ما، لجهة أن المصلحة في هذا السلوك –المشوّه- ترتد عليها مباشرة، وهي تستمرئها، وما فيها من لذائذ تستهوي النفوس، وتأسر العقول… وتدفع نحو الفعالية المشوّهة للبقاء على هذه المصالح واللذائذ…والتي هي في مستوى ما –فلسفي-أخلاقي، تعتبر انحطاطا، وانحدارا في القيمة الحياتية- والمعنى المفترض لها- للإنسان، والمأمول منه…!
لكن السؤال الذي يبقى ملحا ودوما هو:
كيف نلتمس للصف الثاني والثالث والرابع… نزولا حتى المستويات الأخيرة في الدرجة من أبناء المجتمع، كيف نلتمس عذرا لها، في سلوك من موقع التبعية التي تتنازل الشخصية فيها- دون ممانعة حقيقية- عن الكثير من مقوماتها الإنسانية القيمية، والتي يتميز الكائن البشري بها؛ قياسا الى الكائنات الأخرى، والتي لا عقل لها، ويختص البشر بالعقل وحده من بينها…؟!
كيف نتقبل مثل هذا السلوك الذي ينحدر عن المفترض من المستوى العقلي المميز،وما يفرزه من تخلّ- أو تجرد-عن القيمة الأساسية في الإنسان (البشر).
الآيات التالية تخاطب البشرية في ما ورد في مضامينها- القيم والمعاني-:
” ولقد كرمنا بني آدم”.
“ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم”.
وغيرها من آيات في الكتب المقدسة عموما، وفي نتائج وخلاصات مسعى المفكرين والفلاسفة والمهتمين عن وعي عموما…؟!