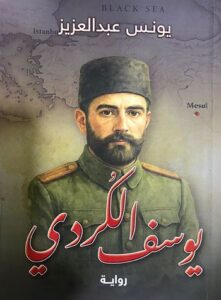دلور ميقري
دلور ميقري1
إنها المرة الأولى، كما أعتقد، التي يَجدُ فيها أدونيس نفسه مضطراً للدفاع عن وجهة نظره، الخاصّة بالثورة السورية. المناسبة، كانت مقالة للكاتب المغربي صلاح بوسريف، ينتقد من خلالها موقفَ الشاعر السوري من الأزمة؛ حيث ردّ عليه الأخير بمقالة عنوانها ” من أجل الثورة “.
وعلى رأيي المتواضع، فإنّ صفة الغرور، الملازمة لشخص شاعرنا العتيد، كانت هيَ مَبعث استنكافه عن الردّ على منتقدي مقالاته، ومقابلاته، التي دأبَ على نشرها في الصحافة العربية، والعالمية، منذ الأشهر الأولى لاشتعال انتفاضة الحرية والكرامة: فأدونيس الذي وَلجَ، منذ فترة بعيدة، مرحلة َ “الصنميّة” في الأدب، فإنه راحَ يُجاري صفة الديكتاتور المُستبدّ، المُتعالي على معارضيه بوَصفهم ـ كذا ـ أدوات مؤامرة خارجية تستهدف شخصه ومشروعه.
أما تنازل “الصنم الأدبيّ”، المفاجيء، بخصوص مقالة الكاتب بوسريف، فلا بدّ أنها تأكيدٌ على صفة أخرى في شخصيته؛ وهيَ الانتهازية: لأنّ أدونيس مَعنيّ بتوضيح موقفه / فضيحته، من ثورة شعبه السوريّ، طالما أنه بذلك يُخاطب جمهورَ منتقده، المغربيّ؛ وهوَ الجمهورُ، المنفتحُ على الثقافة الفرنسية بشكل فاعل، والاسبانية بدرجة أقل. بعبارة أخرى، فقد رغبَ صاحبُ “مفرد بصيغة الجمع”، عبرَ رمية مقاله الأخير، إصابة هدفين معاً: الأول، ضمان شعبيته بين نخبة ثقافية عربية / فرانكفونية، وبالتالي تواصل ترجمة أعماله والدعاية لها؛ والثاني، محاولة ايصال صوته إلى المقامات الأوروبية، النافذة أدبياً، تبريراً لموقفه السياسيّ، الملتبس.
2
عنوان المقالة، ” من أجل الثورة “، لا يقلّ إلتباساً. إنه بعاطفيته، ليذكرنا بعنوان فيلم هنديّ؛ هوَ ” من أجل أولادي “. إن أدونيس، ولا ريب، يتعكّز على العاطفة هنا، سعياً لتبرئة ذاته من تهمة ممالئة السلطة الأسدية، المستبدّة، في محاولتها اجهاض الثورة من خلال تصويرها، إعلامياً، كمؤامرة خارجية بأدوات داخلية من عصابات ارهابية، سلفية: الواقع، فإنّ خطاب أدونيس في مقالته هذه، مثلما الأمر في أخواتها السابقات، إنما يتماهى بشكل أو بآخر مع ذلك الخطاب السلطويّ، الإعلاميّ؛ وكما سنعمل على ابرازه في سياق هذا العرض.
منذ مستهلّ ردّه، يعترف شاعرنا بأنّ ما يسميها ” التيارات الشبابية ” هيَ من فجّرت الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية، وأنها فعلت ذلك بأصالة وطنية بعيداً عن التأثر بأيّ نموذج غربي. هذه الحقيقة، سرعان ما يداور حولها، حينما يؤكد أنّ الربيع العربي قد جنى ثماره التيارُ الأصوليّ، من خلال الجماعات الاسلامية، بعدما اختطفت قيادته: ” وها هيَ تقبض على زمام الحكم “.
هذا التأكيد، جديرٌ بالتوقف عنده ملياً، طالما أنه محورُ موقف أدونيس من الثورة السورية. إنّ مجرّد جمعه التيارات الاسلامية في خانة واحدة، هيَ ” الأصولية “، يجعلنا نفترض النيّة المسبقة لديه على تشويه حقيقة الأوضاع في دول الربيع العربي. فضلاً عن أنّ توصيفه لأوضاع تلك البلدان، وكما لو أنها متماثلة اجتماعياً واثنياً واقتصادياً وثقافياً، لا يقلّ خطلاً وديماغوجية. هذا التوصيف الأدونيسي، يُحيلنا إلى تنظيره الطويل في التراث والحداثة، والذي انطلق منه أساساً بكون المجتمع العربيّ وحدة ً ثقافية متجانسة، وليسَ مجموعة من الثقافات الوطنية، المتعددة والمتنوّعة: لكأن المرء هنا يستشفّ هذه ” الباطنية “، الماكرة، المتخفي خللها أقطابُ السلالة الأسدية الحاكمة، والتي جعلتهم على مدى أربعين عاماً يكبتون بالقوّة أيّ نشاط طبيعيّ لطائفتهم العلوية، طقسياً أو ثقافياً، لمجرّد رغبتهم بالتماهي في المجموع العام؛ العربيّ السنيّ.
3
النقطة الثانية، المثارة في ردّ أدونيس، تتحدد في رؤيته للمستقبل. إذ يفترض أن الاسلاميين، بعد وصولهم للحكم، سيمارسون باسم الديمقراطية وصندوق الاقتراع: ” عنفاً شاملاً ضد الانسان وعلى جميع المستويات الاجتماعية والسياسية والثقافية، فالفاشية الدينية لا تقل هولاً عن الفاشية العسكرية “.
يبدو أدونيس هنا، وكأنما صارَ ذلك الشاعر / العرّاف، القادم من عصور ما قبل الميلاد. فهو يكتفي بدور ” المنجّم “، المتنبيء بالهيمنة الأكيدة لما يسميه ” الفاشية الدينية ” على الحكم في حال انتصار الثورة السورية، بدلاً عن الدور المفترض به ـ كمثقف ـ أن يلعبه؛ من خلال دعم التيارات العلمانية واليسارية في بلده عموماً، وفي طائفته العلوية بشكل خاص. ومن النافل التنويه بدور هذه الطائفة، سواء على صعيد السلطة أو الجيش، كونها تستأثر بهما من خلال سلالة الأسد وزبانيتها ومشايعيها.
المثل السوريّ يقول: ” لما يجي الصبي، نصلي على النبي “؛ أي أنّ على الانسان أن ينتظر مجيء الصبي، ومن ثمّ المجادلة بشأن اسمه أو ملبسه. ويبدو أن شاعرنا، أدونيس، لم يقتد بهذا المثل الشعبيّ، البليغ. فهوَ ينكصُ أوباً عندما يتعلق الموضوع بثورة عارمة في وطنه تريد انهاءَ نصف قرن من الاستبداد والفساد، بدعوى أنها ستفضي حتماً إلى وصول الاسلاميين إلى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع. لا بل، والأسوأ، إنه من خلال رسالته المفتوحة لـ ” السيد الرئيس “، يطالبه بتطبيق الاصلاح وقيادة مسيرته. وإذ يستنكر أدونيس، في مقالته الأخيرة، توقف ناقديه عند تلك العبارة، السيادية، إلا أنه يتجاهل بخفة ما هوَ أدهى بكثير منها؛ حينما وَصفَ الطاغية، المغتصب للسلطة، بأنه رئيسٌ شرعيّ، منتخب، لم يأتِ بانقلاب عسكريّ.
4
في القسم الأخير من مقالته، يتساءل صاحبُ ” مفرد بصيغة الجمع ” عن هؤلاء الثوار؛ ثوار القرن الواحد والعشرين، الذين لا يقبلون بالرأي الآخر، المختلف، حتى لو كان من المنحى الثوريّ نفسه؛ وما إذا كانوا يمارسون نفس الأساليب التي يتبعها خصومهم في السلطة المستبدة، بتخوينهم وتكفيرهم كل من يخالفهم في آرائهم: ” حتى أنهم يرون التعامل مع الأجنبي وطنية، والعنف المسلح ضد مواطنيهم واجباً وطنياً “..؟
إنه لمثيرٌ للاستغراب، حقا، أن يواصلَ أدونيسُ حتى النهاية استفزاز مشاعر غالبيــــة مواطنيه؛ عندما يصرّ على ترديد السمفونية الإعلامية للنظام، التي تتهم الثوار بالعمالة والارهاب. تشديدنا على الغالبية، إنما تأتى من حقيقة أنّ هذا الشاعر، الذي تغنى دهراً بالعروبة والانسانية، لا يجد اليومَ حرجاً من الاصطفاف مع من يخيّل إليه أنهم ” حماة الطائفة “؛ أو ” حماة الأقلية ” في آخر المطاف.
وإنه لمثير للسخرية، هذه المرة، تناهض أدونيس في مختتم مقالته، إلى تذكير القاريء بتاريخه النضاليّ، المديد، في مقارعة الأنظمة الشمولية؛ ومنها حزب البعث، بالطبع. ويقول أن صراعه مع السلطة يرقى إلى العام 1956: ” حيث انتقدتُ الواحدية السياسية والفكرية، وابتعدت عنها لكي أعيش خارج سورية، وعانيت في هذا الصراع على مدى نصف قرن “.
بدءاً، ثمة لبْسٌ رأيتني فيه، بالنسبة للتاريخ المُبتده فيه ” النضال الأدونيسي “؛ إذ اعتقدتُ لوهلةٍ أنه خطأ مطبعيّ، وأن صحيحه هو عام 1965. بيْدَ أنني استدركتُ، متذكراً حادثة اغتيال العقيد التقدمي عدنان المالكي، في عام 1956، على يد أحد أعضاء الحزب السوري القومي الاجتماعي، الفاشيّ العقيدة والممارسة. من النافل، أيضاً، التذكير بحقيقة انتساب أدونيس لهذا الحزب واعتقاله من ثمّ على خلفية تلك الجريمة. فما يهمّ هنا، هوَ اعتبار شاعرنا ـ المناضل آنذاك في الحزب القومي السوري ـ للحقبة الديمقراطية البرلمانية في منتصف الخمسينات، كتجلّ للنظام الشمولي المبني على الواحدية السياسية والفكرية..؟
في هذه الحالة، علينا ألا نعتب على أدونيس، حينما يعتبر النضالَ ضد أصحابه البعثيين، حالياً، إنما هوَ مجرّد إعادة لتلك ” الواحدية السياسية والفكرية “؛ التي حكمت موطنه في الخمسينات من خلال نظام برلماني، ديمقراطي: وبما أنه مصرّ على استعادة ماضيه، النضاليّ، فكان عليه، أيضاً، أن يتذكرَ تهليله للثورة الإيرانية ضد الشاه، والتي لم يغيّر رأيه فيها قط، حتى عندما تحوّلت إلى سلطة ” ولاية الفقيه “، المستبدّة الاوتوقراطية.. أم أنّ ” الفاشية الدينية ” محصورة، حَسْب، في الاسلام السني وثورات الربيع العربي..؟
أما وجه الغرابة، الآخر، فهوَ مزايدة أدونيس على ثوار سورية، فيما يتعلق بموضوع التدخل الأجنبي: فهوَ، على حدّ علم الجميع، أكثر المثقفين السوريين ـ بل والعرب أجمعين ـ في تماهيه مع ” الأجنبيّ “؛ أوروبياً كان أم أمريكياً.. أم إسرائيلياً. فهل بلغ شاعرنا من العمر عتياً، حدّ نسيانه حادثة طرده ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ من اتحاد الكتاب العرب، على خلفية اجتماعه مع كتاب إسرائيليين في كوبنهاغن..؟
بنفس النبرَة، المتعالية والمستهترة، التي خاطب بها أدونيسُ في مقالته الأخيرة من أسماهم ” ثوار القرن الحادي والعشرين “، يحق لي أن أتساءلَ بدوري: ما بال هذا الشاعر السوريالي الكبير ـ كذا ـ يواكبُ مزاجَهُ مع متغيّرات ” المزاج النوبليّ “، صعوداً وهبوطاً. فإذا كانت توقعات العام رائقة، ومبشرة بكونه مرشحاً ” بقوّة ” للجائزة العالمية العتيدة، فإنّ شاعرنا سيرتفع صوته أكثر قوّة ضد الحجاب وبناء المآذن في أوروبة. أما إذا كان الأمرُ خلافه، فلن يسلمَ هذا الغرب من انتقامه؛ فإذا بمقالاته تترى، في زاويته بصحيفة ” الحياة ” خصوصاً، يكيلُ فيها المديح لحزب الله والجمهورية الاسلامية الإيرانية، مبرئاً إياهما من تهمة الإرهاب والعنف.
اليوم، ومع مرور عام على اشتعال ثورة الحرية والكرامة، يبدو حلمُ أدونيس بجائزة نوبل وكأنما تماهى مع كابوس الحرب الإجرامية للنظام الأسدي على الشعب السوري. وإذن، ما على صاحب ” مفرد بصيغة الجمع ” من بأس في تواشج خطابه مع خطاب ذلك النظام الفاشيّ؛ إن كان لجهة المتاجرة بقضية فلسطين، وموقف الغربيين منها، أو لجهة المبررات المتهافتة بشأن محاربته للثورة السورية. فأدونيس، وبالرغم من جميع تبجحاته، لم يكن يوماً على خصام مع هذا النظام الشمولي، الطائفي، ويبدو أنه سيبقى على وئام معه حتى النهاية.
2
عنوان المقالة، ” من أجل الثورة “، لا يقلّ إلتباساً. إنه بعاطفيته، ليذكرنا بعنوان فيلم هنديّ؛ هوَ ” من أجل أولادي “. إن أدونيس، ولا ريب، يتعكّز على العاطفة هنا، سعياً لتبرئة ذاته من تهمة ممالئة السلطة الأسدية، المستبدّة، في محاولتها اجهاض الثورة من خلال تصويرها، إعلامياً، كمؤامرة خارجية بأدوات داخلية من عصابات ارهابية، سلفية: الواقع، فإنّ خطاب أدونيس في مقالته هذه، مثلما الأمر في أخواتها السابقات، إنما يتماهى بشكل أو بآخر مع ذلك الخطاب السلطويّ، الإعلاميّ؛ وكما سنعمل على ابرازه في سياق هذا العرض.
منذ مستهلّ ردّه، يعترف شاعرنا بأنّ ما يسميها ” التيارات الشبابية ” هيَ من فجّرت الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية، وأنها فعلت ذلك بأصالة وطنية بعيداً عن التأثر بأيّ نموذج غربي. هذه الحقيقة، سرعان ما يداور حولها، حينما يؤكد أنّ الربيع العربي قد جنى ثماره التيارُ الأصوليّ، من خلال الجماعات الاسلامية، بعدما اختطفت قيادته: ” وها هيَ تقبض على زمام الحكم “.
هذا التأكيد، جديرٌ بالتوقف عنده ملياً، طالما أنه محورُ موقف أدونيس من الثورة السورية. إنّ مجرّد جمعه التيارات الاسلامية في خانة واحدة، هيَ ” الأصولية “، يجعلنا نفترض النيّة المسبقة لديه على تشويه حقيقة الأوضاع في دول الربيع العربي. فضلاً عن أنّ توصيفه لأوضاع تلك البلدان، وكما لو أنها متماثلة اجتماعياً واثنياً واقتصادياً وثقافياً، لا يقلّ خطلاً وديماغوجية. هذا التوصيف الأدونيسي، يُحيلنا إلى تنظيره الطويل في التراث والحداثة، والذي انطلق منه أساساً بكون المجتمع العربيّ وحدة ً ثقافية متجانسة، وليسَ مجموعة من الثقافات الوطنية، المتعددة والمتنوّعة: لكأن المرء هنا يستشفّ هذه ” الباطنية “، الماكرة، المتخفي خللها أقطابُ السلالة الأسدية الحاكمة، والتي جعلتهم على مدى أربعين عاماً يكبتون بالقوّة أيّ نشاط طبيعيّ لطائفتهم العلوية، طقسياً أو ثقافياً، لمجرّد رغبتهم بالتماهي في المجموع العام؛ العربيّ السنيّ.
3
النقطة الثانية، المثارة في ردّ أدونيس، تتحدد في رؤيته للمستقبل. إذ يفترض أن الاسلاميين، بعد وصولهم للحكم، سيمارسون باسم الديمقراطية وصندوق الاقتراع: ” عنفاً شاملاً ضد الانسان وعلى جميع المستويات الاجتماعية والسياسية والثقافية، فالفاشية الدينية لا تقل هولاً عن الفاشية العسكرية “.
يبدو أدونيس هنا، وكأنما صارَ ذلك الشاعر / العرّاف، القادم من عصور ما قبل الميلاد. فهو يكتفي بدور ” المنجّم “، المتنبيء بالهيمنة الأكيدة لما يسميه ” الفاشية الدينية ” على الحكم في حال انتصار الثورة السورية، بدلاً عن الدور المفترض به ـ كمثقف ـ أن يلعبه؛ من خلال دعم التيارات العلمانية واليسارية في بلده عموماً، وفي طائفته العلوية بشكل خاص. ومن النافل التنويه بدور هذه الطائفة، سواء على صعيد السلطة أو الجيش، كونها تستأثر بهما من خلال سلالة الأسد وزبانيتها ومشايعيها.
المثل السوريّ يقول: ” لما يجي الصبي، نصلي على النبي “؛ أي أنّ على الانسان أن ينتظر مجيء الصبي، ومن ثمّ المجادلة بشأن اسمه أو ملبسه. ويبدو أن شاعرنا، أدونيس، لم يقتد بهذا المثل الشعبيّ، البليغ. فهوَ ينكصُ أوباً عندما يتعلق الموضوع بثورة عارمة في وطنه تريد انهاءَ نصف قرن من الاستبداد والفساد، بدعوى أنها ستفضي حتماً إلى وصول الاسلاميين إلى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع. لا بل، والأسوأ، إنه من خلال رسالته المفتوحة لـ ” السيد الرئيس “، يطالبه بتطبيق الاصلاح وقيادة مسيرته. وإذ يستنكر أدونيس، في مقالته الأخيرة، توقف ناقديه عند تلك العبارة، السيادية، إلا أنه يتجاهل بخفة ما هوَ أدهى بكثير منها؛ حينما وَصفَ الطاغية، المغتصب للسلطة، بأنه رئيسٌ شرعيّ، منتخب، لم يأتِ بانقلاب عسكريّ.
4
في القسم الأخير من مقالته، يتساءل صاحبُ ” مفرد بصيغة الجمع ” عن هؤلاء الثوار؛ ثوار القرن الواحد والعشرين، الذين لا يقبلون بالرأي الآخر، المختلف، حتى لو كان من المنحى الثوريّ نفسه؛ وما إذا كانوا يمارسون نفس الأساليب التي يتبعها خصومهم في السلطة المستبدة، بتخوينهم وتكفيرهم كل من يخالفهم في آرائهم: ” حتى أنهم يرون التعامل مع الأجنبي وطنية، والعنف المسلح ضد مواطنيهم واجباً وطنياً “..؟
إنه لمثيرٌ للاستغراب، حقا، أن يواصلَ أدونيسُ حتى النهاية استفزاز مشاعر غالبيــــة مواطنيه؛ عندما يصرّ على ترديد السمفونية الإعلامية للنظام، التي تتهم الثوار بالعمالة والارهاب. تشديدنا على الغالبية، إنما تأتى من حقيقة أنّ هذا الشاعر، الذي تغنى دهراً بالعروبة والانسانية، لا يجد اليومَ حرجاً من الاصطفاف مع من يخيّل إليه أنهم ” حماة الطائفة “؛ أو ” حماة الأقلية ” في آخر المطاف.
وإنه لمثير للسخرية، هذه المرة، تناهض أدونيس في مختتم مقالته، إلى تذكير القاريء بتاريخه النضاليّ، المديد، في مقارعة الأنظمة الشمولية؛ ومنها حزب البعث، بالطبع. ويقول أن صراعه مع السلطة يرقى إلى العام 1956: ” حيث انتقدتُ الواحدية السياسية والفكرية، وابتعدت عنها لكي أعيش خارج سورية، وعانيت في هذا الصراع على مدى نصف قرن “.
بدءاً، ثمة لبْسٌ رأيتني فيه، بالنسبة للتاريخ المُبتده فيه ” النضال الأدونيسي “؛ إذ اعتقدتُ لوهلةٍ أنه خطأ مطبعيّ، وأن صحيحه هو عام 1965. بيْدَ أنني استدركتُ، متذكراً حادثة اغتيال العقيد التقدمي عدنان المالكي، في عام 1956، على يد أحد أعضاء الحزب السوري القومي الاجتماعي، الفاشيّ العقيدة والممارسة. من النافل، أيضاً، التذكير بحقيقة انتساب أدونيس لهذا الحزب واعتقاله من ثمّ على خلفية تلك الجريمة. فما يهمّ هنا، هوَ اعتبار شاعرنا ـ المناضل آنذاك في الحزب القومي السوري ـ للحقبة الديمقراطية البرلمانية في منتصف الخمسينات، كتجلّ للنظام الشمولي المبني على الواحدية السياسية والفكرية..؟
في هذه الحالة، علينا ألا نعتب على أدونيس، حينما يعتبر النضالَ ضد أصحابه البعثيين، حالياً، إنما هوَ مجرّد إعادة لتلك ” الواحدية السياسية والفكرية “؛ التي حكمت موطنه في الخمسينات من خلال نظام برلماني، ديمقراطي: وبما أنه مصرّ على استعادة ماضيه، النضاليّ، فكان عليه، أيضاً، أن يتذكرَ تهليله للثورة الإيرانية ضد الشاه، والتي لم يغيّر رأيه فيها قط، حتى عندما تحوّلت إلى سلطة ” ولاية الفقيه “، المستبدّة الاوتوقراطية.. أم أنّ ” الفاشية الدينية ” محصورة، حَسْب، في الاسلام السني وثورات الربيع العربي..؟
أما وجه الغرابة، الآخر، فهوَ مزايدة أدونيس على ثوار سورية، فيما يتعلق بموضوع التدخل الأجنبي: فهوَ، على حدّ علم الجميع، أكثر المثقفين السوريين ـ بل والعرب أجمعين ـ في تماهيه مع ” الأجنبيّ “؛ أوروبياً كان أم أمريكياً.. أم إسرائيلياً. فهل بلغ شاعرنا من العمر عتياً، حدّ نسيانه حادثة طرده ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ من اتحاد الكتاب العرب، على خلفية اجتماعه مع كتاب إسرائيليين في كوبنهاغن..؟
بنفس النبرَة، المتعالية والمستهترة، التي خاطب بها أدونيسُ في مقالته الأخيرة من أسماهم ” ثوار القرن الحادي والعشرين “، يحق لي أن أتساءلَ بدوري: ما بال هذا الشاعر السوريالي الكبير ـ كذا ـ يواكبُ مزاجَهُ مع متغيّرات ” المزاج النوبليّ “، صعوداً وهبوطاً. فإذا كانت توقعات العام رائقة، ومبشرة بكونه مرشحاً ” بقوّة ” للجائزة العالمية العتيدة، فإنّ شاعرنا سيرتفع صوته أكثر قوّة ضد الحجاب وبناء المآذن في أوروبة. أما إذا كان الأمرُ خلافه، فلن يسلمَ هذا الغرب من انتقامه؛ فإذا بمقالاته تترى، في زاويته بصحيفة ” الحياة ” خصوصاً، يكيلُ فيها المديح لحزب الله والجمهورية الاسلامية الإيرانية، مبرئاً إياهما من تهمة الإرهاب والعنف.
اليوم، ومع مرور عام على اشتعال ثورة الحرية والكرامة، يبدو حلمُ أدونيس بجائزة نوبل وكأنما تماهى مع كابوس الحرب الإجرامية للنظام الأسدي على الشعب السوري. وإذن، ما على صاحب ” مفرد بصيغة الجمع ” من بأس في تواشج خطابه مع خطاب ذلك النظام الفاشيّ؛ إن كان لجهة المتاجرة بقضية فلسطين، وموقف الغربيين منها، أو لجهة المبررات المتهافتة بشأن محاربته للثورة السورية. فأدونيس، وبالرغم من جميع تبجحاته، لم يكن يوماً على خصام مع هذا النظام الشمولي، الطائفي، ويبدو أنه سيبقى على وئام معه حتى النهاية.