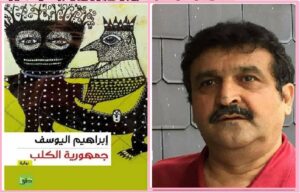عارف حمزة
عارف حمزةلم يتخلّ الكاتب الكردي / السوري سليم بركات، في روايته الجديدة “موتى مبتدئون”، الصادرة حديثاً، عن أسلوبه الشعري واللغوي والبلاغي. ذاك الأسلوب الذي يعتمده بركات في كتابة العمل الروائي كعمل يحتوي على الكثير من الشعرية وقليل من الروائية أوالحكائية. العمل الذي يتابع بركات داخله عمله في نحت اللغة وتأليفها وأخذها من ألسنة وعقول ما عادت موجودة، أوما عادت تقولها وتفكر بها إلا قليلاً، لا بل نادراً.
هذا الأسلوب، الذي اشتهر به بركات وبات مدرسة هومعلمها الشهير، يجعلنا نطلق على روايته “موتى مبتدئون”، وعلى العديد من رواياته السابقة، تسمية الرواية الشعرية، قياساً على المسرحية الشعرية، من حيث طغيان الشعر والإيقاع والموسيقى والتأليف على السرد والنثر وانسيابيتهما والحكاية.
المقصود بالشعر هنا ليس مجرد صفحة أوصفحتين من الشعر تتخلل متن الرواية، بل أقصد بأن أسلوب بركات في كتابة الشعر لا يختلف كثيراً عن أسلوبه في كتابة الرواية سوى بإضافة أسماء شخصيات وأماكن. هذه الشعرية في النص لا تشبه الشعرية التي توجد في الروايات الأخرى، خاصة الأجنبية منها، إذ أنها في تلك الروايات تأتي داخل انسيابية الرواية أوبسببها وبسبب لغتها البسيطة والتي قد تفيد في وصف الحالة، أواللحظة، المروية أوفي دغدغة القارئ أثناء سيره الممتع في قراءة الرواية، بجملة مدهشة، تجعلنا ننظر إليها كجملة من الشعر الخالص، ولكنها، بكل الأحوال، تكون قليلة ومفيدة وخفيفة على متن الرواية. أما هنا، في هذه الرواية، فإنها تأتي ثقيلة لتبدو وكأنها مكتوبة بشكل مقصود لإبراز عضلات اللغة. تأتي كي تفاجئ القارئ بطريقة تشتت وعيه عن متابعة جريان الرواية، أوكي تأتي، هذه الشعرية، ضد مفهوم الخفّة التي يتم فهمها بطريقة خاطئة كميزة من ميزات كتابة الرواية.
لنأخذ هذا المقطع الذي جاء في الصفحة الأولى للرواية: “لولبياً تسلقَ الجذعَ. حمله غصن إلى غصن، طبقة بعد أخرى، في اتجاه الأعالي، فتناثرت حفنات من الثلج العالق بها ـ ثلج المشورة التي درج البياض على إسدائها للخلاء الموحش. استأذن السنجاب شجرة الكستنة إذ بلغ ذروة فضائها الفارغ، قافزاً باتجاه شجرة الصنوبر. حط عليها في خفة كفكرة ارتجلها أمل عابر”. (ص 5). ولنأخذ مقطعاً آخر من الصفحة الحادية عشرة: “شحذ الرجل الجالس على جذع شجرة مهشّم، قبالة المياه في خليج أودن، مديته العريضة الشفرة على مبرد حجر مضلع. نطق المعدن في احتكاكه بالمعدن، فأصغى قلب الرجل إلى حكمة اللسان الصلب.
“ثلاثة عشر طيراً من قبائل البط، المطوق العنق ببهاء أصفر، عبرت البرزخ الثلج إلى البرزخ المياه كقوارب من ريش. مسّها الرجل ببصره؛ مسّ ببصره الدوائر المتداخلة على السطح الرمادي الساكن. تأمل البعيد المـُعتصَر في قبضة الأفق، المعتصَر تحت ثقل السماء. أغمض عينيه. تحركت شفرة المدية، ثانية، على المبرد، فأصغى المجهول، بعقله الذهبي، إلى الهسيس المرتعش في خيال المعدن.”. (ص 11).
طبعاً الرواية، هذه الرواية، مليئة بالكثير جدا من هذه المقاطع التي تعج بالوصف الثقيل على أية رواية. هذا الوصف الذي يشبه، ويرفع من قيمة، شعر سليم بركات نفسه. ولكن هل الرواية تحتمل مثل هذه الجمل الوصفية والاعتراضية والنحت اللغوي (حتى في أسماء الشخصيات: غيرموهالي، ماسيلدي، راموسيراسمو، جيماتيرك، والشابتين: داهناليدا، نيديداد) والبلاغة اللغوية على حساب الخفّة والرشاقة والمتعة والفكرة، رغم قلة أهميتها، وتسلية القارئ… رغم أن فكرة الرواية كلها تقوم على فكرة تسلية الغريب.
ينطلق الشبان الأربعة، الذين ذكرنا أسماءهم قبل قليل، والشابتان، في رحلتهم من أرض “السحلبية الزرقاء” إلى خليج “مورتفيك”، وخلال هذه الرحلة، التي لا ندري ما سببها، يأملون اللقاء بغريب ما من أجل تسليته. تبدوهذه المهمة، تسلية الغريب، كمهمة عظيمة بالنسبة لهم وكأن حياتهم، رغم أنهم أموات، متعلقة بهذا الأمل الغريب. “ليس هناك ما أخسره مذ وهبت رحلتي، هذه، للأمل في تسلية غريب، رد جيماتيرك”. (ص 23).
أثناء رحلتهم الطويلة، وطواف البلاغة والمماحكات من حول خطواتهم، يلتقون برجل جالس على جذع شجرة عند خليج أودن يشحذ مديته، وهم لا يعرفون أنه خليج أودن، ويفرحون لأنهم أخيراً التقوا بغريب ويريدون تسليته. لكن ذلك الرجل لا يرد على جميع محاولاتهم في محادثته، وحتى على تعنيفهم له، ولا ينظر إليهم حتى، متابعاً شحذ مديته.
إزاء موقفه السلبي هذا وصمته المريع يتركونه في حاله ويذهبون.
قصة ذلك الرجل الذي يشحذ مديته هي أجمل ما في الرواية، وهي عبارة عن أسطر قليلة إذا نزعنا عنها ثياب البلاغة، وهي تتحدث عن مائتي رجل من أرض “دوكون” صنعوا سفينة كبيرة ثم قاموا بسحلها بالحبال، فوق رصيف من جذوع الشجر، عبر الفراسخ الألف لكي يبلغوا شاطئ “هيلاكريتوثينيس” ويأخذوا التماثيل المعدنية الثلاثة المنتصبة فوق صخرة هناك والعودة بها إلى أرض دوكون.
رغم الرحلة الشاقة والمهلكة والطويلة جداً ورغم وجود الخرائط الدقيقة، والمرسوم عليها التماثيل الثلاثة، وسحلهم لسفينة كبيرة على البر، دون أن يركبوها في البحر، مئات الفراسخ ليحصلوا على اللا شيء. ليحصلوا على الخيبة. فهم وصلوا بدقة إلى الصخرة المرادة التي لن يكون عليها أي تمثال. بل لن يجدوا على الصخرة أي دليل، إذ “لا خدوش في الأرض؛ لا زجْرَ للحصى أوالرمل”. ( ص 36).
مونولوغ شعري رائع يتوالد بغزارة وألم على لسان ذاك الرجل الخائب والمتعب والذي قطع المسافة من جديد، ولكن بالاتجاه المعاكس، لا لشيء، بل لكي يفقد ذاكرته طوال أطول طريق قطعها، خائباً، في حياته.
الشيوخ الإثنا عشر، وهم آباء الشبان الستة، الذين خرجوا في إثر أبنائهم الذاهبين إلى خليج مورتفيك، يلتقون أيضاً الرجل الغريب الذي يشحذ مديته. الرجل الغريب لن يرد على طوفان المحاورات التي أجراها معه أولئك الشيوخ.
بعد ذلك الطوفان من النحت اللغوي والفلسفة والحكمة الثقيلة، المستخلصة من حياة اثني عشر شيخاً، يصل الشبان الستة إلى نفس المكان وتبدأ المناوشات البليدة بينهم وبين آبائهم، بعد اليأس من استنطاق الغريب، إذ يرفض الشبان البقاء مع آبائهم ويريدون متابعة مهمتهم العظيمة التي وهبوا أنفسهم لها. في تلك اللحظة سينطق الغريب بالجملة الذهبية في الرواية ليقول لهم:
“هذا خليج أودن، (..) أكمل الرجل المرهق العينين سيره فعبر الجمع الواجم. رفع صوته من غير أن يلتفت إليهم: لا أحد في خليج مورتفيك”. (ص 120). وهكذا تنتهي الرواية وتنتهي الرحلة العبثية لجميع الشخصيات في أرض فارغة من الغرباء ومن التسالي.
عندما ينتهي القارئ من الرواية سيجد في نهاية النص الجملة التالية “سكوغوس / السويد ـ القرن الثاني عشر الميلادي 2005”. وسيتساءل ماذا يعني القرن الثاني عشر الميلادي، هل هو خطأ مطبعي أم نهاية شعرية جديدة للتأريخ اخترعها سليم بركات؟
“كل شيء افتراض حين يكون الموتى مبتدئين”. بهذه الجملة، التي من ثوب الحكمة، يقدم بركات روايته الجديدة. الرواية التي تقوم على فكرة خروج مجموعة من الموتى من ذاكرة قبورهم للبحث عن خليج مورتفيك، لا ندري لماذا يبحثون عنه، وفي الطريق يتمنون أن يلتقوا بغريب كي يقوموا بتسليته، هذا ما ينطبق على الشبان الستة، أو لإبهاره بكمال الحكمة التي وصلوا إليها وحرقوا كتابها الوحيد، من خلال مجموعة الشيوخ، ولكنهم لن يجدوا أحياء على قيد الحياة بل سيجدون حيا يموت تحت ثقل ضربات الخيبة والخديعة.
القارئ الذي أحب بركات في سيرتي الطفولة والصبا، والذي تعلق بروايات جميلة، ولا تـُنسى، من أمثال “أنقاض الأزل الثاني” و”دلشاد” (فراسخ الخلود المهجورة) و”كبد ميلاؤس” و”فقهاء الظلام”… ماذا سيفعل عندما يقرأ هذا العمل الروائي الأخير لسليم بركات؟ بمعنى آخر. عندما ننتهي من قراءة رواية ما لكاتب ننتظر كتابه الجديد، ثم نحصل عليه، فهناك فرق بين أن نـُقبِّل الكتاب ونهنئ أنفسنا على انتظاره واقتنائه وأن نقول، بعد القراءة، لتلك الأنفس “يا سلام”، وبين أن نصاب بالوجوم والتعب والإرهاق، وربما الخيبة، وعدم الفهم وبأن نعزي أنفسنا بسبب أملها وانتظارها الطويل.
السؤالان اللذان طرحتهما على نفسي بعد انتهائي من قراءة رواية “موتى مبتدئون”، وربما سيعتب علي كثيرون من محبّي بركات، كانا: كيف سيقوم المترجمون بترجمة هذا العمل إلى الإنكليزية أوالفرنسية أوالإيطالية في الوقت الذي نتمنى أن يترجمها، أحد ما، إلى العربية من العربية التي كتب بها بركات؟
السؤال الآخر، ربما كان قاسيا نوعا ما، كان: هل بدأ سليم بركات بالتخلّي عن قرائه؟
* المستقبل – الاحد 10 كانون الأول 2006 – العدد 2471 – نوافذ – صفحة 14