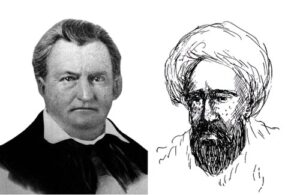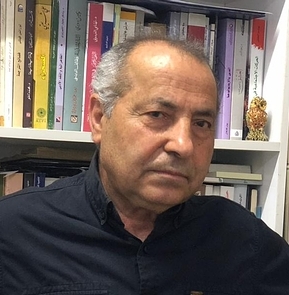ترجمة وتقديم : إبراهيم محمود
ما ترجمته تالياً ليس بقصة، سوى أنها تبزُّ الكثير من القصص بمرارتها وعنف الوارد فيها، لعلها حكاية ولكنها أكثر جماليةَ أداءَ معنى من الحكاية، كونها تثير الانتباه إلى ما هو قائم في المحيط الجغرافي الكردستاني حدودياً وتسمّي معايشي أحداث على شاكلتها. إنها بإيجاز عن واقعة جارية، حقيقية ذات يوم كردستاني في نطاق المفصل الحدودي المصطنع بين قامشلو ونصيبين، الملغَّم والمسيج بالأسلاك الشائكة والشاهد على إزهاق الآلآف ممن عبروه من الكرد خصوصاً، واقعة سمعتْها مؤلفة كتاب ” كردستان والحدود في القرن العشرين ” السيدة أصليخان يلدِرِم، والذي قدَّمت له ونشرت قسماً من الختام فيه، وفي هذا الموقع ” ولاتي مه “، وتقع ما بين صص 500-501، وأنا أنشغل بترجمته الآن، وجدت أن نشر هذه الواقعة مترجمة، قادرة بذاتها أن تلفت الأنظار إلى مضمونها، وهي بمناخها الفيلمي واقعاً، بل تمتلك كل إمكانات الترجمة إلى فيلم ” أكشِن ” خاص جداً،مع اعتماد بعض التقنيات الفنية تلك التي يعرفها المخرج المعايش لمناخات حدودية، من نوع ” بهمن قبادي ” الفنان الكبير، وله حضور في الكتاب.
الواقعة الفاجعة التي تستشرف بنا جغرافيا حدودية وحدوداً جغرافية منهوبة ومستلبة ومفخخة لأهلها الكرد، مكاشفة حرّيفة وعن قرب لما يمكن قراءته ومقاربته لما هو جار كردستانياً، كما لو أن كردستان الجغرافيا المصدوعة والمفجوعة بالحدود المنفذة، هي خلاصة تاريخ حدود لا تحتاج إلى شهود عيان ليقسموا بالأيمان المغلظة إزاء متردداتها الآلمة المؤلمة.
إن ” درد ” المكان الشريطي الحدودي من الآلام والفظائع فيه .
لقد بذلت ما استطعت من جهد جهة الترجمة عسى أن تأتي اللغة المقابلة مؤاخية شقيقتها الأصلية: لغة الكتاب الكردية، وفي الصور المتلاحقة والمتداخلة ما يعمّق من نفاذ المعنى.
والعنوان المقدم عبارة عن اجتهاد مني من خلال قراءة الواقعة- النص، مبقياً على العنوان الفرعي للفصل وما يتقدم سردية الواقعة.
آمل أن ” تستمتعوا ” مثلي ” بهذا المشهد ” السريالي ” التركيّ العلامة !
بعض الذكريات
مكان اللقاء : نصيبين
السنة: 2005
السيدة التي تحمل اسم ت.ا. في الستين من عمرها تقريباً
عاشت أكثر من خمسين سنة في نصيبين
الواقعة التي رأتها بذاتها قصَّتها علينا هكذا:
إنها مسألة واقعة تخص فتى من نصيبين واسمه محمود. كنت حينها صغيرة عندما وقعت الواقعة. بمعنى أنه قبل الآن بـ 35-37 عاماً ” سنوات ما قبل 1970 “. كان الفتى طالب مدرسة، وقد أحرِقت مدرستهم، فاتهموه هو وثلاثة أو أربعة من أصحابه بأنهم السبب. واعتِقل أصحابه حيث أمضوا محكوميتهم، أما هو فلم يسلّم نفسه للبوليس، فصار محكوماً. ولقد بقي مختبئاً في البيت لبعض الوقت، وكان البوليس يراقب بيته، فتأكد للفتى أن لا خلاص له منهم، فتوجه إلى سوريا ” بنختي binxetȇ ” .
وبقي هناك لبعض الوقت. ثم حاول أن يأتي إلى البيت قرب حلول العيد. كانوا يقولون أنه كان يحمل معه مرآة، قد حملها لأخته، إلى جانب جيليه منعّم للشعر، أما أخوته فقد جلب لكل منهم قميصاً. وعندما عاد، غدر به العسكر، حيث سمحوا له بالعودة، لكنه عندما حاول العبور أطلقوا عليه النار. لقد قتل برصاص العسكر. كانت الواقعة بالقرب من البيوت الحدودية، وقد رآها جميع الناس هناك، وكنا نصعد إلى سطح البيت، حيث كنا نرى من كان يذهب ويعود. ولقد كان بيت والدته قريباً من الأسلاك الشائكة، وحيث كان أبوه متوفياً. وأما الفتى فقد كان مقابل بيته، وبقي جريحاً وسط الأسلاك تلك، وكان صدى صراخه وتألمه يتردد في الجوار حتى الصباح. كان ينادي، ويقول: ناشدتكم بالله أن تذهبوا وتعلموا أمي لتأتي إلي وتنقذني. وقد عرفه الناس، ولم يجرؤ أحد منهم على الاقتراب منه، وكان ينادي العسكر أن تعالوا أنجدوني دون جدوى .
ومات الفتى في اليوم التالي، حيث بقي قرابة ستة عشر يوماً بين الأسلاك الشائكة، وفي ذلك الحر الصيفي، ولا أدري بالضبط هل كان شهر تموز أم حزيران. وقد حاول ذووه المستحيل وهم يرجون العسكر والجهات الأمنية لتسليمهم جثته إنما دون نتيجة. إذ ردوا عليهم أن لا بد عليه أن يبقى هناك حيث هو، ليكون عبرة للناس. لهذا، فإنه أحياناً كان يتجه كلب أو ابن آوى نحو جثته وهو يلتهم لحمه. وأمه كانت مقابله أيضاً. فلم تتحمل أمه ذلك، فجنّت. أحياناً كانت تركض من عند البيت وتقول: النجدة، النجدة. ولدي يا ولدي، وتذهب لتأتي بجثة ولدها، وكنا بدورنا نحن الأطفال نتحلق حولها، ونقول: ربما أنقذت جثته .
ذات مرة، ذهبت وحملت جثة ولدها، فأوشك العسكري أن يقتلها، فتركته، وتعلق وشاح رأسها بالأسلاك، وهي تحمل يداً لابنها في يدها، وأخذها العسكري منها، ليشد يد ابنها تلك بوشاحها ويعلقها بالأسلاك، وقد نبه مسئول العسكر أنها إذا أقبلت هذه المرة، أطلقوا عليها النار، اقتلوها. وبعد مضي ستة عشر يوماً، كان المتبقي طبعاً هي العظام وحدها. لقد أتت الكلاب وبنات آوى على لحمه بالكامل. وجرّاء حر الصيت انبعثت منه الرائحة منتشرة في الجوار .
وكان ثمة شجرة توت بالقرب من الأسلاك الشائكة، ومقابلها كانت عظام الفتى. وقد حددوا موقعاً للعسكري على شجرة التوت لحراسة العظام، لئلا يأتي أحدهم ويأخذها. وأعلِمَ العسكري أنه إذا أقبلت أمه، أطلقْ عليها النار، واقتلها. وترى أم الفتى كيف أن الكلاب تأتي على جثة ابنها، فتصرخ وتستنجد مراراً وتكراراً، ثم انقذفت نحو ابنها. كان العسكري بدوره غارقاً في النوم، فهرعنا إليها لمساعدتها. ولا زلت أتذكر كيف أن أمه قد جمعت عظام ابنها وشدتها إلى صدرها، وكانت رِجل الفتى معلَّقة بحذائها وهي تتمرجح، فما كان من صهرها إلا أن أسرع مهرولاً وأتى بشرشف فراش، ووضع العظام داخلها ولفها عليها مثل بقجة ” صرَّة “،ثم أخذها من يدها ومضى بها.
ما بين إعلام العسكري للمخفر وقدوم العسكر، كان ذلك مدة كافية لينجوا بأنفسهم. ولقد انشغل العسكر بتلك العظام كثيراً، حيث خيَّرونا بين أمرين : أن نأتي بتلك العظام، أو أنهم سيحرقون بيوتنا جميعاً. أما بالنسبة للعسكري الحارس والغارق في النوم، فقد سألوه: لماذا غفوت؟ ثم شدَّوه إلى سيارة ” جيمس ” عسكرية، وجرّوه خلفها حتى المخفر، ونزف الدم من أنفه وفمه. وثمة من قالوا أنه مات، وآخرون قالوا: لقد أخذوه إلى المشفى، ولا نعلم ما إذا كان مات أم لا.
أما أم الفتى فحاكموها، وكانوا يسألونها: قولي أين وضعت تلك العظام. ومعلوم أن الأم كانت قد فقدت عقلها، حيث ما كانت تعلم كيف تجيب. كانت أحياناً تحمل العظام، وتخبئها في بيوت الجيران، وذات مرة وضعتها في صندوق الخرزات، ومرة أخرى وضعتها تحت قفة. لقد كانت تنقلها وتخبئها في أمكنة مختلفة، بسبب تحري العسكر عنها.
ذات ليلة ذهب الأهالي ليحفروا للفتى قبراً ودفنوه، كان قبره قبر طفل صغير، حيث وضعوا فيه مجموعة عظام هي خلاصته. أما المحكمة فحين تبيَّن لها أن أمه قد فقدت عقلها، تركتها لحال سبيلها.
دهوك