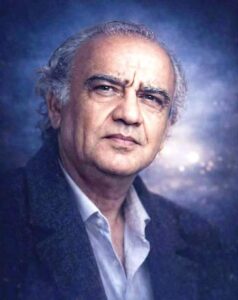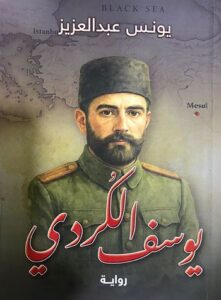ابراهيم محمود
في المشهد الحي والمباشر تلفزيونياً ” عبر قناة روداو ” لامرأتين كرديتين حديثاً: شنكالية وكوبانية، كانت كل منهما تقول: ليأتي العدو، لن نترك أرضنا! لم تكن المرأة الشنكالية على علم بالكوبانية، ولا كانت الكوبانية على علم بالشنكالية، فما أبعد شنكال الجبل عن كوباني السهل، وبالعكس، سوى أن التوحد الكردي مع المكان” الأرض ” هو الذي ألغى المسافة، هو الذي وحَّد بينهما: المرأة الكُردية !
كانت المرأة الكردية الشنكالية أو الكوبانية تقول بمزيد من ضبط النفس، وبعفوية عن أنها باقية، ولن تذهب إلى جهة أخرى، وهي بذلك تكون قد حددت جهاتها، عرَّفت بنفسها دون رتوش، أفصحت عن انتمائها الأزلي إلى المكان وعراقة التوحد.
في طريقة الكلام، ما كانت المرأة في الجهتين: الجهة الواحدة، تنظر إلى حيث يكون حامل الكاميرا، إنما حيث يكون امتلاءها بالمكان، كما لو أنها معنية به وليس بالصورة وبالناظر. للعلم، ولمن يريد التقاط حكمة الصورة، إن قيمة الصورة تتوقف أحياناً على زاوية النظر، والمرأة في الحالتين: الحالة الواحدة، وبعفوية لا صلة لها ببعد استعراضي، ما كانت تريد إرسالة بلاغ، أو إعلام أحد عمن تكون، بقدر ما كانت تريد الاستمرار، فالصورة طارئة، والمتحدثة متأصلة في المكان، وأكبر من حدث الصورة وتأريخه .
في أدبياتنا الذكورية النفاثة، يشار إلى الأرض على أنها شرفنا، أو عِرضنا ” عرض الرجل “، وأن المرأة شرف الرجل، عرضه، كما لو أن المرأة معطوفة عليه، أو مضافة إليه. إذاً ماذا يمثّل الرجل للمرأة ؟ ” تاج رأسها ؟ “، لغتها، صوتها، حاميها …الخ، في المشهد المذكور، ماذا يمكن أن يقال، وقد بدت المرأة في الحالتين: الحالة الواحدة، في وضع طبيعي، طبيعية ؟ ألم تعلمنا مجريات الأحداث بعد، بما يجب علينا التحرر منه، أو لزوم التخلص منه، وهو الخروج من وهم أنوية الرجل ؟ فما ترينا إياه الأحداث، وما أشيرَ إليه، لم يكن قائماً على تلقين في دور مسرحي، إنما هو وعي العفوية البليغ، وعي المرأة المتحد بالمكان.
المسافة الفاصلة بين المرأتين الكرديتين، هي عينها المسافة الفاصلة بين العينين في الوجه الواحد تقديراً، المسافة التي تعمّق آصرة العمل في الإبصار بينهما، كل منهما عين على المكان، والمكان وجه، والعين عين في الوجه وعلى المكان وبه..ما أبلغ التوحد هنا.
بين المرأتين الكرديتين : الشنكالية، والكوبانية، يظهر الوطن أكثر سموَّ معنى: الجبل الذي يتدعم بالسهل، والسهل الذي يُسنَد إلى الجبل، إنما في الميزة الجغرافية، ما ليس في الحسبان وهو قائم، هو أن كل امرأة كانت بجهة جغرافية تتكامل مع الأخرى وبها، إنما الأهم أيضاً، لمن يحاط بالجغرافيا علماً، هو أن الشنكالية كانت تسمّي في القرب منها حزامها” زنّارها ” المائي: دجلة للشنكالية، والفرات للكوبانية! أرأيتم أي باع طويل لحكمة التداعي في الوصل بين المرأتين، في فعل الوجد العفوي الفائض بالدلالات كردياً ؟
في المشهد الحي لكلتا المرأتين، كان ثمة فيض حياة، مقاومة دون رتوش: ليأتي العدو، كان ثمة إبلاغ لمن يجد سهولة في الانسلال من المكان، خوفاً على روحه، في حالات كثيرة، كان ثمة إدانة نافذة، كان ثمة أكثر من درس في حب الأرض، الوطن، الحياة، في اكتشاف المعنى الذي لا يحتاج إلى دورات تثقيف مدرسية أو تعبوية موجهة، ليكون المرء على بيّنة من هذا الحب، فالسهل الممتنع لاحدودي، ولعل الذي تفوهت به المرأة في الجهتين: الجهة الواحدة في وحدة الحال العظمى، وفي عدة كلمات، ما يبز خطابات حشودية كاملة.
في المشهد الحي للمرأة الكردية : الشنكالية وتوأمتها الكوبانية، أو بالعكس، تحضر كل النساء الكرديات في الجهات الكردية، كغيرهن من النساء المقاومات، وهن يتوحدن مع المكان، وهن يعلّمن الرجال المأخوذين بذكورتهم، أن خاصية حب المكان أبعد ما يكون عن الترقيم النوعي/ الجنسي، وأن القول الكردي المأثور şêr şêre çi jine çi mêre ” الأسد أسد : أنثى أم ذكر، أو: لبؤة، أم ذكر أسد “، وفي العبارة الكردية ثمة تطابق وتعالق لافت بين المفردتين وذهاب بالمعنى إلى خاصية اللغة أحياناً وروعة المعنى الكامن .
عود على بدء: ما أكثر ما يقال عن أن الرجل، وباعتباره ” علامة إخصاب ” للمرأة، وتكون هذه متلقية، كما لو أن المرأة وباعتبارها أنثى، سلبية في التلقي، منفعلة، والآخر هو الفاعل، سوى أن وقائع كثيرة تقول: إن ثمة غبناً كبيراً في رسم حدود العلاقة هذه، فالرجل الذي ” يخصب ” المرأة بعلامة ” رجولته “، تخصبه المرأة بحب الحياة، تعلّمه معنى أن يكون ضمن وسع الحياة ذاتها.
ولو أن أنهار كردستان كلها، استحالت مداداً، لو أن غابات كردستان، أو أشجارها كلها استحالت أقلاماً، لما كفتنا في التعبير الدقيق عن لحظات مشاهدة مقتطعة من الزمن لما رأينا في المشهد الحي والموصوف، وضمناً، لما كفتنا في نقل تلك المشاهد التي تفيض مآس وبطولات في آن لهؤلاء اللواتي تابعناهن، لهؤلاء الذين تابعناهم، ولا زلنا نتابعهن، ونتابعهم في مستويات عمرية مختلفة، في مشاهد تضعنا في الزمن المبثوث كردياً وإلى كل لغات العالم وشاشات تلفزته. فلنتعلم، ولو قليلاً، مما رأينا ونرى، لنكون أكثر انتماء إلى أنفسنا، إلى كرديتنا، إلى إنسانيتنا التي نريدها وننشدها كردستانياً .