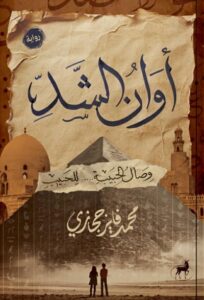أحمد اسماعيل اسماعيل
أحمد اسماعيل اسماعيلالطفل أولاً:
لنتفق أولاً على أن مسرح الطفل الجيد، مثل التعليم والتربية الصحيحين، يهدف إلى بناء شخصية الطفل بناءً منسجماً وسليماً، وهو يفوقهما بدروسه التي لا تلقن بالكتب بطريقة مرهقة، أو في المنزل بطريقة مملة، كما يؤكد مارك توين، الذي نعتقد معه، إن هذا الفن أعظم اختراع في القرن العشرين، لامتلاكه أساليب ووسائل جمالية وجميلة، تمكنه من تحقيق أكبر الأثر في شخصية الطفل على المستويات كافة (السلوكية والاجتماعية والعقلية ..)
وهو إذ يفعل ذلك؛ يهيئ، في الوقت عينه، الطفل للدخول إلى الحياة الوطنية الرحبة، وذلك حين يعالج هذا الجانب بأسلوب مقنع وممتع، لا يقتصر على الصراع مع العدو الظالم والغاصب، أو تقديم الأحداث التاريخية المضيئة، أو الشخصيات الوطنية البارزة في التاريخ القديم أو الحديث، أو المواقع الأثرية.. فحسب، على الرغم من أهمية ذلك، بل يشمل، وقد يتقدم، في كثير من الأحيان، موضوع الإنسان الشريك في وطن الطفل، فرداً كان هذا الشريك، أم جماعة، المغاير له ديناً، أو مذهباً، أو لغة، أو أي انتماء آخر مختلف عن انتمائه، ليعرف الطفل المتلقي في المسرح هذا الشريك، بدون تشويه أو تزييف
ويتعرف إليه، ويتواصل معه في الواقع عبر حوار صادق أساسه الحب والاحترام، كي يستمر، ويطرح ثماره المرجوة، من تآلف، واحترام، وتماسك، ووحدة. فإذا كان الحوار في المسرح يلم شمل المسرحية بكل ما فيها من اختلافات وتناقضات، في وحدة النص أو العرض، فإنه في المجتمع يعتبر ضمانة لجمع شمل كل المكونات الوطنية المختلفة، في وحدة أشبه باللوحة التشكيلية، يكسبها تمايز ألوانها تميزاً إبداعياً.
غير أن ذلك كله لن يتحقق إلا بمسرح جيد، مدرك لواقع الطفل، ملتزم بواجبه نحوه، لا يقدم للطفل مواضيعه، مهما سمت، بهدف تطويعه، أو تدجينه في أية حظيرة اجتماعية، أو سياسية كانت، بل يكون هدفه هو تحرير طاقات وقدرات الطفل من كل قيود التعليم التلقيني، وتربية الزجر، وفقدان الثقة، والتعصب، بأساليب ووسائل ومعالجات تضمن تحقيق هذا الهدف النبيل، وبدون ذلك لن يصلح المسرح ما قد يفسده التعليم والتربية.
إذا اتفقنا على كل ما سبق قوله فإننا سنتفق على أن ما يتم تقديمه من مسرحيات للطفل في سوريا المتعددة المذاهب والقوميات والأثنيات، لا يخدم في شيء هذا الجانب الذي ظل مغفلاً أو هامشياً، فالوطنية التي تناولها هذا المسرح اُختزل في خانة ضيقة وموظفة إيديولوجياً، ولم يستطع المسرح أن يرتقي بها إلى ما هو أفضل، أو يتجاوز الخطوط الحمر التي حددها له أولو الأمر من الساسة ووكلائهم في دوائر التربية والفنون؛ وطنية تتجسد في مآثر الأجداد، في معاركهم التي خاضوها والانتصارات التي حققوها على الأعداء، وخاصة الأعداء الذين يناصبهم هذا النظام العربي أو ذاك العداوة، الفرس بالنسبة لنظام هذا البلد في مرحلة ما، أو الترك بالنسبة لنظام عربي آخر في مرحلة معينة من مسيرته وعلاقاته الدبلوماسية أو السياسية، أو حتى الاستعمار الأجنبي، الفرنسي أو البريطاني، وإن بكثير من الدقة والحساسية، وكم من مسرحية مُنعت من العرض بسبب هذا التوجه.
أما التجسيد الثاني للوطنية المسموح به في المسرح، ومسرح الأطفال خاصة، فقد تمثل في ذكر الأوابد التاريخية من مواقع أثرية ومعالم حضارية قديمة وقلاع وما شابه ذلك، وهو أمر يكاد أن يكون حيادياً وأقرب إلى الرومانس؛ فكراً وعاطفة.
ورغم أهمية ذلك بالنسبة للطفل الذي ينبغي أن يكون ذلك جزءاً من ذاكراته الوطنية وتربيته، وإن بشكل غير انتقائي أو مضبوط على إيقاع سياسة النظام وعلاقاته وتوجهاته، شعارات وصيحات لا تنتج سوى مشاعر ومعلومات تخزن في الذاكرة لحين الطلب ولا تستثمر بما يخدم الوطن، دون أن يولي المسرح المعني بالوطنية معايشة وعلاقات أي اهتمام، وطنية أساسها تقبل الآخر والشراكة معه في وطن للجميع، جميع ألوان الطيف الوطني، وقد كان لذلك أثره على أطفال الأمس وشباب اليوم، الذين استنكروا على من يحدثهم عن الوطنية بغير ما سمعوا ورأوا وقرأوا وتربوا عليه. لينقلبوا عليه وعلى من سحرهم أيضاً بتعاويذه الاستبدادية والشوفينية. ناقمين عليه وعلى مسرحه، بل وعلى فن المسرح وكل ما يتعلق بما هو جميل من إبداع وتربية وفكر في هذا الربيع الذي تكسرت فيه الأحلام على موجة الصقيع القاتلة.
المسرح معلباً :
في مناخ غير صحي، ملوث بالاستبداد، لا يمكن عزل أو استثناء حقل ثقافي، أو حتى غير ثقافي، عن آثار هذا المناخ، بهذا القدر والشكل، أو ذاك، ولذلك سيجد المتتبع لنشاطات هذا المسرح في سوريا وتاريخه أنه لم يكن فناً خالص النية، يقصد به الارتقاء بذائقة الملتقي، الراشد والطفل، وتوعيته، وتثبيت وجوده فناً مدنياً في اللوحة العامة للثقافة الوطنية، وقد تجلى ذلك أكثر ما تجلى في سياسة تدجين هذا الفن، وخاصة من جهة عروضه، في المؤسسة الرسمية، البعثية، والمتمثلة في منظمتي: اتحاد شبيبة الثورة، ومنظمة طلائع البعث.
يقول مفكر “حتى الساعة المعطلة تكون صحيحة قي اليوم مرتين”، وفي تجربة هاتين المنظمتين اللتين أساءتا لمسرح الطفل بشكل خاص، وللطفل المتلقي، لا نعدم ما هو ايجابي، فطلائع البعث استطاعت في بداية أمرها، من سبعينيات القرن الفائت حتى بداية الثمانينات منه، استقطاب أقلاماً لها حضورها في الساحة الثقافية، أغنت هذا الحقل بما قدمته من نصوص مسرحية للأطفال، إضافة إلى ظاهرة المهرجانات التي كانت تقيمها المنظمتان في كل سنة، والتي كانت أشبه بعرس لكل المعنيين بفن المسرح.
غير أن وصاية الحزب على المسرح، لا رعايته، قد عطلت هذا الصحيح أيضاً، ليتحول من كان يكتب لمنظمة الطلائع إلى موظف، وذلك بعد هجرة كتاب كثر لها، ولتتحول المهرجانات الشبابية التابعة لمنظمة اتحاد شبيبة الثورة إلى استعراضات ومناسبات للتكسب وترجمة سياسة الحزب فنياً.
وإذا كان كل ما قدمته هاتان المنظمتان في مجال المسرح لم يكن في حقيقته سوى نشاطات فنية لصالح الحزب وأهدافه، فذلك لأنه كان مسرحاً حزبياً لا وطنياً، الممثل فيه وسيلة دعاية، وإعلان، والمتلقي زبون ومستهلك لا مواطن. وفي ظل مثل سياسة كهذه كان من الطبيعي أن يفتقر هذا المسرح إلى أي شكل من أشكال الوطنية القائمة على أساس الشراكة، والتفاهم والتعايش المشترك، أو تحقيقاً لمصداقية العمل المسرحي الذي تقدمه فرق المنظمات، والذي لا ينهض إلا على أساس قبول الآخر والاعتراف به، وعلى التعاون والتفاهم، وكل ذلك من خلال الحوار، فلا مسرحية بلا حوار، حوار ظاهر بين الشخصيات في العرض المسرحي، وحوار مضمر بين هذه الشخصيات والمتلقين في صالة العرض، وحوار بين الصالة والمدينة. كما نوه إليه المسرحي المعروف سعد الله ونوس في كلمته الجوع إلى الحوار، الأمر الذي كان يدركه النظام، ويخشاه، لذلك سارع منذ بداية تسلمه السلطة إلى تدجين هذا الفن في مؤسساته الرسمية، الحزبية، وحتى غير الحزبية مثل مديرية مسرح الطفل والمسرح القومي، التي لم تكن، هذه المؤسسة، تتناول سوى القضايا العامة، مثل الحرب، الاستبداد، الفساد..دون تحديد المكان والزمان المسرحيين، وفي المرحلة الأخيرة قضايا فردية صرفة، تماشياً مع المسرح التجريبي وما افرزه، ولو في جانب من جوانبه، من هلوسات، كالمبالغة في معالجة موضوع الشذوذ الجنسي. ولم يختلف الأمر في مسرح الطفل غير الحزبي، عن المسرح القومي أو العمالي.. أو المعهد العالي للفنون المسرحية. حيث تكاد جلُّ المواضيع تنحصر في تصوير العدو الخارجي على أنه وحش كاسر، وأحياناً كائن خرافي، أو معالجة مواضيع تربوية عامة..سلبية، دون المساس بما هو داخلي، أو الإشارة إلى مسبباتها، ولو من طرف خفي. بقصد المعالجة، وتجاوزها، وتهميش مواضيع أخرى حيوية وساخنة، مثل الطائفية التي أيقظها النظام وأذكى نارها منذ بداية الثورة، وكذلك قضية القوميات، وخاصة القومية الكردية، التي تجاهلها المسرح السوري كما فعل النظام في كل مفاصل الحياة السورية، ليتجاوز هذا التجاهل والتهميش النظام إلى معارضته، في الأدب والمسرح، كما في السياسة، إذ لا يمكن لأي متابع أن يلتقط ولو جملة واحدة تخص الكرد، شخصيات، أو حدثاً، أو مكاناً.. في كتابات مبدعين كبار لم يكونوا في حالة انسجام وتوافق مع النظام، أمثال سعد الله ونوس وممدوح عدوان ومحمد الماغوط وغيرهم.
وإذا كان الفنان همام حوت قد أنفرد بهذا الموقف، وأظهر الكردي في مسرحيته المعنونة (ليلة سقوط بغداد) في شخصية مستو الكردي، فقد قدمه بصورة أقرب إلى السذاجة والتهريج منها إلى الشخصية الدرامية ذات الجذر الواقعي، ووضع على لسانها عبارات وأقوالاً وأفكاراً لا علاقة لها بالشخصية الكردية الواقعية والحقيقية. وتوجهاتها السياسية، وكل ذلك بهدف تجسيد مقولة وطنية رومانسية عامة تدعو إلى المحبة والتعاون من أجل مجابهة مؤامرات العدو الخارجي، والتغاضي عن الثغرة التي هيأها الاستبداد للعدو الخارجي.
عدا ذلك لم يسجل للمسرح السوري ، كتابة ونصاً، أي حضور للكردي، وللتركماني أيضاً، وللكلدو أشوري..حتى ولو بشكل سطحي ومفبرك كما قدمها همام حوت في مسرحيته المذكورة، فيما انصرفت معظم الكتابات والعروض المسرحية إلى الحديث عن العمال والفلاحين والمهمشيين واليساريين والبعثيين والعدو الخارجي المتمثل في العدو الإسرائيلي أو الأمريكي..في تجسيد وترجمة لإيديولوجية اليسار العربي الذي تناغم في موقفه من المكونات الوطنية من غير العرب مع سياسة النظام وثقافته.
الأمر الذي أثبت خطأ كل ما ذهب إليه المسرح السوري في هذا الاتجاه، ففي الوقت الذي فشل فيه رهان اليسار على العمال والفلاحين، لأسباب تاريخية وسياسية يطول شرحها، ظهر دور المكونات المهمشة أكثر فاعلية في مجريات الثورة التي لم تكن عمالية أو فلاحيه بل وطنية، ونتيجة تهميش المثقف والمسرحي والسياسي لهذا الجانب، أستطاع النظام وقوى أخرى لا تختلف عنه كثيراً، من كسب الرهان، ولو في هذه المرحلة التاريخية التي لما تنته بعد، وذلك اعتماداً على الجدران الوهمية التي أقيمت بين هذه المكونات، رغم حالة السلام والاستقرار التي كانت سائدة بينها.
الفعل ورد الفعل مسرحياً :
هذا التجاهل للمكونات الوطنية في المسرح، وعلى كافة المستويات، لغة وأحداثاً وشخصيات وهموم.. من قبل مسرح النظام وكتاب مسرحيين آخرين، غير محسوبين على النظام، حزبياً، دفع هذه المكونات إلى البحث عن مسرح يعنيهم هم، يتحدث عن همومهم وقضاياهم بلغتهم.
ليتم تشكيل العديد من الفرق المسرحية الكردية بالدرجة الأساس، وفرق أخرى: سريانية وأرمنية وأشورية، وخاصة في منطقة الجزيرة السورية التي تنفرد، دون باقي المدن السورية الأخرى، بأنها تضم كل ألوان الطيف الوطني السوري. ومن أهم هذه الفرق يمكننا أن نشير إلى: فرقة (هامازكين) الأرمنية. وفرقة خلات ونارين وشانو وميديا الكردية. وفرقة نصيبين السريانية وأورنينا الأشورية..
إذا كان من الطبيعي تقديم مسرحيات بالكردية والسريانية والأشورية والأرمنية. وذلك نتيجة سياسة المنع والتهميش التي مارسها النظام ضد كل مناحي الحياة التي تخص المكونات الوطنية فقد كان لرد فعل هذه الفرق ما يشابه فعل النظام من الناحية الوطنية، إذ يكاد كل ما تم تقديمه من مسرحيات، لدى هذا المكون أو ذاك، يقتصر على ما يخصه فقط، دون أي حضور للشريك
الآخر في الوطن، وقد كان لهذا التوجه واستمراره في المسرح، كما في حقول إبداعية أخرى، ترسيخاً للجدران الوهمية التي أقامها النظام بين مكونات وأطياف الوطن الواحد، أثمرت نبتاً شيطانياً في أماكن وزوايا معتمة من هذا الوطن الواحد، وتأتي العروض المسرحية الموجهة للأطفال في هذا الاتجاه من قبل الجميع. بمثابة إنتاج لحالة التنابذ والتجاهل في المستقبل، عبر ترسيخ ثقافة الكانتونات الوطنية على أساس قومي أو طائفي أوديني، واعتبار مواطنه المختلف عنه لغة أوديناً أو مذهباً، العربي أو الكردي أو التركماني أو الأشوري خصماً وليس شريكاً له. من المفيد أن نؤكد إن فناً إنسانياً مثل المسرح، الحوار سقفه والاعتراف بالآخر ركنه، لا يمكن أن يحقق أهدافه لدى أي طرف ينفي الآخر ويتنكر للحوار معه. فالمسرح بالذات، وسيط حضاري يمكن أن يساهم في تدعيم قيم التعاون والتفاهم وتقبل الآخر عبر حوار وطني وإنساني.
الوطن مثل المسرح، لا يمكن له أن ينجح إلا بتضافر جميع عناصره ومكوناته.
صحيفة القلم الجديد العدد 55 سنة 2016