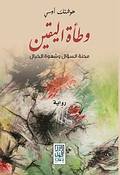بسمة علاء الدين
بسمة علاء الدين«العابرون بهذه الأسطر، عابرون بأنفسهم. والماكثون فيها، ربما ينتظرون عابراً معيّناً، ينتشلهم مما يجهلونه ويجهلهم. منهم من يعتبرُ الخشية من الحقيقة، حقيقة. والمروق منها باطلاً. والباطل بتجلّياته، هو أيضاً حقيقة. ومنهم من يخشى أن تكون الروحُ رسالة الجسدِ، والجسدُ آبداً، والروحُ فانية. وثمّة من يخشى أن تكون الروحُ والجسدُ، رسالتين متضاربتين، خطّهما، ويخطّهما المجهولُ لمجهولٍ آخر». هكذا افتتح الشاعر والكاتب السوري هوشنك أوسي روايته الأولى «وطأة اليقين».. محنة السؤال وشهوة الخيال» الصادرة في 380 صفحة عن «دار سؤال» في بيروت.
بدأت الرواية بفاتحة هي نفسها الخاتمة أيضاً الموجودة على الغلاف الخلفي للرواية، ليخلق الكاتب حالة إحاطة واشتباك بين القارئ وأبطال الرواية، ولإشراك القارئ في كتابة هذا العمل السردي عبر فعل القراءة. وجاءت لوحة الغلاف للفنان العراقي ستّار نعمة المرسومة بتقنية التجريد، لتثير مساحاتها اللونية المتداخلة والمبهمة بعض الأسئلة. وبعد الانتهاء من قراءة العمل، نجد أن اللوحة وكأنّها تعبّر عن تنوع الأماكن والأحداث داخل الرواية التي تتوزّع على مناطق جغرافية متعددة، حيث تشبه اللوحة الصورة الملتقطة للأرض عن طريق الأقمار الصناعية، فهناك مساحات رمادية وأخرى خضراء وصفراء وحمراء، بحيث عسكت حالة تنوع الألوان تنوع الأمكنة أيضاً، بما فيها من الحروب والفقر والاستبداد، وأماكن خضراء تنعم بالحرية والأمان.
تبدأ الرواية من بلجيكا حيث يقيم الراوي، لتمتد نحو بقع جغرافية متنوعة في العديد من الدول، وتتشابك القصص في نقاط زمنية مختلفة، مع التركيز على فترات حاسمة في تاريخ سوريا وبداية ثورتها عام 2011. استند الكاتب في روايته إلى تقنيتين، الأولى؛ أسلوب التهكم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. والثانية؛ الإرجاء في الأحداث لشخصيات الرواية، حيث تُبتنى السرديات الكبرى والتشابكات والتعقيدات المتداخلة في القصة حول التاريخ والثقافة والهوية القومية، ومأساة المجتمع الرازح تحت وطأة جور وطاغوت النظام الفاسد والمستبد، وحالة الكذب السياسي والاجتماعي والثقافي، على الذات في حالات كهذه. ومن ثم تستكمل الأحداث في مدينة «أوستند» البلجيكية، لتستحوذ الرواية على إشارات زمنية تحيل دائماً إلى زمن مرجعي يسكن خلف الحكاية، فيدخلنا في نفق الحكاية التي تقف خلفها حكاية اخرى… وهكذا دواليك. فيسرد الكثير من التفاصيل حول كاتب سوري علوي معارض، يدعى «حيدر السنجاري» الذي قضى خمسة عشر عاماً في المعتقل، وبعد الإفراج عنه، دخل في سجن اليأس والقنوط والتيّبس الفكري والروحي، بحيث صار يجد السجن الخارجي أرحم من السجن الداخلي، وصار يحنّ إلى السجن السابق هرباً من مرارة السجن الجديد – الحياة الذي يكابده، حتّى أعادت ثورة تونس إليه التفاؤل منذ أن أحرق البوعزيزي نفسه وأشعل ثورتها، لتمتد بعد ذلك إلى مصر، وتقتلع صنماً آخر من الأصنام الجاثمة على صدور الشعوب العربية منذ عقود. وبعد عودة الأمل وتفاعله مع الثورات بوصفها ولادة جديدة للشعوب، اتجه حيدر مرة أخرى للكتابة، ليراسل صديقه الأرمني وشريكه في الانتماء السياسي وفي المعتقل أيضاً «هاغوب زرادشتيان» المقيم في السويد. وجاء في رسالته الأخيرة: «أحلم بأن أقدّم شيئاً لهذه الثورة التي أعادتني إلى الحياة. غداً سأخرج في مظاهرة جمعة أزادي. ولا أعرف إن كنتُ سأعود إلى بيتي». لكن سرعان ما يتمّ اعتقاله مره أخرى ويموت تحت التعذيب، ليتم استئصال أعضائه، وإرسالها عبر شبكات ومافيات الاتجار بالأعضاء إلى أوروبا. وصلت هذه الأعضاء إلى بلجيكا، وتم زرعها فى أجساد ثلاثة أشخاص يعيشون فب هذا البلد؛ الشاب الإيطالي جورجينيو والفتاة الألمانية كلارا والشاب الكونغولي رولان، ليلاحظوا جميعاً حدوث تغييرات طرأت على سلوكهم وأمزجتهم بعد عمليات زرع اعضاء (الكلية والكبد والشبكية) التي أجريت لهم في المستشفى نفسه وفي فترات متقاربة، وصاروا يتساءلون حول إمكانية انتقال الأمزجة والأفكار والميول عن طريق نقل هذه الأعضاء؟ كونهم صاروا يميلون نحو الثقافة والأدب والفن، والتفاعل مع الثورات، ما أثار الشك لديهم. وبدأت الأسئلة الأخرى تتوالد تباعاً حول احتمال أن تكون الأعضاء لشخص واحد؟ ومن هو هذا الشخص الذي تتوزّع روحه على أجساد هؤلاء الأصدقاء الثلاثة؟ دفعهم شغف السؤال للبحث عن هوية الشخص ومعرفة سبب وفاته. وهنا تبدأ الحبكة البوليسية وجرعة التشويق، ليتوصلوا أخيراً إلى أن هذا الشخص هو كاتب سوري معارض «حيدر السنجاري». وتكتمل الصورة لدى رولان، كلارا وجورجينو بعد استماعهم لأحاديث شقيق حيدر، الضابط المنشق عن جيش الأسد المتواجد في تركيا، والاستماع لأحاديث هاغوب المطولة، صديق حيدر، وعن تجربتهما في السجن، وما كان يرويه حيدر عن أسرته وقريته وجده. وقراءتهم رسائل حيدر الأربع الاخيرة التي نجت من التلف.
أخذت بعض أحداث الرواية أبعاداً فلسفية برزت فيها الحوارات الداخلية التي تشارك القارئ في الصدمات العاطفية التي تجعله يضحك ويبكي مع تسلسل أحداث الرواية، والنقلات المفاجئة في الأحداث بطريقة واعية، تخلق مساحة من التأمل، وحيّزاً من التفكير لدى القارئ. تزدحم الأحداث لترهق القارئ، فيرى نفسه منها، ويسمع صوته داخلها. وثمة ما يشبه توريط القارئ في إعادة إنتاج النص، عبر القراءة. على سبيل الذكر لا الحصر: تجربة المرأة البلجيكية المسنّة كاترين دو وينتر. وتجربة الشاب الكونغولي رولان بونيوبا، والشاب الكردي ولات أوسو، هي تجارب إنسانيّة، يمكن أن يجد القارئ نفسه فيها.
اعتمدت الرواية في نصها السردي وتحديدها للإحالات الحديثة على «فضاء تاريخي» ليس من الأساسي الانشغال بمدى مطابقته للواقع، لأنه، حتماً لن تكون هنالك مطابقة. فتأخذ الأحداث التاريخية أبعاداً جديدة يمنحها التخيّل عبر اللوحات والمشاهد الروائية، حيث تناول السرد الأحداث في تونس وتجربة بورقيبة والديكتاتورية التي أسسها وتجاوزها كل حدّ، وعلاقة تلك الديكتاتورية بالنظام المصري أيام الرئيس جمال عبد الناصر، والنظم الاستبدادية العربية الأخرى. فحاول الكاتب اختلاق بعض الشخوص والجوانب أو الأحداث، التي لم تكن موجودة في الرواية الرسمية. مثلاً حادثة اغتيال نظام بورقيبة للمعارض التونسي صالح بن يوسف، الحادثة حقيقيّة، لكن الكاتب أضاف إليها مجريات وشخوصا متخيّلة. ويبدو أن هذه التقنية استخدمها الكاتب في أماكن أخرى، للطعن في الرواية الرسمية للأحداث، عبر اختلاق أحداث موازية تربك أو تشكك في الرواية الرسمية، ليس فقط في سرد القصة التونسية وحسب، بل أثناء سرد القصة الفلسطينيّة والقصة الكردية والقصة المصرية أيضاً، حيث يتشابك الزمن الواقعي بالزمن المتخيل، ليولد زمناً خاصاً يتلاءم مع الوضع المتأزّم، زمنا آخر يقاس بدرجة الضغط الداخلي الذي تتعرّض له شخوص الرواية من خلال نسج علاقات متشابكة ومركّبة بين الرواية والتاريخ.
التخُيل التاريخي في هذه الرواية، يجعل الحالة الثقافية والسياسية في هذه الأوقات أيضاً قيد المساءلة، ذلك أن اشتغال السرد على بعض الوقائع التاريخية وإضافة قصص خيالية، وتقديمها بحبكة ذات مستويات متعددة، لتخرج الرواية من إطار التاريخية، إلى فضاء نص أدبي يضم بين طيّاته العناصر والقيم والاسئلة المعاصرة أيضاً. ولعل هذا ما جعل من الرواية قيمة أدبية متميزة. إلى جانب ما سلف ذكره، ثمة اشتغال على تقنيات متعددة أثناء كتابة هذا النص الروائي، عبر توظيف عقيدة التقمّص وتناسخ الأرواح، بالإضافة إلى حضور النَفَس الصوفي التأمّلي في القسم الأخير من الرواية. واختتم أوسي روايته بنهاية مفتوحة على احتمالات ترك للقارئ تخمينها.
باختصار: «وطأة اليقين»؛ رواية تتزاحم في فضاءاتها القصص والأسئلة والخيالات. وربما هكذا هي الحياة التي من المفترض أن تعكسها السرود الروائية.
٭ كاتبة مصرية
صحيفة القدس العربي