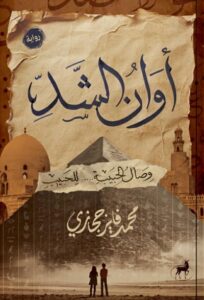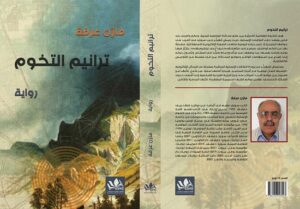خالد إبراهيم
خالد إبراهيمفي عام 1990 كنتُ أتخيل أنه في عام 2020 ستكون هناك سيارات تعمل على الهواء، و طائرات تغطس في المياه، و كواكب أخرى نستطيع شراء حاجياتنا منها، فانتهى بنا الأمر لنتعلم كيف نغسل أيدينا، و كيف ندير شؤوننا اليومية .
في عام 1990 كنتُ قد رسمت في مخيلتي عام 2020 و ما بعده فضاءا أستطيع أن أقوده و أنا على فراشي ، انتهى الأمر و أنا على فراشي أتابع أعداد الضحايا الهائلة و التي تتساقط كُل يوم أسوةً بالضحايا السوريين الذين ماتوا بسبب إجرام الأسد، و أمام أعين العالم، دون أن تقشعر لهم الأبدان .
أتساءل ، بل هناك أسئلة جمّة أبحثُ عن أجوبة لها مِثل المُصاب في حقل ألغام ورقية ، ورقية مطلية بهول هذه الجائحة المطاطية ، حيث لا مفر من النفس ، النفس الأمَّارة بالسوء على حين غفلة مِن ذواتنا الهشة السيئة الصيت و العادات و التقاليد البالية .
هل يحق لكل مِنا إعادة التأهيل الأخلاقي و الديني اللذين يُديران بوصلة أيامنا الاجتماعية ؟
هل انتهى زمنُ الصفاء الذي كان كفيلا بزرع الحب و التفاؤل ؟
لم يعد هناك متسع من الوقت ، فحتى الوقتَ بات ملغوماً مسموماً بكل شيء ، الوقت الذي بات أقصر من مُدّة شرب فنجان قهوة ، أو حتى رؤية سحابة سيجارة و أنا على شرفة منزلي في الطابق الرابع و الألف صرخة و ألم .
ليتنا جميعًا نمتلكُ الجرأة ، قائلين عَن هذا الفايروس ما لا تستطيع ضحية واحدة قوله ، بل نمتلكُ من الجُبن ما يكفي لزيادة قوة هذا الفايروس لحرق الجلود و الوجوه و الضمائر المائلة للخراب المتخثر تحت عرش الله .
أغلب الأوقات ، أقول لنفسي ، متمنيا أن يغزو هذا الوباء كُل مدن العالم ، حتى في كل شارع و على كل رصيف ، عندما أتذكرُ الأرصفة السورية ، الأرصفة التي وطأتها أقدام الملاعين و ضعاف النفوس من كل دول العالم لتذبح و تحز عنق الأطفال و تسلخ و تغتصب ، و تمضي دون رادع أو حتى حساب مِثل هذا اليوم .
كُلنا خطاؤون ، لأننا بشر ، حتى الأنبياء أخطأوا ، فكيف بالأصدقاء ، أصدقائي الذين بللتهم مياهُ التشتت و غيبهم هواء الخريف الطاعن ، لا شيء يدعو للتفاؤل غير هذا السرير الذي أتمددُ فيه مِثل جثة ، لا شيء يستطيع انتشالي مِن فوهة هذا البئر المليء بالأفاعي و وبر العقارب ، و طعنات الاقارب سوى زوجتي .
زوجتي هي الفاصل الأول و الأخير بيني و بين هذه الجثث ، و مدن الخراب المصطنعة ،
هذه المرأة التي تحجز بأصابعها عني كل داءٌ ساخنٌ و باردٌ لا أشتهيه ، هي التي تستطيع دفع ظلم أمريكا و زغاريد المجوس التي تصدع أذني كل مساء ، أمريكا أم الوباء و الويلات على أطفال هذا العالم الممتد بين الشاطئ والماء ، المغروز مِثل خنجرٌ بين ملمس العشب و طعم الماء ، زوجتي التي أتمنى أن تُنجب لي طفلا صغيرا مُبتسم ، يضيء عتمة أيامي الباقية و كفى كي أنهض و أشيرُ بأصبعي لهذا العالم القبيح قائلا :
أنا الذي فقأت اعين الملاعين و مضيت دون أن التفت خلفي
أحببتكِ أنتِ
أخترتكِ أَنْتِ ، كَي تَتَّسِع بُقعة الْأَرْضِ الَّتِي أقفُ عَلَيْهَا
كَي أَحْيَا ، كَي أرْتَعَش مِثل عُصْفُور بَيْن يديكِ
كَي أَرَى الْأَمْوَاج و ضِلَع الْمَسَافَة بَيْن الشَّاطِئ و الْمَاء
كَي أُفرقُ بَيْن مَلْمَس الْمَاءُ وَ رَائِحَة العُشْب
كَي أَرَى النَّوَاقِيس و النُّجُوم و بَريق عينيكِ .
كي أنتشلَ خراب هذا الجسد بعيداً ، و أحتضنُ زجاجة العمر عبر فوهة مُعلقة على باب قلبكِ
أنظرُ مِن حولي ، تتقاذفني أخطائي كالسكاكين و فوهات المدافع ، وحيدا عارياً و بيديَّ هاتين ، قمرٌ يحترق على وسادة بيضاء
يخرج بركانٌ مِن فمي ، أسقطُ بين يديكِ مِثل الأخرس الموبوء بالطاعون و رائحة التبغ يفور من جلدي الأسمر الهارب نحو جنون عشقكِ الذي لا ينتهي