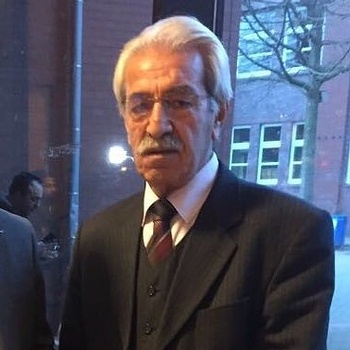حيدر عمر
تمهيد.
الأدب المقارن منهج يعنى بدراسة الآداب بغية اكتشاف أوجه التشابه والتأثيرات المتبادلة بينها، ويكون ذلك بدراسة نصوص أدبية، كالقصة أو الرواية أو المقالة أو الشعر، تنتمي إلى شعبين ولغتين أو أكثر، و تخضع لمقتضيات اللغة التي كُتبت بها. ترى سوزان باسنيت أن أبسط تعريف لمصطلح الأدب المقارن هو أنه “يعنى بدراسة نصوص عبر ثقافات مختلفة، وأنه واحد من مجالات الدراسة البينية، وأنه يهتم بأنماط العلاقات في الآداب عبر كلٍّ من الزمان والمكان”.
و يعرِّفه الدكتور محمد غنيمي هلال بأنه “يدرس مواطن التلاقي بين الآداب في لغاتها المختلفة، وصلاتها المعقدة، في حاضرها أو في ماضيها، و ما لهذه الصلات التاريخية من تأثير أو تأثُّر”. وهو ، حسب جون جاك أمبير، أحد الأثافي الثلاث التي يكتمل بها تاريخ الأدب وهي تاريخ الأدب والنقد الأدبي ونظرية الأدب ويعرِّفه بندتوكروشيه بأنه “اسم جديد لنوع من الخبرة هي موضع التبجيل على مرّالعصور”.
نستنتج مما تقدم أن الأدب المقارن في دراسته النصوص المنتمية إلى لغات مختلفة يلعب دوراً كبيراً في تاريخ الآداب القومية بما يضيفه إليها من الآداب الأخرى، بحيث يفتح الطريق أمامها إلى آفاق إنسانية أكثر رحابة.
ظهر هذا النوع من الدراسات المقارنة، أول الأمر في فرنسا من خلال عمل قام به جان فرانسوا ميشيل في جمع عدد من النصوص الأدبية ونشرها عام (1816). أما في الأدب العربي فقد ظهرت المحاولات الأولى في هذا الميدان في منتصف القرن التاسع عشر بفضل روّاد النهضة العربية، الذين ركَّزوا على دراسة التشابه والاختلاف بين الأدب العربي والآداب الغربية الحديثة، كدراسات رفاعة رافع الطهطاوي و علي مبارك وأديب إسحاق وأحمد فارس الشدياق وغيره.. أما في الأدب الكوردي، فلم أقع على دراسات من هذا النوع، ولكن هذا لا يعني خلوَّه من هذا النوع من الدراسات الأدبية والفكرية.
ولا يكتمل الحديث عن الأدب المقار ن ما لم نمرَّ على دور الترجمة في الدراسات المقارنة، فهي تلتقي معها في تقريب الشعوب من بعضها والتعرُّف على قيمها وفكر ها، وفي نقل الأفكار بين الشعوب. ومن هنا تكون الترجمة ضرورية في الدراسات المقارنة، وخاصة للدارس الذي لا يعرف لغات الآداب التي يعقد المقارنة بينها، عندئذ تقدم له الترجمة العون الكبير في إنجاز دراسته.
و نحن إذ ندرس في هذا البحث نقاط التشابه و التأثيرات المتبادلة بين عدد من الحكايات الشعبية التي تنتمي إلى بعض الشعوب الآسيوية في أحداثها وأهدافها وشخصياتها، ننطلق من أن بعض المشتغلين بدراسة الأدب يقولون “إن الأدب المقارن يعني أول ما يعني دراسة الأدب الشفهي وبخاصة موضوعات القصص الشعبي وهجرته، وكيف ومتى دخل حقل الأدب الفني الذي هو أكثر رقياً منه، وذلك لأن الأدب المكتوب يتأثر كثيراً بالأدب الشفهي”.
في دراستنا هذه لن نقوم بتحليل الحكايات الشعبية التي يشملها البحث على ضوء المنهج الوظيفي للباحث الروسي فيلاديمير بروب، الذي حدَّد إحدى وثلاثين وظيفة في الحكاية الشعبية، ولكنه لا يفترض توفُّرها جميعاً، باستثناء سبع أو ثمان منها، في كل حكاية، بل سنقتصر على دراسة مضامينها لتتبيَّن لنا نقاط التلاقي فيها والتأثيرات المتبادلة فيما بينها.
تعريف الحكاية الشعبية.
الحكاية لغة. جاء في لسان العرب: الحكاية من حكى يحكي، كقولك حكيتُ فلاناً وحاكيته: فعلتُ مثل فعله أو قلتُ مثل قوله، وحكيتُ عنه الحديثَ حكاية، وحكوتُ عنه حديثاً في معنى حكيته”.
وفي القاموس المحيط “حكوتُ الحديث أحكوه، أي حكيتُه أحكيه. وحكيتُ فلاناً و حاكيتُه شابهتُه و فعلتُ مثله أو قوله سواءً، وحكيتُ عنه الكلام حكايةً نقلتُه”.(8)
أما اصطلاحاً. فإن الباحثين يسردون تعريفات متعددة. فالباحثة نبيلة إبراهيم تستمد تعريفها من المعاجم الألمانية فتقول: “إنها الخبر المتصل بحدث قديم ينتقل عن طريق الرواية الشفوية من جيل إلى جيل، أو هي خلق حرٌّ للخيال الشعبي ينتجه حول حوادث مهمة وشخوص ومواقع تاريخية”. و تنقل عن المعاجم الإنكليزية أنها “حكاية يصدقها الشعب بوصفها حقيقة، وهي تتطور مع العصور، كما أنها قد تختص بالحوادث التاريخية الصرفة أو الأبطال الذين يصنعون التاريخ”. وهي “جزء من تراث الإنسان الفكري والديني والواقعي الذي تشترك فيه الشعوب دون استثناء”.
وبهذا المعنى، تُصنًّف الحكاية ضمن الأدب الشعبي، باعتبارها أحد أنواعه، ونتاج معتقدات الناس وعاداتهم وعواطفهم، وهي عريقة وموغلة في القدم، ومهما اختلفت حكايات الشعوب عن بعضها بعضاً، فإنها تلتقي عند العراقة والقِدَم، إذ يربط الباحث محمد بوزكويان ظهورها بظهور البشرية، فيقول “يمتد تاريخ ظهور الحكاية الشعبية إلى تاريخ ظهور البشرية، ومهما كان ثمة اختلافات بين حكايات الشعوب، فإنها تشترك في الاعتقاد بوجود الحكاية مع أول وجود للبشرية”. وهي كذلك على رأي الكاتب السوري عادل أبو شنب أوغل قِدَماً في التاريخ الفكري للبشرية من القصة المكتوبة. ويرى الكاتب السوري الآخر ميخائيل عيد أن أثرها أو أسلوبها يتخلل مختلف ميادين الكتابة والعلوم.
ترتبط الحكاية الشعبية بأفكار وموضوعات وتجارب متعلقة بالإنسان، ومن هنا تكون مادة خصبة للدراسات الاجتماعية والتاريخية والفكرية والدينية. وهي تحكي حدثاً قد يكون واقعياً، وقد يكون من نسج الخيال، بحيث يلعب الخيال دوراً كبيراً في صياغته أحداثاً واقعية، ربما حدثت بالفعل، وأخرى خيالية، فيكسبها قدرة هائلة على جذب انتباه القُرَّاء أو المستمعين. يستمتع الشعب بروايتها والاستماع إليها. وتتجلى فيها حكمته وخبراته ونتائج ممارساته وطرق معايشته الحياة. إنها خلاصة تجارب الأجيال مصاغة في قالب قصصي مشوِّق مليئ بالعبر والقيم النبيلة.
ولا يُعرف للحكاية الشعبية، شأنها شأن سائر أنواع الأدب الشعبي، قائل أو كاتب معين، ولهذا تُنسب إلى مجموع الشعب، وتنتقل عن طريق الرواية الشفهية، من جيل إلى جيل و من عصر إلى عصر حاملة تجارب وخبرات الآباء والأجداد إلى الأبناء والأحفاد. ولها في الإلقاء لغة خاصة ومتميِّزة تمنحها القدرة على الإيحاء والتأثير في المتلقي، ويكون الإلقاء “مصحوباً بتلوُّن صوتي، يناسب المواقف والشخصيات، وبإشارات من اليدين والعينين والرأس، فيها قدْر من التمثيل والتقليد، ما يعني أن لغة الجسد تلعب دوراً كبير ومميَّزاً في روائتها.
وهي كغيرها من الفنون القولية تخضع في أثناء انتقالها لتغييرات في الرواية تبعاً لظروف الزمان والمكان، واستجابة لمستوى تطوُّر المجتمع اجتماعياً واقتصادياً وفكرياً فيما يشبه إعادة الإنتاج. ومن هنا نجد روايات متعددة لحكاية واحدة، تختلف من عصر إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، ومن إقليم إلى آخر ومن راوٍ إلى آخر، بحيث تحمل كل رواية بصمات زمانها ومكانها.
وقد تندرج الحكاية الخرافية تحت التسمية نفسها، ولكن أحداثها تدور في عالم خيالي غير واقعي، ويغلب عليها العنصر الخارق، الذي يؤثِّر في تنامي أحداثها وتطوُّرها، ويختلط فيها الغريب والعجيب، فترى فيها الضعفاء ينتصرون على الأقوياء، والفقراء يصيبون من الغنى، وينتهي أغلبها نهاية سعيدة، كأن يتزوج البطل من أميرة، أو ينال الأشرار عقابهم والأخيار ثوابهم. وأهم سمة فيها هي أنها غالباً ما تُحكى على ألسنة الحيوانات، وتهدف من حيث المضمون إلى غاية تربوية أخلاقية.
لم تتحرَّر الحكاية الشعبية من آثار الأسطورة بالسرعة التي يمكن أن يتصوَّرها المرء، بل تظل بعض تلك الآثار تطل برأسها في بعض الحكايات في مراحل تاريخية لاحقة، تبعاً لتطوَّر الوعي البشري. وهذا ما دعا رائدَيْ الفولكسكوندة الألمانية الأخوين غريم إلى اعتبارها “حطام أساطير أو بقاياها”، أو هي موروثات باقية للأساطير القديمة، أو هي “الأسطورة في عهد تاريخي جديد.
المراجع:
- سوزان باسنيت: الأدب المقارن، مقدمة نقدية، ترجمة أميرة حسن نويرة، المشروع القومي للترجمة، رقم و مكان الطبعة غير مذكورين، 199.
(1) سوزان باسنيت: الأدب المقارن، مقدمة نقدية، ترجمة أميرة حسن نويرة، المشروع القومي للترجمة، رقم و مكان الطبعة غير مذكورين، 1999، ص 5.
([1]) الدكتور صابر عبد الدايم: الأدب المقارن بين التراث و المعاصرة، ط 2، مكان واسم دار النشر غير مذكورين، 2003، ص 11.
(3) الدكتور عبد الحميد إبراهيم: الأدب المقارن من منظور الأدب العربي، ط 1، دار الشروق، القاهرة 1997، ص 16.
(4) الدكتور صابر عبد الدايم: الأدب المقارن بين التراث و المعاصرة، مصدر سابق، ص 11.
(5) الدكتور محمد عباسة: المدرسة العربية للأدب المقارن:، مجلة حوليات التراث، جامعة مستغانم، الجزائر، العدد 17 سنة 2017، ص 7.
- الدكتور صابر عبد الدايم: الأدب المقارن بين التراث و المعاصرة، مصدر سابق، ص 13.
- ابن منظور: لسان العرب. ص 690.
- الفيروزأبادي: القاموس المحيط. طبعة القاهرة 2008، ص 390.
- نبيلة إبراهيم: أشكال التعبير في الأدب الشعبي، ط 1، مكتبة غريب للطباعة، القاهرة 1991، ص 119.
- المصدر نفسه والصفحة نفسها.
- الدكتورعبد الوهاب المقالح: الأميرة الضاحكة، حكايات شعبية من تركيا.” ط 1، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أبو ظبي 2010، ص 9.
Mehmet Bozkoyan: Beşek ji folklora kurdî. çîrok. Bingöl üniversitesi Yaşaya Diler Enstitüsü Dergisi, Kasim 2015, rû 146. .12
محمد بوزكويان: من الفولكلور الكردي، الحكاية الشعبية. جامعة بنكول / تركيا 2015، ص 146.
- عادل أبو شنب: مدخل إلى دراسة الحكاية الشعبية العربية. مجلة المعرفة، السنة التاسعة عشرة، العدد 219، دمشق، أيار/مايو 1980، ص 85.
- ميخايئل عيد: قضايا فكرية في بعض الحكايات. مجلة المعرفة، وزارة الثقافة، السنة 43، العدد 487، دمشق نيسان 2004، ص 154، 155.
- الدكتور أحمد زيادمحبك: حكايات شعبية، ط 1، منشورات اتحاد الكُتَّاب العرب، دمشق 1999، ص 18، 19.
- شوقي عبد الكريم: الحكاية الشعبية العربية، ط 1، دار ابن خلدون، بيروت 1980، ص 8.
- الدكتور عزالدين مصطفى رسول: دراسة في أدب الفولكلور الكردي، دار الثقافة والنشر الكردية، بغداد 1987، ص 15.