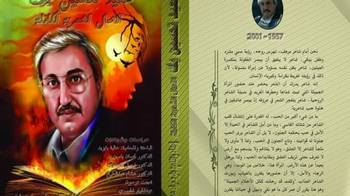إبراهيم سمو
شعرية الجرح والتحوّل أو ثلاثية التمرّد والرومانسية والمفارقة:
يشكّل شعر سعيد تحسين صوتا متفرّدا في مشهد الشعر العربي الحديث، يتميّز بقدرته على التوليف بين التوتّر الداخلي والاختراق الجمالي، بين الحُلم والخذلان، وبين اللغة بوصفها خلاصا، والوجود بوصفه سؤالا معلّقا.
يغترف “مهندس الأعمال الشعرية الكاملة” جوهر قصيدته من حواف الذات لا من استقرارها؛ حيث يتقاطع العاطفي بالثوري، ويتحوّل الانكسار إلى طاقة إشعاع شعري، لا إلى خفوت أو تكرار للخذلان. ومن هذا المنطلق، تقارب هذه القراءة ثلاثية مركزية تتجلّى في مختارات من تجربته: التمرّد، والرومانسية، والمفارقة، لا بوصفها عناوين موضوعية فحسب، بل كبُنى بلاغية، ورؤى معرفية تتسرّب إلى نسيج اللغة ذاته، فتُشكّل معمار القصيدة وعمقها الدلالي.
التمرّد والثورة: من كسر الواقع إلى ابتكار المعنى:
في تجربة “تحسين”، لا يُقدَّم التمرّد كشكل من أشكال الاحتجاج العابر أو الرفض الانفعالي، بل كقيمة وجودية تنبع من وعي الذات بانهيار أنساق العالم القديم، وسعيها لإعادة تشييده من رماده. الشعر هنا ليس استجابة للغضب، بل ممارسة رمزية للهدم وإعادة البناء، ومختبر حيوي لإنتاج المعنى من العدم:
“لا ترمّم شيئا
بل اهدم ما تبقّى
من القديم…
وابنِ كلّ شيء
من جديد”(ص 114ـ115)
هذه الدعوة لا تُقارب الثورة بلغة خطابية، بل تنبع من موقع معرفي داخلي، وتشكل إرادة ملحّة في إشعال قطيعة مع المألوف، وتأسيس ذات جديدة تكتب كينونتها بيديها.
وهنا يقترب شاعرنا من “أدونيس” في نقده للغة الموروثة، ومن “نيتشه” في رؤيته للإنسان كمشروع دائم للتجاوز والتجدّد.
وفي موضع آخر، تترسّخ فلسفة الحرية حتى في مواجهة المصير:
“كن شراعا بوجه الريح
ولا تقبل أبدا أن تكون أسيرا”.(ص 383ـ 384)
هذا “الشراع” لا يطلب أمان الميناء، بل يسعى إلى اختلاق معنى في مواجهة العاصفة. ويمكن القول إن التمرّد هنا يتجاوز أبعاده السياسية أو الاجتماعية، ليتحوّل إلى بيان وجودي: طيران لا يخاف السقوط، بل يجعله جزءا من تجربة التحليق.
الرومانسية: من الحبيبة إلى التجلّي الكوني:
الرومانسية في شعر سعيد تحسين لا تعيد إنتاج صورة العاشق والمحبوبة، بل تُؤسس لمنظومة وجدانية تتقاطع فيها الذات مع العالم. فالحب لا يظهر كعاطفة فحسب، بل كقوة تطهيرية، وطقس من طقوس استعادة البراءة الأولى:
“لأتطهّر بقطرات
مائه اللؤلؤي…
ليعود إلي شبابي ثانية”(ص95)
هنا يتحوّل الماء، بوصفه عنصرا أسطوريا، إلى رمز للتجدّد الروحي. وكأن الحب يعيد الزمن إلى لحظة البدايات، حين لم يكن الوجود مثقلا بالخسارات.
وفي موضع آخر، تُصبح الحبيبة محورا كونيا يتوازن عليه العالم:
“لا تغيبي كثيرا…
كي لا يتحوّل الكون ظلاما”(ص306ـ307)
غيابها ـ والها تعود على الحبيبة ـ لا يعني مجرد الفقد الشخصي، بل اختلال نظام الوجود، كأنها لم تعد “الآخر”، بل “المركز الضوئي” للعالم. هذه الرؤية تستدعي “المخيّلة الصوفية”، حيث المحبوب يتماهى مع “المطلق النوراني” الضامن لاستمرار الكون.
كما تتجلّى الرومانسية في لحظات الألم، التي لا تخلو من بُعد فدائي:
“لا تبخلي على عاشق
غسل شفاهك بدموعه”(ص396)
العاشق هنا ليس فقط كائنا عاشقا، بل كائن مضحٍّ، يُقدّم دمعه قربانا في تماهٍ مع رموز الفداء والتطهّر. فالحب، في ” الاعمال”، ليس علاقة عاطفية بل تجربة وجودية تقود إلى أقصى حدود الانكسار والسمو في آنٍ واحد.
المفارقة او الشعر من قلب التناقض:
تشكّل المفارقة أحد العناصر البنيوية في شعر صاحب “الاعمال”، ولا تطغى بوصفها زينة بلاغية، بل كاستراتيجية تأويلية لتكشف عن التصدّع بين ما يُراد وما هو كائن. وهي ليست، من هذا المنظور، “لعبة لغوية”، انما “لغة ثانية” تفرض حضورها ك”قيمة أحفورية” في طبقات التجربة.
في قصيدة “جبل الثلج”، يحتدم التناقض في صورة حسّية:
“فوق جبل من ثلج…
يحترق جبل الثلج
ويحترق من شدة الحب العاشقان”(ص329)
الثلج المحترق، في تعبيره الفيزيائي المستحيل، يُمثّل حرارة وجدانية تشعل المستحيل ذاته, المفارقة هنا لا تذيب الجليد، بل تحرقه، وتحوّل التناقض إلى لحظة إشراق جمالي تتجاوز المنطق.
أما المفارقة الأكثر كثافة واختزالا:
“تموت الوردة بالماء”(ص415)
هنا يتحوّل “الماء” من رمز للحياة إلى أداة للفناء، عبر صورة شعرية تفتح الأبواب على مصراعيها على التأمل في “فلسفة العطاء المفرِط”: أن ما يُنقذ قد يكون هو ذاته ما يُهلك. المفارقة هنا تقف على حافة الجمال والدمار، وتُضيء العلاقة المتوترة بين الحياة والإفراط.
حين تُولد اللغة من عمق الجرح:
شعر سعيد تحسين ليس تجريبا لغويا مجرّدا، ولا تأملا متعاليا، بل كتابة تنبثق من الجرح، وتُعيد من خلاله بناء الذات والعالم. فالتمرّد في قصائده، لا يعني الرفض فحسب، بل فعل تجاوز للأنقاض ومسعى لتوليد معنى من رماد الخراب. أمّا الرومانسية فليست وجدانية عاطفية ساذجة، بل طقس رمزي للتطهّر، حيث الحب يتجاوز العلاقة ليغدو تجربة وجودية تُعيد تشكيل الكينونة. وكذلك المفارقة، لا تتجلى كترف بلاغي، بل كوعي مقلق بحقيقة أن كل يقين يخفي في جوهره سؤالا.
هذه الثلاثية ـ التمرّد، والعشق، والمفارقة ـ ليست محاور منفصلة، بل نسيج شعري متشابك، مفتوح على احتمالات الذات واللغة والكون.
وعليه، فإن شعر” تحسين” لا يسعى إلى إبهار القارئ ب”سطوة المجاز”، بل إلى ملامسة اضطرابه الداخلي، ومساءلة تصوّراته الجاهزة، وإعادة طرح الأسئلة القديمة بلغة جديدة، حيث الكلمة لا تواسي فقط، بل تخلخل، وتكشف، وتجرح، وتضيء.