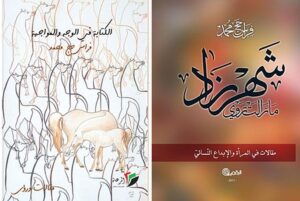خلات عمر
لم يكن الطفل قد فهم بعد معنى الانفصال، ولا يدرك لماذا غابت أمّه فجأة عن البيت الذي كان يمتلئ بحنانها. خمس سنوات فقط، عمر صغير لا يسع حجم الفقد، لكن قلبه كان واسعًا بما يكفي ليحمل حبًّا لا يشبه حبًّا آخر.
بعد سنواتٍ من الظلم والقسوة، وبعد أن ضاقت الأم ذرعًا بتصرفات الأب وسلوكه الذي دنّس قدسية البيت، لم تجد مفرًّا سوى الرحيل. رحلت لتحمي ما تبقى من روحها، لكنها تركت خلفها قطعةً منها… طفلًا لم يشبع من حضنها، ولم يعرف غيرها ملجأً للأمان.
في إحدى أمسيات القرية، رفع الطفل الهاتف بيدين صغيرتين وقلبٍ مليء بالشوق، وقال بصوته المرتجف:
“ماما… راح أملّا سلة ورد من كل ألوان الطبيعة بقرية جدي… وأحضرها إلى الحدود عندما تعودين”
كان يظن أن الحدود مجرد مكان تلتقي فيه الأقدام… لم يكن يعرف أنها في حقيقتها جدارٌ عالٍ من الوجع يمنع أمًّا عن طفلها.
لم يكن قلبه الصغير يفهم أن أمه لم تعد قادرة على السفر إليه، وأنها تعيش كل ليلة عذابًا لا يُطاق… تبكيه ولا تستطيع الوصول إليه، كأن المسافات سكاكين تُغرس في صدرها كلما سمعت صوته.
كانت تقول في سرّها:
“يا ابني… تلك الحدود التي تنتظرني عندها ليست حدود بلد… إنها حدود قلبي المكسور.”
لكن الوجع لم يكن من الأب وحده…
كان هناك مجتمعٌ يقف خلفه، يشدّ على يده ويزين له جبروته. مجتمع يرفع راية العادات والتقاليد فوق كل شيء، حتى فوق حق طفل في حضن أمه. يردد بصوت واحد:
“الأولاد لأهل أبيهم… هكذا ورثنا.”
لم يسأل أحد:
أين رحمة الأم؟
أين حق الطفل؟
أين صوت العدالة في قلوب البشر؟
لم يروا دموع الأم كل ليلة، ولا انكسارها وهي تعرف أن طفلها يجمع الورود ليهديها لها، بينما هي عاجزة عن عبور الحدود نحوه.
ولم يلمحوا حزن الطفل وهو يضع سلة الورد قرب باب البيت كل صباح، وكأنه يهمس للعالم:
“أمي سترجع… أكيد سترجع.”
كبرت السلة… ذبلت الورود… ثم امتلأت من جديد.
صارت رسائل حب بينه وبين أمّه، رسائل لا يقرؤها أحد غير السماء.
هكذا استمرت الحكاية:
ظلمٌ يستند إلى التقاليد،
وأمٌ تستند إلى الصبر،
وطفلٌ يستند إلى الأمل…
وسلة ورد تقف عند الحدود كشاهدٍ صامت على قسوة مجتمعٍ فرّق بين أم وفلذة كبدها.
ومع ذلك… بقيت الأم تؤمن أن الحق لا يموت.
وأن الطفل الذي يجمع الورود اليوم… سيكبر يومًا، وسيفهم الحقيقة كلها، وسيعرف أن العادات التي فرّقتهما لم تكن يومًا شريعة… بل كانت قيدًا من صنع البشر.