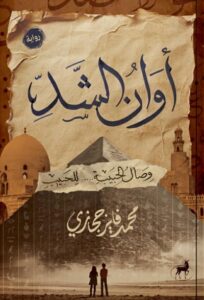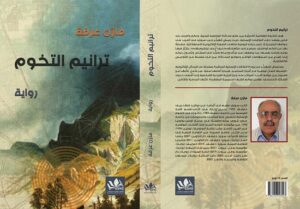صبحي دقوري
ليس من اليسير أن يُتناوَل رجلٌ مثل جان دانييل بوصفه صحافيًّا وحسب، فإن في هذا الوصف اختزالًا لحقيقةٍ أوسع، وتقليصًا لدورٍ تجاوز حدود المهنة إلى حدود الفكرة. فالصحافة، كما تُمارَس في الغالب، صناعةُ خبرٍ وتعليقُ ساعةٍ واستجابةُ ظرفٍ؛ أما الصحافة كما أرادها هو، فهي موقفٌ من التاريخ، ونظرٌ في مصير الإنسان، وسؤالٌ عن العلاقة بين السلطة والمعنى. ومن هنا كان فهمُه للصحافة فهمًا ثقافيًّا قبل أن يكون سياسيًّا، إذ أدرك أن السياسة إذا انفصلت عن الثقافة صارت صخبًا لا روح فيه، وتدبيرًا بلا بوصلة، وإدارةً لأحداثٍ لا رؤيةَ لها.
ولم يكن هذا الإدراك ثمرة تأملٍ نظريٍّ فحسب، بل تجلّى في مسيرته العملية حين جعل من منبره الصحافي ساحةً للفلاسفة والمفكرين، لا للسياسيين وحدهم، وكأنما أراد أن يقول إن السياسة لا تُفهَم إلا في ضوء الأسئلة الكبرى التي يثيرها الفكر: ما الحرية؟ ما العدالة؟ ما الهوية؟ ما الإنسان؟ فالأحداث عابرةٌ بطبيعتها، أما الأفكار فباقيةٌ بما تحمله من قدرةٍ على التفسير والتجاوز. وقد تُستهلك المقالة السياسية في يومها، ولكن المقالة التي تتكئ على رؤيةٍ فلسفية تبقى لأنها لا تُخاطب اللحظة وحدها، بل تُخاطب البنية العميقة التي تتكرر عبر اللحظات.
من هذا المنطلق ينبغي أن يُقرأ مفهوم «السجن» الذي صاغه في كتابه عن السجن اليهودي، فإنه لم يقصد به جدرانًا تُحاط بها جماعةٌ من خارجها، بل قصد به قيدًا يتكوّن في داخلها حين تُغلِق على نفسها باب التأويل وتحتكر لنفسها معنى الاصطفاء. إن فكرة «الشعب المختار» إذا فُهِمت بوصفها تكليفًا أخلاقيًّا ومسؤوليةً تاريخيةً أمكن أن تكون باعثًا على العمل، ولكنها إذا فُهِمت بوصفها امتيازًا ميتافيزيقيًّا حصريًّا تحوّلت إلى قفصٍ ذهنيٍّ يعزل أصحابه عن غيرهم، ويجعلهم أسرى سرديةٍ لا يرون خارجها أفقًا. وهنا يكون السجن سجنًا من الداخل، لا تُحكمه الأقفال، بل تُحكمه اليقينيات المغلقة.
وليس هذا النقد مقصورًا على دينٍ دون دين، ولا على أمةٍ دون أمة، فإن بنية الانغلاق واحدة، وإن اختلفت أسماؤها. فكل جماعةٍ تعتقد أنها احتكرت الحقيقة، وكل مذهبٍ يزعم أنه الفرقة الناجية دون سواه، وكل أمةٍ ترى في تاريخها مجدًا لا يُمَس ولا يُراجَع، إنما تُشيّد لنفسها سجنًا رمزيًّا تُحكِم إغلاقه بقدر ما تُحكِم دفاعها عنه. والنتيجة واحدة: عزلةٌ معرفية، وضيقٌ في الأفق، وتحوّلٌ من فاعلٍ في التاريخ إلى متفرجٍ عليه.
ولقد أصاب جان دانييل حين أشار إلى أولئك الذين خرجوا من هذا السجن دون أن يخرجوا من ذواتهم؛ فإن سبينوزا، وفرويد، وآينشتاين، لم يتنكروا لأصولهم، ولكنهم رفضوا أن يجعلوا منها قيدًا على عقولهم. خرجوا من التفسير الضيق إلى أفقٍ إنسانيٍّ أوسع، فكان خروجهم ولادةً ثانية، لا قطيعةً عدائية. وهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يُفهَم: إن الخروج من السجن اللاهوتي ليس خيانةً للهوية، بل تحريرٌ لها من ضيقها، وردٌّ لها إلى وظيفتها الأصلية بوصفها انتماءً ثقافيًّا لا حصارًا فكريًّا.
ومن هنا يتصل هذا النقد بما قاله مفكرون آخرون في سياقاتٍ مغايرة، حين دعوا إلى الخروج من «السياجات الدوغمائية» التي تحيط بالعقول وتمنعها من التنفس. فالسياج، وإن بدا حمايةً، قد يتحول إلى عائقٍ يمنع صاحبه من رؤية العالم. والدين، إذا أُحيط بهالةٍ من العصمة التأويلية، يفقد قدرته على التجدد، ويغدو تراثًا يُكرَّر لا معنىً يُبتكر. وليس في هذا القول دعوةٌ إلى إلغاء المقدس، بل دعوةٌ إلى تحريره من الاحتكار، وإعادته إلى فضاء السؤال لا فضاء التحريم.
ومن أعمق ما يُستفاد من هذا الطرح إعادةُ النظر في معنى «الاختيار». فالاختيار، في نظرٍ تاريخيٍّ رشيد، ليس صفةً أزليةً تُلازم جماعةً دون سواها، بل هو لحظةُ عطاءٍ حضاريٍّ تتجلى حين تُسهم أمةٌ في خدمة الإنسانية. فحين أبدعت الحضارة العربية الإسلامية في علوم الطب والفلك والرياضيات والفلسفة، لم تكن «خير أمة» بلفظٍ يُتلى، بل بعملٍ يُنجَز. وحين تُقدّم أمةٌ علاجًا ينقذ البشر، أو فكرةً تُحررهم من قيدٍ، فإنها تمارس نوعًا من الاختيار بمعنى المسؤولية، لا بمعنى الامتياز. فالاختيار إذن وظيفةٌ تاريخية، لا هويةٌ مغلقة.
إن الفرق بين الامتياز والمسؤولية هو الفرق بين السجن والأفق. الامتياز يُغري صاحبه بالاستعلاء، أما المسؤولية فتُلزمه بالعمل. الامتياز يُشيّد جدارًا، أما المسؤولية فتفتح طريقًا. وإذا أُعيد فهم الهوية على هذا الأساس، زال عنها كثيرٌ من التوتر الذي ينشأ من وهم التفوق أو خوف الذوبان. فالهوية ليست قوقعةً تُحاط بها الذات، بل طبقةٌ من طبقات الانتماء، يمكن أن تتعايش مع انتماءاتٍ أوسع دون أن تتلاشى فيها.
ولعل أخطر ما يهدد المجتمعات في عصرنا هذا هو عودة الهويات المغلقة في ثوبٍ جديد، تتغذى من الخوف وتستمد قوتها من الإحساس بالتهديد. ففي زمن العولمة والتداخل، يسهل على الجماعات أن تنكفئ على ذاتها طلبًا للأمان، غير أن هذا الانكفاء قد يتحول إلى انغلاقٍ يقطع الصلة بالعالم. وهنا يتجدد سؤال السجن، لا بوصفه حادثةً في تاريخ جماعةٍ بعينها، بل بوصفه احتمالًا قائمًا لكل جماعةٍ تخشى النقد وتُقدّس ذاتها.
إن تجربة جان دانييل، في هذا السياق، تُذكّرنا بأن المعركة الحقيقية ليست بين الأديان، ولا بين الأمم، بل بين عقلٍ يُراجع نفسه وعقلٍ يكتفي بيقينه. فالعقل المراجع يدرك أن الحقيقة أوسع من أن تُحتكر، وأن الهوية أغنى من أن تُختزل، وأن التاريخ لا يرحم من يتقوقع في ماضيه. أما العقل المكتفي بيقينه، فإنه يرضى بالسجن لأنه يراه حصنًا، ولا يشعر بضيق الجدران لأنه لم يجرّب الخروج.
وليس الخروج مغامرةً بلا ضابط، ولا قفزًا في الفراغ، بل هو انتقالٌ من انغلاقٍ إلى انفتاح، ومن تفسيرٍ أحاديٍّ إلى تعدديةٍ نقدية. وهو انتقالٌ يتطلب شجاعةً فكرية، لأن من اعتاد الجدران يخشى الفضاء. ولكنه، مع ذلك، الشرطُ الأول لكل نهضةٍ حقيقية، إذ لا نهضة بغير مساءلة، ولا مساءلة بغير حرية.
على هذا الأساس يمكن القول إن مفهوم «السجن اللاهوتي» ليس نقدًا لجماعةٍ بعينها، بل تحذيرٌ إنسانيٌّ عام. إنه تنبيهٌ إلى أن الهوية، إذا لم تُفتح على أفقٍ كوني، تحولت إلى عبءٍ على أصحابها قبل أن تكون مصدر قوةٍ لهم. وأن الاختيار، إذا لم يُترجم إلى عملٍ نافعٍ للناس، صار ادعاءً أجوف. وأن الصحافة، إذا لم تتكئ على فكرٍ عميق، صارت صدىً للحدث لا تفسيرًا له.
وفي عالمٍ تتكاثر فيه الأصوات وتتنازع فيه السرديات، يبقى السؤال معلقًا: من المختار اليوم؟ أهو من يرفع شعارًا، أم من يرفع عن الناس ألمًا؟ أهو من يحتكر الحقيقة، أم من يُسهم في توسيعها؟ إن الجواب، في ضوء ما تقدم، لا يكون بالانتماء، بل بالفعل، ولا يكون بالادعاء بل بالإسهام. ومن هنا يكون الخروج من السجن — أيًّا كان اسمه — شرطًا أوليًا لكل مشاركةٍ حقيقيةٍ في صناعة المستقبل.
باريس