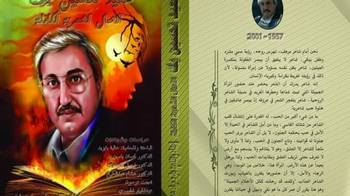إبراهيم سمو
في إشْكال الناشر كمعضلة ثقافية وأرشيفية :
في طبعة ” سعيد تحسين: الأعمال الشعرية الكاملة“، يبرز خللٌ بنيويّ لا يمكن تجاوزه بسهولة، يتمثل في غياب الإشارة الصريحة إلى دار نشر محددة. والسؤال هنا: هل “رقم الإيداع” المثبت في العمل هو ذاته الرقم المعياري الدولي (ISBN)؟ وإن لم يكن كذلك، فما الذي يمنح هذه الطبعة صفة التوثيق أو الحماية القانونية؟.
يُضاف إلى ذلك الاكتفاء الغامض بذكر “مطبعة: طهران”، من دون أي تعريف دقيق أو عنوان مؤسسي واضح، ما يُحدث شرخا في الإخراج المعرفي للعمل، ويدفع إلى طرح تساؤلات وجيهة: ما الجهة التي تقف فعليا وراء نشر هذا الأثر؟ ثم هل “مطبعة طهران” دار نشر بالمعنى القانوني والثقافي؟ ولماذا تبدو الإشارة إلى الناشر ملتبسة أو حتى مُموّهة إلى هذا الحد؟ وأين تقع حدود مسؤولية من أشرف على هذا المشروع التحريري؟.
في الأعراف المهنية للنشر، لا تكون “دار النشر” مجرّد جهة تنفيذية، بل طرفا مركزيا يُضفي على العمل شرعيته الرمزية، ويوثّق انتماءه إلى حقل معرفي ومؤسساتي معيّن. فغياب هذه الجهة لا يؤثر فقط على آليات التوزيع أو شروط التلقي، بل يُربك وظيفة الأرشفة، ويفكّك الصلة بين النص وسياقه المؤسسي. والنتيجة: عملٌ كبير بحجم” الأعمال” يبدو وكأنه وُلد خارج رحم مؤسسات الثقافة المعتادة، أو كأن وجوده الماديّ سابق على تثبيته في ذاكرة النشر المعتبرة.
هذا الغياب لا يُقرأ بوصفه تفصيلا شكليا، بل كعلامة على اختلال في البنية الاعتبارية للعمل. فالكتاب، الذي يمثل التجسيد الأخير لتجربة شاعر آثر الانفصال عن الامتيازات الاجتماعية بحثا عن معنى أكثر جوهرية للوجود، كان جديرا بأن يُقدَّم ضمن إطار نشر احترافي، يُكرّم النص كما يُكرّم صاحبه لا فقط من حيث التصميم أو الطباعة، بل أيضا عبر تحديد الجهة التي تتبنى هذا الإرث وتؤطره ضمن مشروع ثقافي واعٍ.
إن “الأعمال” ليست مجرد تجميع عشوائي لنصوص منشورة أو مبعثرة، بل هي وثيقة نهائية يُفترض أن تُثبّت حضور الشاعر في التاريخ الأدبي، وترسم ملامح سياقه الكتابي والزمني.
وغياب هوية النشر او قل ضبابيته لا يطرح، في هذا السياق، إشكالا توثيقيا وحسب، بل يشوّش أيضا على فكرة “الذاكرة الثقافية”، التي يُفترض أن تُبنى على تعاقد صريح بين المؤلف، الناشر، والقارئ.
وما يُثار هنا لا يُقصد به اللوم، بل يأتي من حرص تأمليّ على أن يُقرأ سعيد تحسين كما يجب، وأن تُحاط تجربته بعناية تليق بتفرّدها، لا كنتاج فردي فقط، بل كأثر حيّ في السردية الشعرية المعاصرة.
من هذا المنطلق، ربما يكون من الضروري، في طبعة لاحقة، تدارك هذا النقص، عبر التعاون مع دار نشر موثوقة تُعيد تقديم العمل بما يوازي أهميته وفرادته، وتؤمّن له الموقع الذي يليق به في خريطة الشعر “العربي” الحديث.
الإهداء كنَسبٌ مكتوم او عتبة مصادَرة :
يُسطر الإهداء في صورته المألوفة كوشوشة أولى، كلمسة حنين، أو كبذرة عاطفة يعلّقها الكاتب “تميمة” على صدر الكتاب، مستشفعا بها استحضار غيابٍ حميم، أو حضورٍ مطمئنّ. ومن هنا، فالإهداء عتبة وجدانية لا تُسرف في الدلالة، ولا تُفصح بقدر ما تُلمح.
غير أن ما يحدث هنا ليس من جنس العادة، ولا من نَفَسِ الطقوس المؤنسة؛ فالإهداء لا يُعطى، بل يُنتزع. لا ينسكب من الذات، بل يُسلَب منها. تنقلب الأدوار، وتضطرب الحركة: الشاعر، الذي يُفترض أن يكون مانح الإهداء، يُزاح ليتلقّاه. كأن النص يستدير، لا ليُهدي صاحبه، بل ليحجبه، ويُقدّم عنه بديلا غامضا يتكلّم باسمه، كوصي.
يجد المتلقي نفسه هنا في لحظة ارتباك جوهري؛ إذ تُجرَّد الذات من حقّها في تمهيد القول، فيصبح الإهداء لا مدخلا دافئا إلى التجربة، بل سؤالا معلّقا في الفراغ: من كتب؟ ولمن؟ ولماذا نيابة عن الغائب وبأي حق؟
يُفترض في الإهداء أن يكون إعلانا ذاتيا حرا، لكن ما يُقدَّم هنا أشبه بانقلاب ناعم، احتلال رمزي لعتبة النص، عبر صوتٍ بلا ملامح ولا نوايا مُعلَنة. صوتٌ يختبئ خلف خطاب مقتضب، يتسلّل بحجة الفراغ، ويتلبّس مقام المبدع متذرّعا بالصمت المفروض. وما يُخفيه هذا التسلّط أكثر مما يُظهره: رغبة غير بريئة في بسط يدٍ غاصبة ـ وإن رمزيا ـ على مساحة لا تُمنح إلا بطيب خاطر من باذر الفكرة الأصيل.
هذا “الغريب”، من هو؟ وبأي صفة يكتب؟ وكيف استحوذ على تلك اللحظة التي تُعدّ، في أعراف الإبداع، من أكثر العبارات خصوصية؟ لقد كتب، لكنه لم يوقّع. أهدى، لكنه لم يُعرّف بنفسه. ترك النص معلقا، مسكونا بالريبة، كمن يترك رسالة في الظل ويغادر دون أن يطرق الباب.
لكن النص، بذكائه الخفي، لم يغفل عن هذا الدخيل. أسقط الإهداء من فهرس” الأعمال”، كأنما رفض الاعتراف به. لم يُمنح قيدا، ولم يُدرج ضمن النظام الداخلي للكتاب. بقي خارج النظام، كنصٍّ منفيّ، ككائن لم تُسجَّل ولادته. وكأن الصدفة، في التباسها العادل، قررت أن تُنصف الشاعر الغائب بإقصاء من تكلّم باسمه.
سعيد تحسين، الذي غيّبه الموت قبل أن يضع يده على هذه العتبة، لم يُتح له أن يختار كلماته الأولى، أن يُحدّد وجهة العاطفة، أو أن يضمّن الإهداء حرارة روحه. ومع ذلك، تكفّل القدر ـ ولو عرضا ـ بحماية إرادته من التدخّل، فأبقى الإهداء كوصمة على الهامش: بلا توقيع، بلا شرعية دخول.
كُتِب، لكنه لم يُعترف به. نُشر، لكنه لم يُدرج.
وهكذا، يقف الإهداء هنا ككائن “مكتوم القيد”، مسلوب النسب، معلّق على أبواب الغياب، لا يشير إلى صاحبه إلا بغيابه، ولا يدلّ إلا على فراغٍ حاول أحدهم أن يملأه… فانكشف.