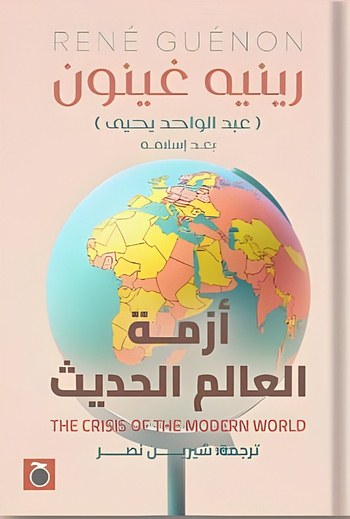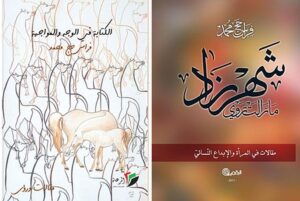صبحي دقوري
يضع كتاب أزمة العالم الحديث لرينيه غينون قارئه أمام أحد أعمق التشخيصات الميتافيزيقية لانحدار العصر الحديث، تشخيص لا ينطلق من داخل الحداثة بل من خارجها، من أفقٍ تقليدي يرى العالم لا من زاوية التاريخ بل من زاوية المبدأ. غير أنّ هذا التشخيص لا يكتمل فهمه إلا إذا وُضع في موازاة جهود مفكرين كبار واجهوا السؤال ذاته، كلٌّ من جهة مختلفة: مارتن هايدغر، أوسفالد شبنغلر، وميرسيا إلياد. فغينون ينطلق من فرضية أنّ الحداثة انقطعت عن “الأصل”، عن الحقيقة المتعالية التي تمنح الكون نظامه ومعناه، وأن هذا الانقطاع هو أصل الانحطاط الروحي والحضاري. في المقابل، لا يرى هايدغر الأزمة بوصفها سقوطًا عن مبدأ ثابت، بل بوصفها نسيانًا لــ “سؤال الوجود”، أي أنّ التقنية وذهنية العصر الحديث جعلت الإنسان محجوبًا عن ما دعاه “انكشاف الحقيقة”. إن صرامة غينون في العودة إلى المبدأ يقابلها عند هايدغر سعي إلى فتح أفق جديد، لا إلى استعادة شكل قديم؛ فالحقيقة ليست أصلًا يُستعاد، بل حدثًا يُكشف باستمرار. وما يجمع الرجلين رغم اختلافهما هو قناعتهما بأن الحداثة فقدت شيئًا أساسيًا، وأن هذا الفقد لا يعالج بزيادة الإنتاج ولا بالحرية الشكلية، لأن أصل العطب أعمق من السياسة والاقتصاد.
أما شبنغلر فيقف على مسافة أخرى تمامًا. فهو، بخلاف غينون، لا يرى الانحطاط نتيجة خطأ روحي أو سقوط أخلاقي، بل يعتبره تطورًا طبيعيًا: فالحضارات، عنده، كالكائنات الحية، تولد وتنمو وتشيخ ثم تموت. إن أفول الغرب — في نظره — ليس انحرافًا بل نهاية دورة، ولذلك فهو لا يدعو إلى العودة إلى أصلٍ ميتافيزيقي، بل إلى تقبّل ما لا مهرب منه. ومع أنّ غينون يرفض هذا التصوّر رفضًا مطلقًا، ويرى فيه استسلامًا للعبث، إلا أنّهما يلتقيان في شيء واحد: الحداثة، في صورتها الراهنة، ليست لحظة قوّة، بل لحظة غروب، حتى وإن بدت من الخارج مزدهرة تقنيًا. وبالمقارنة مع إلياد، يتبدّى الاختلاف بصورة أعمق. فإلياد، وإن وافق غينون على أنّ الإنسان الحديث فقد علاقته بالمقدّس، إلا أنّه لا يتبنّى موقفًا راديكاليًا ضد الحداثة. إنه يرى أنّ الإنسان قادر على استعادة الزمن المقدس بشكل رمزي عبر الأسطورة والطقس وإعادة فتح القنوات التي تربط الكائن بما يتجاوز اليومي. وهو بهذا يقدّم تصورًا أكثر مرونة من غينون، إذ لا يشترط العودة إلى التقاليد بحرفيتها، بل يكفي — عنده — إيقاظ “بنية المعنى” الكامنة التي لا تزال حيّة في أعماق الوعي الإنساني، حتى لو تغيّرت الأطر التاريخية.
وهكذا، يظهر غينون في هذا الإطار الفلسفي المقارن بوصفه المفكر الأكثر صرامة وجذرية؛ فهو لا يساوم على المبدأ، ولا يقبل أي إمكانية للتجديد داخل الحداثة، ولا يرى خلاصًا إلا في استعادة الحكمة التقليدية كما تجلّت في الحضارات الكبرى. بينما يقدّم هايدغر إمكانية “أفق جديد للظهور”، ويقدّم شبنغلر سردية قدرية، ويقدّم إلياد طريقًا رمزيًا لإعادة إنعاش العلاقة بالمقدّس دون التقيد بأشكال الماضي. ومع أنّ هؤلاء المفكرين الأربعة يختلفون جذريًا، إلا أن اجتماعهم على نقد الأساس الروحي للحداثة يكشف عن حقيقة غير قابلة للتجاهل: أنّ العالم الحديث، رغم اتساع معرفته وارتفاع إنتاجه، لا يزال عاجزًا عن الإجابة عن السؤال الأكثر بداهة: ما معنى الوجود؟ وفي هذا العجز بالذات تتقاطع أصواتهم، وإن اختلفت مساراتهم؛ فكلّ واحد منهم، بطريقته، يعلن أن أزمة العالم ليست في العلم ولا في الصناعة، بل في الإنسان الذي أخطأ طريقه إلى ذاته.