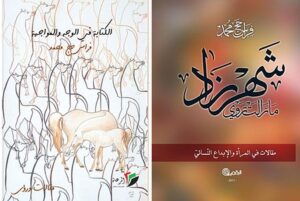صبحي دقوري / باريس
يُعَدّ هنري غوهييه أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في ترسيخ تقاليد كتابة تاريخ الفلسفة في فرنسا خلال القرن العشرين، لا بوصفه صاحب نسق فلسفي مستقل، بل باعتباره مفكّرًا اشتغل على الشروط المنهجية والمعرفية التي تجعل من تاريخ الفلسفة حقلًا فلسفيًا قائمًا بذاته، لا مجرّد فرع تابع للتاريخ العام أو لعلم الاجتماع الثقافي. وقد تميّز مشروعه الفكري بسعيه الدائم إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورة إدراج الفلسفة في سياقها التاريخي، وضرورة الحفاظ على استقلالها المفهومي والحجاجي، بما يمنع اختزالها في مجرد نتاج لعوامل خارجية.
ينطلق غوهييه من افتراض أساسي مفاده أنّ الفلسفة لا تُمارَس خارج التاريخ، لكنها في الوقت ذاته لا تُختزَل فيه. فالتاريخ، في نظره، ليس إطارًا تفسيريًا مغلقًا، بل شرطٌ من شروط الفهم. ومن هنا رفض النزعات التي تتعامل مع النصوص الفلسفية بوصفها وثائق سوسيولوجية أو سياسية تُفهم من خلال ظروف إنتاجها فحسب، كما رفض، في المقابل، القراءات التي تفصل الفلسفة عن زمانها، وتحوّلها إلى خطابٍ مجرّد لا جذور له في التجربة الإنسانية. إنّ الفلسفة عند غوهييه هي فعل تفكير ينبثق من وضع تاريخي معيّن، لكنه يحمل في بنيته الداخلية قابليةً للتجاوز والاستمرار.
هذا الموقف المنهجي يتجلّى بوضوح في التمييز الذي أقامه بين «تاريخ الأفكار» و«تاريخ الفلسفة». فبينما يهتمّ تاريخ الأفكار بتتبّع الأفكار بوصفها عناصر ثقافية قابلة للانتقال والتأثير المتبادل، يركّز تاريخ الفلسفة، كما يفهمه غوهييه، على تتبّع الإشكالات والمفاهيم داخل نسقٍ فلسفي محدّد، وعلى فهم منطق تطوّرها الداخلي. وقد رأى أنّ الخلط بين المستويين يؤدّي إلى نتائج مضلِّلة، لأنّه يُفقِد الفلسفة خصوصيتها، ويحوّلها إلى مادّة خام للتحليل الخارجي، بدل التعامل معها بوصفها ممارسة عقلية لها قواعدها وأسئلتها الخاصة.
لقد انعكس هذا التصوّر بوضوح في قراءاته لعدد من أعلام الفلسفة الفرنسية الحديثة، وفي مقدّمتهم ديكارت. فقد رفض غوهييه اختزال المشروع الديكارتي في كونه مجرّد تأسيس للمنهج العقلي الحديث، وركّز بدلًا من ذلك على البعد الوجودي والميتافيزيقي الذي يرافق تجربة الشكّ عند ديكارت. فالشكّ، في نظره، ليس تقنية منهجية فحسب، بل تعبير عن أزمة معرفية عميقة، وعن بحثٍ وجودي عن يقين قادر على إنقاذ الذات المفكّرة من التشتّت. وبهذا المعنى، يصبح فهم ديكارت مستحيلًا إذا أُهملت الرهانات التي يتأسّس عليها مشروعه، سواء كانت لاهوتية أم ميتافيزيقية.
وينطبق الأمر نفسه على قراءة غوهييه لمالبرانش، حيث أبرز الطابع الإشكالي لمحاولة التوفيق بين العقل والإيمان، دون الوقوع في التبسيط أو التلفيق. فقد تعامل مع مالبرانش بوصفه مفكّرًا يسعى إلى بناء علاقة دقيقة بين المعرفة الإنسانية والمطلق الإلهي، في سياقٍ فلسفي متأثّر بالتراث الديكارتي، لكنه غير قابل للاختزال فيه. أمّا في قراءته لبرغسون، فقد ركّز غوهييه على مقاومة هذا الأخير للنزعة الاختزالية التي تسعى إلى تفسير الوعي والزمن تفسيرًا آليًا، مبرزًا كيف تمثّل فلسفة برغسون دفاعًا عن التجربة الحيّة بوصفها مصدرًا أصيلًا للفهم الفلسفي.
لا يمكن فصل هذه القراءات عن موقف غوهييه النقدي من النزعات العلموية التي سادت جزءًا كبيرًا من الفكر الفلسفي في القرن العشرين. فقد رأى أنّ تحويل الفلسفة إلى ملحق بالعلوم الوضعية يؤدّي إلى فقدانها سؤالها الجوهري عن المعنى، ويُفرغها من بعدها التأملي. كما اتّخذ موقفًا نقديًا من الأدلجات التي سعت إلى توظيف الفلسفة في الصراع السياسي أو الاجتماعي، معتبرًا أنّ الفلسفة تفقد استقلالها حين تُختزل في وظيفة تبريرية أو نضالية.
وتكتسب فلسفة الدين مكانة خاصّة في مشروع غوهييه، لأنها تكشف عن طبيعة العلاقة التي يقيمها بين التفكير الفلسفي والالتزام الشخصي. فعلى الرغم من انتمائه الكاثوليكي الواضح، لم يتعامل مع الدين بوصفه حقيقةً معطاة خارج النقاش، بل بوصفه تجربة إنسانية قابلة للتفكير والتحليل الفلسفي. وقد دافع عن حقّ الفلسفة في مساءلة الدين، كما دافع عن حقّ الدين في أن يكون موضوعًا فلسفيًا جادًا، دون أن يتحوّل ذلك إلى خطاب وعظي أو لاهوتي دفاعي. وفي هذا السياق، تمثّل كتاباته نموذجًا لتوازن نادر بين الإيمان والصرامة العقلية.
تتجلّى القيمة العميقة لمشروع غوهييه في أخلاقيته المنهجية بقدر ما تتجلّى في نتائجه المعرفية. فكتابة تاريخ الفلسفة، في نظره، ليست ممارسة محايدة أو تقنية، بل فعل مسؤولية تجاه الماضي وتجاه القارئ. إنّ إسقاط مفاهيم الحاضر على نصوص الماضي، أو قراءة الفلاسفة من خلال صراعات لم يعرفوها، يُعدّ إخلالًا بالأمانة الفكرية. ومن هنا تأتي راهنية غوهييه في زمن تتكاثر فيه القراءات الانتقائية، ويُختزل فيه التراث الفلسفي في اقتباسات معزولة أو شعارات أيديولوجية.
يمثّل غوهييه، في هذا المعنى، نموذج «المؤرّخ الفيلسوف» الذي يسعى إلى فهم الفلسفة دون أن يقتلها باسم التاريخ، وإلى كتابة التاريخ دون أن يفرّغ الفلسفة من مضمونها. إنّ مشروعه يذكّر بأنّ الفلسفة لا تُقرأ على عجل، ولا تُستَعمل دون كلفة، بل تتطلّب صبرًا وتأمّلًا واحترامًا لتعقيد التجربة الإنسانية التي انبثقت منها. ومن هنا، فإنّ دراسة غوهييه لا تقتصر على كونه موضوعًا تاريخيًا، بل تشكّل في حدّ ذاتها درسًا منهجيًا في كيفية قراءة الفلسفة وممارسة تاريخها.
ويتعزّز هذا البعد الأخلاقي في مشروع غوهييه حين نضعه في سياق الجدل الفرنسي الأوسع حول كتابة تاريخ الفلسفة خلال القرن العشرين. فقد عاصر تيارات قوية سعت إلى إعادة تفسير الفلسفة من خلال مناهج خارجية، سواء عبر السوسيولوجيا، أو التحليل النفسي، أو البنيوية، أو الماركسية بمختلف تفرّعاتها. ولم يكن موقفه من هذه التيارات موقف رفضٍ مطلق أو إنكار لقيمتها المعرفية، بل موقف تحفّظ نقدي صارم. فقد رأى أنّ هذه المناهج تصبح مشروعة ومثمرة حين تظلّ أدوات مرافقة للفهم الفلسفي، لكنها تتحوّل إلى عائق حين تدّعي امتلاك المفتاح الوحيد لتفسير النصوص، أو حين تُقصي السؤال الفلسفي باسم تفسير شامل يختزل المعنى في البنية أو الوظيفة.
من هذا المنظور، يمكن اعتبار غوهييه مدافعًا عن نوع من «العقلانية التأويلية» التي ترفض الحتمية المنهجية، سواء كانت تاريخية أم بنيوية. فالنص الفلسفي، في نظره، لا يُختزَل في سياقه، ولا يُفهم خارج سياقه، بل يُقرأ في توتّر دائم بين الداخل والخارج، بين منطق المفهوم وشروط ظهوره. وهذه القراءة لا تتحقق إلا إذا تعامل الباحث مع الفلسفة بوصفها خطابًا يتوجّه إلى الحقيقة، لا مجرّد أثر ثقافي قابل للتفكيك اللامتناهي.
وتظهر هذه النزعة بوضوح في موقف غوهييه من فكرة «القطيعة» في تاريخ الفلسفة. فهو لا ينكر وجود تحوّلات جذرية، ولا يتبنّى تصورًا تراكميًا ساذجًا لتقدّم الفكر، لكنه في الوقت ذاته يتحفّظ على السرديات التي تقطع أوصال التاريخ الفلسفي إلى مراحل منفصلة جذريًا. إنّ الفلسفة، كما يفهمها، تتحرّك عبر الاستمرارية بقدر ما تتحرّك عبر الانفصال، ولا يمكن فهم أي لحظة فلسفية دون تتبّع ما ورثته ممّا سبقها، وما أضافته في الآن ذاته. وهذا ما جعله شديد الحساسية تجاه القراءات التي تُسقط مفاهيم لاحقة على نصوص سابقة، فتشوّهها باسم الحداثة أو النقد.
وفي هذا السياق، تبرز قيمة غوهييه بوصفه مفكّرًا قاوم، بصمتٍ نسبي، النزعة الاستعراضية في الكتابة الفلسفية. فهو لا يسعى إلى إنتاج خطاب صادم، ولا إلى إعادة تسمية المفاهيم من أجل إثبات الجِدّة، بل إلى بناء معرفة متينة، قابلة للنقاش والتدقيق. وقد جعل هذا الخيار منه مرجعًا أكاديميًا راسخًا، وإن لم يمنحه بالضرورة حضورًا إعلاميًا أو فلسفيًا صاخبًا. غير أنّ هذا الهدوء المنهجي هو بالذات ما يمنح أعماله قيمة طويلة الأمد، لأنّها لا ترتبط بسجالات ظرفية، بل بإشكاليات بنيوية في فهم الفلسفة وتاريخها.
ويزداد هذا البعد وضوحًا حين ننتقل إلى علاقته بفلسفة الدين. فغوهييه لا يقدّم نفسه بوصفه فيلسوفًا دينيًا بالمعنى الدفاعي أو الاعتذاري، ولا بوصفه ناقدًا خارجيًا للإيمان، بل بوصفه مفكّرًا يرى في الدين أحد الأبعاد المركزية للتجربة الإنسانية التي لا يمكن للفلسفة تجاهلها دون أن تُفقِر نفسها. لقد تعامل مع الإيمان بوصفه تجربةً ذات بنية عقلية ورمزية معقّدة، تستحق أن تُفكَّر فلسفيًا، لا أن تُختزل في الانفعال أو الطاعة. وفي هذا الإطار، اكتسبت كتاباته أهمية خاصة في السياق الفرنسي، حيث ظلّ التوتر بين الفلسفة والدين حاضرًا بقوة منذ القرن التاسع عشر.
ولا يعني هذا الموقف حيادًا زائفًا، بل التزامًا واعيًا بحدود الفلسفة ودورها. فغوهييه يدرك أنّ الفلسفة لا تستطيع أن تحسم مسائل الإيمان، لكنها تستطيع أن تفكّر شروطه، ولغته، ورهاناته الوجودية. وهذا الوعي بالحدود هو ما يمنح مشروعه مصداقيته، ويجنّبه السقوط في لاهوت فلسفي مقنّع أو في عقلانية إقصائية.
إنّ أحد الجوانب التي تستحق التوقف عندها في مشروع غوهييه هو نظرته إلى القارئ. فكتابة تاريخ الفلسفة، كما يمارسها، ليست خطابًا موجّهًا إلى المختصّين وحدهم، ولا هي تبسيط مخلّ موجّه إلى الجمهور الواسع، بل محاولة لبناء جسر معرفي يقوم على الاحترام المتبادل بين الكاتب والقارئ. فهو يفترض قارئًا قادرًا على التفكير، ومستعدًا لبذل جهد في الفهم، ولا يسعى إلى جذبه عبر الإثارة أو الاختزال. وهذا الاختيار يضع أعماله في موقع تربوي عميق، لأنها تدرّب القارئ على طريقة في القراءة بقدر ما تقدّم له معرفة جاهزة.
ومن هنا يمكن القول إنّ غوهييه لا يقدّم فقط محتوى فلسفيًا، بل يقدّم نموذجًا لممارسة الفلسفة داخل الجامعة وخارجها. نموذج يقوم على الصبر، والانتباه للنص، والوعي بالمسؤولية المعرفية. ففي زمن تتسارع فيه الإنتاجات الأكاديمية، وتُقاس القيمة بعدد المنشورات لا بعمقها، يذكّرنا مشروعه بأنّ الفلسفة ليست سباقًا، بل مسارًا طويل النفس.
إنّ راهنية غوهييه اليوم تتجلّى بوضوح في النقاشات المعاصرة حول معنى التراث، وحدود التأويل، ودور الفلسفة في المجال العام. فبين من يسعى إلى استدعاء الفلاسفة لتبرير مواقف أيديولوجية راهنة، ومن يدعو إلى تجاوز التراث باسم القطيعة، يقترح غوهييه طريقًا ثالثًا: طريق الفهم الدقيق، الذي لا يقدّس الماضي ولا يحتقره، بل يسعى إلى استيعابه بوصفه موردًا حيًا للتفكير.
وبهذا المعنى، لا يُختزل غوهييه في كونه مؤرّخًا للفلسفة الفرنسية، بل يمكن اعتباره مفكّرًا في شروط إمكان الفلسفة ذاتها داخل التاريخ. إنّ مشروعه يذكّر بأنّ الفلسفة لا تعيش إلا إذا قُرئت قراءة عادلة، وأنّ تاريخها ليس سجلًا للأسماء والمذاهب، بل تاريخ أسئلة ما تزال مفتوحة. ومن هنا، فإنّ العودة إلى غوهييه اليوم ليست عودة إلى الماضي، بل هي في جوهرها مساءلة للحاضر، وللطريقة التي نفهم بها الفلسفة ونمارسها ونورّثها للأجيال اللاحقة.