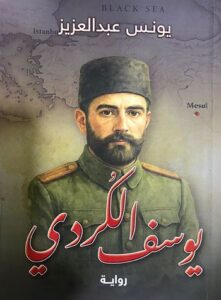محمد قاسم “ابن الجزيرة”
محمد قاسم “ابن الجزيرة”m.qibnjezire@hotmail.com
في القسم الأول من المقال حاولنا رصد واقع الحياة البشرية في أهم ملامح وظروف وجودها، وتكوينها ، واتجاهات نموها …
هنا نحاول أن ننهج الدرب الى مفهوم حدده العنوان وهو: “الأولويات في الحراك الإنساني اجتماعيا وسياسيا وثقافيا…وحديث عن الحوار”. على المستوى السيكولوجي –النفسي والمستوى الواعي العقلي …ومختلف الفعاليات التي تختزنها الكينونة البشرية.
بالطبع لا نستطيع الإحاطة بالموضوع في كل جوانبه، فهنا مجرد مقال- وان كان من أجزاء- فهو يبقى ذا حيّز محدود- نحاول فيه، أن نسلط الضوء على بعض الملامح.
نفترض أن هذه الإضاءة ستحرك الحافز لدى المهتمين-بعضهم على الأقل- للبحث في منابعه، عن هذه المفاهيم برغبة قوية، لمعرفة المزيد؛ جلاء، وعمقا، وتمثّلا…لعل ذلك سيكون من العوامل الهامة في بلورة رؤية ثقافية أقرب الى الصحة، تجاه مختلف مواضيع الحياة، هذه التي نحن جزء-وجزء مهم – فيها، ونطمح -بالتأكيد-إلى أن تكون حياة طيبة، فيها مختلف معطيات الراحة، والسلام، والسلم، والأمان، والمحبة، والرفاهية… والتفاعل الايجابي عموما؛ سواء على مستوى العلاقات داخل التجمعات –أو الجماعات الصغيرة- أم في العلاقات البشرية الأعم، والتي أصبحت ترتد علينا في شكل ما- مهما بعدنا أو قرُبنا- وخاصة في ظل العولمة –عولمة كل شيء؛ التكنولوجيا ودورها الواسع جدا، ومنها الاتصالات، والمواصلات، والاقتصاد، والسياسة، والمفاهيم الثقافية والفنية…الخ.
كثيرة هي النظريات التي حاولت فهم الحياة، وأسرار العلاقات فيها، العلاقات بين البشر بعضهم بعضا، وبينهم وبين المخلوقات الكونية الأخرى، الظاهرة منها والمتخيلة … برز من بين هذه النظريات –وربما غلب فيها- تلك التي تبنت فكرة أن الصراع جوهر الحياة –أو أن الصراع في العلاقات ليس فقط بين البشر،بل أيضا بين تكوينات- أو مكونات- مختلف موجودات الطبيعة،أي في صميم الكينونة الحياتية بل الكونية، بما فيها من كائنات حية أو جامدة…
واستُغل هذا التفسير -من البعض- لتبرير سلوك سياسي أيديولوجي، تحت عنوان الموضوعية والعلمية، فلم يكن موفقا في التطبيق -السياسي على الأقل. وتسبب، أو شكل هذا السلوك الأيديولوجي، الحافز لعمليات عسكرية وحروب…–ليست هي وحدها المسؤولة عنها بلا شك- لكنها استثارت –وعقّّدت(من العقيدة) روح الصراع في تبنيها أيديولوجية؛ كل ما فيها صراع -بالضرورة- في نسيج الكون، والتكوين، والصيرورة فيه. بنهج واع وقاصد-ودعونا لا نشكك في النوايا الآن..
وهناك من تبنى نظريات تتضمن فكرة أن معطيات الحياة تتكامل في منظومة واحدة ؛ ويفترض أن تكون محور الفعالية البشرية، ربما كانت الأديان أكثر من احتضنت مثل هذا الفهم، استنادا إلى كون الخالق واحدا، تبدأ به -وتنتهي عنده- الوحدة الكونية خَلْقا ونهاية- (أبدا وأزلا).
هذه النظرية تبدي فشلا ملموسا على الصعيد السياسي- راهنا على الأقل- أما البعد الاعتقادي والتعبدي، وبعضه الاجتماعي فيها، فقد تكون لا تزال حية، وربما ستبقى و تتبلور الى صيغ أفضل، إذا زاد الفهم والوعي لها، بعيدا عن إضافات ذاتية خاصة؛ سُخّرت –في الكثير منها –لمصالح المتنفذين، فرادى و جماعات، أو في تحالف مع الغير من قوى متنفذة في ميادين أخرى مختلفة، سياسية نافذة، أو مالية طاغية، أو حتى اجتماعية؛ تحكمها تقاليد متخلفة، ومتحكمة بحالة سيكولوجية انتهى مفعول فعاليتها الإيجابية، بسبب تطور الظروف والمعطيات، ودخول التكنولوجيا وآثارها ومنعكساتها؛ عاملا مُغيّرا، ومجددا بآفاق واسعة جدا؛ تنعكس على الحياة عموما…
كل ذلك حصل –ويحصل- في ظروف وجود أمور منها مثلا:
الجهل والأمية، استثارة المشاعر العدوانية تجاه المختلفين عن عمد ووعي في الغالب، سوء الفهم، رابطة مصالح معقدة ومغزولة بإتقان، وخبث أيضا أحيانا…الخ. وكنتيجة-أو حصيلة لهذا الواقع المتشابك العناصر والتجليات..استحالت الأديان –وغيرها-عامل تفريق، في حين أنها ذات مهمة تجميع-أو على الأقل- إيجاد حالة تفاعل ايجابية بين الناس في شكل ما، أقلها تفهم حق وحرية كل إنسان- فردا وجماعة- وتعهُّد روح المحبة من خلال إدراك المشتركات الإنسانية العامة، وصيغة العلاقات المفترضة على ضوء ذلك..
الإسلام يقول: “الدين معاملة”. و المسيحية تقول: ” من ضربك على خدك الأيمن فادر له الأيسر”. فهل هذا هو الواقع المعتمد ميدانيا؟!.
الخطير في حالة الأديان هو: أنها-كثيرا ما- تُتّخذ كأيديولوجيا؛ يُستفاد من عمق العقيدة فيها، وحساسية الملامسة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، لذا قال أحد منظري الماركسية-بل ربما ماركس نفسه: “الدين عفيون الشعوب إذا استغل” وهناك من فعل- واستغل- هذا بإتقان، وتحت أردية دينية لها سحر التأثير النفسي على العامة من الناس. فاستفاد، ولكنه أساء الى الدين في الصميم.
وهناك نظريات مختلفة أخرى، ولا تزال تتفاعل في بحر الثقافة البشرية، لكن في ظروف أكثر ضبابية، فقد كانت عناصر الحياة الأقل مما هي الآن- في الماضي- تتيح فرصة المتابعة، وتأملها، ومحاولة فهمها، واستنباط ما يمكن منطقيا، وتجريبيا، … إضافة الى روح إنسانية فطرية –أو طبيعية، ربما- كانت المؤثرات المادية فيها لا تزال غير عميقة، ولا متعمقة كما هي الآن، ولم تكن القيم المادية قد اتخذت عصا السبق فيها بالمستوى التي عليه الآن…الخ.
الحصيلة مما سبق الحديث عنه:
الحياة أكثر تعقيدا مما نظن أحيانا، والحاجة الى فهمها تتطلب البحث والمجهود والصدق فيهما،إضافة الى امتلاك أدوات معرفية تتعلق بموضوع البحث..وهذا قد يفرز بعض حاجة الى نوع من تخصص –لكن ليس الى درجة الوصول الى مرتبة “الإنسان ذو البعد الواحد” كما وصف احد فلاسفة الغرب، الإغراق في مستواه. ولعل قصة بعنوان: “أنا لا أتدخل” للقاص التركي الساخر عزيز نيسين يفسر حالة العجز في التخصص- أو التشدد في تجسيد بعض الأفكار بأية ذريعة كانت- عندما نبالغ فيه، أو قصة جان فالجان في رواية فيكتور هيجو الفرنسي “البؤساء ” يفسر أيضا جانبا من هذا. فالتخصص -والتشدد…- إذا لم يكن مَرِنا يصبح جمودا؛ وهذا خطير.
إن انخراطنا في الحياة دون محاولة لفهم طبيعتها، ومعطياتها، وعناصرها –الأساسية منها على الأقل-… قد يجردنا من أدوات التفاعل الواعي معها، ومن ثم العيش الصحيح فيها بوعي، يحفظ لنا منهج العمل الأفضل في كل أنشطتنا، والتي لابد من أن نقع في الخطأ في بعضها ،لكن… أبدا ليس مقبولا أن نعيش معظمها أخطاء…
إن انعكاسات أخطائنا ليست فقط على حياتنا الخاصة، لنعتبر ذلك بعض حرية شخصية مثلا، بل إنها انعكاسات قد تدمّر البيئة أو العلاقات أو الأهداف والنتائج والمنعكسات الايجابية …أحيانا، وتعيق نمو الحياة بعناصرها المختلفة أحيانا أخرى، وقد تسيء أحيانا الى الغير –أيا كان- قريبا ام بعيدا… المهم إنها تسيء.
ولقد خلق الإنسان –لا ليُسيء – بل ليُحسن في كل شيء، وقد عبر عن بعض هذا حديث شريف إذ قال ما معناه :
الصديق الطيب كبائع المسك، إن لم تشتر منه المسك فإنك واجد منه ريحا طيبة،والصديق السيئ كنافخ الكير، إن لم يؤذك في شيء فإن رائحة خبث الحديد تؤذيك…
نفترض أن هذه الإضاءة ستحرك الحافز لدى المهتمين-بعضهم على الأقل- للبحث في منابعه، عن هذه المفاهيم برغبة قوية، لمعرفة المزيد؛ جلاء، وعمقا، وتمثّلا…لعل ذلك سيكون من العوامل الهامة في بلورة رؤية ثقافية أقرب الى الصحة، تجاه مختلف مواضيع الحياة، هذه التي نحن جزء-وجزء مهم – فيها، ونطمح -بالتأكيد-إلى أن تكون حياة طيبة، فيها مختلف معطيات الراحة، والسلام، والسلم، والأمان، والمحبة، والرفاهية… والتفاعل الايجابي عموما؛ سواء على مستوى العلاقات داخل التجمعات –أو الجماعات الصغيرة- أم في العلاقات البشرية الأعم، والتي أصبحت ترتد علينا في شكل ما- مهما بعدنا أو قرُبنا- وخاصة في ظل العولمة –عولمة كل شيء؛ التكنولوجيا ودورها الواسع جدا، ومنها الاتصالات، والمواصلات، والاقتصاد، والسياسة، والمفاهيم الثقافية والفنية…الخ.
كثيرة هي النظريات التي حاولت فهم الحياة، وأسرار العلاقات فيها، العلاقات بين البشر بعضهم بعضا، وبينهم وبين المخلوقات الكونية الأخرى، الظاهرة منها والمتخيلة … برز من بين هذه النظريات –وربما غلب فيها- تلك التي تبنت فكرة أن الصراع جوهر الحياة –أو أن الصراع في العلاقات ليس فقط بين البشر،بل أيضا بين تكوينات- أو مكونات- مختلف موجودات الطبيعة،أي في صميم الكينونة الحياتية بل الكونية، بما فيها من كائنات حية أو جامدة…
واستُغل هذا التفسير -من البعض- لتبرير سلوك سياسي أيديولوجي، تحت عنوان الموضوعية والعلمية، فلم يكن موفقا في التطبيق -السياسي على الأقل. وتسبب، أو شكل هذا السلوك الأيديولوجي، الحافز لعمليات عسكرية وحروب…–ليست هي وحدها المسؤولة عنها بلا شك- لكنها استثارت –وعقّّدت(من العقيدة) روح الصراع في تبنيها أيديولوجية؛ كل ما فيها صراع -بالضرورة- في نسيج الكون، والتكوين، والصيرورة فيه. بنهج واع وقاصد-ودعونا لا نشكك في النوايا الآن..
وهناك من تبنى نظريات تتضمن فكرة أن معطيات الحياة تتكامل في منظومة واحدة ؛ ويفترض أن تكون محور الفعالية البشرية، ربما كانت الأديان أكثر من احتضنت مثل هذا الفهم، استنادا إلى كون الخالق واحدا، تبدأ به -وتنتهي عنده- الوحدة الكونية خَلْقا ونهاية- (أبدا وأزلا).
هذه النظرية تبدي فشلا ملموسا على الصعيد السياسي- راهنا على الأقل- أما البعد الاعتقادي والتعبدي، وبعضه الاجتماعي فيها، فقد تكون لا تزال حية، وربما ستبقى و تتبلور الى صيغ أفضل، إذا زاد الفهم والوعي لها، بعيدا عن إضافات ذاتية خاصة؛ سُخّرت –في الكثير منها –لمصالح المتنفذين، فرادى و جماعات، أو في تحالف مع الغير من قوى متنفذة في ميادين أخرى مختلفة، سياسية نافذة، أو مالية طاغية، أو حتى اجتماعية؛ تحكمها تقاليد متخلفة، ومتحكمة بحالة سيكولوجية انتهى مفعول فعاليتها الإيجابية، بسبب تطور الظروف والمعطيات، ودخول التكنولوجيا وآثارها ومنعكساتها؛ عاملا مُغيّرا، ومجددا بآفاق واسعة جدا؛ تنعكس على الحياة عموما…
كل ذلك حصل –ويحصل- في ظروف وجود أمور منها مثلا:
الجهل والأمية، استثارة المشاعر العدوانية تجاه المختلفين عن عمد ووعي في الغالب، سوء الفهم، رابطة مصالح معقدة ومغزولة بإتقان، وخبث أيضا أحيانا…الخ. وكنتيجة-أو حصيلة لهذا الواقع المتشابك العناصر والتجليات..استحالت الأديان –وغيرها-عامل تفريق، في حين أنها ذات مهمة تجميع-أو على الأقل- إيجاد حالة تفاعل ايجابية بين الناس في شكل ما، أقلها تفهم حق وحرية كل إنسان- فردا وجماعة- وتعهُّد روح المحبة من خلال إدراك المشتركات الإنسانية العامة، وصيغة العلاقات المفترضة على ضوء ذلك..
الإسلام يقول: “الدين معاملة”. و المسيحية تقول: ” من ضربك على خدك الأيمن فادر له الأيسر”. فهل هذا هو الواقع المعتمد ميدانيا؟!.
الخطير في حالة الأديان هو: أنها-كثيرا ما- تُتّخذ كأيديولوجيا؛ يُستفاد من عمق العقيدة فيها، وحساسية الملامسة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، لذا قال أحد منظري الماركسية-بل ربما ماركس نفسه: “الدين عفيون الشعوب إذا استغل” وهناك من فعل- واستغل- هذا بإتقان، وتحت أردية دينية لها سحر التأثير النفسي على العامة من الناس. فاستفاد، ولكنه أساء الى الدين في الصميم.
وهناك نظريات مختلفة أخرى، ولا تزال تتفاعل في بحر الثقافة البشرية، لكن في ظروف أكثر ضبابية، فقد كانت عناصر الحياة الأقل مما هي الآن- في الماضي- تتيح فرصة المتابعة، وتأملها، ومحاولة فهمها، واستنباط ما يمكن منطقيا، وتجريبيا، … إضافة الى روح إنسانية فطرية –أو طبيعية، ربما- كانت المؤثرات المادية فيها لا تزال غير عميقة، ولا متعمقة كما هي الآن، ولم تكن القيم المادية قد اتخذت عصا السبق فيها بالمستوى التي عليه الآن…الخ.
الحصيلة مما سبق الحديث عنه:
الحياة أكثر تعقيدا مما نظن أحيانا، والحاجة الى فهمها تتطلب البحث والمجهود والصدق فيهما،إضافة الى امتلاك أدوات معرفية تتعلق بموضوع البحث..وهذا قد يفرز بعض حاجة الى نوع من تخصص –لكن ليس الى درجة الوصول الى مرتبة “الإنسان ذو البعد الواحد” كما وصف احد فلاسفة الغرب، الإغراق في مستواه. ولعل قصة بعنوان: “أنا لا أتدخل” للقاص التركي الساخر عزيز نيسين يفسر حالة العجز في التخصص- أو التشدد في تجسيد بعض الأفكار بأية ذريعة كانت- عندما نبالغ فيه، أو قصة جان فالجان في رواية فيكتور هيجو الفرنسي “البؤساء ” يفسر أيضا جانبا من هذا. فالتخصص -والتشدد…- إذا لم يكن مَرِنا يصبح جمودا؛ وهذا خطير.
إن انخراطنا في الحياة دون محاولة لفهم طبيعتها، ومعطياتها، وعناصرها –الأساسية منها على الأقل-… قد يجردنا من أدوات التفاعل الواعي معها، ومن ثم العيش الصحيح فيها بوعي، يحفظ لنا منهج العمل الأفضل في كل أنشطتنا، والتي لابد من أن نقع في الخطأ في بعضها ،لكن… أبدا ليس مقبولا أن نعيش معظمها أخطاء…
إن انعكاسات أخطائنا ليست فقط على حياتنا الخاصة، لنعتبر ذلك بعض حرية شخصية مثلا، بل إنها انعكاسات قد تدمّر البيئة أو العلاقات أو الأهداف والنتائج والمنعكسات الايجابية …أحيانا، وتعيق نمو الحياة بعناصرها المختلفة أحيانا أخرى، وقد تسيء أحيانا الى الغير –أيا كان- قريبا ام بعيدا… المهم إنها تسيء.
ولقد خلق الإنسان –لا ليُسيء – بل ليُحسن في كل شيء، وقد عبر عن بعض هذا حديث شريف إذ قال ما معناه :
الصديق الطيب كبائع المسك، إن لم تشتر منه المسك فإنك واجد منه ريحا طيبة،والصديق السيئ كنافخ الكير، إن لم يؤذك في شيء فإن رائحة خبث الحديد تؤذيك…