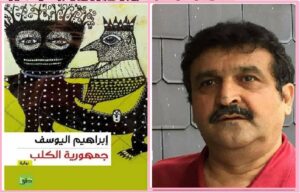حوار: أحمد الخليل
حوار: أحمد الخليل كونه يعيش في مدينة بعيدة عن العاصمة «القامشلي» بقي الكاتب أحمد إسماعيل إسماعيل بعيداً عن دائرة الضوء، فهو يعمل بصمت بعيداً عن اهتمام الإعلام، لكن فوزه بعدة جوائز آخرها جائزة «جائزة الهيئة العربية للمسرح سنة 2010 عن مسرحيته «الطائر الحكيم» الموجهة للأطفال، لفت الأنظار إليه ككاتب مسرحي وقصصي. من كتبه: مسرحنا المأمول- مقالات مسرحية تمهيدية، عندما يغني شمدينو، رقصة العاشق – مجموعة قصصية- الشارقة سنة 2001، أهلاً جحا- عفواً مموزين:
مسرحيتان، توبة الثعلب -4 مسرحيات «وزارة الثقافة»، جراب البدليسي، الحقل المنيع، الثغرة- مسرحية للفتيان، حكاية الأشقياء الثلاثة، أحلام الحمار الكسول-الهيئة العامة السورية للكتاب، الطائر الحكيم-الهيئة العربية للمسرح-الشارقة-2010…
نال العديد من الجوائز الأدبية منها: جائزة الشارقة للإبداع العربي– الإمارات العربية المتحدة- عن مجموعته القصصية «رقصة العاشق» سنة 2000 – جائزة ثقافة الطفل العربي الإمارات العربية المتحدة – عن مسرحيته – الحقل المنيع سنة 2001، جائزة نقابة المعلمين في سوريا- المكتب المركزي- سنة 2001 المرتبة الأولى عن مسرحيته الموجهة للأطفال «السور»..
نص الحوار:
– تأخرت في دخول مجال الكتابة، ما الذي دفعك للدخول إلى ساحة الإبداع؟
ج- التأخر صفة أو عادة غير حميدة، بدءاً من التأخير عن موعد ما وانتهاء بالتأخير عن ركب الحضارة، غير أنها تصبح إيجابية عندما يتعلق الأمر بالكتابة، وأنا لم أتأخر في شيء سوى في هذا المجال.. حتى المصائب التي ابتليت بها من: يتم ومرض جاءتني مبكرة جداً. حتى نهاية العقد الثالث من عمري وبداية العقد الرابع لم أكن أنوي ممارسة مغامرة الكتابة، غير أن مجزرة حلبجة التي حدثت سنة 1988 هي التي وضعت القلم في يدي وجعلتني أكتب أول نص لي، كان النص قصة حملت عنوان «الطائرات وأحلام سلو» نشرت بعد عدة سنوات في ملف للقصة القصيرة في مجلة دراسات اشتراكية سنة 1994. خلال هذه الفترة لم أكتب سوى مادتين، بعدها كتبت بغزارة جعلتني أخشى على نفسي من هذه الغزارة.
– البعض يجرب بداية في القصة القصيرة أو الشعر، أنت بدأت بالمسرح وذلك رغم نصك القصصي الذي أشرت إليه.. ما سبب ميلك إلى المسرح؟
ج- حتى سنة 2000 العام الذي فازت فيه مجموعتي القصصية الوحيدة بجائزة الشارقة للإبداع الأول، وعلى مدى عقد من الزمن تقريباً، كنت أكتب في المجالين: القصة والمسرح، وبشكل شبه متوازن، فصدر لي إلى جانب مجموعتي رقصة العاشق كتاب يحوي مجموعة من الدراسات المسرحية حمل عنوان «مسرحنا المأمول»، وذلك سنة 1997 ، ثم صدر لي كتاب آخر ضم ثلاث مسرحيات وحمل عنوان «عندما يغني شمدينو» سنة 1999. بعد هذا التاريخ توجهت كتاباتي كلية نحو المسرح وكانت البداية مع مسرحيات للأطفال صدرت عن وزارة الثقافة في كتاب يحمل عنوان «توبة الثعلب» سنة 2000 وأعتقد أن سبب هذا الميل لفن المسرح هو أنني كنت ومنذ صغري أعشق هذا الفن وأتابع عروضه في مدينتي القامشلي. وكانت لي محاولة يتيمة لممارسة هواية التمثيل وهي الهواية التي لم أستطع ممارستها بسبب الخجل الذي كنت قد ابتليت به، بعدها ترسخ إيماني بهذا الفن وقناعتي بأهميته ودوره في حياتنا وحياة أطفالنا.
ج- التأخر صفة أو عادة غير حميدة، بدءاً من التأخير عن موعد ما وانتهاء بالتأخير عن ركب الحضارة، غير أنها تصبح إيجابية عندما يتعلق الأمر بالكتابة، وأنا لم أتأخر في شيء سوى في هذا المجال.. حتى المصائب التي ابتليت بها من: يتم ومرض جاءتني مبكرة جداً. حتى نهاية العقد الثالث من عمري وبداية العقد الرابع لم أكن أنوي ممارسة مغامرة الكتابة، غير أن مجزرة حلبجة التي حدثت سنة 1988 هي التي وضعت القلم في يدي وجعلتني أكتب أول نص لي، كان النص قصة حملت عنوان «الطائرات وأحلام سلو» نشرت بعد عدة سنوات في ملف للقصة القصيرة في مجلة دراسات اشتراكية سنة 1994. خلال هذه الفترة لم أكتب سوى مادتين، بعدها كتبت بغزارة جعلتني أخشى على نفسي من هذه الغزارة.
– البعض يجرب بداية في القصة القصيرة أو الشعر، أنت بدأت بالمسرح وذلك رغم نصك القصصي الذي أشرت إليه.. ما سبب ميلك إلى المسرح؟
ج- حتى سنة 2000 العام الذي فازت فيه مجموعتي القصصية الوحيدة بجائزة الشارقة للإبداع الأول، وعلى مدى عقد من الزمن تقريباً، كنت أكتب في المجالين: القصة والمسرح، وبشكل شبه متوازن، فصدر لي إلى جانب مجموعتي رقصة العاشق كتاب يحوي مجموعة من الدراسات المسرحية حمل عنوان «مسرحنا المأمول»، وذلك سنة 1997 ، ثم صدر لي كتاب آخر ضم ثلاث مسرحيات وحمل عنوان «عندما يغني شمدينو» سنة 1999. بعد هذا التاريخ توجهت كتاباتي كلية نحو المسرح وكانت البداية مع مسرحيات للأطفال صدرت عن وزارة الثقافة في كتاب يحمل عنوان «توبة الثعلب» سنة 2000 وأعتقد أن سبب هذا الميل لفن المسرح هو أنني كنت ومنذ صغري أعشق هذا الفن وأتابع عروضه في مدينتي القامشلي. وكانت لي محاولة يتيمة لممارسة هواية التمثيل وهي الهواية التي لم أستطع ممارستها بسبب الخجل الذي كنت قد ابتليت به، بعدها ترسخ إيماني بهذا الفن وقناعتي بأهميته ودوره في حياتنا وحياة أطفالنا.
– توجهك العام لمسرح الطفل والذي يبتعد عنه أغلب المبدعين لصعوبته فكيف تتعامل مع عوالم الأطفال؟
ج- لقد اطلعت على الكثير مما يخص الطفل أدباً وتربية وعلم نفس.. بل ومعايشة أيضاً، بحكم عملي معلماً في مدارس القامشلي، ولكنني أقولها بصدق: حين أتهيأ لكتابة نص للأطفال فإنني أتخفف من هذه الوصايا وأدخل بعفوية وبساطة إلى عالم الطفل، هي حالة أشبه بالتماهي مع الطفل والطفولة، أحذر فيها أن أبرز كمعلم أو حتى راشد أو وصي. ولقد فعلت ذلك بعد أن وجدت أن هذا الكم من الوصايا تجعل الكتابة للطفل أشبه بمن يسير في حقل ألغام، بكثير من الحب للطفل والصدق معه مع تمكن من أدوات الكتابة هي جواز سفري إلى عالم الطفل .
– لك مجموعة قصصية يتيمة هل توقفت عن كتابة القصة؟
ج-عملياً نعم، ولكنني في أشد الشوق للعودة إلى كتابة القصة، فالقصة بالذات تحررني من قيود الكتابة المسرحية وتعود علي بحالة أو فعل تطهيري، وما أشد حاجتي إليها، فقد أصبحت في الفترة الأخيرة متوتراً: توتراً عالياً.
– وهل ستدخل عالم الرواية بعد تجربة القصة والمسرح كما فعل آخرون؟
ج – الرواية فن له عوالمه وشروطه الخاصة، وليس مرحلة متطورة عن القصة، لأن القصة أيضاً فن مستقل بذاته مثل الرواية وباقي الفنون الأخرى، وما انتقال بعض كتاب القصة أو المسرح إلى الكتابة الروائية وهجر حقل المسرح أو القصة تماماً سوى تقليعة أدبية وموضة سائدة، ويخطئ من يتوهم أنه أصبح كاتباً كبيراً لأنه توجه إلى كتابة الرواية، فالأدب ليس قطعة عسكرية، الرواية فيها رتبة أعلى من رتبة القصة والمسرح، فكم من قاص مبدع كتب رواية فاشلة، فأساء إلى ما كتبه من إبداع قصصي أو مسرحي أو شعري. وكم من قاص أهم من كم من الروائيين. وأنا لست من عشاق التقليعات، ما يهمني شخصياً هو أن أطور أدواتي في مجالي القصة والنص المسرحي فقط.
– مازال هناك احتدام وجدل بشأن نص محلي وعالمي والبعض يرى أن هناك ندرة في النص المحلي أو العربي، كيف ترى هذا الجدل؟
ج- أكاد أجزم أن الجدل المثار حول النص المسرحي المحلي مفتعل ولا يخلو من بعض التجني، فالنصوص موجودة ولدينا كتاب كثر قدموا ويقدمون نصوصاً جيدة وقابلة للتجسيد على الخشبة، وفي هذا الزمن، زمن سيادة الصورة على حساب الكلمة، الكلمة الأدبية والكلمة الفعل على حد سواء، نلاحظ أن الكلمة قد أصبحت أشبه بالعلكة في فم غانية، وليس وشماً على خدود الحركة كما قال ميرخولد، ولقد كرس المخرج غير الفنان هذه الحالة لطرد المؤلف من المسرح، بحجة مواكبة العصر وتطوير المسرح، الذي لن يكون إلا إذا قدمنا الكاتب قرباناً للتخلص من تخلف المسرح، وذلك رغبة منه في تنصيب نفسه السيد الأوحد في المسرح، وقد كان لكل ذلك أثره السلبي على نتاج المؤلف، ناهيك عن تهميش المؤسسات للكاتب ونتاجه، بعد ذلك كيف يراد ممن هو خارج المسرح الكتابة للمسرح بلغة مسرحية حقة، ومن ثم الكتابة بذلك الزخم الذي شهدته الساحة المسرحية في مرحلة سابقة، وعن هجر فن أصابه العجز مبكراً؟؟ غير أن ما حدث للكاتب من داخل المسرح وخارجه، لا يبرر له عدم مواكبته للتطورات الحاصلة في المسرح وخارجه: فكرية وسياسية وعلمية.. وتطوير أدواته.
– ابتعادك عن العاصمة سبب جهل الوسط الثقافي بك. كيف ترى علاقة المبدع مع العواصم ؟
ج- لدينا مثل يقول «بعيد عن العين بعيد عن القلب» وللأسف فإن هذا المثل يصح في حالتنا الثقافية أيضاً، ومن المؤسف أكثر هو أن الوجود المادي والشخصي للكاتب في العاصمة وتحت الأنظار له أهمية أكبر ممن هو بعيد عنها، حتى ولو كان الكاتب البعيد عن العين مبدعاً بحق. ولا يقلل من صحة هذا الرأي ذكر أسماء معينة كبيرة، لأن سطوع نجم هذه الأسماء يعود، إضافة إلى قوة إبداعها، إلى تواصلها الدائم مع العاصمة، وإلى انتمائها إلى مرحلة ستينيات وسبعينيات القرن الفائت، عصر الخلافة المسرحية، ولك أن تعود بالقراءة لخصوصية ذلك الزمن الناهض ثقافياً، والدور الذي لعبه النقاد المنصفون الباحثون عن الكلمة الجميلة والإبداع الحق. الأمر الذي نفتقده منذ أكثر من عقدين من الزمن. هذه الحقيقة هي التي تجعل المبدع في أقصى شرق وشمال وجنوب وغرب الوطن يلجأ إلى العاصمة، غير أن هجرة هذه العقول انعكس سلباً على الحراك الثقافي في أغلب المناطق.. وخاصة البعيدة عن العاصمة مثل الجزيرة مثلاً. ناهيك عن أسباب أخرى يطول شرحها.
– أصبح اسمك مطروقاً في سورية بعد حصولك على عدة جوائز ومنها جائزة الهيئة العربية للمسرح لهذا العام، فهل من الضروري أن يسوق الكاتب من خارج بلده لتهتم به المؤسسات والإعلام والوسط الثقافي ؟
ج-هذا يؤكد ما ذهبت إليه من أن الهام لدى مؤسساتنا ووسطنا الثقافي هو القرب من العين وليس القلب، فالموجود بالنسبة لها هو الماثل أمامها، الموجود تحت الأنظار والأيدي، أما ما يقع خارج مجال الرؤية، وليست الرؤيا، فهو غير موجود، أو وجوده هلامي، وعلى من يريد أن يصبح معروفاً عليه أن «يدبر حاله» والوسائل كثيرة، وامتلاك القليل من الإبداع يفي بالغرض. أما بالنسبة إلي فإن الإعلام لا يتطرق إلى اسمي إلا حين أحصل على جائزة، هكذا فقط، حصل فلان الفلاني على.. وكفى. أما النقاد، وهم قلة قليلة، فلم يبرحوا الفترة الذهبية من القرن الفائت، مرحلة الستينات وبداية السبعينيات، وهنا علي أن أستثني الناقد النبيل الدكتور نبيل حفار الذي كان أول من قدمني للمسرح السوري من خلال المقدمة التي كتبها لكتابي «عندما يغني شمدينو» الصادر سنة 1999وكذلك الناقد جوان جان الذي تناول مسرحيتي أهلاً جحا الصادرة حديثاً بالنقد في أحد كتبه. إضافة إلى مقالة جميلة كتبها الناقد العراقي خالد سليمان عن كتابي عندما يغني شمدينو.
– كيف تقرأ وضع المسرح في ظل الانتصار الساحق لفن الصورة ووسائل الاتصال الحديثة هذا غير العقبات الإدارية والقانونية التي تعيق عمل المسرح؟
ج- ليست التقنيات الحديثة ولا سيادة الصورة هو ما يهدد وجود المسرح، فللمسرح قدرة عجيبة على التكيف مع كل ما هو جديد، بل إنه يملك قدرة على تحويلها إلى أدوات لخدمته، إن ما يهدد وجود المسرح هو بقاء الكاتب بعيداً عنه، منفياً ومنبوذاً، وعدم ممارسة العملية المسرحية بروح المسرح، فالمسرح فن مدني وديمقراطي بامتياز، وهو مثل الديمقراطية التي لا يمكن تحقيقها بأساليب غير ديمقراطية. لابد من تضافر كل جهود صناع المسرح دون تفرد وتسيد، إضافة إلى تطوير الآليات الإدارية التي تشرف على هذه العملية، فالإداري في المجال الفني فنان أيضاً، ولابد أن يكون مدركاً لأهمية وحساسية هذا المجال.
مؤخراً تم تسمية الدكتور رياض عصمت وزيراً للثقافة، فدعنا نستبشر خيراً بذلك، فالرجل كاتب مسرحي مرموق، وصاحب همّ ومشروع ثقافي، ويشهد له بالتواضع ودماثة الخلق، فأرجو أن يعود ذلك بالفائدة على المشهد الثقافي الوطني، والنشاط المسرحي بالذات.
– قدمت عملاً للتلفزيون، هل الدافع مادي أم إبداعي، هل يتوجه للأطفال أيضا؟
ج- يحمل العمل الذي قدمته عنوان «مملكة القمر» وهو دراما موجهة للفتيان، يتناول دور الثقافة في حياة الفرد والمجتمع، التي يمكن أن تكون خير سلاح حين يحدق الخطر بالوطن. لا أزعم أنني كتبته بدافع غير مادي محض، ولكن جدية الموضوع تشي بالغاية، والتلفزيون يمنح الكاتب حقه المادي أكثر بما لا يقاس من المسرح الذي بدأ بعض المخرجين يسطون على نصوصه بطريقة أشبه بالقرصنة. ناهيك عن ضعف المكافأة المقدمة من قبل مديرية المسارح، وقد حدثت معي مواقف مع مخرجين هم في الحقيقة قراصنة، فقد قدم لي أحد المخرجين المحليين ألف ليرة سورية فقط عن نصي الذي قدمه في ربيع الأطفال الأخير، ومخرج آخر من محافظة أخرى أرسل لي ألفي ليرة في ربيع مسرحي سابق، أما الطامة الكبرى فقد كانت من قبل مخرجة مسرحية من دمشق قدمت مسرحيتي الأشقياء الثلاثة لصالح مديرية المسارح وبدعم من الاتحاد الأوربي على أنه نص معد عن نص أجنبي؟؟!! هكذا، وبكل بساطة، نزعت اسمي عن النص، واعتبرته لقيطاً لا أب له، وحين اتصلت بها وسألتها، قالت ظننتك كاتباً عراقياً»؟!!». وبهذا أحمل مديرية المسارح مسؤولية وضع أمر مكافأة النص بيد المخرج، هل هو تكريس لسيادة المخرج أم إذلال للكاتب؟ حسن، أياً كان السبب، وبعد كل هذا، كان علي أن أفكر في الكتابة للتلفزيون، وها أنذا مرة أخرى أتأخر في الدخول إلى هذا الحقل، هل هذا هو قدري؟ لا بأس، فالنص التلفزيوني المعروض يحقق انتشاراً جماهيرياً أوسع من العرض المسرحي. ونحن نريد قطف العنب لا قتل أحد، كما يحدث في المسرح، ورغم ذلك سيبقى المسرح هو حبي الأول الذي لن أتخلى عنه أينما نقلت هواي. فهو بالنسبة إلي همّ ومشروع حياتي.
– توجهك العام لمسرح الطفل والذي يبتعد عنه أغلب المبدعين لصعوبته فكيف تتعامل مع عوالم الأطفال؟
ج- لقد اطلعت على الكثير مما يخص الطفل أدباً وتربية وعلم نفس.. بل ومعايشة أيضاً، بحكم عملي معلماً في مدارس القامشلي، ولكنني أقولها بصدق: حين أتهيأ لكتابة نص للأطفال فإنني أتخفف من هذه الوصايا وأدخل بعفوية وبساطة إلى عالم الطفل، هي حالة أشبه بالتماهي مع الطفل والطفولة، أحذر فيها أن أبرز كمعلم أو حتى راشد أو وصي. ولقد فعلت ذلك بعد أن وجدت أن هذا الكم من الوصايا تجعل الكتابة للطفل أشبه بمن يسير في حقل ألغام، بكثير من الحب للطفل والصدق معه مع تمكن من أدوات الكتابة هي جواز سفري إلى عالم الطفل .
– لك مجموعة قصصية يتيمة هل توقفت عن كتابة القصة؟
ج-عملياً نعم، ولكنني في أشد الشوق للعودة إلى كتابة القصة، فالقصة بالذات تحررني من قيود الكتابة المسرحية وتعود علي بحالة أو فعل تطهيري، وما أشد حاجتي إليها، فقد أصبحت في الفترة الأخيرة متوتراً: توتراً عالياً.
– وهل ستدخل عالم الرواية بعد تجربة القصة والمسرح كما فعل آخرون؟
ج – الرواية فن له عوالمه وشروطه الخاصة، وليس مرحلة متطورة عن القصة، لأن القصة أيضاً فن مستقل بذاته مثل الرواية وباقي الفنون الأخرى، وما انتقال بعض كتاب القصة أو المسرح إلى الكتابة الروائية وهجر حقل المسرح أو القصة تماماً سوى تقليعة أدبية وموضة سائدة، ويخطئ من يتوهم أنه أصبح كاتباً كبيراً لأنه توجه إلى كتابة الرواية، فالأدب ليس قطعة عسكرية، الرواية فيها رتبة أعلى من رتبة القصة والمسرح، فكم من قاص مبدع كتب رواية فاشلة، فأساء إلى ما كتبه من إبداع قصصي أو مسرحي أو شعري. وكم من قاص أهم من كم من الروائيين. وأنا لست من عشاق التقليعات، ما يهمني شخصياً هو أن أطور أدواتي في مجالي القصة والنص المسرحي فقط.
– مازال هناك احتدام وجدل بشأن نص محلي وعالمي والبعض يرى أن هناك ندرة في النص المحلي أو العربي، كيف ترى هذا الجدل؟
ج- أكاد أجزم أن الجدل المثار حول النص المسرحي المحلي مفتعل ولا يخلو من بعض التجني، فالنصوص موجودة ولدينا كتاب كثر قدموا ويقدمون نصوصاً جيدة وقابلة للتجسيد على الخشبة، وفي هذا الزمن، زمن سيادة الصورة على حساب الكلمة، الكلمة الأدبية والكلمة الفعل على حد سواء، نلاحظ أن الكلمة قد أصبحت أشبه بالعلكة في فم غانية، وليس وشماً على خدود الحركة كما قال ميرخولد، ولقد كرس المخرج غير الفنان هذه الحالة لطرد المؤلف من المسرح، بحجة مواكبة العصر وتطوير المسرح، الذي لن يكون إلا إذا قدمنا الكاتب قرباناً للتخلص من تخلف المسرح، وذلك رغبة منه في تنصيب نفسه السيد الأوحد في المسرح، وقد كان لكل ذلك أثره السلبي على نتاج المؤلف، ناهيك عن تهميش المؤسسات للكاتب ونتاجه، بعد ذلك كيف يراد ممن هو خارج المسرح الكتابة للمسرح بلغة مسرحية حقة، ومن ثم الكتابة بذلك الزخم الذي شهدته الساحة المسرحية في مرحلة سابقة، وعن هجر فن أصابه العجز مبكراً؟؟ غير أن ما حدث للكاتب من داخل المسرح وخارجه، لا يبرر له عدم مواكبته للتطورات الحاصلة في المسرح وخارجه: فكرية وسياسية وعلمية.. وتطوير أدواته.
– ابتعادك عن العاصمة سبب جهل الوسط الثقافي بك. كيف ترى علاقة المبدع مع العواصم ؟
ج- لدينا مثل يقول «بعيد عن العين بعيد عن القلب» وللأسف فإن هذا المثل يصح في حالتنا الثقافية أيضاً، ومن المؤسف أكثر هو أن الوجود المادي والشخصي للكاتب في العاصمة وتحت الأنظار له أهمية أكبر ممن هو بعيد عنها، حتى ولو كان الكاتب البعيد عن العين مبدعاً بحق. ولا يقلل من صحة هذا الرأي ذكر أسماء معينة كبيرة، لأن سطوع نجم هذه الأسماء يعود، إضافة إلى قوة إبداعها، إلى تواصلها الدائم مع العاصمة، وإلى انتمائها إلى مرحلة ستينيات وسبعينيات القرن الفائت، عصر الخلافة المسرحية، ولك أن تعود بالقراءة لخصوصية ذلك الزمن الناهض ثقافياً، والدور الذي لعبه النقاد المنصفون الباحثون عن الكلمة الجميلة والإبداع الحق. الأمر الذي نفتقده منذ أكثر من عقدين من الزمن. هذه الحقيقة هي التي تجعل المبدع في أقصى شرق وشمال وجنوب وغرب الوطن يلجأ إلى العاصمة، غير أن هجرة هذه العقول انعكس سلباً على الحراك الثقافي في أغلب المناطق.. وخاصة البعيدة عن العاصمة مثل الجزيرة مثلاً. ناهيك عن أسباب أخرى يطول شرحها.
– أصبح اسمك مطروقاً في سورية بعد حصولك على عدة جوائز ومنها جائزة الهيئة العربية للمسرح لهذا العام، فهل من الضروري أن يسوق الكاتب من خارج بلده لتهتم به المؤسسات والإعلام والوسط الثقافي ؟
ج-هذا يؤكد ما ذهبت إليه من أن الهام لدى مؤسساتنا ووسطنا الثقافي هو القرب من العين وليس القلب، فالموجود بالنسبة لها هو الماثل أمامها، الموجود تحت الأنظار والأيدي، أما ما يقع خارج مجال الرؤية، وليست الرؤيا، فهو غير موجود، أو وجوده هلامي، وعلى من يريد أن يصبح معروفاً عليه أن «يدبر حاله» والوسائل كثيرة، وامتلاك القليل من الإبداع يفي بالغرض. أما بالنسبة إلي فإن الإعلام لا يتطرق إلى اسمي إلا حين أحصل على جائزة، هكذا فقط، حصل فلان الفلاني على.. وكفى. أما النقاد، وهم قلة قليلة، فلم يبرحوا الفترة الذهبية من القرن الفائت، مرحلة الستينات وبداية السبعينيات، وهنا علي أن أستثني الناقد النبيل الدكتور نبيل حفار الذي كان أول من قدمني للمسرح السوري من خلال المقدمة التي كتبها لكتابي «عندما يغني شمدينو» الصادر سنة 1999وكذلك الناقد جوان جان الذي تناول مسرحيتي أهلاً جحا الصادرة حديثاً بالنقد في أحد كتبه. إضافة إلى مقالة جميلة كتبها الناقد العراقي خالد سليمان عن كتابي عندما يغني شمدينو.
– كيف تقرأ وضع المسرح في ظل الانتصار الساحق لفن الصورة ووسائل الاتصال الحديثة هذا غير العقبات الإدارية والقانونية التي تعيق عمل المسرح؟
ج- ليست التقنيات الحديثة ولا سيادة الصورة هو ما يهدد وجود المسرح، فللمسرح قدرة عجيبة على التكيف مع كل ما هو جديد، بل إنه يملك قدرة على تحويلها إلى أدوات لخدمته، إن ما يهدد وجود المسرح هو بقاء الكاتب بعيداً عنه، منفياً ومنبوذاً، وعدم ممارسة العملية المسرحية بروح المسرح، فالمسرح فن مدني وديمقراطي بامتياز، وهو مثل الديمقراطية التي لا يمكن تحقيقها بأساليب غير ديمقراطية. لابد من تضافر كل جهود صناع المسرح دون تفرد وتسيد، إضافة إلى تطوير الآليات الإدارية التي تشرف على هذه العملية، فالإداري في المجال الفني فنان أيضاً، ولابد أن يكون مدركاً لأهمية وحساسية هذا المجال.
مؤخراً تم تسمية الدكتور رياض عصمت وزيراً للثقافة، فدعنا نستبشر خيراً بذلك، فالرجل كاتب مسرحي مرموق، وصاحب همّ ومشروع ثقافي، ويشهد له بالتواضع ودماثة الخلق، فأرجو أن يعود ذلك بالفائدة على المشهد الثقافي الوطني، والنشاط المسرحي بالذات.
– قدمت عملاً للتلفزيون، هل الدافع مادي أم إبداعي، هل يتوجه للأطفال أيضا؟
ج- يحمل العمل الذي قدمته عنوان «مملكة القمر» وهو دراما موجهة للفتيان، يتناول دور الثقافة في حياة الفرد والمجتمع، التي يمكن أن تكون خير سلاح حين يحدق الخطر بالوطن. لا أزعم أنني كتبته بدافع غير مادي محض، ولكن جدية الموضوع تشي بالغاية، والتلفزيون يمنح الكاتب حقه المادي أكثر بما لا يقاس من المسرح الذي بدأ بعض المخرجين يسطون على نصوصه بطريقة أشبه بالقرصنة. ناهيك عن ضعف المكافأة المقدمة من قبل مديرية المسارح، وقد حدثت معي مواقف مع مخرجين هم في الحقيقة قراصنة، فقد قدم لي أحد المخرجين المحليين ألف ليرة سورية فقط عن نصي الذي قدمه في ربيع الأطفال الأخير، ومخرج آخر من محافظة أخرى أرسل لي ألفي ليرة في ربيع مسرحي سابق، أما الطامة الكبرى فقد كانت من قبل مخرجة مسرحية من دمشق قدمت مسرحيتي الأشقياء الثلاثة لصالح مديرية المسارح وبدعم من الاتحاد الأوربي على أنه نص معد عن نص أجنبي؟؟!! هكذا، وبكل بساطة، نزعت اسمي عن النص، واعتبرته لقيطاً لا أب له، وحين اتصلت بها وسألتها، قالت ظننتك كاتباً عراقياً»؟!!». وبهذا أحمل مديرية المسارح مسؤولية وضع أمر مكافأة النص بيد المخرج، هل هو تكريس لسيادة المخرج أم إذلال للكاتب؟ حسن، أياً كان السبب، وبعد كل هذا، كان علي أن أفكر في الكتابة للتلفزيون، وها أنذا مرة أخرى أتأخر في الدخول إلى هذا الحقل، هل هذا هو قدري؟ لا بأس، فالنص التلفزيوني المعروض يحقق انتشاراً جماهيرياً أوسع من العرض المسرحي. ونحن نريد قطف العنب لا قتل أحد، كما يحدث في المسرح، ورغم ذلك سيبقى المسرح هو حبي الأول الذي لن أتخلى عنه أينما نقلت هواي. فهو بالنسبة إلي همّ ومشروع حياتي.
ملحق الثورة الثقافي
9/11/2010
9/11/2010