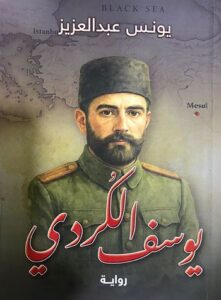صالح بوزان
صالح بوزانفي الحقيقة لا نستطيع، نحن السوريون، أن نشخص حالتنا النفسية. لأن أحداث القتل والدمار والتشرد لا تفسح لنا المجال لكي نفكر بشيء آخر أو بحيادية. لقد فقدنا كل خصوصيتنا الشخصية، ولم نعد نفكر إلا بالآخر. الآخر الذي يَقتل والآخر الذي يُقتل. وتبين أننا لم نكن مهيئين لهذه الحالة. بل لم يتوقع أحدنا بأن يحل بنا هذا الكابوس الذي نعيشه مهما كان جامحاً في الخيال.
كان لدينا طموح كبير وبسيط في الوقت نفسه. وهو تغيير واقعنا الكئيب الذي عشناه خلال نصف قرن من الذل والمهانة وهدر الكرامة والاغتراب عن الوطن وعن الهوية. كنا نتصور أن التغيير أصبح واقعاً لا مفر منه، ولا يمكن لأي منطق رفضه، بما في ذلك النظام السوري العتيد. فالطريقة التي يحكمنا بها أصبحت طريقة بالية، ناهيك أن هذا النموذج من الاستبدادية أصبح من الماضي.
كنا نعيش في جمهورية الصمت والقهر. هذا القهر الذي لا أمل في نهاية أفقه. كان مثلنا مثل الذي أصيب بالسرطان. فالمصاب بالسرطان يُرضِخ عقله لحقيقة مؤلمة وهي أن أيامه معدودة. وبالتالي لا يجوز أن يحلم، ولا أن يأمل، أو يفكر بمستقبل ما. أتذكر فيلماً أجنبياً تدور أحداثه عن زوج أصيب بالسرطان. فيهرب من زوجته ليموت وحيداً. وعندما تبحث عنه زوجته وتتحدث معه بالتلفون يقول الزوج لها: أنا أحبك وعندما أكون معك يراودني الأمل في الحياة. وبما أنني أعرف نهايتي الوشيكة فعليّ أن أعيش هذه الأيام المعدودة بدون أمل. لأن الأمل في هذه الحالة يا عزيزتي عذاب لا أتحمله. وهكذا يقوم بإخضاع عقله للموت الذاتي المعنوي قبل أن يحل به الموت الطبيعي. هذه كانت حالتنا كشعب سوري. فكما أن الخلاص من مرض السرطان لا يمكن أن يحدث حتى في الأوهام، كان الشعب السوري يتصور أن التحرر من هذا النظام هو الآخر وهم، لأنه سرطان أصيب به المجتمع السوري.
ووقعت الواقعة في درعا. وهزّ مجموعة من الأطفال كياننا قبل أن يهزوا كيان النظام. ومن حيث لا ندري انفجر في دماغنا صرخة غطت خارطة الوطن كله: “عاشت الحرية “Bijî azadî”. في البداية بكينا, بكينا لأننا أدركنا أنه مازال تنبض فينا الروح، وما زال جزء من جسدنا حي. فقد أحيت الثورة إنسانيتنا قبل أي شيء آخر. تصوروا أن هؤلاء الأطفال أعادوا إلينا الثقة بالذات وأن بإمكاننا أن نحلم، وأن نطمح، وأن نمسح الغبار عن آمالنا.
في شبابي كنت مغرباً بالسينما. شاهدت مرة فلماً هندياً سحر فيه ساحر كبير فتاة وجعلها من أقبح خلق الله. وأنتم تعرفون طبيعة الأفلام الهندية، من حيث الطول وتشعب الأحداث. في نهاية الفلم وبعد مغامرات عديدة وخطيرة جداً استطاع حبيبها أن يحصل على البلسم الذي يفك سحر حبيبته. كان هذا البلسم عبارة عن دواء سائل في قنينة زرقاء. وعندما شربته الفتاة خرجت من ذلك القبح وتحولت إلى أجمل خلق الله. لقد كان مسار تحولها من القبح إلى الجمال بطيئاً. وعندما تخلصت نهائياً من السحر واكتمل جمالها شعرت أن الدموع تنهمر من عيني. وهذا ما حدث معي مرة أخرى عندما قامت الثورة السورية. وأعتقد أن هذا ما حدث مع أكثرية أفراد الشعب السوري. لقد بدأنا ننتقل من القبح إلى الجمال.
لكن تبين أن قوى الشر في النظام السوري تملك طاقة هائلة, فالتغيير الذي بدأ مع الثورة صار ينجرف مع الأيام والأشهر وبقوة هذه الطاقة الهائلة إلى استنزاف جنوني. استنزاف لحياة الناس، استنزاف لكرامتهم، واستنزاف لممتلكات الدولة والأهالي. تبين أن كل ما قام به هذا النظام خلال نصف قرن لا يشكل سوى شيئاً يسيراً من قدرته على تحطيم الإنسان وتخريب الوطن. اكتشفنا وحشية مركبة، هي مزيج من الغرائز البدائية التي تعود إلى القرون الأولى من التاريخ البشري مع كل وسائل وإمكانيات عصرنا التكنولوجية والمعرفية. أمام هذه الوحشية التي لا يتحملها العقل البشري انزلق الكثير منا إلى هاوية اليأس، ليقولوا في داخلهم، وبعضهم علناً، ليتنا تركنا هذا الوحش نصف يقظ كما كان خلال نصف القرن الذي مضى.
اليوم نجد أن قسما كبيراً منا ما عاد لديه القدرة على التفكير، التفكير بالخلاص، والتفكير بأننا مازلنا بشراً.
لدى النظام السوري معادلة بسيطة: “إما أنا وإما الدمار الشامل”. أعلن عن هذه المعادلة صراحة، وطبقها على أرض الواقع عملياً خلال سنتين ونصف. إنه لا يفعل الدمار بالوطن وبالشعب فحسب بل بروحنا وعقلنا أيضاً. تصوروا عندما أقرأ في الدساتير الحديثة بأن مهمة الجيش الوطني هو حماية الوطن والمواطن تنهار في داخلي قرون من الزمن، وأشعر باللا انتماء للمكان والزمان. أشعر أنني إنسان بدائي يتسول في عصر غير عصره.
كنا نقول أننا كسوريين شعب عريق ومتحضر(وما زال بعضنا يقول ذلك حتى الآن). عريق بعربه وكرده وببقية مكوناته الاثنية. كنا نعتبر أن الشعب العربي السوري هو أكثر رقياً بين الشعوب العربية، وأن الشعب الكردي السوري أكثر تطوراً من بقية الكرد في الأجزاء الأخرى من كردستان. لكن، وكم يحزنني ذلك، صفعتنا الوقائع بقوة.
خلال سنتين ونصف من الثورة السورية تبين أن هذا النظام الذي يدمر الوطن والمواطن، ووصل إلى استخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه، هو جزء من هذا الشعب وليس مستعمراً قدم من الخارج. تبين أن هؤلاء اللصوص الذين ينهبون أموال المواطنين ويقتلون من أجل النهب هم من هذا الشعب وليس قراصنة القرون الوسطى. تبين أن الكثير من الذين ركبوا قطار الثورة ويقتلون الثوار الحقيقيين ويعتقلون الناشطين ويغتصبون الحرية باسم الحرية، ويقلدون النظام في استبداده ووحشيته، هم أيضاً من هذا الشعب.
يا للعار..! كل هؤلاء وغير هؤلاء خرجوا من بين صفوف هذا الشعب السوري، ومن كل مكوناته القومية والدينية والطائفية بدون استثناء.
عندما أفكر بسنتين ونصف من عمر الثورة أصاب بالذهول أمام المنقلب الذي انقلبنا إليه. أستغرب أنني لا أجد حالة شبيهة لحالتنا الراهنة في التاريخ المعاصر. نحن نقتل شعبنا ونهجّره ونشتته في شتى أصقاع العالم ونحرق الوطن وذاكرتنا الوطنية وفوق ذلك ندعي أننا شعب عريق.
بئس هذه العراقة.
عندما أعيد إلى ذهني كتاباتنا خلال نصف قرن مضى، كتاباتنا كسياسيين وككتاب ومفكرين وأدباء، أشعر كم كنا سذجاً في تحليل النظام السوري، كم كنا سذجاً في تحليل مجتمعنا السوري وأفكارنا القومية والدينية والطائفية. لم يكن النظام وحده شوفينياً وطائفياً ودكتاتورياً واستبدادياً. بل زرع كل ذلك فينا خلال نصف قرن. أتصور أن ما كان يجمعنا هو شيء واحد. لقد وضعنا النظام البعثي في سجن كبير أعده لنا باسم الوطن. وكما هو الحال في أي معتقل، كنا في هذا السجن محرومين من كل شيء. لم تكن لدينا أية هوية نتمايز بها سوى ذلك الرقم الذي على صدرنا. وعندما فتح أطفال درعا ثقباً في هذا السجن الرهيب تبين كم من صفات البعث قد تعشعشت فينا. لقد أصبح غالبيتنا مصابين بمرض اسمه المنطق البعثي.
سأبرهن لكم على صحة استنتاجي هذا ببساطة. تعلمون أن غالبية الساسة والكتاب والمفكرين السوريين يعبرون في أقوالهم وكتاباتهم أن سوريا المستقبل دولة ديمقراطية تعددية تساوي بين جميع المواطنين وتحصل فيها كل مكونات الشعب السوري على حقوقها، وأننا سنعيش في سلام ووئام.
ولكن.. خلف هذه المقولات الجميلة نكتشف كيف تتحفز للسطو على عقولنا فكر قومي نتن وفكر ديني مرعب، ومذاهب فاشية مقيتة. نجد بعض مظاهر هذا التوجه على الأرض من خلال بعض الكتائب المسلحة، وما نقرؤه ونسمعه من تصريحات وكتابات لسياسيين سوريين سواء من داخل النظام أو من مؤيديه العلنيين وغير العلنيين، ومن غالبية المعارضة ورجالات الدين والطوائف. وما يحزنني أكثر أن العديد من الكتاب والمثقفين السوريين يدخلون في هذه الدائرة العفنة. هؤلاء موجودون في كل قومية سورية وفي كل دين ومذهب سوري.
كنا نعيش في جمهورية الصمت والقهر. هذا القهر الذي لا أمل في نهاية أفقه. كان مثلنا مثل الذي أصيب بالسرطان. فالمصاب بالسرطان يُرضِخ عقله لحقيقة مؤلمة وهي أن أيامه معدودة. وبالتالي لا يجوز أن يحلم، ولا أن يأمل، أو يفكر بمستقبل ما. أتذكر فيلماً أجنبياً تدور أحداثه عن زوج أصيب بالسرطان. فيهرب من زوجته ليموت وحيداً. وعندما تبحث عنه زوجته وتتحدث معه بالتلفون يقول الزوج لها: أنا أحبك وعندما أكون معك يراودني الأمل في الحياة. وبما أنني أعرف نهايتي الوشيكة فعليّ أن أعيش هذه الأيام المعدودة بدون أمل. لأن الأمل في هذه الحالة يا عزيزتي عذاب لا أتحمله. وهكذا يقوم بإخضاع عقله للموت الذاتي المعنوي قبل أن يحل به الموت الطبيعي. هذه كانت حالتنا كشعب سوري. فكما أن الخلاص من مرض السرطان لا يمكن أن يحدث حتى في الأوهام، كان الشعب السوري يتصور أن التحرر من هذا النظام هو الآخر وهم، لأنه سرطان أصيب به المجتمع السوري.
ووقعت الواقعة في درعا. وهزّ مجموعة من الأطفال كياننا قبل أن يهزوا كيان النظام. ومن حيث لا ندري انفجر في دماغنا صرخة غطت خارطة الوطن كله: “عاشت الحرية “Bijî azadî”. في البداية بكينا, بكينا لأننا أدركنا أنه مازال تنبض فينا الروح، وما زال جزء من جسدنا حي. فقد أحيت الثورة إنسانيتنا قبل أي شيء آخر. تصوروا أن هؤلاء الأطفال أعادوا إلينا الثقة بالذات وأن بإمكاننا أن نحلم، وأن نطمح، وأن نمسح الغبار عن آمالنا.
في شبابي كنت مغرباً بالسينما. شاهدت مرة فلماً هندياً سحر فيه ساحر كبير فتاة وجعلها من أقبح خلق الله. وأنتم تعرفون طبيعة الأفلام الهندية، من حيث الطول وتشعب الأحداث. في نهاية الفلم وبعد مغامرات عديدة وخطيرة جداً استطاع حبيبها أن يحصل على البلسم الذي يفك سحر حبيبته. كان هذا البلسم عبارة عن دواء سائل في قنينة زرقاء. وعندما شربته الفتاة خرجت من ذلك القبح وتحولت إلى أجمل خلق الله. لقد كان مسار تحولها من القبح إلى الجمال بطيئاً. وعندما تخلصت نهائياً من السحر واكتمل جمالها شعرت أن الدموع تنهمر من عيني. وهذا ما حدث معي مرة أخرى عندما قامت الثورة السورية. وأعتقد أن هذا ما حدث مع أكثرية أفراد الشعب السوري. لقد بدأنا ننتقل من القبح إلى الجمال.
لكن تبين أن قوى الشر في النظام السوري تملك طاقة هائلة, فالتغيير الذي بدأ مع الثورة صار ينجرف مع الأيام والأشهر وبقوة هذه الطاقة الهائلة إلى استنزاف جنوني. استنزاف لحياة الناس، استنزاف لكرامتهم، واستنزاف لممتلكات الدولة والأهالي. تبين أن كل ما قام به هذا النظام خلال نصف قرن لا يشكل سوى شيئاً يسيراً من قدرته على تحطيم الإنسان وتخريب الوطن. اكتشفنا وحشية مركبة، هي مزيج من الغرائز البدائية التي تعود إلى القرون الأولى من التاريخ البشري مع كل وسائل وإمكانيات عصرنا التكنولوجية والمعرفية. أمام هذه الوحشية التي لا يتحملها العقل البشري انزلق الكثير منا إلى هاوية اليأس، ليقولوا في داخلهم، وبعضهم علناً، ليتنا تركنا هذا الوحش نصف يقظ كما كان خلال نصف القرن الذي مضى.
اليوم نجد أن قسما كبيراً منا ما عاد لديه القدرة على التفكير، التفكير بالخلاص، والتفكير بأننا مازلنا بشراً.
لدى النظام السوري معادلة بسيطة: “إما أنا وإما الدمار الشامل”. أعلن عن هذه المعادلة صراحة، وطبقها على أرض الواقع عملياً خلال سنتين ونصف. إنه لا يفعل الدمار بالوطن وبالشعب فحسب بل بروحنا وعقلنا أيضاً. تصوروا عندما أقرأ في الدساتير الحديثة بأن مهمة الجيش الوطني هو حماية الوطن والمواطن تنهار في داخلي قرون من الزمن، وأشعر باللا انتماء للمكان والزمان. أشعر أنني إنسان بدائي يتسول في عصر غير عصره.
كنا نقول أننا كسوريين شعب عريق ومتحضر(وما زال بعضنا يقول ذلك حتى الآن). عريق بعربه وكرده وببقية مكوناته الاثنية. كنا نعتبر أن الشعب العربي السوري هو أكثر رقياً بين الشعوب العربية، وأن الشعب الكردي السوري أكثر تطوراً من بقية الكرد في الأجزاء الأخرى من كردستان. لكن، وكم يحزنني ذلك، صفعتنا الوقائع بقوة.
خلال سنتين ونصف من الثورة السورية تبين أن هذا النظام الذي يدمر الوطن والمواطن، ووصل إلى استخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه، هو جزء من هذا الشعب وليس مستعمراً قدم من الخارج. تبين أن هؤلاء اللصوص الذين ينهبون أموال المواطنين ويقتلون من أجل النهب هم من هذا الشعب وليس قراصنة القرون الوسطى. تبين أن الكثير من الذين ركبوا قطار الثورة ويقتلون الثوار الحقيقيين ويعتقلون الناشطين ويغتصبون الحرية باسم الحرية، ويقلدون النظام في استبداده ووحشيته، هم أيضاً من هذا الشعب.
يا للعار..! كل هؤلاء وغير هؤلاء خرجوا من بين صفوف هذا الشعب السوري، ومن كل مكوناته القومية والدينية والطائفية بدون استثناء.
عندما أفكر بسنتين ونصف من عمر الثورة أصاب بالذهول أمام المنقلب الذي انقلبنا إليه. أستغرب أنني لا أجد حالة شبيهة لحالتنا الراهنة في التاريخ المعاصر. نحن نقتل شعبنا ونهجّره ونشتته في شتى أصقاع العالم ونحرق الوطن وذاكرتنا الوطنية وفوق ذلك ندعي أننا شعب عريق.
بئس هذه العراقة.
عندما أعيد إلى ذهني كتاباتنا خلال نصف قرن مضى، كتاباتنا كسياسيين وككتاب ومفكرين وأدباء، أشعر كم كنا سذجاً في تحليل النظام السوري، كم كنا سذجاً في تحليل مجتمعنا السوري وأفكارنا القومية والدينية والطائفية. لم يكن النظام وحده شوفينياً وطائفياً ودكتاتورياً واستبدادياً. بل زرع كل ذلك فينا خلال نصف قرن. أتصور أن ما كان يجمعنا هو شيء واحد. لقد وضعنا النظام البعثي في سجن كبير أعده لنا باسم الوطن. وكما هو الحال في أي معتقل، كنا في هذا السجن محرومين من كل شيء. لم تكن لدينا أية هوية نتمايز بها سوى ذلك الرقم الذي على صدرنا. وعندما فتح أطفال درعا ثقباً في هذا السجن الرهيب تبين كم من صفات البعث قد تعشعشت فينا. لقد أصبح غالبيتنا مصابين بمرض اسمه المنطق البعثي.
سأبرهن لكم على صحة استنتاجي هذا ببساطة. تعلمون أن غالبية الساسة والكتاب والمفكرين السوريين يعبرون في أقوالهم وكتاباتهم أن سوريا المستقبل دولة ديمقراطية تعددية تساوي بين جميع المواطنين وتحصل فيها كل مكونات الشعب السوري على حقوقها، وأننا سنعيش في سلام ووئام.
ولكن.. خلف هذه المقولات الجميلة نكتشف كيف تتحفز للسطو على عقولنا فكر قومي نتن وفكر ديني مرعب، ومذاهب فاشية مقيتة. نجد بعض مظاهر هذا التوجه على الأرض من خلال بعض الكتائب المسلحة، وما نقرؤه ونسمعه من تصريحات وكتابات لسياسيين سوريين سواء من داخل النظام أو من مؤيديه العلنيين وغير العلنيين، ومن غالبية المعارضة ورجالات الدين والطوائف. وما يحزنني أكثر أن العديد من الكتاب والمثقفين السوريين يدخلون في هذه الدائرة العفنة. هؤلاء موجودون في كل قومية سورية وفي كل دين ومذهب سوري.
يا له من واقع مرعب..!