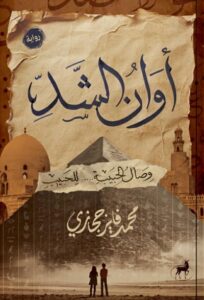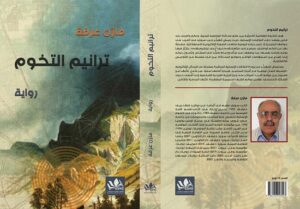دهام حسن
دهام حسنثمة رأي ساد حينا من الزمن، من أن العرب لم ينتجوا فكرا أخلاقيا، لا في الحقبة الإسلامية، ولا ما قبل الإسلام، كما أن البحث-كما يبدو- لم يطل هذا الجانب، وما يعزز هذا الرأي، خلوّ المكتبة العربية، أو تكاد تخلو من كتب أو دراسات تتناول الأخلاق العربية بالنقد والتحليل..ويبدو في الإسلام، أن المسلمين لم يعملوا الفكر كما اليونان، بل اكتفوا بالدين كشارح للأخلاق وموجه لهم بالموعظة الحسنة، أو الأخذ والإصغاء لما وصلت إليهم من حكم وأمثال تناقلها الناس في الجاهلية والإسلام، دون أثر للتفكير الفلسفي، وربما خفّ الطابع الفكري بمضي الزمن، لتتلفع بالتالي بشعار الدين الإسلامي، وكان إعمال الفكر والبحث والتقصي في القضايا التي قد يذهب بالفكر بعيدا بخلاف الاعتقاد السائد، كان ذلك من القضايا المحذورة..
لقد حدثت بعض التجاوزات على المحذور منذ بدايات القرن العشرين، في مصر خاصة، لكن الأزهر كانت لها بالمرصاد، فما الضجة التي أحدثها طه حسين في كتابه (في الشعر الجاهلي) عام 1926 سرعان ما جاء وأدها ردعا من الأزهر، لتعاد طباعة الكتاب من جديد خاليا هذه المرة من تلك (الملابسات) وقبل ذلك بعامين صدر للدكتور زكي مبارك كتاب يتناول فيه (الأخلاق عند الغزالي) وهذا عنوانه، لكن الكتاب أيضا أخمل، وأبعد، ولم يسمع به إلا على نطاق ضيق جدا، بسبب ردع الأزهر له أيضا.. ثم كانت هناك محاولات تناولت كتبا من التراث، أدرجت في تصنيف الكتابات الأخلاقية، ولكن على العموم رغم هذه الإقحامات، يبقى الأثر الفلسفي في الكتابات التراثية قليلة الشأن، ومن دون عمق فكري؛ ويبدوكما نوهنا قبل الآن، من أن الرأي الذي ساد في الجانب الأخلاقي، رأى وجوب الاكتفاء بالقرآن والسنّة كمصدر للأخلاق، فالإسلام حقيقة دعا لتكريس كثير من القيم الحميدة، ونبذ قيم أخرى ذميمة، في نظر الدين الجديد، واقتدوا بالرسول الكريم، فاتخذوا سيرته أسوة حسنة لهم ومسلكا صالحا به يهتدون، وبسلوكه يقتدون..مع انتقال المسلمين من حالة الخصاصة والعوز في بداية الدعوة، إلى حالة فيضان المال في خلافة عمر، لاسيما خلافة عثمان، وتراكم الثروات في أيدي بعض الصحابة، وتنميتها بالتالي، انعكس كل هذا على حياة المسلمين، فكانت أمارات الغنى والترف والبذخ والإسراف والتبذير واضحة على المستكبرين الذين تمسكوا بمباهج حياة الدنيا، ولم يتورعوا أن يعبّوا من متعها، بخلاف المستضعفين الذين رأوا أنهم يمثلون الضمير الديني الحقيقي الصحيح، وشكلوا بهذا الطبقة الدنيا في المجتمع الإسلامي، وجاهروا بالاحتجاج، والتمرد والعصيان أحيانا، أي أن الفرز الطبقي بلغة اليوم أصبح فسيحا واضحا ولو أنه تماهى أو تستر بشعار الإسلام المساواتي- لا فرق بين عربي وأعجمي، ولا بين غني وفقير – هذا التباين الصارخ في الحالة الاقتصادية، انعكس بالطبع في السلوك والقيم لدى الناس، فالصحابي الذي صار يسكن في قصر منيف، فضلا عن دور للراحة، ليس بذاك الصحابي الذي يلاحق حتى في لقمة عيشه، لأنه في خطابه كان لا يخاف في الله لومة لائم، كما هي الحال عند أبي ذر الغفاري..
هذا الاغتناء الفاحش كان حافزا للمقتدرين ماديا من امتلاك العديد من العبيد، واقتناء الجواري، وتفشي حال السكر والعربدة، فأصبح الناس تحرّكهم قيم مختلفة جراء وضعهم الطبقي.. وبالمقابل هناك من استبدّ بهم اليأس، أو هكذا رأوا الدين، فمالوا إلى الزهد والتقشف في حياتهم، والتفرغ للعبادة، وهؤلاء عرفوا بـ (العبّاد الـزّهّاد) انصرفوا عن متع حياة الدنيا الفانية راجين لقاء ربهم..
شهد العراق عن طريق موانئ البصرة خاصة، قدوم أعاجم من بلاد فارس على الوجه الأخص، فضلا عن أخلاط من أقوام مختلفة، وفئات أخرى ممتهنة للتجارة، كل هؤلاء قدموا إلى ديار الإسلام يحملون معهم ميولا وعادات وسلوكيات مختلفة، ناهيك أن كبراء الأمويين أنفسهم، كانوا رقيقي الإيمان، فلم يتملكهم الدين بعمق، ولم يستحكم في أفئدتهم، ولم يستغلق عليهم التفكير، فالأمويون كانوا يبررون سلوكهم باقتراف إثم ما بالقضاء والقدر، أي إن الله قضى على هذا الإنسان باقتراف هذه الجريرة، فليس من راد إذن لقدر الله، وبالتالي فهذا تبرير للسلوك الإباحي عند الفرد، فقد جعلوا من (الجبر) عقيدة تبرر سياساتهم، وتسقط المسؤولية عنهم، طالما الله قضى بذلك.بالمقابل وبالضد من ذلك، ظهرت حركة فكرية تنويرية عرفت بالقدرية، التي رأت عن قدرة الإنسان من التحكم بأفعاله، وبالتالي فهو يتحمل مسؤولية ما يصدر عنه، وكان هؤلاء من الذين تشيّعوا لعلي وآل البيت، ومثل هذه الحجة كانت موجهة بالأساس للأمويين، لتفنيد مزاعمهم وما هم عليه..
شاع في العصر الأموي أدب الترسل، وهو نمط من الكتابات، كانت بمثابة منابر إعلامية لتكريس كثير من الأفكار والقيم، لاسيما قيم (الجبر) وطاعة أولي الأمر، وعدّ هذا من مرتكزات السياسة الأموية، واعتبرت طاعة الخليفة، (خلافة الله) من طاعة الله، ويبدو أن هذا الضرب من الطاعة، انتقلت إلى الأمويين عبر الموروث الثقافي الفارسي كما سنرى، ورغم ذلك، فقد عــدّ حكم الأمويين أكثر تساهلا في الأمور الدينية، مقارنة بالعباسيين، أي أنهم لم يتوسلوا الدين لفرض طاعتهم على الناس، بل كانت حكوماتهم أقرب إلى أخلاقيات العرب الغساسنة قبل الإسلام، المطبوع بالطابع العربي القبلي، في حين وجدنا أن العباسيين عملوا على توظيف الدين لتكريس سيادتهم، وتسويغ حكمهم، وتمكين تواصلهم واستمرار تحكمهم في الناس، لهذا فقد وجدنا الخليفة الثاني أبا جعفر المنصور يفاجئ الناس في أول خطبة له قائلا: (أيها الناس، إنما أنا سلطان الله في أرضه) وهنا إشارة إلى أن طاعة السلطان من طاعة الله..
كان تأثير القيم الفارسية واضحا في سلوك الإنسان المسلم، وكان ابن المقفع الأبرز دون منازع نقلا لهذه القيم، عن طريق كتاباته، بما فيها ترجماته، وكان الاطلاع على حياة ملوك الفرس، وتمثّلها من قبل الخلفاء ظاهرا للعيان، فتعظيم الخلفاء، وطريقة الدخول إليهم، واختيارهم لندمائهم، وطرائق إقامة المآدب، والظهور بحالة الأبهة، وطريق التخاطب بلغة التعظيم، كل هذا منقول عن الموروث الفارسي، وكان المخاطبة إما بخليفة الله، أو أمير المؤمنين.. وكل هذا للتعظيم وتمجيد الطاعة وتقديس لشخص الخليفة الملك، وكان يعطى دور لرجال الدين، كحلقة هيمنة، فقد كانوا يتزلفون للخليفة وخواصه من جانب، وبالمقابل يقومون بربط العوام بوجوب الطاعة والخنوع للخليفة، وبأن طاعة الخليفة من طاعة الله، وكثيرا ما حصلت انقسامات في تفسيراتهم وتأويلاتهم للنصوص الدينية، فانقسموا متناحرين..راح ابن المقفع يؤكد على خصال السلطان كسبيل لنجاحه وطريقة لدوام جبروته وملكيته، ووقايته من الشر..وقد تخلق أبوجعفر المنصور بقيم أكاسرة الفرس (قيم كسروية)، كما تم تداول حكايات وأمثال شاعت في الدولة الإسلامية، لها مغاز، مثلا كقولهم: القائد الذي تخافه الرعية، أفضل من قائد يخاف هو الرعية، وهنا لا يخفى الهدف من تكريس سطوة الظالم، أو قولهم: إذا كان الإمام عادلا فله الأجر، ولك الشكر، وإن كان ظالما، فعليه الوزر، ولك الصبر..وهنا أيضا تكريس للإذعان والخنوع مع السلطان الجائر، أو ما روي عن الرسول الكريم قوله: (لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة) هذا الحديث قيل بالأساس في الفرس وفي حالة لها طابع الخصوصية، عندما ورثت ابنة كسرى العرش عن أبيها بعد وفاته. وهذه المناسبة الخاصة جرى تعميمها كحالة عامة للحط من شأن المرأة، وينقل لنا ابن المقفع مثالا آخر عن الإساءة للمرأة والحذر من الارتباط بها: (المرأة غلّ، فانظر ماذا تضع في عنقك) أو عدم ائتمانهن على سر..
إن كثيرا من القيم الأخلاقية هي نتاج اجتماعي، نرثها من المجتمع كعادات وتقاليد وأعراف، وهناك من يرجع أصل الأخلاق إلى الدين، وآخر إلى العقل أو الضمير، ناهيك عن المجتمع كمصدر لهذه القيم، أنا من الذين يرون أن هذه القيم صناعة اجتماعية، أما الذين يردون الأخلاق إلى العقل أو الضمير، فالسؤال الطبيعي هو: ماهو العقل أو الضمير.؟ وبالتالي كيف يتكونان.؟ وهل يتكونان خارج المجتمع, وبغنى عنه.؟ أما الذين يرجعون تلك القيم إلى الدين، فالسؤال هو:هل تنتفي الأخلاق في حال غياب الدين عن مجتمع ما؟ أو فلنقل الدين الإسلامي، طالما الدين عند الله هو الإسلام.. وهذا لا يمكن قبوله أو الركون إليه وهو أصلا لا يصمد أمام الحقيقة والواقع..
لقد فرضت القيم الكسروية على الحالة الإسلامية، بل حدا بعضهم ليقول من إن النزاع بين علي ومعاوية هو نزاع بين القيم التي ورثها الإسلام عن الفرس، فالطاعة غير المشروطة عند الفرس، اتخذت في الإسلام وجهة ألوهية الإمام، كما عند بعض فرق الشيعة، بخلاف موروث الخلافة الراشدية.. فطاعة كسرى كانت من طاعة الله عند الفرس، حتى أن عبادة كسرى لدى البعض لا تثير الاستهجان، ولا يؤاخذ صاحبه عليه..ومثل هذا الواقع انتقل إلى دنيا الإسلام في ديار العرب، فاستحال خليفة المسلمين إلى كسرى المسلمين.
إن الموروث الفارسي قد لامس أهواء الخلفاء الأمويين، لما فيه من تكريس للطاعة، وإذا كان خطاب الطاعة بدأ بالخلافة الأموية، غير إن العباسيين الذين خلفوا الأمويين أبقوا على خطاب الطاعة، بل أعطوه الأولوية: (من اشتدت وطأته، وجبت طاعته) فطاعة كسرى واجبة دون شرط أو مجادلة فيه، ومثل هذه النزعة سرت في فرق إسلامية عرفت بـ (الغلاة) الذين رفعوا أئمتهم إلى مرتبة الإله، وهم من الشيعة المتطرفة، فمنهم من دعا بإلهية علي بن أبي طالب، وآخر هو عبد الله من أحفاد أبي طالب، دعا لنفسه بأنه ربّ ونبي، وقد عبده بعض الناس، أي بمعنى آخر تشكلت صورة الإمام أعلى مقاما من الخليفة، تشبّها بكسرى، فطاعة الإمام هي نفسها طاعة الإله، وهذا الأمر الأخير مازال ساريا عند فرق من الشيعة اليوم..
وغني عن البيان عن تأثر الإسلام بالقيم العربية، قبل الإسلام، وقد وصلت على شكل حكم وأمثال، لاسيما الشعر، الذي عرفوه بديوان العرب، ولم ترق إلى مستويات العمق الفكري، إنما كانت ترجمة عن خبرة الإنسان وتجاربه في الحياة، وجاءت الدعوة إلى خصلة الكرم، فقيل أكرم من حاتم، إلى جانب قيم الشجاعة، والمروءة وإغاثة الملهوف، وقيم أخرى كثيرة وردت في أشعار زهير بن أبي سلمى وطرفة ولاحقا المتنبي وسواه.. لكن ليس المجال هنا للخوض في هذا الجانب، فقط مررنا للتذكير ليس إلا..
وعندما نندار إلى الفكر اليوناني، فنبادر إلى القول من أن الفكر اليوناني انصرف إلى الطبيعة، إلى الكون والإنسان، (اعرف نفسك بنفسك) أي كان ميدانه هو العلوم الفكرية، ومن أن الطبيعة في تغيير دائم.. لم يكن تأثير القيم اليونانية قويا في الفكر الإسلامي، كما تأثير الموروث الفارسي، لكن لا يمكن نفي التأثر فمثلا ما نقله ابن رشد عن أرسطو وعدّ شارحا له، وأيضا الفارابي فيما نقله، وفي العلوم الأخرى أيضا كالطب مثلا..كل هذا وسواها من العلوم لا بدّ له، أن يترك أثرا في القيم الإسلامية…
هذا الاغتناء الفاحش كان حافزا للمقتدرين ماديا من امتلاك العديد من العبيد، واقتناء الجواري، وتفشي حال السكر والعربدة، فأصبح الناس تحرّكهم قيم مختلفة جراء وضعهم الطبقي.. وبالمقابل هناك من استبدّ بهم اليأس، أو هكذا رأوا الدين، فمالوا إلى الزهد والتقشف في حياتهم، والتفرغ للعبادة، وهؤلاء عرفوا بـ (العبّاد الـزّهّاد) انصرفوا عن متع حياة الدنيا الفانية راجين لقاء ربهم..
شهد العراق عن طريق موانئ البصرة خاصة، قدوم أعاجم من بلاد فارس على الوجه الأخص، فضلا عن أخلاط من أقوام مختلفة، وفئات أخرى ممتهنة للتجارة، كل هؤلاء قدموا إلى ديار الإسلام يحملون معهم ميولا وعادات وسلوكيات مختلفة، ناهيك أن كبراء الأمويين أنفسهم، كانوا رقيقي الإيمان، فلم يتملكهم الدين بعمق، ولم يستحكم في أفئدتهم، ولم يستغلق عليهم التفكير، فالأمويون كانوا يبررون سلوكهم باقتراف إثم ما بالقضاء والقدر، أي إن الله قضى على هذا الإنسان باقتراف هذه الجريرة، فليس من راد إذن لقدر الله، وبالتالي فهذا تبرير للسلوك الإباحي عند الفرد، فقد جعلوا من (الجبر) عقيدة تبرر سياساتهم، وتسقط المسؤولية عنهم، طالما الله قضى بذلك.بالمقابل وبالضد من ذلك، ظهرت حركة فكرية تنويرية عرفت بالقدرية، التي رأت عن قدرة الإنسان من التحكم بأفعاله، وبالتالي فهو يتحمل مسؤولية ما يصدر عنه، وكان هؤلاء من الذين تشيّعوا لعلي وآل البيت، ومثل هذه الحجة كانت موجهة بالأساس للأمويين، لتفنيد مزاعمهم وما هم عليه..
شاع في العصر الأموي أدب الترسل، وهو نمط من الكتابات، كانت بمثابة منابر إعلامية لتكريس كثير من الأفكار والقيم، لاسيما قيم (الجبر) وطاعة أولي الأمر، وعدّ هذا من مرتكزات السياسة الأموية، واعتبرت طاعة الخليفة، (خلافة الله) من طاعة الله، ويبدو أن هذا الضرب من الطاعة، انتقلت إلى الأمويين عبر الموروث الثقافي الفارسي كما سنرى، ورغم ذلك، فقد عــدّ حكم الأمويين أكثر تساهلا في الأمور الدينية، مقارنة بالعباسيين، أي أنهم لم يتوسلوا الدين لفرض طاعتهم على الناس، بل كانت حكوماتهم أقرب إلى أخلاقيات العرب الغساسنة قبل الإسلام، المطبوع بالطابع العربي القبلي، في حين وجدنا أن العباسيين عملوا على توظيف الدين لتكريس سيادتهم، وتسويغ حكمهم، وتمكين تواصلهم واستمرار تحكمهم في الناس، لهذا فقد وجدنا الخليفة الثاني أبا جعفر المنصور يفاجئ الناس في أول خطبة له قائلا: (أيها الناس، إنما أنا سلطان الله في أرضه) وهنا إشارة إلى أن طاعة السلطان من طاعة الله..
كان تأثير القيم الفارسية واضحا في سلوك الإنسان المسلم، وكان ابن المقفع الأبرز دون منازع نقلا لهذه القيم، عن طريق كتاباته، بما فيها ترجماته، وكان الاطلاع على حياة ملوك الفرس، وتمثّلها من قبل الخلفاء ظاهرا للعيان، فتعظيم الخلفاء، وطريقة الدخول إليهم، واختيارهم لندمائهم، وطرائق إقامة المآدب، والظهور بحالة الأبهة، وطريق التخاطب بلغة التعظيم، كل هذا منقول عن الموروث الفارسي، وكان المخاطبة إما بخليفة الله، أو أمير المؤمنين.. وكل هذا للتعظيم وتمجيد الطاعة وتقديس لشخص الخليفة الملك، وكان يعطى دور لرجال الدين، كحلقة هيمنة، فقد كانوا يتزلفون للخليفة وخواصه من جانب، وبالمقابل يقومون بربط العوام بوجوب الطاعة والخنوع للخليفة، وبأن طاعة الخليفة من طاعة الله، وكثيرا ما حصلت انقسامات في تفسيراتهم وتأويلاتهم للنصوص الدينية، فانقسموا متناحرين..راح ابن المقفع يؤكد على خصال السلطان كسبيل لنجاحه وطريقة لدوام جبروته وملكيته، ووقايته من الشر..وقد تخلق أبوجعفر المنصور بقيم أكاسرة الفرس (قيم كسروية)، كما تم تداول حكايات وأمثال شاعت في الدولة الإسلامية، لها مغاز، مثلا كقولهم: القائد الذي تخافه الرعية، أفضل من قائد يخاف هو الرعية، وهنا لا يخفى الهدف من تكريس سطوة الظالم، أو قولهم: إذا كان الإمام عادلا فله الأجر، ولك الشكر، وإن كان ظالما، فعليه الوزر، ولك الصبر..وهنا أيضا تكريس للإذعان والخنوع مع السلطان الجائر، أو ما روي عن الرسول الكريم قوله: (لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة) هذا الحديث قيل بالأساس في الفرس وفي حالة لها طابع الخصوصية، عندما ورثت ابنة كسرى العرش عن أبيها بعد وفاته. وهذه المناسبة الخاصة جرى تعميمها كحالة عامة للحط من شأن المرأة، وينقل لنا ابن المقفع مثالا آخر عن الإساءة للمرأة والحذر من الارتباط بها: (المرأة غلّ، فانظر ماذا تضع في عنقك) أو عدم ائتمانهن على سر..
إن كثيرا من القيم الأخلاقية هي نتاج اجتماعي، نرثها من المجتمع كعادات وتقاليد وأعراف، وهناك من يرجع أصل الأخلاق إلى الدين، وآخر إلى العقل أو الضمير، ناهيك عن المجتمع كمصدر لهذه القيم، أنا من الذين يرون أن هذه القيم صناعة اجتماعية، أما الذين يردون الأخلاق إلى العقل أو الضمير، فالسؤال الطبيعي هو: ماهو العقل أو الضمير.؟ وبالتالي كيف يتكونان.؟ وهل يتكونان خارج المجتمع, وبغنى عنه.؟ أما الذين يرجعون تلك القيم إلى الدين، فالسؤال هو:هل تنتفي الأخلاق في حال غياب الدين عن مجتمع ما؟ أو فلنقل الدين الإسلامي، طالما الدين عند الله هو الإسلام.. وهذا لا يمكن قبوله أو الركون إليه وهو أصلا لا يصمد أمام الحقيقة والواقع..
لقد فرضت القيم الكسروية على الحالة الإسلامية، بل حدا بعضهم ليقول من إن النزاع بين علي ومعاوية هو نزاع بين القيم التي ورثها الإسلام عن الفرس، فالطاعة غير المشروطة عند الفرس، اتخذت في الإسلام وجهة ألوهية الإمام، كما عند بعض فرق الشيعة، بخلاف موروث الخلافة الراشدية.. فطاعة كسرى كانت من طاعة الله عند الفرس، حتى أن عبادة كسرى لدى البعض لا تثير الاستهجان، ولا يؤاخذ صاحبه عليه..ومثل هذا الواقع انتقل إلى دنيا الإسلام في ديار العرب، فاستحال خليفة المسلمين إلى كسرى المسلمين.
إن الموروث الفارسي قد لامس أهواء الخلفاء الأمويين، لما فيه من تكريس للطاعة، وإذا كان خطاب الطاعة بدأ بالخلافة الأموية، غير إن العباسيين الذين خلفوا الأمويين أبقوا على خطاب الطاعة، بل أعطوه الأولوية: (من اشتدت وطأته، وجبت طاعته) فطاعة كسرى واجبة دون شرط أو مجادلة فيه، ومثل هذه النزعة سرت في فرق إسلامية عرفت بـ (الغلاة) الذين رفعوا أئمتهم إلى مرتبة الإله، وهم من الشيعة المتطرفة، فمنهم من دعا بإلهية علي بن أبي طالب، وآخر هو عبد الله من أحفاد أبي طالب، دعا لنفسه بأنه ربّ ونبي، وقد عبده بعض الناس، أي بمعنى آخر تشكلت صورة الإمام أعلى مقاما من الخليفة، تشبّها بكسرى، فطاعة الإمام هي نفسها طاعة الإله، وهذا الأمر الأخير مازال ساريا عند فرق من الشيعة اليوم..
وغني عن البيان عن تأثر الإسلام بالقيم العربية، قبل الإسلام، وقد وصلت على شكل حكم وأمثال، لاسيما الشعر، الذي عرفوه بديوان العرب، ولم ترق إلى مستويات العمق الفكري، إنما كانت ترجمة عن خبرة الإنسان وتجاربه في الحياة، وجاءت الدعوة إلى خصلة الكرم، فقيل أكرم من حاتم، إلى جانب قيم الشجاعة، والمروءة وإغاثة الملهوف، وقيم أخرى كثيرة وردت في أشعار زهير بن أبي سلمى وطرفة ولاحقا المتنبي وسواه.. لكن ليس المجال هنا للخوض في هذا الجانب، فقط مررنا للتذكير ليس إلا..
وعندما نندار إلى الفكر اليوناني، فنبادر إلى القول من أن الفكر اليوناني انصرف إلى الطبيعة، إلى الكون والإنسان، (اعرف نفسك بنفسك) أي كان ميدانه هو العلوم الفكرية، ومن أن الطبيعة في تغيير دائم.. لم يكن تأثير القيم اليونانية قويا في الفكر الإسلامي، كما تأثير الموروث الفارسي، لكن لا يمكن نفي التأثر فمثلا ما نقله ابن رشد عن أرسطو وعدّ شارحا له، وأيضا الفارابي فيما نقله، وفي العلوم الأخرى أيضا كالطب مثلا..كل هذا وسواها من العلوم لا بدّ له، أن يترك أثرا في القيم الإسلامية…