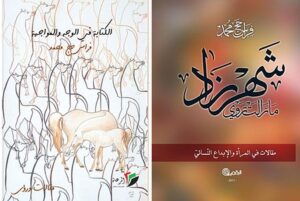محمد باقي محمد
محمد باقي محمد في ما بعد سيُقيّض لروائيّين عرب أن يبيئوا الرواية الكلاسيكية تلك ، وقد يحضرنا في هذا الجانب أسماء مهمة كنجيب محفوظ وحنا مينة – في روايته ” الشراع والعاصفة ” – على سبيل المثال لا الحصر ، ما أتاح لأجيال تالية من الروائيين إنجاز رواية تتسم بالجدة ، في إطار من التفرّد ، ناهيك عن الاشتغال على مفهوم المُخالفة ، على هذا ستنتقل الرواية من تقنيّة السارد الكلي الهيمنة إلى تقنية السرد المُتعدّد الأصوات ، ولن يكون هذا الانتقال بمعزل عن إنجازات علم النفس ، هذا بغضّ النظر عن المواقف المُتباينة من تلك الإنجازات ، وبخاصة ما جاء عليه فرويد ، ولعلنا نستنجد هنا بنجيب محفوظ – ثانية – مُتوسّلين المثال في روايته المعنونة بـ ” ميرامار ” ، ما يذهب بنا جهات التأكيد على أنّ الرواية العربيّة لم تكتف بالتأصيل ، بل أنّها خاضت معركة الحداثة باقتدار ، وقد يكون الخروج عن المثال الأوروبي – في حدّ ذاته – إجازة مرور للقول بتلك الحداثة ، لتحلّ – من ثمّ – مفاهيم الابتكار والاستلهام والنقد محلّ مفاهيم التقليد والاقتباس والنقل ، ولنا في رواية حنا مينة ” الشمس في يوم غائم ” خير مثال على ما نودّ التدليل عليه ، وفي هذا الإطار جاء اشتغال الروائيّين على تيّار الوعيّ ، لينهض بتحرير لغة الشخصيّة تحريراً كاملاً بعيداً عن تدخّل السارد ، وقد نتذكّر – في هذا الجانب – إنجاز الروائيّ المعروف هاني الراهب داخل الفصل الذي جاء على لسان المرأة في روايته ” الوباء ” ، أو ما كتبه سليم بركات في غير رواية له ، واضعين في اعتبارنا انتقال المقال إلى الفعل المضارع غالباً ، واعتماد ضمير المُتكلّم الذي يسمح بالغوص – عميقاً – في الدواخل القصية للشخوص التي تنثال على المتن ، ثمّ حضرت الأسطورة لتؤسّس للتجاوز ، فانهمك بعض الروائيّين في التشبيك بين متونهم وأساطير مُتواترة معروفة ، فيما لجأ بعضهم الآخر إلى اجتراح أسطورته الخاصة ، أو إلى توليف عناصر أسطرة داخل المتون ، كما في اشتغال الـ : د . عبد الرحمن منيف على شخصيّة متعب الهذال “ مدن الملح – التيه ” !
كان العسكر قد تسلّموا السلطة في أكثر من قطر عربيّ غبّ الاستقلال بوقت قصير في ظاهرة عالمثالثية بامتياز ، ربّما لأنّ الأقطار العربيّة هزمت في حرب الـ 48 أمام إسرائيل ، فحمّل الجيش وزر تلك الهزيمة للسياسيّين ، وانقلب عليهم مُتسنّماً سدّة السلطة ، وشيئاً فشيئاً راحت دولة العسف تتوطّد ، فحضر المكان الافتراضيّ تحاشياً لغضبها ، حتى لكأنّ الروائيّ العربي كان يترسّم مبدأ التقية الإسلاميّ خوف السلطان غالباً ، ولأسباب قد تندرج تحت خانة الفنيّ أحياناً ، هذا كان حال جبرا إبراهيم جبرا وعبد الرحمن منيف في ” عالم بلا خرائط ” ، إذْ حضرت ” الطيبة ” كمكان رمزيّ بديل للمكان الواقعيّ !
وفي خطوة أخرى اشتغل الروائيّون على تقنية الرواية داخل الرواية ، فحضر الروائي داخل المتن كشخصيّة روائيّة ، ولنا في ” شكاوى المصري الفصيح ” ليوسف القعيد خير مثال على هذا الحضور !
ولم يكن المُتكأ التاريخي بعيداً عن الأذهان ، إذْ تمّ استلهام الموروث التاريخيّ في هذا الجانب ، لتمكّن الروائي من قراءة الحاضر بدلالة الماضي ، لكن لا كزمن ارتجاعيّ بل كزمن مُتنقل بين الماضي والحاضر والمُستقبل ، وذلك عبر دوائر مرموز تتسع باستمرار عبر مستويات التأويل ، ذلك أنّ الرواية فن مُتحرّر من سلطة اللاهوت ومن سلطة الزمن الأصل ، ولنا في ” الزيني بركات ” لجمال الغيطاني – الذي استمدّ مادته الأساس من ” بدائع الدهور ” لابن إياس – انموذج في ما ذهبنا إليه من رأي !
حتى الوثيقة بحرفيّتها حضرت في المتن الروائيّ ، ربّما بهدف ” وقعنة ” العمل ، أو بهدف التجديد والتنويع في أساليب السرد ، وقد نجد مثالنا هنا في ” بيت الخلد ” لوليد إخلاصي !
هكذا – ربّما – لعب الروائيون العرب على التجريب ، فخاضوا غمار المتحوّل ، وعملوا على خلخلة الثوابت والبديهيات ، وإذا كان القول بحداثة عربية في مجال الرواية ممكناً ، كانت الإشارة إلى أنّ هذه الحداثة – على تأثرها بالغرب – جاءت لتجيب على أسئلة تخصّ الثقافة والمجتمع العربيََيْن ، نقول إنّ إشارة كهذه ضرورة من جهة ، وإقرار بواقعة من جهة أخرى !
قطع الروائيون العرب مسافة طويلة – في طريقهم – من الماضوية والنقلية إلى الكشف والتجريب والإبداع .. من المُطلق – الملحمي مثلاً – إلى التاريخي المُعقلن – ما أعاد الاعتبار للواقع المُعاش – على الطريق نحو إنجاز رواية تخييل ، رواية راحت تقطع شأواً كبيراً على طريق النضج الفنيّ ، فتبدّت حداثتها على أكثر من مُستو ، سواءً أكان ذلك على مستوى العلاقات الكلية بين عناصر اللغة والزمان والمكان والشخوص ، أو على مُستوى العلاقات الجزئيّة داخل كلّ عنصر ، وفي هذا الجانب يمكننا أن نستشهد بصنع الله إبراهيم في روايته ” تلك الرائحة ” ، وسيحضرنا اشتغال أحلام مستغانمي في ثلاثيتها ” ذاكرة الجسد ، فوضى الحواس ، وعابر سرير ” ، أو اشتغال عبد الرحمن منيف في ثلاثيته ” أرض السواد ” كأمثلة أخرى على الطريق ذاته ، وسيمدّنا إلياس الخوري في ” الوجوه البيضاء ” وعلوية صبح في ” دنيا ” وسليم بركات في ” الريش ” بغير مثال على امّحاء المسافة بين الواقعيّ والمُتخيّل ، فتنفتح أمام الرواية العربية آفاق لا تحدّ !
وعطفاً على الشق الثاني من موضوعتنا – أي على النقد – يُمكننا القول بأنّ أحد مشكلاته الرئيسة تتجلى في أنّه ما يزال يتعامل مع المادة الروائية على أنّها حدث حقيقيّ لا جدال فيه ، ولهذا فهو ما يزال يناقشه بالقياس إلى مُطابقته للواقع !
إنّ العمل الروائي يتقدّم على النقد ، شانه في ذلك شأن أي عمل فنيّ ، وخلال مسيرته الطويلة تناوب النقد الأكاديمي والنقد غير الأكاديمي – الذي مارسه الأدباء ذاتهم – على المشهد الثقافيّ ككلّ ، فحضرت قراءات الـ : د . طه حسين – التي جمعت بين الحالين – إلى جانب إنجاز الـ : د . محمد مندور ، الذي اقتصر في عمله على السياق الثاني ، وما بين هذا وذاك اشتغل ميخائيل نعيمة وعباس محمود العقاد – إلى جانب آخرين – على موضوعات شتى!
هنا أيضاً قد نتساءل أن هل نحن امتداد للقاضي عبد القاهر الجرجاني وابن قدامة وابن جعفر والآمدي ، أم أنّنا صوى لنورثوب فراي وجاك دريدا وتزفيتان تودورف وكلود ليفي شتراوس ورولان بارت وميشيل فوكو .. إلخ !؟ ذلك أنّنا في ما أتوهّم أمام مُشكلة لا تقلّ عن سابقتها ، إن لم تكن أكثر أهميّة وإلحاحاً ، وتتمثل في غياب المثال والقدوة أو اختلاطهما ، إذْ لا تؤسّس إشارات مُتباعدة لمحمود درويش – مثلاً – أو لصبحي حديدي إلى ما جاء على لسان التوحيديّ في ” المقابسات ” أو في ” الإمتاع والمؤانسة ” من آراء إلى حضور مرجعيّ للترتث النقدي العربي في اشتغال النقاد العرب !
أمّا اليوم فلا تبدو الصورة شديدة التبدّل ، إذْ ما يزال النقاد والأدباء يتناوبون – أو يتعاونون – على الممارسة النقدية ، هذا هو حال نبيل سليمان – الروائي والناقد مثلاً – أو حال جبرا إبراهيم جبرا وإلياس الخوري ، وفي الجانب الآخر تحضر أسماء عديدة كإدوارد سعيد ومحمود أمين العالم و صلاح فضل وجابر عصفور وإحسان عباس ، يمنى العيد ويوسف اليوسف ومحمد بنيس وعبد الله الغدامي ، هذا على سبيل المثال لا الحصر، وإذن فلماذا الحكم الجائر الذي تصدّر مقالتنا حول تخلف العمارة النقدية عن العمارة الإبداعيّة !؟ هل يعني هذا بأنّ النقد الذي يبوّب ويصنّف ويرتّب ، ويبعد أنصاف المواهب – أو المتسلّقين على الأدب عنه – غائب !؟ وهل نودّ الذهاب جهات غياب نقاد شديدي الأهميّة على مستوى الوطن العربي !؟
وفي الجواب قد نوافق على محتوى السؤال الأوّل في معرض الإجابة الضمنية عليه ، لكنّنا سنجزم – من كلّ بدّ – بوجود قامات نقديّة كبيرة مشهود لها كإجابة عن التساؤل الثاني ، مُمثلين لذلك بحنا عبود أو يوسف اليوسف أو إدوارد سعيد أو جابر عصفور أو فيصل دراج ، وقد نتحايل على الموضوع بجواب آخر أن نعم ثمّة نقّاد كبار في الوطن العربيّ ، بيد أنّنا نفتقد إلى تقاليد نقديّة ، وعليه فقد نجازف بالقول أن ليس ثمّة نقد ، ولإزالة المُلتبس في كلامنا والمُتناقض سنوضح المسألة بمثال ، فنذكّر بأنّ الإمارات المتّحدّة تنفق كثيراً على الثقافة ! يكفيها في هذا الجانب مسابقة أمير الشعراء ، ولكن هل لنا أن نتحدّث عن حركة شعريّة فيها تنتمي إلى عقد الثمانينات مثلاً .. أو التسعينات.. أو ما بعدها !؟ الجواب – قطعاً – هو النفيّ ، إذْ ليس ثمّة حراك ثقافيّ حقيقيّ هناك ، فهل نطالب الناقد أن يغامر بلقمة أولاده ، ليبوح بهذه الحقيقة !؟ هذا يُحيلنا إلى الجهات التي ترعى النقد – اليوم – في مشرق الوطن العربيّ ومغربه !
ثمّ أنّ المحسوبيّة والشلليّة إذْ تطلّ برأسها كدمّلة قبيحة ، ناهيك عن القراءات الصحفيّة التي تتسّم بالسرعة والسطحية والاحتكام إلى المزاجي والعلائق غير الصحيّة ، إلى جانب غياب كبير للمنهجيّة ، يُسهم في تشويه الصورة وإفسادها ! ولهذا – ربّما – حقّق شاعر كأنسي الحاج حضوراً لافتاً ، مع أنّه لا يُقارَن بشاعر من وزن المرحوم خليل حاوي ، ولهذا – أيضاً – قد نتساءل كيف لنا أن نقارن شغل يوسف اليوسف على ت . س . اليوت ، أو عمله في ” المعيار والقيمة ” ، بنقده التطبيقيّ على تجارب شعريّة مُعيّنَة !؟
- ورقة عمل ألقيت في مهرجان العجيلي للرواية في الرقة 10 / 12/ 2009 ، ويشكل الشق الثاني منها جواباً على سؤال في المنحى الذي جاء عليه !