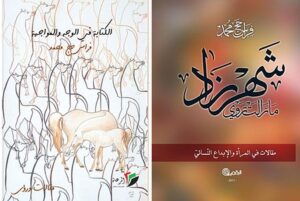زيور محمود
زيور محمود لكن بعد ذلك الوسم الجغرافي القصير، يدخل كاهون إلى صلب معركته الاجتماعية الثقافية فيقول : ” إن صفة الحذر والجفول التي يتسم بها هذا الشعب، والغموض الذي يحيط بمعتقداته الدينية، والثبات والحمية التي دافع وما يزال عن قوميته العربية، ضد كل الغزاة الأجانب، والهيئة المميزة لهؤلاء الشقر ذوي العيون الفاتحة والمختلفة بشدة عن هيئة المارونيين والأتراك والأكراد .. الخ . كل هذا دفعني إلى جمع المعطيات الأنثروبولوجيا، بحيث يكون العلويين من بين الجماعات البشرية الأخرى التي أسعى لكشف أصولها والتعريف إيجابيا بخصائصها الأنثروبولوجية ”
والأبعاد الثقافيةالاجتماعية ذات الدلالة في الشخصية التي يتفاعل معها كاهون خلال رحلته، تتمثل في وصفه لعدد من الشخصيات العلوية التي تنحدر من أكثر من منبت ومرتبة عمرية، حيث نستطيع كشف دلالات اجتماعية وثقافية واقتصادية من كل وصف لتلك الشخصيات التي لاحظها كاهون في رحلته، وهو الشيء الأكثر فائدة في مجمل المذكرات التي مثل هذه، فالوصف الذي كان يبدو بديهيا وعاما وقتها، يأخذ في الراهن ثقلا معرفيا تاريخيا، بسبب جملة المعاني المنبثقة منه : ” فأبو سليم، بكوفيته الملفوفة حول رأسه بطريقة عسكرية وبندقيته ذات الطلقتين، ومشلحه الأبيض، بدا في هيئة محارب حقيقي وهو يمتطي فرسا رمادية جميلة، أما ابنه سليم فقد أمتطى فرسا لائقا، إلا أنه لم يحمل بندقية ولا يضع كوفية أو مشلحا ولم ينتعل جزمة أيضا , كان يرتدي سترة ذات لون ضائع بين الأحمر والأسود، ويمسك بمظلة بيضاء .. الخ …. أما الامرأتان اللتان كانتا تتحدثان دون أن يبدو عليهما أي مظهر من مظاهر الوجل أو التوجس، كانتا تتحدثان بتلقائية دون فضول متطفل، وتظهران الكثير من الحرية الحقيقية والسامية، وأنا لا استطيع إطلاق هذه الصفة على النساء من المذاهب الأخرى، ولا حتى المسيحيات في لبنان اللواتي كن يتوارين عن أنظاري، عدا الحالات النادرة الاستثنائية ….. وفي مقطع آخر ” تجمع سكان قرية ” غلليني” على مدخل قريتهم يرحبون بنا ويتمنون لنا إقامه طيبة . وكان هناك عدد من النساء يختلطون بالرجال . لفت نظري إحداهن … كانت شابة طويلة القامة تبدو على وجهها سيماء الصحة والعافية، شعرها كثيف أسود ضفرته في جدليتين، قدمت لنا الماء القراح في أناء الذي كان هو نفسه في كل مكان من تلك القرية المتناثرة ألا وهو ” طاسة نحاس” . حيث جاء هذا الوصف بالمجمل كدلالة على عمق قيم التحرر في اجتماع بيئة العلويين التي رصدها كاهون من طرف – تحرر نسبي مقارنة بالبيئات المحيطة بتلك الجبال – ومن طرف آخر على حضور هام لقيم الرجولة والشهامة والفداء، وهو مزج كان نتج من طبيعة دور المرأة في البيئة الاقتصادية لتلك الجبال، وبسبب قسوتها وطبيعة الحكم التركي بها من طرف آخر .
حيث تعتبر تلك الصياغة لشخصية كائن تلك الجبال، مدخلا لوصف الحياة العامة للعلويين، فالمجتمع كان على شاكلة أفراده .” شرع الوجهاء العلويون ” إسماعيل العثمان” وقريباه و”مهنا” يشربون القهوة مراعاة لي لأن تناول ماء الحياة أو العرق لم يحن بعد . وحسب الأصول فقد بدأ الرجال يشربون برفقتي وتجمع بقية الوجهاء على بضعة أمتار وأخذوا يشربون الخمر ( العرق)، أما النساء فقد انسحبن للقيام بتجهيز الطعام …. دار الحديث حول السياسية بيني وبين الوجهاء … ومع بدء شرب طاسة العرق الثامنة (!! ) انحلت الألسن وازداد الحديث حمية وصراحة … وعلى بعد 50 خطوة، كانت قهقهات الوجهاء وبقية الرجال والنساء تختلط بالدبكات حول النار المستعرة في الحقل . كان الجميع في ذهاب وإياب من والى خيمتي دون الالتفات إلى ما كنا فيه من إعادة لرسم خرائط أسيا وأوروبا . وقد جاء ” أبو سليم” الرزين وابنه غريب الأطوار لحضور مجلسنا، إلا أنهما امتنعا عن إمتاعنا بآرائهما السياسية . كان أثنان أو ثلاثة من أفراد هذا الحشد الكريم يسكبون لنا العرق….. وهكذا حتى وجه الصباح (!! ) فذلك المشهد شبه الروائي، يقدم دلالات عميقة عن طبيعة البيئة الاجتماعية في تلك الجبال قبل مئة عام، فقد كانت الحدود الطبقية خفيفة إلى حد بعيد، وكان الكل يتساوى في المأكل والمشرب، أما أهم دلالة، فهي الطبيعة الاحتفالية التي كانت تسود نوعية حياتهم .
وعين الروائي نفسه، تدخل إلى صلب البيئة المكانية، حيث وصف البيوت يعتبر كجسر لكشف الطبيعة الاقتصادية والشواغل النفسية اليومية التي كان العلويون ينشغلون بها في بيئتهم تلك : ” يعلو الباب من الجهة الكبيرة إناء ماء مبارك ومن الجهتين اللتين تحيطان بالباب الكبير فتحتان مستديرتان أو مربعتان حيث تساعد الأولى في تيسير انطلاق روح ساكن البيت الذي يشرف على الموت .. وثانية مدخلا لروح طفل قادم للحياة … أما سطح البيت فقوامه جذوع أشجار متكئة على أربعة سواميك (أعمدة وهي أيضا عبارة عن جذوع أشجار تختلف عن تلك التي في السطح، وهو يحتفظون بمساحات من الفروع الرئيسية للأغصان ) . وضعت دون تنسيق في كل غرفة، أما الفتحات التي تظهر من بين العوارض المتكئة فقد سدت بالنباتات، ثم طليت جميعها بطبقة من الصلصال الممزوج بالرمل وحبيبات الكلس … أطراف السطح حفرت فيها قناة لجر المياه الهاطلة فوقه . وعلى العموم يمكن نزع العواض عن السطح دون مشكلة كبيرة، وهذا ما كان العلويون يفعلونه حينما يتعرضون لهجوم في أطراف القرية .
ويضيف “بجانب المنزل تنتصب صقالة مؤلفة من أربعة جذوع ترتفع ثلاثة أو أربعة أمتار عن الأرض تنتصب فوقها خيمة من العوارض الخشبية تستعمل كغرفة نوم في أيام الصيف، ويتم الصعود أليها عن طرق سلم يرفع بعد الصعود إلى هذه الخيمة (العرزال) . … وفي الداخل لا يوجد أي أثر للأثاث المنزلي … هناك مقعد طيني على طول الجدار في غرفة الاستقبال وبعض الأباريق من الفخار، قطعتان أو ثلاث من اللباد الأبيض، طاولة كبيرة من القش ملقاة في الزاوية بجانب قدور معدنية وأدوات الحراثة …. أما أسرة الأطفال فهي عبارة عن صندوق من الخشب زينته الأم ببعض النقوش، وعلى باب المدخل، علقت أسلحة متنوعة من خناجر وسيوف .. ولا يوجد أي صندوق لوضع الثياب إذ الجرار الفخارية تقوم مقام الخزائن والصناديق، كدت أن أنسى أن أذكر ماعونا يكاد يكون موجودا في كل البيوت الثرية، انه الكاز . كانت خيوط التبغ معلقة بعوارض السقف كي تجف، أذ أنها في الشتاء تتعرض للرطوبة لذلك فإن تعليقها في الغرفة التي يكون الموقد فيها يكسبها لونا غامقا ورائحة مميزة أعطتها لقب ” تبغ أبو ريحة”…. وهذا التبغ المعروف بلقب “أبو ريحة” يتم مزج العُشر منه بتسعة أعشار من التبغ العادي وهو يعرف عندنا في فرنسا باسم ” تبغ اللاذقية” ويباع في اللاذقية نفسها بضعف ثمن التبغ العادي تحت اسم -التبغ البلدي- ” فالمعيشة البسيطة المطعمة بالاستقرار الاقتصادي هو ما مميز تلك البيئة، فالمنزل ببساطة محتوياته كان يبدو مقسما إلى أكثر قسم معين، وكان عميقا من حيث دلالاته الروحية، وفي كل منزل كان ثمة مكان للاستخدامات الكمالية في حياة القرويين “التبغ” فكل عائلة علوية وقتها، كانت تنتج كفايتها من المنتج الاقتصادي .
لكن وصف الكاتب لطبيعة مساكن الموتى، يبرهن على مدى حذاقته السردية من طرف، على مدى تضخم “الانشغال الروحي” في ذات السكان العلويين من طرف آخر ” كان من المستحيل الوصول أليها على ظهر الحصان، فالمنحدرات القاسية لا يمكن اجتيازها إلا سيرا على الأقدام وذلك بسبب كثرة الصخور الضخمة الملساء، إلى درجة تثير الدهشة والعجب … وأثناء تجوالي في أعماق أحد الأودية وعلى جنبات الصخور الرمادية عثرت على غرف محفورة في الصخر يدعونها بـ ” نواغيص” وهي في الحقيقة مدافن لسكان ما قبل التاريخ في هذه المنطقة . كان المدخل ضيقا، لذلك فقد توجب علي الانزلاق أولا عبر ممر يبلغ المترين طولا امتلأ بالأعشاب اليابسة التي سدت على طريق وربما كانت هذه الأعشاب مرتعا للأفاعي والزواحف والحشرات … بعد الممر كان هناك باب يبدو أنه كان يغلق سابقا ببلاطة ضخمة أو بصخرة كبيرة . كان عرض هذا الباب 60 سم وارتفاعه 80 سم . تعلوه فتحة كاملة العقد يتم الدخول عبرها إلى مغارة طولها 5 م وعرضها 2 م وارتفاعها بمقدار متر واحد . هاهنا كان عرق بشري مندثر يدفن موتاه دون أية كتابة جدارية ودون أي أثر لأي تزيين, بضع بقايا فقط لشظايا من عظام هؤلاء الأموات اختلطت بالتراب العضوي الناتج عن تفسخ الجثث وتراكم الغبار وبضع قطع لإناء فخاري يشوبه الاحمرار والخشونة ورداءة الصنع” .
لكن بين كل مقطع وآخر، لا يمكن للكاتب كاهون، إلا أن ينزلق إلى السياسية وتفاسيرها، فالإمبراطورية العثمانية كانت تعيش آخر أنفاسها مع صعود السلطان عبد الحميد سدة السلطنة، والمناطق الجبلية الوعرة، مثل جبال العلويين، كانت تحت سلطة الإمبراطورية بشكل رمزي فحسب : ” كان يجلس على أحداهما شاب طويل القامة يرتدي “سترة” أوربية من القماش الأبيض فوق سروال حريري .. وكان من السهل معرفة هذا الشخص ذا الجبهة الضيقة والزي الغريب، لم يكن سوى تركي . كان شارباه معقوفين بحدة نحو الأعلى، كانت تصرفاته الخرقاء وهيئته المتغطرسة تشير إلى أنه ضابط احتياط . كان هناك أيضا بضعة جنود ببذاتهم المتباينة والباهتة اللون والمهترئة، يتسكعون هنا وهناك تحت أشجار المرج، وبين هؤلاء الجنود كان نافخ البوق، ذا وجه مربع أو بعبارة أخرى مفلطح، وسحنة سمراء يشوبها اصفرار، شديد الوسامة، أنه رجل من نواحي “جفا” التركية أو بعبارة أدق أحد النازلين الأميين، لا شك في ذلك ….. كان يبدو على أبناء ” قللورية” الانزعاج، وكان وجود الحامية التركية يفسر سبب ارتباكهم . ….. أخذت مكاني دون أن أعير الضابط الاحتياطي أي اهتمام ولم يكلف هو نفسه عناء القيام عند اقترابي منه . لذلك فقد جلست على البساط بجانبه وأدرت له ظهري، ثم انخرطت بالحديث مع أحد العلويين المسنين الوقورين ويدعى ” الشيخ إبراهيم سعيد” وهو شيخ دين جليل لطائفة العلويين الجنوبيين، كان هذا الشيخ المسن ذو الأربعة وثمانين عاما يرتدي ثياب قديمة العهد كانت فيما مضى بيضاء اللون … إلا أن عيناه تشعان ذكاء وتضجان بالحياة، وكانت حركاته النشيطة واللائقة تتعارض مع مظهره البسيط . وقد علمت بعد مكوثي بين القوم الذين كانوا يتحدثون بكل شيء، بأن الشيخ إبراهيم سعيد كان غنيا جدا، إلا أنه عقب مداهمة قامت بها قوات تركية لجمع أسلحة العلويين عام 1877 تعرض الشيخ إبراهيم السعيد لاعتداء عنيف استباح الأتراك خلاله قرية الشيخ وأحرقوها وفقد على أثر ذلك أربعة من أولاده الشباب …. لقد بدا لي أن العلويين يعيشون في واد والعالم كله يعيش في واد آخر، أما الحروب القريبة العهد فتبدو لهم كحرف ميت، كانوا بارعين في الحديث عن كوارثنا عام 1870 . هل كان مراعاة لي ؟ . فالمراعاة تبدو غريبة لي هنا . أكثر من واحد من هؤلاء الرجال الأقوياء كان قد شارك في الحملات . منهم من حارب في “شيبكا” و”إيلينا” وآخر في “زيفين” كل هؤلاء الجنود القدامى كانوا رجالا بسطاء جندوا عنوة وأجبروا على الانضمام إلى الجيش التركي، ولم يستثن أي زعيم علوي من الخدمة في الجيش الأنكشاري . …. أحد القرويين من الذين كانوا يسكبون لنا الشراب، اقترب مني بفضول مميز، بدت حركته وتصرفاته حضرية، صارحته بذلك فأجابني : كنت جنديا وأعرف الأصول، فأنت ضابط رديف وعلي أن أقدم لك فروض الاحترام … سألته: هل نلت رتبة عسكرية ما ؟ وهنا أخرج القروي من تحت قميصه البالي شرائط ورتبا مدعوكة بالإضافة إلى نيشان عثماني وقال : كنت شاويشا (رقيبا) عثمانيا وقد قدم لي الأتراك نيشان … سألته : أين حصلت عليه ؟ فأجاب : في “أيلينا” لقد استوليت هناك على مدفع من المسكوفيين وعندما رجعت كتيبتنا كان علينا أن نسير مدة شهرين للوصول إلى “كوزان داغ” ونحارب في الوقت نفسه ضد التركمان، وبما أننا أبحرنا من “مرسين” فقد رأيت أنني قريب من الديار وهكذا اتخذت قراري بالفرار …. سألته : لكنك لو بقيت لأصبحت ضابطا، بيك أو باشا … يجيب : بيك او باشا أو حتى “جعفر الطيار” أنا أفضل أن ألبس قميصا ممزقا وأظل جائعا في بلادي على أن أكون بيك أو باشا عند الأتراك “
ربما يمكن ذلك الوصف دقيقا إلى حد ما، لكن طيات كتابة كاهون لا تخفي نزوعه الاستعماري، ولو بشكل رمزي : ” أود أن أشير إلى أنه بانتهاء العهد الروماني سادت عهود الفوضى استمرت إلى اليوم، ولا أبالغ أبدا إذا قلت بأنه لم يكن هناك في الشرق على الإطلاق شيء يمكن تسميته بالحكومة أو بالإدارة . وأعتقد بأن اليوم الذي ستتذوق فيه هذه الشعوب محاسن الإدارة المنظمة فإنها ستنضوي سريعا تحت لوائها بكل عرفان بالجميل حتى وإن كانت بأدنى مستوى من التنظيم الإداري” (!! ) .