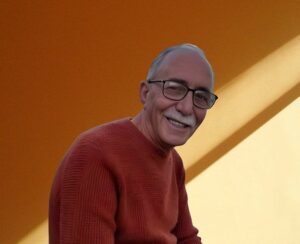إبراهيم اليوسف
إبراهيم اليوسفمن يجهل نفسه لن يعرف الآخرين…!
عبارة، كهذه، من الممكن أن تكون بداية نص روائي، يجمع خلاله مؤلفه بين أمرين لابدَّ منهما وهما: الشرط الإبداعي والرؤية، حيث أن النص الروائي يبنى على دعامات عديدة، تربط أوصاله ببعضها هيولى ووشائج دقيقة، لا يمكن الاهتداء إليها، واكتشافها، وتوظيفها إلا من قبل ذلك المبدع الذي خبر فنون الكتابة، وأدرك أن أية فكرة مهمة، قابلة أن تكون نواة نتاج فني عظيم، في ما إذا توافرت تلك الأصابع التي تضع بذرة روح الإبداع في مكانها المناسب.
وعند التدقيق في مثل العبارة، وهي في حد ذاتها مفتاح إلى فضاء معرفي خاص، نضع أصبعنا على مدخل الأسئلة الكبرى، لاسيما أنه يتناول محورين، هما:الجهل والمعرفة، فالمعرفة وحدها تطال فلسفة وجود الإنسان منذ الخليقة وحتى الآن، كما أن الجهل هو بؤرة الشرور طوال ذلك الشريط الزمني، ذاته، وأن آثاره ستظل مدى الدهر، كما هو حال أثر المعرفة التي استنار بها الآدمي، خلال رحلته الطويلة على سطح البسيطة، وهي رحلة الحياة في مواجهة رحلة الزوال.
وفي انطلاق هذه العبارة من النفس، سلباً وإيجاباً، باعتبارها فضاء أول جديراً بالاستقراء، ومعرفة ما يموج في عوالمه، ما يدعو إلى التعامل مع أخطوطة مكثفة، عصية على الاستنفاذ، حيث ما لانهاية لها من المتضادات التي يقرر المرء من خلال تربيته و ثقافته وقيمه كيفية التعامل معها، مادامت قادرة على تنشئته الروحية السامية، كما أنها قادرة في الوقت نفسه على إسقاطه إلى درجة الحضيض، في حضور السلالم الأطول من مجاهل الخيال، و مرامي الواقع، وهي توصل به إلى أعلى عليين، أو أسفل سافلين. وكلا الاحتمالين ممكن، نظراً لغرائبية طبيعة هذه النفس الأمارة بالعجائب والمتناقضات.
ومن يتقصَّ مسيرة الآدمي، تلك، وفق الخطّ البياني لها، يستطيع أن يعيد كل إنجاز عظيم من قبله، إلى منابع في نفسه، كما يمكن فعل مثل ذلك- تماماً- أمام كل دمار جزئي أو كبير، بحق الكون والكائنات، إذ أن هذه النفس هي الداء، والدواء، هي بيت الحكمة، كما هي بيت الشرور، هي بيت الحب، كما هي بيت الكراهية، مثل غيرها من الثنائيات المتنافرة، المتلاغية، التي يمكن الاستشهاد بها، على امتداد حيز أكبر، وحبر أكثر.
ولعل الالتباس في الرؤية، يكمن من مدى ذلك التقارب بين منطلق كل تلك المتضادات، إذ أن في مقدور صنَّاع ثقافة التضليل، وبالاستعانة بمجرد استبدال نظرة الإعجاب، بنظرة اللؤم، أو استبدال الابتسامة بالعبوس المتأجج ضغينة، وهو ما يمكن أن يترجم في النسق الكلامي، كي يكون نواة الثقافة المضللة التي يعتمدها كثيرون، وباتت لا تصمد البتة في عصر الإعلام الكاشف الذي وكأني به يسلط”بجكتوراته” على شجرة النفس، كي يبين عرى أغصانها المتهالكة، أواشتعالها بالخضرة والأزاهير.
وفي انطلاق هذه العبارة من النفس، سلباً وإيجاباً، باعتبارها فضاء أول جديراً بالاستقراء، ومعرفة ما يموج في عوالمه، ما يدعو إلى التعامل مع أخطوطة مكثفة، عصية على الاستنفاذ، حيث ما لانهاية لها من المتضادات التي يقرر المرء من خلال تربيته و ثقافته وقيمه كيفية التعامل معها، مادامت قادرة على تنشئته الروحية السامية، كما أنها قادرة في الوقت نفسه على إسقاطه إلى درجة الحضيض، في حضور السلالم الأطول من مجاهل الخيال، و مرامي الواقع، وهي توصل به إلى أعلى عليين، أو أسفل سافلين. وكلا الاحتمالين ممكن، نظراً لغرائبية طبيعة هذه النفس الأمارة بالعجائب والمتناقضات.
ومن يتقصَّ مسيرة الآدمي، تلك، وفق الخطّ البياني لها، يستطيع أن يعيد كل إنجاز عظيم من قبله، إلى منابع في نفسه، كما يمكن فعل مثل ذلك- تماماً- أمام كل دمار جزئي أو كبير، بحق الكون والكائنات، إذ أن هذه النفس هي الداء، والدواء، هي بيت الحكمة، كما هي بيت الشرور، هي بيت الحب، كما هي بيت الكراهية، مثل غيرها من الثنائيات المتنافرة، المتلاغية، التي يمكن الاستشهاد بها، على امتداد حيز أكبر، وحبر أكثر.
ولعل الالتباس في الرؤية، يكمن من مدى ذلك التقارب بين منطلق كل تلك المتضادات، إذ أن في مقدور صنَّاع ثقافة التضليل، وبالاستعانة بمجرد استبدال نظرة الإعجاب، بنظرة اللؤم، أو استبدال الابتسامة بالعبوس المتأجج ضغينة، وهو ما يمكن أن يترجم في النسق الكلامي، كي يكون نواة الثقافة المضللة التي يعتمدها كثيرون، وباتت لا تصمد البتة في عصر الإعلام الكاشف الذي وكأني به يسلط”بجكتوراته” على شجرة النفس، كي يبين عرى أغصانها المتهالكة، أواشتعالها بالخضرة والأزاهير.
وللجهل والمعرفة، أرومة تعود إلى أعماق خلجات النفس الآدمية، حيث بين هذين الخطين مسافة:الموت والحياة، الهلاك أوالبناء، وكل ما نشهده من تطور في مسا رالمعرفة، يقابل بسرطنات لا تتوقف في خلايا الجهل، ما يدفعنا إلى الخوف المستمر،لاسيما أن الجهل لم يعد أسير حدود الأمية، وفك الكلمة، بل إن ثقافة الجهل-وهي حاضنة معجم الشرور كاملة- باتت تطور ذاتها، أمام أية فتوحات معرفية كبرى، كي يكون المنجز نفسه-كما طبيعة النفس- أداة المتناقضات، فالطائرة يمكن أن تختصر جغرافيا العالم، ويمكن أن تسهم في تدميرها، شأن غيرها من الإنجازات الهائلة، وكأن سلمي النفس هذين، يسيران في اتجاهين متناقضين، أحدهما للمجد والآخر للجحيم.