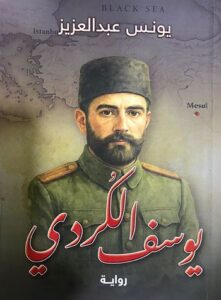قصة مثل من تراث الشعب الكردي…إهداء متواضع إلى الشعب السوري المناضل مع رجاء تقبله.
قصة مثل من تراث الشعب الكردي…إهداء متواضع إلى الشعب السوري المناضل مع رجاء تقبله.د. كسرى حرسان
هل علمتم من هي شمّي (شمسة)؟، وهل دريتم ما هو خطبها؟!
إنها المرأة بطلة المثل الكردي ذائع الصيت: (شمّي برا زوِّجاندْ!).
وترجمتهُ الحرفية بالعربية هي أن: شمّي زوجت أخاها!، من باب التهكم والسخرية ومن ناحية الاستخفاف بالموضوع، أي أن شمّي لم تفعل هذا الواجب بل قصّرت دونه، فالمديح هنا إذاً ذمّ، فهذا المثل مضربه في المشروع السلبي قليل الخير الذي يتبجح بفكرته صاحبه، وربما كان لهذا المثل مرادف في اللغة العربية. ولكن نحن بصدد هذا المثل.
إنني بصدد قصة مثل، وليس المثل بحد ذاته، فالمثل شهير؛ ولكنَّ روايته مازالت غريبة كل الغرابة عن أفهام جماهير غفيرة من الشعب الكردي، فهم مع أنهم لا يفتئون يتفوهون به؛ ولكنه يمرّ على ألسنتهم مرور الكرام، لا يعلمون منه إلا علماً ظاهراً، وإذا توخينا لهذه الظاهرة تعليلاً فينبغي أن نُقر بالواقع ونقول الحقيقة.
إننا نحن الشارع الكردي آل أمرنا إلى التفاهة والهوان وتشتت الحال. انحطت مرتبتنا عن سوية العلم وقد بلغ أوج حضارته، أما نحن فرجعنا أدراجنا سائرين على سَنن عصورٍ جهلانية، نسينا الترف وأصبحنا نكابد خشونة البداوة بتشنجاتها كافة. أعني إنه رحل المرح وحل الترح، وما أحسب أحداً يجادلني في ذلك بتاً، وطبق يومنا هذا أمام قارئي فليقرأ إذا شاء.
كما أسلفت لم يعد يهمنا طلب العلم، وإنما خيمت الجهالة وربيبها الفقر. وانظروا بأنفسكم إلى براعمنا الناعمة الفتية، أعني أطفالنا، الضحايا الأحياء، بعد أن أضحوا صُيّع الطرقات، والفضل في ذلك يعود بلا شك إلى هذه الرصانة في بلدنا التي لم يعرف التاريخ لها صِنواً على وجه البسيطة.
نعود إلى موضوعنا، فهو أهم من كل استطراد وابتعاد، فمثلنا – وهو مجال بحثنا – طريف ممتع أثير على القلوب هكذا دون زبرج، فكيف إذ عُرفت روايته؟ يعرفه الناس ويجهلونه كذلك في آنٍ واحد، أما أنا فإني عشته مثلاً وقصة معاً، عاينتُ أشخاص المثل ووقائعه معاينة حسية مباشرة إلى حدٍّ كبير وأنا غرٌّ صغير، أتلقى معلوماتي حوله هناك في قريتي (كِرصور)، مما يرويه لي الكبار الذين عاصروا القصة وعاشروها، فاطلعتُ عليها منهم اطلاع الخلف على معارف السلف. المثل بقصته إذاً ابنُ ضيعتي إن صح التعبير، أقدم مني قليلاً، لأن بطله (خلو) مواطن من مسقط رأسي (كِرصور). ومن أجل الولوج إلى صلب الرواية فعلى الذاكرة أن تعود لهذا الغرض إلى أيام الانفصال فتكون الأحداث بذلك موقتة زمانياً ومكانياً معاً، كان يشكو (خلو) من وهَن في عينيه، كما كانت عشيقته شمّي فتاة عرجاء وهذا نقيصتها من سكان قرية (توبز) الواقعة على طريق قامشلي عامودا. لعرجها دورٌ واضح مؤثر فهي إذا سارت هبطت تارة وارتفعت أخرى، دون أن يكون لانخفاض الأرض وارتفاعها علاقة بذلك. وربما وجدت شمّي، لأجل ما تقدم ذكره، ضالتها في خلو بسهولة عفوية، فهو أنسب لها حتى يتوافقا ويتجانسا، وبذلك تتحقق لهما السعادة الزوجية نظراً للتكافؤ والانسجام الجمّ بينهما، أما الصدمة فلن تكون إلا من نصيب فرَمز شقيقها عاقدِ آماله العِراض على منكبيها المتقاربَين، فشمّي على أساس أنها مهرُ أخيها بأسلوب التقايض ليتحول فرَمز أيضاً من حالة العَزب الممقوت إلى وضعية التأهيل الجميل؛ ولكنها أجهضت دور العملية المعدّ لها وحولته باتجاهٍ آخر، حين نكثت بما تجشمت من قيود فرضها واقعٌ عائلي، تتزوج وتزوّج شقيقها، لقد تملصت من المسألة لمّا رأت أن ركوب المشقة ليس في صالحها، أما سائر الخطب فليس من شأنها أو مهامّها. ولذا أزمعت السفر من ذلك المستنقع الوبئ إلى وادي حبها الحالم، تاركة فرَمز يتخبط في أحابيل تعاسته في الجانب الآخر، لتنبعث المفارقات العجيبة والتناقضات المريرة بصدر أخيها في لحظة واحدة فاصلة تشكل نقطة انعطاف في حياته، وعليه أن يتغلب على همّهِ ويمتص الصدمة ليتأقلم ويتلاءم مع الوضع الجديد دون تبعات نفسية. وإذ لم تكترث شمّي لنوازع شقيقها فكيف لا تخاطر بالعُروة اليتيمة (الحبل الذي كانت سوف تحزم به ربطة القش) ضاربة إياها عُرض القاع الزراعي، كأفعى فارقت حياتها وأضحت تعيش هموداً بلا نهاية. لقد عشقت شمّي خلو ولتهُنْ في سبيل نيل حبها بقية التضحيات، كان صباحاً وردياً بالنسبة إليها منعشاً بنعيمه كنسيمه. ووداعاً للقش المسؤوم والمشؤوم.
عندما تناهى خبر ذهابها مع خلو إلى سمع والدتها قالت ساخرة عفو خاطِرها: نا، نا شمّي فرَمز زوّجاند. فتحوّل قولها هذا مثلاً تتناقله الأجيال الكردية جيلٌ عن جيل، يضربونه في حالة الاستهانة بالنشاط المزمع القيام به.
يؤكد المثل ثوابت لا يمكن تحويلها. فالحب أعمى لا يتقيد بمنطق، والعشق وفاء وتضحية وإن لبس زي الأنانية، والحرية الفردية مصونة لا جدال في ذلك. كما يمكنني أن أفضي انتهاء من هذا المثل إلى مقارنات أخرى تذخر بها الذاكرة، إذ لا علاقة لهذا المثل بالتعقيدات التي لا تغتفر والآثام التي من الكبر بحيث لا تكفَّر، إذ إن ما قامت بعمله شمّي لا يشبه مبدأ مكيافيللي المستحب في هذه الأيام والقائل (الغاية تسوّغ الوسيلة) بل يختلف عنه جدّ الاختلاف، فأن هذا المثل ظريف وطريف أمّا قرار مكيافيللي فهل وجدتم فيه شيئاً من هذه الظرافة.
إننا نحن الشارع الكردي آل أمرنا إلى التفاهة والهوان وتشتت الحال. انحطت مرتبتنا عن سوية العلم وقد بلغ أوج حضارته، أما نحن فرجعنا أدراجنا سائرين على سَنن عصورٍ جهلانية، نسينا الترف وأصبحنا نكابد خشونة البداوة بتشنجاتها كافة. أعني إنه رحل المرح وحل الترح، وما أحسب أحداً يجادلني في ذلك بتاً، وطبق يومنا هذا أمام قارئي فليقرأ إذا شاء.
كما أسلفت لم يعد يهمنا طلب العلم، وإنما خيمت الجهالة وربيبها الفقر. وانظروا بأنفسكم إلى براعمنا الناعمة الفتية، أعني أطفالنا، الضحايا الأحياء، بعد أن أضحوا صُيّع الطرقات، والفضل في ذلك يعود بلا شك إلى هذه الرصانة في بلدنا التي لم يعرف التاريخ لها صِنواً على وجه البسيطة.
نعود إلى موضوعنا، فهو أهم من كل استطراد وابتعاد، فمثلنا – وهو مجال بحثنا – طريف ممتع أثير على القلوب هكذا دون زبرج، فكيف إذ عُرفت روايته؟ يعرفه الناس ويجهلونه كذلك في آنٍ واحد، أما أنا فإني عشته مثلاً وقصة معاً، عاينتُ أشخاص المثل ووقائعه معاينة حسية مباشرة إلى حدٍّ كبير وأنا غرٌّ صغير، أتلقى معلوماتي حوله هناك في قريتي (كِرصور)، مما يرويه لي الكبار الذين عاصروا القصة وعاشروها، فاطلعتُ عليها منهم اطلاع الخلف على معارف السلف. المثل بقصته إذاً ابنُ ضيعتي إن صح التعبير، أقدم مني قليلاً، لأن بطله (خلو) مواطن من مسقط رأسي (كِرصور). ومن أجل الولوج إلى صلب الرواية فعلى الذاكرة أن تعود لهذا الغرض إلى أيام الانفصال فتكون الأحداث بذلك موقتة زمانياً ومكانياً معاً، كان يشكو (خلو) من وهَن في عينيه، كما كانت عشيقته شمّي فتاة عرجاء وهذا نقيصتها من سكان قرية (توبز) الواقعة على طريق قامشلي عامودا. لعرجها دورٌ واضح مؤثر فهي إذا سارت هبطت تارة وارتفعت أخرى، دون أن يكون لانخفاض الأرض وارتفاعها علاقة بذلك. وربما وجدت شمّي، لأجل ما تقدم ذكره، ضالتها في خلو بسهولة عفوية، فهو أنسب لها حتى يتوافقا ويتجانسا، وبذلك تتحقق لهما السعادة الزوجية نظراً للتكافؤ والانسجام الجمّ بينهما، أما الصدمة فلن تكون إلا من نصيب فرَمز شقيقها عاقدِ آماله العِراض على منكبيها المتقاربَين، فشمّي على أساس أنها مهرُ أخيها بأسلوب التقايض ليتحول فرَمز أيضاً من حالة العَزب الممقوت إلى وضعية التأهيل الجميل؛ ولكنها أجهضت دور العملية المعدّ لها وحولته باتجاهٍ آخر، حين نكثت بما تجشمت من قيود فرضها واقعٌ عائلي، تتزوج وتزوّج شقيقها، لقد تملصت من المسألة لمّا رأت أن ركوب المشقة ليس في صالحها، أما سائر الخطب فليس من شأنها أو مهامّها. ولذا أزمعت السفر من ذلك المستنقع الوبئ إلى وادي حبها الحالم، تاركة فرَمز يتخبط في أحابيل تعاسته في الجانب الآخر، لتنبعث المفارقات العجيبة والتناقضات المريرة بصدر أخيها في لحظة واحدة فاصلة تشكل نقطة انعطاف في حياته، وعليه أن يتغلب على همّهِ ويمتص الصدمة ليتأقلم ويتلاءم مع الوضع الجديد دون تبعات نفسية. وإذ لم تكترث شمّي لنوازع شقيقها فكيف لا تخاطر بالعُروة اليتيمة (الحبل الذي كانت سوف تحزم به ربطة القش) ضاربة إياها عُرض القاع الزراعي، كأفعى فارقت حياتها وأضحت تعيش هموداً بلا نهاية. لقد عشقت شمّي خلو ولتهُنْ في سبيل نيل حبها بقية التضحيات، كان صباحاً وردياً بالنسبة إليها منعشاً بنعيمه كنسيمه. ووداعاً للقش المسؤوم والمشؤوم.
عندما تناهى خبر ذهابها مع خلو إلى سمع والدتها قالت ساخرة عفو خاطِرها: نا، نا شمّي فرَمز زوّجاند. فتحوّل قولها هذا مثلاً تتناقله الأجيال الكردية جيلٌ عن جيل، يضربونه في حالة الاستهانة بالنشاط المزمع القيام به.
يؤكد المثل ثوابت لا يمكن تحويلها. فالحب أعمى لا يتقيد بمنطق، والعشق وفاء وتضحية وإن لبس زي الأنانية، والحرية الفردية مصونة لا جدال في ذلك. كما يمكنني أن أفضي انتهاء من هذا المثل إلى مقارنات أخرى تذخر بها الذاكرة، إذ لا علاقة لهذا المثل بالتعقيدات التي لا تغتفر والآثام التي من الكبر بحيث لا تكفَّر، إذ إن ما قامت بعمله شمّي لا يشبه مبدأ مكيافيللي المستحب في هذه الأيام والقائل (الغاية تسوّغ الوسيلة) بل يختلف عنه جدّ الاختلاف، فأن هذا المثل ظريف وطريف أمّا قرار مكيافيللي فهل وجدتم فيه شيئاً من هذه الظرافة.
ولكي ننصف المثل ونرفع الظلم عن شمّي فللحق نقول إن شمّي لم تسئ إلى أحد بل أقنعتنا بمثلها ومنطقها، ولكن ماذا قدم لنا نصراء الحروب وذئاب الأزمات.