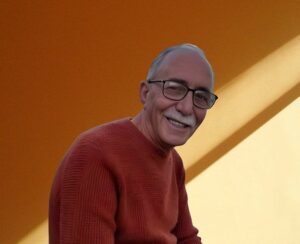إبراهيم محمود
إبراهيم محمودمن بين الكلمات التي تفوَّه بها أورهان باموك، الكاتب التركي، لدى استلامه جائزة نوبل عام 2006، وأمام مسَلّمي الجائزة وآخرين في ستوكهولم، وهو يتحدث عن سبب مناولته الكتابة ( أكتب لأنني أرغب في ذلك..أكتب لأنني غاضب عليكم جميعاً، على الناس جميعاً…أكتب لكي يعرف العالم كله أي نوع من الحياة كنّا نعيش..أكتب لأنني أخشى أن أكون منسياً..).
ولعل الذي فجَّره كاتبنا إبراهيم يوسف، وروائينا هنا، في أحدث مولود روائي جميل له ” جمهورية الكلب ” الرواية الصادرة عن دار : خطوط وظلال الأردنية، لعام 2020، وفي ” 360 “صفحة، من القطْع الوسط، كان كلَّ ما تقدَّم. إنها رواية كلبية من ألفها إلى يائها، سوى أنها تعرية للذين يشوهون سمعة الكلاب، ويتمثلونها زيفاً في حياتهم ضد سواهم. أتراني أبالغ إن قلت، إن من ينتهي من قراءة ” جمهورية كلبـ:ـه ” غيره، قبل مباشرة قراءتها. ذلك تأكيد واع ٍ تماماً، إنه تأكيد وعي يتبصر وعياً، جرّاء مخاض قراءة سابرة لرواية تقاوم ضحالة المرئي اليومي.
ومن خلال قراءتي للرواية هذه، وقد حاولت استدعاء جل ما تناهى إلى مسمعي، أو اطلعتُ عليه قراءةً، أو انشغلت به، بصدد الكلب وعالم الكلب هذا، وما يبقي الكلب كلباً، وما يخرج الكلب من كلبيته ” ككلب حقيقي “، وما يجعله كائناً متعدّياً لصورته، جهة الشكل، أو التكوين، أو القوة، كما هو في الميثولوجيا وسواها، حيث من الصعب في الحالة هذه، أن يصمد الكلب الذي نلتقي به، أو نصادفه أو نعرفه كما هو، أمام المسجَّل باسمه حقيقة، أي استحالة النظر إلى الكلب، إلا من زاوية فكرية، أو ثقافية، زمانية ومكانية محددة، شعرت بالمهمة المضاعفة التي كلَّفَ إبراهيم يوسف ككائن من لحم ودم، وله هويته الشخصيته، وحدود علاقاته اليومية،إبراهيم يوسف الآخر، لا بد أنه قرينه، ذلك المجنح بالمتخيل، والنظرة الرباعية الجهات، من خلال هذه الذخيرة اللافتة من المعلومات التي تدوَّن باسم الكلب، الكلب الذي يتلون وفْق متصوراته كروائي فنان طبعاً، والكلب الذي لا يكف عن الحضور والغياب، لنكون في عهدة ما لا يتناهى من مشهديات الكلاب، في أجناسها وأنواعها وطباعها، حيث يغدو استشرف العالم الخارجي والداخلي للكلب، قبْضاً على تلك الخاصيات الدفينة للبشر، حين ” يكلبنون ” ما في نفوسهم، أو رؤوسهم، وهم يعيشون متعة التشكيل الكلبي ما استطاعوا إلى ذلك سبياً. يا لدهشة البناء !
لننطلق من هنا، وباسمي المفرد، لأنطلق من هنا، والذي يعايَن بأكثر من اعتبار جمالي وقيمي.
أمَّا عن جمهورية الكلب
لدى الكاتب الحداثي رغبة دائمة، في ألّا تكون رغبته الكتابية، كما هي المسكونة بين جنبيه، إنما تلك التي تحيل اليومي إلى واقع يُنظَر فيه، وهو مستجد الجرَيان في الجهات كافة، وأن يكون مفارقاً لليومي فيه تالياً. إن المعهود فيه يكون برسم التوقيف، وتوقاً إلى المنشود فيه، وإلا لتوقف لسان الفن أن يكون الناطق باسمه هنا وهناك.
ذلك ما نتلمسه بدءاً من العنوان ” جمهورية الكلب ” كما هي الصورة المتمازجة مع العنوان، ليس من قدرة على مكاشفة بنيته، إنما ما يقيم وصلاً بين الخيالي والواقعي، ليكون الرمزي حصادهما .
تدفع صيغة ” جمهورية الكلب ” ما لا يُسمى إلى الواجهة، أي حين يكون للكلب جمهورية. ذلك هو المحال الذي يرتبط بالواقع، لكنه الذي يرتقي إلى الخيال وصولاً إلى الرمز، خلاف المتردد عن الكلب عملياً، وتعزيزاً لما يعرَف به الكلب، ككائن حيواني، ربما اُعتبِر الأكثر شهرة، في البرزخ الفاصل بين الوحشي والأهلي، كما لو أن هذا الفاصل البرزخي الأليف هو الذي يعمّق في الرغبة اللاواعية للإنسان، لأن تتلبس حالة الوحشي والأهلي، ليكون الكلب ذاته، امتحانه، وليس العكس، وهي اللعبة الأكثر خرقاً للمعتاد اليومي، تلك التي يرمّحها يوسف روائياً.
وعلى قدْر هذه المناورة المستثمرة والمؤثّرة، يعبّر عن معاناة، أو مخاض معاناة صاعدة، في معايشة الجمعي الغزير فيه. ويا له من مرض مدنف هذا الذي يستوطن فيه الجسد والروح، على وقْع هذه المكابدة. وبالتالي، ليكون قول رينيه جيرار هنا، بخصوص مغامرة الكتابة الروائية، مغامرة الاستغراق في المرض دون مفارقته، المرض النوعي طبعاً، والمستعاد والمتجدد فنياً كذلك ( فالذين يُعانون المرضَ أكثرهم المهووسون بمرض الآخرين ).
دون ذلك، أكان في مقدور أي فنان، أي أديب، أن يكون ما لا يكونه في واقعه اليومي؟ قطعاً لا !
يصبح الكلب الحيوان المنتقى ليس عن هوىً، وإنما عن وعي مدروس، لأكثر من توجه بحثي، تأريخي، اجتماعي، سياسي، وفني، وحتى بمفهومه الاقتصادي. قد يُطرَح سؤال: وما علاقة الكلب بالاقتصاد؟ يأتي السؤال الجواب: وكيف يجري الحديث عن الجانب الكلبي في الاقتصاد؟ كيف يكون التوفير والحرص عليه كلبياً ؟
ليس من استدعاء للكلب، أو ذهاب إليه، إلا لأن فيه هذه الجمهرة من العلاقات المفتوحة، هذا التاريخ العريق، وهذا المدى الواسع، والذي يمكّن من إضاءة نقاط النظام العضوية والحياتية لسواه، ولبني البشر أنفسهم.
يمكن الحديث عن شراهة كلبية في اليقظة” في الحراسة “، وعن زهد كلبي في الطعام، إلا عند اللزوم، ليكون الحيوان الممتلىء بالعالم، دون اكتناه سره، نموذج الحكمة غير المباحة، إلا لمن يتفهم لغته السلوكية .
ذلك ما يستوقفنا في النطاق الحيواني، وما يصدم وعينا المحدود، عندما نتجرد من ذاتية المركزية فينا، والإصغاء إلى الانتروبولوجي الفرنسي شتراوس، بأن ( الحيوانات “جيدة في التفكير )، وهو يتوقف على كيفية التحرر من خرافة أن البشر وحدهم من يمكنهم فك رموز بيئتهم، بوصفهم كائنات عاقلة، وليس لأن لدى الحيوانات كيانات عضوية كاملة، وهي تتبادل مشاعر ربما يستحيل على البشر، في قوقعتهم العقلية، استبيانها، وليس لها أي صِلة بما تواضع عليه هؤلاء فكرياً، إذ، وكما يقول فلوران كوهلر( غالبًا ما يُنظر إلى الحيوانات الخيالية أو الحقيقية على أنها انعكاس للأفكار البشرية عن نفسها )، وفي هذا كان مقتل بني البشر في بعضهم بعضاً، وفي عموم الكائنات الحية، وحتى الدفع بالوجود إلى منحدر الكارثة الحياتية وتمزقات وحدة الوجود مأسوياً.
تلك هي حصيلة القائمة الكبرى من الدراسات ذات النشأة الحديثة المتعلقة بما هو حيواني، ومن خلال متابعتي الخاصة لها، وهي بالمئات كتباً وأبحاثاً ومقالات، وحتى نصوصاً شعرية كذلك، دفعاً بالإنسان، وهو في مهب ريح نزواته، وتمركزه على ذاته، لأن يخرج من قمقم هواه، وما يستبد به من هذا المنطلق .
ألم يقل أحد الشعراء، وهو هودزينغر، في قصيدة ” صلاة شعب الحيوان “:
نتوسل إليكم أيها البشر،
أن توقفوا حروبكم، وعبوديتكم ،
أن توقفوا مذابحكم. المعاناة فظيعة ،
شعبنا مثل شعبكم يعرف كيف يشعر بالتعاطف؟
هوذا الشاعر الذي يحمّل حيوانه المدرَك في بهاء حقيقته، ما هو جدير به، ليكون رمزه، وهو حامل رمزه، مقارنة بإنسانه الذي لا يكف عن صنع الرموز وتحويلها إلى أدوات تدمير!
كيف ينتقل يوسف إلى ” كلبه ” النموذج ؟
على طريقة دافيد هيوم، يخرج الإنسان العالم الفعلي، والمبدع الفعلي من كهفه الروحي على مدار الساعة، ليحسن تدبير أموره التي تصله بالنجوم. في الرواية هذه، ثمة ارتقاء للكهف !
هناك الإهداء الذي لا يمرَّر بسهولة، بالعكس، لا بد من تنويره، لأنه يقوم على كشف جوهر العلاقة بين الكاتب وحفيداته وأحفاده، وأكثر من ذلك، لأنه في ضوء المستخلَص من قراءة نصه الروائي، ما يشي بالبحث عن براءة ذمَّة له، بالمفهوم الاعتباري والمثالي، لأن انتماءه إلى ما هو بشري، يفتح محضر ضبط تاريخياً، ويخضعه للمساءلة، جرّاء ذلك. لنكون إزاء وضع استثنائي يبعِد عنه تهمة التلبس بالشرور، بما أنه سطَّر كتاباً روائياً، لا يجرَّد مما هو اجتماعي وقيمي
( إلى حفيداتي وأحفادي، وهم يقرؤون ترجمات الرواية،لا أريد لكم أن تقولوا: لكم كان جدُّنا ديكتاتوراً..!)
وثمة إطلالات استهلالية ثلاث، لكل منها حقلها الرمزي المختلف، تعبيراً عن الحمولة الدلالي:
ما يكون الكلب محمَّلاً بِشارة تضمين اجتماعية، وعبر الكلب، وفي مثل كردي:
( حين تحب أنثى فإنك تحب صوت ديك أهلها ونباح كلبهم..! ).
ما يضفي على الكلب قيمة أثرية مرعبة، وما لها من عمق تأريخي، تبعاً لما يقوله وليم بليك:
( موت كلب جوعاً على عتبة دار صاحبه نذير بسقوط عرش).
وما يخص مفهوم ” كلب واقعي “، وهو تنويه من لدن الروائي، وجسارة الكلب، ومن مرجع لا ينفصل عن رؤية عائدة إلى الكاتب نفسه ، من ” مذكرات شاعر “، وطابع المفارقة في هذا المشهد الذي يعلو فيه مقام الكلب:
( ما إن وصلت سيارة النائب إلى نقطة المعبر حتى كادت البوابة الالكترونية تنفتح له بينما رجال البوليس انشغلوا برفع التحية له وحده الكلب البوليسي ظّل يعوي وهو ينق ينقض على السيارة موقفًا إياها مشيًرا إلى مستودعها الذي ضبطت فيه بعدئذ- كمية كبيرة من المخدرات…! ).
إنها، من حيث التسطير بداية، ليست عناصر جار توقيفها خارجاً، واعتبارها عناصر العتبة، إنما ما يوسّع حدود البيت، دارة الرمز في الرواية، وهي في حالاتها، سياسة رغبة الكاتب في الكتابة، ولفت نظر قارئه إلى أن لديه الكثير ليقوله، لينثره في تربة النص الأدبي، وليشعل رغبة الانتظار في نفس قارئه، كي يبصر ثمر انتظاره.
ألا ما أكثر افتتان السارد الروائي بضمير الأنا. إنه الحضور الحامل لبعديه: الماضي والمستقبل، إنه وجه يبصر من خلف وأمام، إن تجاوبنا مع استراتيجية مسار الرواية. وما أكثر تمسُّك الروائي بهذا الضمير الكشاف !
يحضرني هنا توصيف أدبي جميل لروجيه غرينييه، بوصلة القراءة في دار” غاليمار ” الأشهر عالمياً، بخصوص ضمير ” الأنا “L يمكن لـ” أنا ” أن يكون أحياناً مجرد راو ٍ، وأحياناً أخرى شاهداً وأحياناً شخصية رئيسة .). لا مهرب للروائي من شهادة هذا الضمير الذي يستأثر بأحداث روايته السعيدة والشقية معاً، أي لا مناص من التنكر لهذا الضمير الذي يسرّب ما يمكن التستر عليه، وإذا به يفجّره خارجاً .
ولأنني مأهول بشغف المتابعة، ولأنني أكتب وكلّي يقظة بصدد الممكن قوله في حيّز ورقي معين، أجدني مقتصراً على ما ينير هذا الجانب، وما أوسعه من جانب، في مضمار ” جمهورية الكلب “!
القلق ساعة دقاقة بين جنبي الكاتب، وهو مشغول بعالمه حتى النخاع، كما في مبتدأ النص، أي في العنوان الفرعي ” نهاية مزلزلة..! “، وهاجس رؤية الكلب، وما يجعل الكلب شاغله الرئيس :
( أينما سرت هنا، فثمة كلاب تلوح أمام عيني وأكاد لا أرى إلا سواها!
لا بد أن أقلع عن عادة عِّد الكلاب، فما الذي أستفيده من هدر وقتي بذلك على مدى اليوم، والانشغال عن الناس؟ لا سيما وأنني في كل يوم، أنسى عدد كلاب اليوم السابق. ) .
يتحول القلق إلى حالة عصاب أحياناً، لأنه لا يريه إلا ما يكون مؤثّراً فيه، أي ما يجعله طائفاً حوله، أي ما يجعله قريباً من الكلب، من كلب، أو يقرّبه هو نفسه منه، رغم الممانعات الأسرية :
(كنت أعلم أن زوجتي ستمانع إقدامي على هذه الخطوة الشنيعة في عرف الأسرة. أبنائي وبناتي المتزوجون الذين كانوا يعيشون مع أسرهم في بيوت مستقلة تفاجؤوا بالأمر. لا غرابة في ذلك. كنت قبل أن آتي إلى ألمانيا أسخر ممن أعرفهم من أبناء بلدنا. من الشرقيين عامة، ممن راحوا يقتنون كلاباً، ويربونها في بيوتهم. هو ما حدث معي شخصيًا. لو حدث الأمر قبل أسبوع واحد مع أي شخص من بلدي، أو أسرتي، من اتخاذ قراري هذا. قراري الذي اتخذته بال تفكير لاستهجنت سلوكه، ولأدنته، ولتدخلت في الأمر لأقنعه كي يقلع عن هذا التفكير الجنوني.
سأسميه باسم أول كلب لا تزال صورته في مخيلتي. أقصد صورة” كازي” gazî ،منذ أيام الطفولة.
لا سأسميه باسم كلب صديقتي الألمانية..*
ردا على سؤال قد يطرحه المراجع: وماذا عن الكلب ” كونان” الذي شارك في غارة البغدادي؟ ً.
أقول: مخطوط الرواية أنجز قبل مقتله بحوالي سنة؟
رغم محاولات جميع أفراد العائلة والأقرباء، وما كان من مآس، كان هناك إصرار: سأقتني كلبًا..! ).
السارد هنا، يصعّد من الشاغل النفسي في الفضول لدى قارئه. أو ما يحفّز في قارئه إرادة معرفة سر هذا القلق، سر التقرب من الكلب، سر هذا التوتر العائلي كرمى امتلاك كلب معين.
لكن الذي ذُكِر سابقاً، مرّر معنى ماضياً، له أكثر من قيمة تذكارية. ما يكون عليه الكلب حين كان صغيراً، وما هو عليه الكلب وهو كبير، وفي عالم جغرافي مغاير تماماً في الثقافة والأعراف :
(ربما شكك أفراد أسرتي في، ولا سيما زوجتي بأنني كنت على علم بمقدم روكي إلى بيتنا، وأنني استقدمته لأنني تأثرت بالمجتمع الجديد، بالرغم من أنهم جميعًا يعرفون موقفي من الكلاب، فأنا لا أحبُّها وقد بت لا أكرهها. أقصد أنني بت لا أكره من يقتنونها ويربونها أيضاً، وهو أقصى ما يمكن أن يثبت في سجل علاقتي بالكلاب ، ليس خوفاً، وأنا في مكان ، للكلب فيه سلطته. سلطته الأكبر من سلطته في قريتي، أو مدينتي، بل لأنني متأكد أن لمن يربون الكلاب ويعنون بها مسوغاتهم. لهم ثقافتهم. سبب شكوك أهل البيت إن تمت، فهي لأنهم صاروا يعرفون أنني أقضي في كل يوم أوقاتًا غير قليلة بين مربي ومربيات الكلاب، وفي حديقة الكلاب التي تبعد ألفًا وسبعمائة وخمسين خطوة عن بيتي.) .
تبدأ هنا المفارقات، حيث إن الكلب ” روكي ” المقتنى طبعاً، يكون في مقام الشرارة، لإضاءة وقائع متحورة حول الكلب في أمكنة مختلفة، وعبر الكلب، تتلون العوالم، وتبرز مراتب الإنسان وقيمه الاجتماعية هنا وهناك .
وفي تحركات السارد، تتنوع المفارقات، حيث يتكفل الكلب ذاته بإظهارها، وما فيها من طرافة. فالذي لم يعهد مثل هذه العلاقة المرسومة قانونياً هنا، في ألمانيا، وحتى أوربا عموماً، وما في ذلك من تقدير للكلب، كما سنرى، وما كان عليه من سوء اعتبار في منطقته، لا بد أن ينتقل من خطأ إلى آخر، ومدعاة للسخرية بالمقابل .
وما جرى بينه وبين صديقته الألمانية، كسارد رئيس في الرواية، بدءاً بعلاقته بالكلب :
( روكي صار ينبح..ينبح. الجيران. المارة صاروا ينظرون تجاه بيتنا. صوت نباحه يعلو يعلو يعلو.. لم يحدث لهم مرة أن وجدوا كلباً في بيتنا، أو في شرفة البيت، خيّل إلي أنه جائع، وكان جد منهك. جد متعب. جد حزين، قدمت له بعض هذه المأكولات، عساه يكف عن النباح، فلم ينظر فيها، بل صار يدير لها ظهره. قدمتها ويدي على قلبي خشية أن يصاب بمكروه، فأحرج أمام صاحبته وأتعرض للمسئولية القانونية.
حوار السارد مع صديقته الألمانية، حول مفارقات مكانة الكلب في بلاده وهنا،.
شطت بي المخيّلة: نحن مقصرون في حق كلابنا، فإننا ننعتها بأسوأ الأوصاف، فالكلب أمين، بَيْد أننا نصف اللص، الغادر، الكذاب، المنافق، بقولنا: إنه كلب! ).
وما كان من أمر شخص آخر، ينتمي إلى جغرافيته القروية، أو منطقته:
(حين حدثتها عن صديقي ديدار الذي تم لم شمله ، مع زوجته في ألمانيا ، إلا أنه أصر على اصطحاب كلبيه معه. كان قد اشتراهما من أربيل/ هولير بعد أن لجأ إليها. استخرج لهما جوازي سفر، وقطع لكل منهما تذكرة طائرة، وقال لزوجته المشرفة على الموت بسبب إصابتها بالسرطان الذي انتشر في جسدها: لن آتي دون كلبي.
ضحكت وقلت لها: ما إن نزل كلبا صديقي برفقته في المطار حتى ج ن جنونهما، كانا يهجمان على كلاب المكان، مما اضطّر الجهات المعنية إلى اتباع أكثر من دورة تمكين واندماج له ولكلبيه في آن واحد. ).
وفي سردية جزئية أخرى:
(تذكرت أن خلافات كثيرة تمت بين رجال ونساء من سوريا فور وصولهم إلى أوروبا، إحدى الصديقات أكدت أنها جاءت وإحدى عشرة أسرة سورية عن طريق البرِ ، وما إن عبروا حدود تركيا في اتجاه بلغاريا، حتى قررت سبع نساء الطلاق من أزواجهن، أي قبل الوصول إلى الكامب، بالرغم من أن هؤلاء الرجال دفعوا كل ما لديهم من مال، ومنهم من باعوا بيوتهم وعقاراتهم من أجل أن يعيشوا حياة سعيدة، لكنهم تفاجؤوا بأن زوجاتهم طلبن الطالق منهم. تلك السيدة قالت: في كامب اللاجئين في بلغاريا تطلقت واحدة أخرى، ومن بيننا من مات زوجها بردًا نتيجة إهمال وسوء معاملة البلغار لنا، وعدم توفيرهم وسائل التدفئة، وال أماكن الإقامة المناسبة، بل ولا الأسرَّة ، ناهيك عن أن أطعمتهم كانت سيئة لا تأكلها الكلاب.).
وما سبب له كلبه روكي من مشاكل، وهو يتردد على بيته، إثر اقتنائه له، ومعرفته له، وهو غير مهيأ لذلك.
ومن المظهر الخارجي، إلى الحالة النفسية، وعدم التكيف مع جو اجتماعي، للكلب فيه مكانة مميزة، وليس نظيره هكذا في مجتمعه السالف، إنما بالمقابل، ما يعرضه هو نفسه للسؤال عن حقيقته، حيث إن الكلب لا يعود مجرد كلب، وإنما مستكشفاً العالم الداخلي له، ومن خلال يؤتى على ذكر العالم الهائل للكلاب .
(رائحة كلبها الذي احتضنته، وهي تشاركني المقعد الخشبي الذي يسع لأكثر من شخصين تبدو لي واخزة، ناخرة، إذ أدرك لأول مرة أن الكلاب تُعطَّر، بالرغم من أنني لا أدري أهي عطور كلبية خاصة أم هي عطور آدمية، يستخدمها الذكور أو الإناث. يبدو أنني سأتعَّرف على الكثير من تفاصيل عالم الكلاب الذي كنت أجهله إلى وقت قريب، وأظن أن اصطحاب سيدة أو سيد لكلبيهما لا يكون إلا في عالم السينما، والمسلسلات، والمسرحيات الأجنبية..) .
وما يكون دافعاً له لأن يتعرف على المزيد من الكلام، وهو الذي استغرق في تعقب عالم الكلاب، ومن ذلك:
( هناك أربعمائة قبيلة أو صنف للكلاب، لكنها جميعها، تنحدر من أصل واحد من الكلاب المستأنسة، غير الوحشية، صغيرة كانت، أو كبيرة، بوليسية، أو راعية قطعان المواشي، وحتى كلاب الزينة نفسها. إنها أعظم صديق من عالم الحيوانات للبشر. للكلاب لغة، ولها شيفراتها. هناك دراسة صدرت عن أحد مراكز البحوث المتعلقة بالكلاب تبين أن للكلاب حوالي تسع عشرة إيماءة، منها ما يدل على طلب الطعام، أو الشراب، أو الدعوة للعب، أو لفتح الباب…!).
هذه الجمهرة المراتبية للكلاب، ليست مجرد إحصاء، وإنما إماطة اللثام عن ثقافة مغايرة لثقافته في أوربا، وبعد أن حل فيها هو وعائلته، والبون الشاسع في رؤية العالم وكائناته، من هذا المعبر الدقيق والحساس ، وهو يستعيد بين فقرة وأخرى مشاهد كلبية عن عوالم قريته، والقرى المجاورة، وكيف يتم التعامل مع الكلب عموماً. لكأن النظر إلى الإنسان، ومعرفة موقعه، يكون من خلال سلوكية الكلب، وكيف يتم التعامل معه، هنا، وعلى مختلف الصعد .
من ذلك، انتقاله هو وأهله إلى قرية أخرى (القرية الثانية التي سكنت فيها، مع أسرتي. قرية طوبو، ولعلها تدل على- الطوب- المدفع، أو على-الطابو- نسيت. كان أكثر أهلها من الملّاكين أكثر ، ولدى بعضهم قطعان غنم، وأموال. أتذكر أحدهم وهو الحاج أحمد رشك. كان كبيرا في السن، قال لأبي: كلاب بعض بيوتنا شريكة لنا في أموالنا، فهي قد حرستنا طويلاً. منعت عنا اللصوص، حرستنا وقطعاننا وأموالنا..
كيفية التعامل مع الكلب القوي، كما قال أحدهم:
إن هجم عليك كلب، فليس أمامك إلا أن تجلس في مكانك. اقتعادك الأرض يعني استسلامك. الكلاب أيضا تتلذذ بالقوة، بالسيطرة، بالانتصار. ..).
وفي السياق نفسه ( الحديث عن ارتباط القرية بالكلاب وتفاوتها وحكاياتها ).
العالم القيمي لكلاب قريته، وما فيه من حميمية أهلية، أو طريقة تعامل، يتناسب وطبيعة العلاقة بين الأهالي، وموقعهم الاجتماعي، حيث التراتبية قائمة، بمفهومها العائلي، والعشائري أو التقليدي كثيراً.
وإن تصريحه بجهله في كل مرة، أو تسمية صدمته بما هو مستجد، يعبّر عن ذلك (كنت أظن أن للكلاب ملامح واحدة، وأنها تتشابه، وما بينها من فروقات إنما هي طفيفة، لكن بدا الأمر لي هنا مختلفًا، إذ هناك فوارق كثيرة في ملامح وجوه الكلاب.أجسادها أحجامها. طباعها. منها ما يذ ّكِر بالحصان، ومنها ما يذ ّكر بالقط ومنها ما يذ ّكِر بالذئب، ومنها ما يذ ّكِر بالخنزير، منها ما يذ ّكِرني بالثعلب، أو السنجاب، أو النمر، أو الفهد، أو الفيل، أو الدب، أو األرنب، أو القط، أو الغول، أو الديناصور، أو الإنسان، وإلى ما هنالك من أشكال حيوانية قد لا تخطر على البال!).
وفي مثال حي من الصداقة الودية، أو الملاطفة بينه وبين بيانكا، وسماع ما لم يكن له به علم :
( رائحتها المنعشة صارت تلفحني أكثر. إنها تخترق كل مسامات جسدي. ستكون ليلة جميلة. سنشرب معًا، ثم أخرجت علبة دخانها وولاعتها، من محفظتها الزرقاء، وأشعلت سيكارتها، وبات دخان السيكارة يتصاعد فوقنا، راسماً خطوطاً ودوائر تكبر ، وتتلاشى. لم يبتعد كلبها عنا كثيراً، راح يشُّم أرض المكان، بدا لي جميلاً أكثر مما كان عليه، طوال الأشهر الماضية..!).
وفي الحديث عن ” يوم الكلب العالمي “، هكذا:
( لم أكن أعرفَّ أي شيء عن يوم الكلب العالمي ، خيّل إلي أنها تمازحني، وهي تدعوني لحضور حفل تقيمه في منزلها. صارت تحدثني أن العالم كله يحتفل في يوم الرابع والعشرين من شهر آب في كل عام بهذا اليوم، تقديراً لدور الكلب كحيوان أليف آثر العيش مع الإنسان، وراح يؤازره في حياته، ويدافع عنه، ويحرسه، بل شارك معه في حروبه على خطوط الدفاع والهجوم وفي مجال سلاح الإشارة أو البريد. الكلاب فصائل. قبائل. أنواع. أجناس مختلفة، بينها ما هو مشترك من الصفات، كما أن لبعضها صفاتها المختلفة. لمح كلبها كلبًا آخر يسبق صاحبته، هرول نحوه. أرخت صاحبته هي الأخرى العنان لكلبها، وراحا يلعبان معًا. لا أميز بين ذكور الكلاب وإناثها. ربما هما يتغازلان.).
طبعاً، ثمة الكثير مما يمكن التأكيد عليه، جهة الاهتمام بالكلب ومغزاه. لماذا الكلب وليس سواه، رغم أن الاهتمام بالحيوان في الوقت الراهن، يشهد حضوراً متزايداً به، على خلفية من وجوه العنف المدمرة للحياة والبيئة .
أوربياً، مثلاً، ومن خلال طبيعة العلاقات الاجتماعية، وتنامي الفردية، كان الكلب الحيوان الأكثر قدرة على تلبية العاطفة المطلوبة، أو ملء الفراغ العاطفي، وللمس حيويته، ودون اعتراض، كما هو المقروء في بحث ” فيرونيك سيرفيه: الحيوانات شركاء اجتماعيون تماماً les animaux sont des partenaires sociaux à part entire” مثلاً:
(فإن اللمس هو موضوع المحظورات والتوصيات المقننة اجتماعياً. يعتبر لمس شخص غريب انتهاكًا للمساحة الشخصية (ومن هنا تأتي حقيقة أن مثل هذا الفعل ، حتى لو كان عرضيًا ، يتبعه اعتذار أو تبادل علاجي) ، في نفس الوقت الذي يتم فيه قبول أن يتم لمسه ، ج هو قبول تغلغل شخص آخر في مجاله الخاص. يشير اللمس إلى علاقة حميمة في نفس الوقت الذي تنشئه فيه. لا يتم تنفيذ المحرمات الاجتماعية المتعلقة باللمس عندما يتعلق الأمر بالحيوانات ، لأنها لا تتمتع بوضع الأشخاص الاجتماعيين الأكفاء (وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة للأطفال). لذلك نشعر بأننا مخولون لمسهم.).
أما لماذا يحصل ذلك، فلأننالا نستطيع لمس أي شخص، إنه خرق لحدود علاقة شخصية، لهذا، فنحن حين نكثر من لمس الحيوان الأكثر قرباً منا: القطة داخل البيت، والكلب داخله وعلى عتبته، ولحظة ملاعبته،كما لو أننا بلمسه نفرغ شحنات، كان عليها أن تمرَّر عبر نظير من نوعنا .
هكذا نجعل الحيوان، وقد كيّفناه بمقاييسنا، على هيئة رغباتنا، وقد ضاقت رغباتنا ببعضها بعضاً، أو لوجود سواتر نفسية، واجتماعية لها، وسياجات فردية مانعة للاقتراب إلا ضمن مسافة معينة، بينما مع الحيوان: القط، أو الكلب، فليس من توقيت محدد، وكأن الوحشي نطلقه في لمسنا له، وعبر أساليب تمسيد، أو حركات يدوية، أو جلدية” وجهية ” وسواها مختلفة .
ولنقرأ له ما يعمق قوله ( يعرف السياسيون الذين التقطوا صورتهم مع كلبهم أنه في مجتمعنا سيتم النظر إلى الرجل بشكل أكثر إيجابية إذا كان برفقة حيوان أليف أو كلب أو قطة. ).
والأهم من ذلك، ما بات يعرَف عن الخط المعاكس لما هو معرفي، أو استرشادي، واستهدائي بما هو حيواني، حيث إن ” دومينيك جيلو ” يقدّم لنا إشارات مضيئة بهذا الخصوص تاريخياً، واجتماعياً، ظاهراً وباطناً، من خلال “ما تعلمنا إياه الحيوانات عن قصد الكائنات. أهمية التعديل التفاعلي للنوايا “:
( كيف نفسر العالمية تقريباً لوجود الكلب منذ نشأة البشرية؟
أظهرت الدراسة أن الحيوانات الأليفة ، وخاصة القطط والكلاب ، قادرة على إقامة خطوط اتصال مع البشر. ومن هنا نشأت علاقة حقيقية مليئة بالتواطؤ بين الحيوانات والبشر. سواء كانت للصحة العقلية أو البدنية ، الحيوانات الأليفة مهمة.
دعونا أولاً نفحص أطروحة تدجين البشر عمداً للكلاب. وفقًا لهذه الأطروحة ، فإن الكلب هو نوع حُوِّل من جوهره البري بفعل الإنسان. سيكون مثالًا نموذجيًا للهيمنة البروميثية التي يمارسها الإنسان على الطبيعة. على هذا النحو ، يجب أن يُنظر إليه على أنه قطعة أثرية أكثر من كونه كائنًا متوحشًا حقيقيًا.
من المحتمل جدًا أن تدجين الكلاب بدأ قبل عصرنا بحوالي 30.000 أو أقل من 50000 عام
طبيعة الكلب هي العيش بالقرب من الناس. إنه حرفياً في البرية عندما يكون إلى جانبنا: لذلك فهو متوحش طالما أنه محلي ؛ إنه طبيعي ، طالما أنه قطعة أثرية. إنه ليس “هجينًا” أكثر أو أقل.
من المسلم به أنه يمكن القول إن سوء التفاهم بين البشر والكلاب أكثر من سوء التفاهم بين البشر أنفسهم.).
وما يتأكد من صواب الفكرة الباذخة في هذا التوجه، لدى دوبريل ( يجب على الإنسان أن يقطع عن غريزة الحفاظ على جنسه وحده لاحترام الحياة بجميع أشكالها لأن حياته مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالزخم الحيوي المحيط به من جميع الجوانب.).
يصبح السارد، بالطريقة هذه موضوعاً للألمانية، وهي بدورها شاغلاً نفسياً له، مع فارق المكان والزمان، ونوعية الثقافة التي ترسم الحدود بينهما. حيث نجد أن عليه، وليس عليها إثبات جدارته بعالمها، وليس العكس، لأنه هو من مضى مهاجراً صحبة عائلته، كسواه إلى بلدها، أو قارتها، ولغتها وثقافتها، وبالطريقة هذه، ومهما أوتي علماً، أو حضور غواية، فإن الثقافة المتداولة وبطابعها المؤسساتي تفرض حضورها بقوة.
كما في هذه المواقف أو اللقاءات :
في إظهاره لها ما هو مقبل عليه، لتقبل به أكثر، إنما يجهد نفسه كثيراً، كما أنه يدرك عمق المسافة الفاصلة بينهما: اللغة، تعلمه للغتها ، فهو ناقص الحضور كثيراً هنا:
( بعد أن شرحت لها أني أحب القراءة كثيًراً، حاولت أن تهديني رواية “ساعة بعد منتصف الليل” لهيرمان هيسه كاتبها الألماني المفضل، غير أني قلت لها: الآن أنا بحاجة إلى قراءة كراريس الألفباء وقواميس المبتدئين، وقراءة الروايات بالألمانية فوق طاقتي. لكم كنت أحلم أول مجيئي إلى ألمانيا أن أكتب الشعر بالألمانية.).
ويشار هنا، إلى أن ” ساعة بعد منتصف الليل ” ليست رواية، وإنما مجموعة شعرية لهيرمان هيسه ” 1877-1962 ” وقد نشرت سنة 1899، ولم تلق اهتماماً .
وما يمضي به إلى أيام جده وحكايات جده، ليتوازن من الداخل، أي وهو يورد شذرات من ذكرياته عن جده في سرخت، وسرحد.. وعن طباع كلاب القرية مع الكلاب الغريبة واتحادها ضدها. وذكريات لأهل ومعارف مع كلاب القرى المتناثرة في منطقته.
أي عن عالم الريف الكردي، إن جاز التعبير، وما كان يقال عن الكلب” الكردي ” هناك .
وما يصدمه في البلد الجديد على أكثر من صعيد، مثلاً في ( عالم ساحر، عن هجرته العائلية إلى ألمانيا بسبب الحرب في بلده سنة 2011، وتخيله أن هناك فتاة تكلمه، فإذا بها تكلم كلبها.)
ومتابعة أخبار الكلاب في كل شيء.
وما يخص ” تراجيديات “، ومن وجهة نظره ( حين حدثتني بيانكا عن قصص نفوق كلبها السابق، والذكريات الحزينة لفجيعتها بكالبها الثمانية واحدًا واحدًا، أحسست بمدى الألأم الرهيب الذي تعيشه، فهي تعنى بآلام كلابها كما تعنى بآلام البشر، إذ إنها تهتم بالحيوانات جميعها، ولعل هذا ما جعلها تكون من هؤلاء النباتيين الذين لا يأكلون اللحوم، ولكن دون أي إعلان عن ذلك، إذ تتصرف وكأن الأمر جد عادي، ولربما كانت تحس في ذاتها بأن أكلة اللحوم من أصناف المجرمين..!).
وفيما أشرت إليه سابقاً عن نوع اهتمامه بعالم الكلاب ( راق لبيانكا أنني بّت أفكر في كتابة دراسة عن أهمية الكلب لدى الألمان، ولربما هو فرع من دراسة يجب أن تشمل الأوروبيين كلهم، فهم يشتركون في العناية بالكلاب، فقد أدخلوه بيوتهم، بعد أن طردنا كلابنا من بيوتنا، بسبب نجاستها، وهي التي رأت فينا خير ملاذ، وقاطعت أقرباءها الذئاب، وباتت تواجهها دفا ًعا عن البشر. بل عن حيوانهم، ولكم من كلاب راحت ضحية وفائها على مدى تاريخ ميثاقها مع الآدمي، الميثاق الذي لم تخنه، بل ظل أبناء الشرق. أبناء عالمنا، ينكثون عهودهم معها، ماعدا حالات استثنائية تتم تحت يافطة: الرفق بالحيوان التي نعُّدها من بين مهازلنا العتيدة.).
لينوه إلى ما هو تاريخي بصدد هذه العلاقة (إلا نحن الكرد. آباؤنا كانوا يعتمدون على الكلاب في مرحلة ماقبل إسلامهم، أيام غزو مناطق كردستان على يدي عياض بن غنم وجنده، بعد أن كلفه عمر بن الخطاب بهذه المهمة، وكان أن أدخل بعضهم الإسلام بالسيف، ليدخل آخرون بحريتهم، بعد أن أصبح هذا القوس الكردستاني بين كلابتي خطريْن محدقين.).
وما يشده إلى موقف تجاه نبْت روائي ألماني، لرمز روائي ألماني(مسكت برواية” سنوات الكلاب” لغونترغراس. لم تمنعني استطرادات الرواية، وطريقتها البسيطة في السرد من متابعتها. استوقفني الكلب الأسود الهارب من الفوهرر، مسابقً عربات القطار. الرواية استغرقت في قراءتها أكثر من اللازم. شعرت بنعاس شديد.).
وهي إشارة إلى رؤية من منتم إلى عالم آخر، إشعاراً بأن ليس كل ما يشاد به، يستحق الاهتمام، ولا بد أن تنويهاً قرائياً كهذا، ينطلق من ذات السارد، ويعود إليها، ليكون أكثر توازناً مع نفسه .
وما يرجعه إلى عالم الخدمات العائدة إلى الكلاب:
(ثمة حديث عن كلاب سلاح الإشارة في الجيش. عن الأقنعة والكمامات التي تخصص للكلاب لئلا تتسمم بالغازات الكيميائية، أما الإشادة الأكثر أهمية في هذا الجانب فكانت بكلاب خنادق خط النار. بعضها يستحق الأوسمة، ولا بد من إيجاد نوط شجاعة رفيعة باسم أشجع الكلاب، ناهيك عن أن الكلاب أسعفت حوالي مليون جريح، ونقلتهم من المناطق الوعرة، ويختتم حديثه بالقول: لقد خبرنا في الحرب كلاباً بطلة عمالقة باسلة، كما أن هناك كلاباً عدوة، وكلاباً صديقة. الكلب العدو يجسد روح صاحبه، أما الكلب الصديق فهو يجسد روح الكلب ذاته. ).
وثمة إشارة جميلة ومشعة، بخصوص سعار الكلاب (الكلاب المسعورة كانت تترك أصحابها وتتوجه إلى البراري وتشكل خطراً على الناس. السعار نتيجة قهر، ورفض للعبودية. السعار ثأر من تاريخ استعباد الآدمي للكلب. قالها قريبي، وهو يعُّد لفافة تبغه ليخرج إلى الشرفة ويدخنها. ثم غادرت الغرفة متوجها إلى الحمام كي أستحَّم. كي أتطهر..).
وحين نقترب من نهاية الرواية، يبدو أن التباعد النفسي والثقافي يبقى قائماً، وما يعترف به، يعزّز هذا التوجه:
(خلافه مع بيانكا حول الكلب
وتذكره للكلاب في بلده:
تذكرت ما كان يقال عن الكلاب البوليسية التي يستخدمها رجال المخابرات في سوريا، ويضعونها في منفردات أي سجين يريدون التخلص منه. كانت تنهش ضحيتها، أيًا كان، وهو يصرخ، ولا أحد يستجيب له. بل ثمة ما كان يقال عن كلاب يتم تجويعها ووضعها في منفردات بعض السجناء السياسيين، لتأكل أجسادهم، وفق مخطط مرسوم لها..!
كنت أسير باتجاه باب مركز البوليس، وحدي، وقفت هناك، قلت لهم: أنا فلان، أتيت لأعترف لكم بأكثر من جريمة كبتها. أريد مترجماً لأعترف بكل شيء. أدخلوني إلى مقر المركز، التم حولي عدد من رجال البوليس. لا أعرف رتبهم، كان من بينهم الضابط الذي استقبلني أول مرة. جاءوا بالمترجم السوداني، الذي حضر على جناح السرعة، يبدو أنهم حدثوه في الطريق عن اعترافي الخطير. كان يضحك. قال لي حدثنا كيف قتلتهما: قلت له: سقيت الكلب جرعة من سم الفئران. وضعتها له في عبوة الماء، لأتخلص منه وطعنت صاحبته بالسكاكين، كي آخذ المخطوط وأبيعه. كانت للمخطوط خريطة تبين موقع مقبرة هتلر، وأسراراً ومواقع استراتيجية كثيرة….
كانت رائحة عطرها التي تملأ الغرفة. كلب الطفولة”كازي ” gazîكان يتمسح بي. ربتت على رأسه. لقد وقف معي، عندما هاجمتني كل تلك الكلاب لتنهش لحمي، متهمة إياي، بأني كنت وراء غياب بيانكا وروكي. كنت أصرخ، ولم يكن صوتي يتجاوز فمي. لم يكن ثمة أحد يسمعني لولا” كازي ” gazîوحده…
تباً لهذا الكابوس اللعين..!
كفى إذاً !
سيرتي والكلاب باتت جد أليمة. إنها مصدر معاناتي منذ طفولتي. نباحها كان إحدى وسائل تعذيبي طوال حياتي، وها أنا ذا قد دخلت طوراً آخر معها، مع بيانكا وكلبها روكي، بل مع الأحد عشر كلبًا، على حد سواء.).
وحيث يؤرَّخ بنهاية الرواية بـ ” أواخر تشرين الثاني 2018 “.
المعاناة قائمة، وهي غير مشهود لها بالزوال، وهذا الانتقال من عالم كلبي فرعي إلى آخر، يشكل سلسلة واحدة، من حلقات الرواية التي تزكّي الكلب، وتبرّئه من كل سلبية منسوبة إليه، حيث إن الجمهورية، باسمها ومعناه، تطرح الكلب اسماً وموقعاً ومقاماً، وليكون هو المعري لدواخل النفس، والقادر على خلق اللحمة بين النفوس، وليس ما يُنسَب إليه، من صفات مصدرها الإنسان، وحين نلاحظ أن هذا الكم الهائل من المواصفات، والتوظيفات كذلك، إلى جانب التخريجات القيمية، والجمالية، في الفن والأدب والفكر، من ابتداع الإنسان، وتدل على معرفة معمقة من ناحية، من قبله بالكلب، ومسعاه إلى استلابه، ليكون المرسوم كما يريد، وليس كما هو عليه الكلب، أي ليكون الأكثر قابلية لأن يُرثى، ومن خلال يكون الإنسان مساءَلاً من قبله: الكلب.
طبعاً، هناك المزيد مما يمكن قوله، إنما في مقدوري إيراد، نوعية علاقة مركَّبة أخرى، تقوم بين الإنسان والحيوان،وفي البادية، أو يعلم بها أهل البادية، وكما توقَّف عندها الباحث المغربي عبدالفتاح كيليطو، في كتابه ” الكتابة والتناسخ ” وفي خاتمة الكتاب بالذات، بصدد من يمشي ليلاً في بادية لا نقاط استناد فيها، وخشية التيه، يقلد صوت الكلب: نباحه، أي يستنبح، ومقصده، أن ترد عليه الكلاب، وبذلك، يدرك أن هناك مساكن، أو بشراً في الجوار، فيأوي إليهم، وربما، يكون هناك من يستنبح رداً على استنباح آخر، أي بشر مقابل بشر، يكونون قطاع طرق أو لصوصاً، لإيقاع المستنبح الأول في مصيدتهم، وفي كل ذلك، إفصاح عن مدى حضور الكلب في البادية في الليل والنهار ، أي ما يمنح الكلب اعتباراً، يصعب، أو يستحيل تجاهله في الحالة هذه.
في عود على بدء، والتذكير مجدداً، بما تفوه به أورهان باموق، يمكن الإضافة، إلى إبراهيم يوسف، يكتب لكي يثبت أنه قادر على العيش، قادر على الإبداع، وأنه، وهو مسكون بهواجس الغربة، ومصاعب المغترب، قادر على تحويل الأرض الملحية لاغترابه إلى واحة خضراء، هي روايته هذه ” جمهورية الكلب ” والتي تستحق الترجمة إلى اللغات الحية، والاحتفاء بها بجدارة!