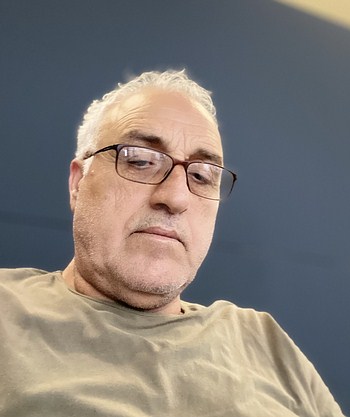عمران علي
كمن يمشي رفقة ظلّه وإذ به يتفاجئ بنور يبصره الطريق، فيضحك هازئاً من قلة الحيلة وعلى أثرها يتبرم من إيعاقات المبادرة، ويمضي غير مبال إلى ضفاف الكلمات، ليكون الدفق عبر صور مشتهاة ووفق منهج النهر وليس بانتهاء تَدُّرج الجرار إلى مرافق الماء .
“لتسكن امرأةً راقيةً ودؤوبةً
تأنَسُ أنتَ بواقعها وتنامُ هي في متخيلك
تأخذُ بعض بداوتكَ وتعطيكَ من مدنيتها :
املأ لها نشيدكَ لها بالصحارى الغامضةِ والخيول
واتركها تبحثُ عن الظلالِ
وعن حروب القبائلِ على الوهم “
حين يطالعك شاعر مكنتّه ملاكاته من لجم زمام الأبجدية وإرغامها على التماهي وفق نسق روحه وما كان سوطاً مسلطاً عليها ومحتاطاً لنسغها، كم كان حريصاً على أن لاتشذّ عن البلاغة، وتفقد مسارها، وما أقدَرَه كونه رؤوماً في احتواء خبب اللغة، والتعاطي بأناة في زادها حينها فقط أدركنا جازمين بأن القصيدة تسير على سكة الابداع .
” كائنُ الهشاشة
البارحة أخبروني أنيَّ ميتٌ منذُ بعيدٍ
وأنّّ هذا الذي ( أنا ) روحُ بحارٍ عنيدٍ
أو عازفُ ربابةٍ
لهذا كلّما اشتدّتْ ريحٌ وتلاطمت أمواجٌ
ترتفع ساريةٌ في روحي
وينبعثُ صوتُ آلةٍ بريةٍ وترها مقدودٌ من الشدائدِ، يُنذرُ بقرب الشواطئ ..
……
….. “
في إحدى جلساتنا طلبت منه الرجوع إلى الشعر كونه يعتمل في روحه ويحتطبُ منها، وكونه لايمتثل إلا لغابة الشجر لذا نرى كيف أن الثمر يثمل برحابة بين أصابعه، ولأن النقد طاف بحيّزه على مساحة تخيّله فبات منشغلاً به، ذلك الذي لاطائل لقلبه منه.
وحين تفاجأت باللامفاجأة بكتابه الجديد، مخطوطه المعدّ حالياً للطبع، تلمست على الفور عودة الإبن الضال إلى كنف التخييل، لأتحسّس فورها نبرة العشق التي كانت مركونة على رفوف التريث، ومعدّة بذلك كل ماأوتيت من أسباب التحفيز للظفر في ماراثون الدهشة، ولتطالعنا في أبهى صورة من خلال هذي المناشدة لأصدقاء بأن يكونوا على دراية بالذي يحفّ بقلبه قبل عينه
، وهل هناك أجمل من هذا السراب الذي يبثّه في لهاثنا ويحفزّنا بالجري إليه، عسانا نشهد لقمحها في سنابل التفاصيل .
“أرسلُ صورتي للأصدقاء
أكتب تحتها : أنا الذي على اليمين
وعلى يساري حقل القمحِ الذي أنتِ
لكن لا أحدَ يراكِ سواي ..
خذوا عيون قلبي وانظروا لتَروا
واتركوا عينيّ لأصرخ بهما ! “
ولكونه عين الذئب المتربص في شيمة الكلام والوفي للوجع الشمالي كيف لنا أن لاننحاز إلى مجريات تبصره، ونمعن مليّاً في هذا الأفق حيث يبدد اللامعقول، ويحيله إلى سائد، وهل لك أن تتخيل نفسك متلاشياً وأنت في حضرة صورتك
” نظرتُ في مرآتي
إلى أنْ صارتْ نافذةً
ورأيتُ – بدلَ صورتي – غيّابي “

من خلال قراءتي للعمل لم تغب عن بالي نبرة التحسر والحنين اللتان أخفاهما الكاتب وكأن به يرمي بمفاتيحهما إلى صدر الراين علّه الماء يشاركه الوجع ويخفي عن ملامحه تلك النبرة التي تسكن عميقه .. نبرة المكان الذي استحال إلى خواء وفاض بالغبار، إلى شواهد لم يتسنَّ لأحجارها سبر البياض وتاركاً في خاصرة الروح ألف سبب للبكاء الكثير .
” كنتُ أصرخُ ملء عيني
وأنتم تهيلونَ الترابَ عليها
كنتُ قوياً بما يكفي لأرفع العالم عن صدر الخطيئة
وأصنعَ نافذةً في الكفن ..
سمعتُ نحيبكم، وضحككم، نباح بعضكم
وميّزتُ في ذلك الموقف الرهيب
عواءً مكتوماً
وكان ذئبٌ حارٌّ
يستفيقُ في دمي البارد فأعوي
لمْ يسمعني أحدٌ، ولمْ يصدقني أحدٌ
واكتفيُ بي، لأفعلَ مالايفعلهُ الآخرونَ
أنا ذئبٌ كثرٌ وهذا الموتُ قليلٌ عليَّ ”
وبالعودة إلى البدايات التي يبدي بداياتها تباعاً وفق رؤاه المتخيلة، والتي لايخفى فيها كمّ الأنين المندرج في صراخه الدؤوب، وتلك البحّة الآهلة بالنحيب والتي لاتقل عن عواء ذئابه المنفلتة في براري التهميش والملاصقة للصفير المنفي في كابينات قطار الشرق والمنسي على لائحة الدسائس .