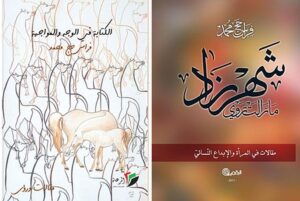هيفي الملا
كثيرة هي الدراسات والمقالات والروايات التي تناولت موضوع تشظي الهوية وصعوبة الاندماج بالمجتمعات الغريبة والاصطدام بحاجز اللغة التي تُعتبر المفتاح الأول للتفاهم وفتح الأبواب المغلقة بين مجتمعيَن يُعتبَر البون شاسع بينهما .
الضياع والإحساس بالتشتت في مجتمع معروف بتنامي الفردية، ووصف سايكولوجية المغترب في ظل تغريبة معاصرة، وذلك ضمن قالب روائي جميل، هي الأجدر بإيصال الفكرة لأن القالب الحكواتي والسردي يناسب طبيعة الإنسان التي تميل لسماع الحكايا الواقعية والمفترضة و المتخيلة وكيف لو كانت شذرات من سيرة لاجئ، بل مرآة تعكس حياة الكثير من اللاجئين، وخاصةً كبار السن الذين يعانون من صعوبة الاندماج وتعلم اللغة، لأن ذكراتهم متخمة بالذكريات وأرواحهم مفعمة بالحنين.
“رواية الكاتب السوري الكردي إبراهيم يوسف جمهورية الكلاب” تصب في خانة الاندماج وشؤون اللجوء لكن بإسقاطٍ جديد وهو المضي في تفكيك العلاقة المركبة بين الإنسان والكلب ونظرة مجتمعيَن مختلفين في الرؤى إلى طريقة تربية هذا الحيوان الذي رافق الإنسان منذ القدم .
ألمانيا تعشق الكلاب وإن أدرجنا كلابها في سلم الأولويات، تأتي حسب الأهمية والأولوية كالتالي : الأطفالِ – النساء – الكلاب – الرجال وربما كان هذا التسلسل شفاهياً مقتبساً من استنتاجات وإفرازت تعاملهم مع الكلاب التي تحظى برعاية خاصة، مبرر هذا إن الكلاب لها روحاً يجب أن تُراعى وجسداً ينبغي المحافظة عليه من التعذيب، بخلافِ الفكرة التي يحملها بطل الرواية الكردي “ألان النقشبندي” الآتي من بيئةٍ الكلب فيها يتدرج بعد الإنسان، يستخدمه فقط لحراسة أغنامه، أو للتباهي أو حراسة أمواله من السرقة كما بعض العائلات الإقطاعية .
ذاكرة البطل متخمةٌ بالذكريات عن مسقط رأسه والانتقال بين مناطق الجزيرة السورية وطفولته التي شهدت حكايا عديدة عن الكلاب التي تحب الكبرياء لذلك يصمت الضيف أو العابر أثناء نباحها وهجومها، وأهل البيت الذين يعطون الماء للضيف إذا نبح عليه الكلب ،خرائط بول الكلاب ورسمها لحدودها التي يجب ألا يتجاوزها كلبٌ اخر، العائلة التي أُحرِقت في دارها بعد أن اُبتُليت بداء الكلب المعدي والخطير، إطلاق النار على الكلب الهرم بعد تقاعده عن العمل وعدم قدرته على مساعدة صاحبه، كلاب البادية وكلاب سنجار التي يُقدم لها الفلفل الحار مع طعامها وتصلم آذانها لئلا تكون نقاط ضعف في جسدها الرشيق، الأطفال الطائشون الذين يحرقون الكلاب بصب اللدائن المحروقة على أجسادهم.
ومهما كانت قيمة الكلب في مجتمعنا وثقافتنا في التعامل معه، لاشي يبرر البتة القسوة في التعامل مع الإنسان والحيوان أيضاً، لكنها التربية وسلوكيات التعامل والموروثات، فكلها تنتج منظومتنا القيمية والسلوكية، وهي التربية نفسها التي تخلف مع آثار الخوف على الأطفال هشاشة وتردداً في المستقبل، فخوف اليوم هو شبح الغد “ابنة العم فليت تعوي، الخالة حفصدي تعوي، أبناؤهم بناتهم يعوون،” ويتوج هذا العواء المسعور بالحرق الجماعي لهم، ويتتوج خوف الطفل بالتبول ليلاً، وبتميمة معلقة في رقبته تحفظه من نباح الكلاب وأشباح الموتى.
ارتبطت الكلاب بمجتمعنا بالنجاسة ومن يلمسها وجب عليه التطهر بالتر اب الأحمر ،حمل البطل وزوجته هذا السلوك لألمانيا، وهم يتذمرون ويشعرون بالقرف من الجيران الذين قلما نجد أحدهم لا يصحبه كلب، فهم يلمسونها يطعمونها يحضنونها يسيل ريقها على أيديهم دون أن يشغل بالهم التطهر، لأن هذه الفكرة الدينية لاتمر بخاطرهم، فكلابهم تملأ عندهم الفراغ العاطفي وتعوض عن الصديق، وما أحظاها من كلاب تلك التي لها جمعيات وحدائق خاصة وأطباء وأدوية وأطعمة تنفرد بها الأرفف، ليتحسرَ الراوي “لكم هي مسكينةٌ كلابنا! إنها كلاب العالم الثالث”
صراع ثقافتين إنسانيتين لكل منهما سلوكيات وثيمات من خلال تسليط الضوء على موقفهما من الكلاب و هنا لاننسى أن السلوكيات هذه لم تنضج وتأخذ شكلها إلا بعد موروثات محمولة من البيئة فكلٌ منا إفراز بيئته نحمل نظمها، تفكيرها، خصوصيتها، تظهر علينا مهما حاولنا لبس عباءة الاندماج والتحرر والتطبع بسلوكيات الغرب .
هذه الرفاهية الممنوحة للكلاب والمتعلقة بطبيعة المجتمع الألماني وثقافته، لاغرابة أن يصطدم المغترب بها، ويقف أمامها مشدوهاً، وهو في داخله يعيش تناقضات عدة غير متقبلاً فكرة إن الكلاب أهم منه، وهي التي تخرج للتنزه لدفع السأم، ويفهم صاحبها حالاتها المزاجية، بل تحتفل في عيدها العالمي لينقض كلبان قويان في هذا اليوم على ألان النقشبندي، تاركةً عليه جروح دامية وثياب ممزقة وروح مشتتة، وهو الخارج من أتون حرب شرسة تحصد ألاف الضحايا، تغتال بسمة الصغار، تهدم المدارس، تيتم وتبيد وتنسف، تحرق الأخضر واليابس، وهو قابعٌ في هذه البقعة يتمنى إرسال هذه الكلاب المرفهة للشرق لتتعلم مامعنى الخوف والاضطهاد :
“لو نرسل هذه الكلاب إلى الشرق، شهراً واحداً لتعلمت الخوف” صفحة ١٤٢
مقارنات ومفارقات عدة يعرضها الكاتب من خلال أمنيات بطل روايته الذي يتمنى أن يكون في مصاف الكلب :
“لابد أن أتعلم الألمانية والانكليزية لئلا أكون أقل شأناً وفهماً من الكلاب”
هي المقاربة ببن كلابنا وكلاب ألمانيا، من خلال اتكاء الكاتب على ذاكرته واستعانته بقصص الطفولة ، ومن خلال نقاشات الكردي ألان مع السيدة الألمانية التي تعرف عليها وأحبها، متناولاً معها مواضيع الاندماج الذي لا يكتمل بانفتاح اللاجئ فقط على ثقافة البلد المضيف بل بانفتاح البلد المضيف أيضاً على ثقافة من حلوا بها، حتى لا يكون هذا الاندماج ناقصاً بل حوتاً يبتلع الطرف الهزيل.
وعندما تحاول السيدة الألمانية(بيانكا) التقليل من شأن بلادنا التي لاتصون قدسية التعامل مع الكلاب بتعذيبها وقتلها، يذكرها بطل الرواية باستخدام الكلاب في الحروب الأوربية وعسكرتها بل وتفخيخ الروس لها في الحرب العالمية ليأخذ الحوار أفاق أرحب وأعمق .
لم يمتد زمان ومكان الرواية امتداداً شاسعاً حيث المحدودية في المكان وهو ألمانيا، وذاكرة الراوي المتنقلة في الجزيرة السورية، والزمان امتد لأشهر كانت كافية من خلال نقاشات ألان والسيدة الألمانية في التقاط تفاصيل عديدة والانتقال بين أزمنة وعوالم مختلفة حتى عالم هتلر وموقفه من الكلاب من خلال مخطوطةٍ محفوظةٍ عند بيانكا أودعتها عندها أمها أمانةً .
لغة السرد طغت بكلمات سهلة يومية مأنوسة القراءة مع رجوع الكاتب لذاكرته والاتكاء على أمثال كردية شعبية مألوفة، تراكيبه لاتقبل التأويل وخالية من الفلسفات المركبة والمنطق غير المتفق عليه، مع الإحساس بحاجة هذا السرد لبعض الشاعرية والتطعيم البلاغي المعتق، و استوقفني تكرار مبالغ لبعض الأفكار والجمل زادت الحشو ليس إلا، كتحدث البطل عن اللغة ومفرداته القاموسية القليلة التي لاتتيح له خوض غمار نقاشٍ بالألمانية .
العنوان استوقفني للوهلة الأولى كيف يكون للكلاب جمهورية؟ وفي عتبة الإهداء يقول “لا أريد لكم أن تقولوا : لكَمْ كان جدنا ديكتاتوراً!”
الجمهورية – الديكتاتور كلمات تنم عن طابع سياسي وربما تطرح أسئلة استفزازية كثيرة .
لم يكن إبراهيم يوسف الكاتب الوحيد الذي تحدث عن الكلاب وتناولها أدبياً، فحتى في العصور القديمة تناولت سرديات كثيرة جوهر العلاقة بين الكلب الإنسان والعديد من الكتاب اختاروا الحيوانات أبطالاً لأعمالهم، فهو لم يكن عفوياً في تناوله لعالم الكلاب، لكن إسقاط هذه العلاقة لإظهار التناقض بين تفكير وسلوكيات مجتمعيَن هي فكرة جميلة .
بطل الرواية شخصيةٌ تختزن تشوهات الماضي وصراعات الحاضر لذلك تبدو هشة ومترددة ، رغم أنها مثقفة صاحبة دراسات وأبحاث، وهي متهالكة في بعض المواقف و متناقضة فالشخصية التي عاشت في جوٍ موبوءٍ من الملاحقات والممنوعات والضغط النفسي، لماذا تنهار أمام محاكمة تنظر إليه بعين الشفقة؟ لماذا يضيق البطل ذرعاً ويذهب ويعترف من ضيقه وتململه بجريمة كاد يضيَّع نفسه فيها.
تبدأ الرواية في لحظة الانتهاء لحظة تمرد الراوي على وعيه، لحظة شعوره بنزع هويته عندما يقرر اقتناء كلب، يريد لهذا الكابوس اللعين أن ينتهي فالكلاب كانت مصدر خوفه وتعذيبه في الطفولة، وهو الآن يريد يريد أن يدخل معها طوراً جديدا في حياته.
هل هو الضياع أم الاندماج أم التماهي أم التمرد؟
أسئلة تبقى مفتوحة على مصراعيها .